"بالشغف وحده يمكن أن نحيا٫ وبالشغف فقط يمكن أن نتجاوز كل الصعاب"؛ درس قد يبدو قديماً ومكرراً يفقد قيمته إذا تصدر عناوين القصص العادية، التي تحاول اكتساب صفة تضعها في بؤرة الحدث، لكن قصة اليوم جديدة، وفريدة، وملهمة.
زينب شفيق التي قارب عمرها على الثمانين فاجأت الجميعَ خلال الفترة الماضية بإصدار أول كتاب لها، اختارت له عنوان "السادسة وأربعون دقيقة صباحاً". اهتم الكثيرون بالفكرة، وبعناوين الأخبار التي تُقدم عمر صاحبة الكتاب على الكتاب نفسه، دون الاهتمام والبحث في الكتاب نفسه وشغف صاحبته، التي حافظت عليه طازجاً رغم ما مر عليها من سنوات، وما مرت به من تحولات دراماتيكية.
تفتح زينب قلبها لرصيف22 وتروي تفاصيل مهمة من سيرتها. تقول إنها عاشت طفولتها في ما أسمته "الصعيد الأوروبي"٫ حيث كان والدها مهندساً في شركة السكر بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، التي دشنها رجل الاقتصاد البارز أحمد عبود باشا، وتعود إلى جوار كل مصنع أن يقيم "كومباوند" على الطراز الأوروبي لإقامة المهندسين وكبار الموظفين الذين كان أغلبهم من الأجانب.
تروي زينب: "في كل كومباوند كان يوجد مدارس وعيادات طبية ومحلات بقالة كبيرة على أعلى مستوى، وكنا كطلبة مصريين يمكن عدّنا على أصابع اليد الواحدة، في مدرسة الراهبات التي ألحقني والدي بها في الكومباوند، والذي عشت فيه 16 عاماً. انتقلت بعدها إلى مدرسة حكومية، لأبدأ الاحتكاك الفعلى بالمجتمع الحقيقي للصعيد، وسعدت بهذا الاحتكاك لأقصى درجة لأني شعرت وقتها بهويتي. ففى مدارس الراهبات وبرغم جمالها كان هناك الكثير من القيود على هويتنا وشخصيتنا. والصعايدة من أجمل ما يمكن في العشرة والصحبة".
لم تندم على أنها لم تمارس الكتابة طوال الـ80 عاماً الماضية، فهي مقتنعة بأن الفرصة وإن تأتي متأخرة فهي أفضل من ألا تأتي
بعد عشرين عاماً في الصعيد، رحلت زينب إلى القاهرة لتلتحق بالجامعة. في تلك الأثناء عاشت صراعاً مريراً بين رغبتها في دراسة الصحافة، وإلحاح المحيطين بها على أن تدرس اللغة الفرنسية التي حققت بها أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية، فيما دخل على الخط اقتراح ثالث بأن تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي كانت قد فتحت أبوابها للمرة الأولى.
تُكمل زينب: "قعدت أسبوع في عذاب٫ وفي النهاية قلت مش قادرة، وعايزة أدرس صحافة. فوافق أبي، واقتنع برغبتي. كنت شغوفة بالكتابة والصحافة في تلك الفترة، وقد وقعت في غرام الصحف والأدب بسبب أمي التى كانت على درجة كبيرة جداً من الثقافة، إلى جانب الجينات الوراثية لعائلة الأم؛ فخالي مثلاً كان أمين عام مجمع اللغة العربية، إلى جانب أن بيتنا كان يضم الكثير من المجلات التي تصلنا بشكل شبه يومي، وأذكر منها مجلة (المصور) و(الهلال)، وكذلك مجلة (السندباد)، التي ساعدتني على إجادة اللغة العربية، خصوصاً أن دراستي كانت كلها باللغة الفرنسية، ومن هنا بدأت أحب الكتابة، وسألت نفسى كيف أنميها؟ ووجدت أن الحل في دراسة الصحافة".
عاشت زينب شفيق في تلك الفترة تحولاً هاماً، بين بلد تنسلخ من الملكية وتلبس رداء الجمهورية، وهى الفترة التي وصفتها شفيق بأنها أثرت فيها وفي تكوينها بشكل كبير، خصوصاً بعد أن بدأت تستمع إلى مفردات جديدة للإعلام، ومنها "حرية".

وعلى الرغم من الشغف الكبير وعشقها للصحافة إلا أن زينب شفيق لم تعمل بها. كيف؟
تجيب زينب على هذا السؤال: "تخرجت من الجامعة في عام 1965، وكان تدريبى في مجلة روز اليوسف، واحدة من أعرق المجلات المصرية". لكن زينب رفضت أن تعمل "صحافية بالقطعة"، خصوصاً بعد أن أعلنت المجلة عدم تعيين أي صحافي بشكل رسمي٫ لأنه لا مجال للتعيين في هذا الوقت، كما أنها في تلك الفترة كانت قد ارتبطت للتوّ بشاب في نفس عمرها كان يبدأ خطواته العملية الأولى، فاختارت أن تُضحي بحلمها وتجمد شغفها إلى حين إشعار آخر.
تتابع: "كان لازم أدور على شغل أساعد به زوجي، لأنه كان لسه في بداية المشوار، كما أن الصحافة بالنسبة لي لا تحتمل القسمة، إما التفرغ لها والتحقق فيها وإما لا".
اختارت عنوانه لأن توقيت السادسة وأربعين دقيقة كان له ذكرى ممتدة معها.
عملت زينب في أكثر من مهنة، لكن أكثر ما كان يضايقها أنها مهن جامدة، لا تعرف الإبداع ولا تعترف به، وبينما تبحث عن خلاص، وقعت نكسة يونيو 1967 لتغير الكثير في نفس زينب كما تحكي لنا: "بدا أمامنا الأمر وكأننا نمضي إلى لا مستقبل. وهنا فكرنا أنا وزوجي في الهجرة إلى أمريكا. ذهبنا إلى السفارة ونجحنا في اجتياز كافة الاختبارات، ولكن فجأة قال لنا القنصل: قفوا وأقسموا بالولاء للعلم الأمريكي. حينذاك شعرت أنني سأموت٫ وبعد خروجنا قلت لزوجي كيف أقسم لعلم غير علم بلدي؟ لن أسافر. لقد تراجعت عن الفكرة. فقال: وأنا أيضاً. بعد ذلك سنحت لنا فرصة السفر إلى الكويت وبقينا هناك 16 عاماً، عملت بها في إحدى المدارس، وقمت بتدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية".
تضيف: "استخدمت كل أساليب التوصيل الجميلة الخاصة بالصحافة للتواصل مع الأطفال، فأحبوا المادة والدراسة. وبعدها كونت فريق للإذاعة المدرسية، وأشرفت على النشاط المسرحي، وخلال 3 سنوات فريق المسرح الخاص بالمدرسة حصل على المركز الأول على مستوى كل مدارس الكويت".

ربما تصورت زينب أنها بعد كل تلك التضحيات، باتت حياتها مستقرة، لكن القدر كان يجهز لها موعداً جديداً لتمارس هوايتها المفضلة٫ وتضحي من جديد.
تقول: "اكتشفت أن ابنتي موهوبة وتحب الموسيقي، ولأن دراسة الفنون في الكويت حكر على أبناء البلد فقط، اتفقنا أنا وزوجي على أن يترك كل منا وظيفته ونعود إلى مصر لنُلحقها بمعهد الموسيقي. وبرغم أن القرار أثار دهشة وصدمة المحيطين بنا إلا أننا ضحينا من أجل مستقبل ابنتنا".
عادت زينب إلى مصر في عام 1987 لتشهد على فترة تحول جديدة فى عصر اتُفق على تسميته بـ"عصر الانفتاح"، وبعد مرور عدة سنوات، حصلت على وظيفة فى مدرسة دولية، وللمفارقة كان عمرها آنذاك 65 عاماً٫ وتوقع الكل أن ترفض، لكن زينب التي، كما تقول "مبحبش أقعد من غير شغل"٫ وافقت لتخوض تحدياً جديداً، استمر لمدة 13 عاماً كانت المشرفة فيها على أنشطة واجتماعات المدرسة، ومع انتشار فيروس كورونا في عام 2019، حلت الأزمات على العالم كله، لكن زينب شفيق وحدها استفادت من تلك التجربة الأليمة.
تحكي: "قررت التقاعد في تلك الأثناء وكان عمري وقتها 78 عاماً، وهنا عاد حلم الكتابة القديم يراودني، فدشنت حفيدتي لي صفحة على فيسبوك بعنوان (حكايات زهرة القمر) لأن اسم الشهرة الذي عُرفت به بين صديقاتي كان (ماجول) ويعني بالفارسية (زهرة القمر). بدأت أكتب حلقة كل يوم أربعاء"، ورغم أن التعامل مع التكنولوجيا كان صعباً في البداية كما تقول٫ إلا أنها علمت نفسها بنفسها حتى تجاوزت كل الصعاب.
خصصت زينب شفيق مجموعة من الحلقات التي اختارت لها اسم "العناوين الدافئة"٫ ومنها حلقة تحدثت فيها عن الأستاذة خديجة علي، مدرسة التربية العسكرية في المدرسة الثانوية، وكيف أثرت في شخصيتها وساعدتها على تجاوز تلك الفترة الصعبة
ومن بين الحلقات المهمة التي نشرتها زينب في الكتاب، كان شرحاً وافياً للبيئة التي نشأت بها في الصعيد وكيف شكلت هويتها، كما تحدثت عن أهمية التعليم في الصغر خلال حلقة ثانية، وكشفت كيف أسهمت المدرسة التي تعلمت بها في تعليمها الانضباط والالتزام واحترام الآخر. فيما تحدثت في حلقة ثالثة عن كيفية الاستماع للفن وتذوقه، وطقوس عائلتها في الاستماع لحفل أم كلثوم الشهري، حين كانت العائلة تجتمع حول التلفزيون لتشاهد "الست" وتستمع إليها.
خصصت زينب شفيق أيضاً مجموعة من الحلقات التي اختارت لها اسم "العناوين الدافئة"٫ ومنها حلقة تحدثت فيها عن الأستاذة خديجة علي، مدرسة التربية العسكرية في المدرسة الثانوية، وكيف أثرت في شخصيتها وساعدتها على تجاوز تلك الفترة الصعبة، خصوصاً وأن مصر كانت قد خرجت للتو من العدوان الثلاثي في 1956، وهو ما جعل زينب تشارك في أول دفعة لنشاط التربية العسكرية بالمدرسة، ووقتها تعملت الرماية والتعامل مع القنابل وخطط الإمداد والتموين لخطوط القتال، وحصلت على بطولات كثيرة في الرماية.

وبرغم أن زينب مؤمنة كما حال كثيرين بأن "زمن الكتاب راح عليه والبركة في السوشال"٫ إلا أن ردود الأفعال على الحلقات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والرغبة في توثيق تلك الأحداث التي كانت شاهدة على مراحل مهمة في تاريخ مصر، كانت الدافع لطرح هذا الكتاب، الذي اختارت عنوانه كما تقول لأن توقيت السادسة و40 دقيقة كان له معها ذكرى ممتدة.
تكشف: "لما انتقلت من مدرسة الراهبات إلى المدرسة الحكومية التي كانت في المنيا٫ كنت أضطر أن أركب القطار في الساعة السادسة و40 دقيقة صباحاً وعلى مدار 3 سنوات. وحين سافرت إلى الكويت كانت السيارة تأتى لتأخذني إلى العمل في الساعة السادسة و40 دقيقة، لمدة 16 عاماً. وحين عدت إلى مصر وعملت بالمدرسة الدولية لمدة 13 عاماً كنت أتحرك أيضاً من بيتي في الساعة السادسة و40 دقيقة صباحاً. هذا التوقيت لعب دوراً مميزاً في حياتي".

تختتم زينب حديثها لنا بتأكيدها على أنها لم تندم على أنها لم تمارس الكتابة طوال الـ80 عاماً الماضية، فهي مقتنعة بأنه قدر، وأن الفرصة وإن تأتي متأخرة فهي أفضل من ألا تأتي، ولذا أمام هذا الكم الكبير من الدعم، التي تلمسه من زوجها وكل المحيطين بها، لا تمانع في أن تطرح كتابها الثاني قريباً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






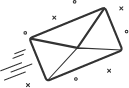
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومينتعليقا على ماذكره بالمنشور فإن لدولة الإمارات وأذكر منها دبي بالتحديد لديها منظومة أحترام كبار...
مستخدم مجهول -
منذ 5 أيامالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا
Jong Lona -
منذ 5 أيامأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...
ghdr brhm -
منذ 6 أيام❤️❤️
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ أسبوعجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ أسبوعمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.