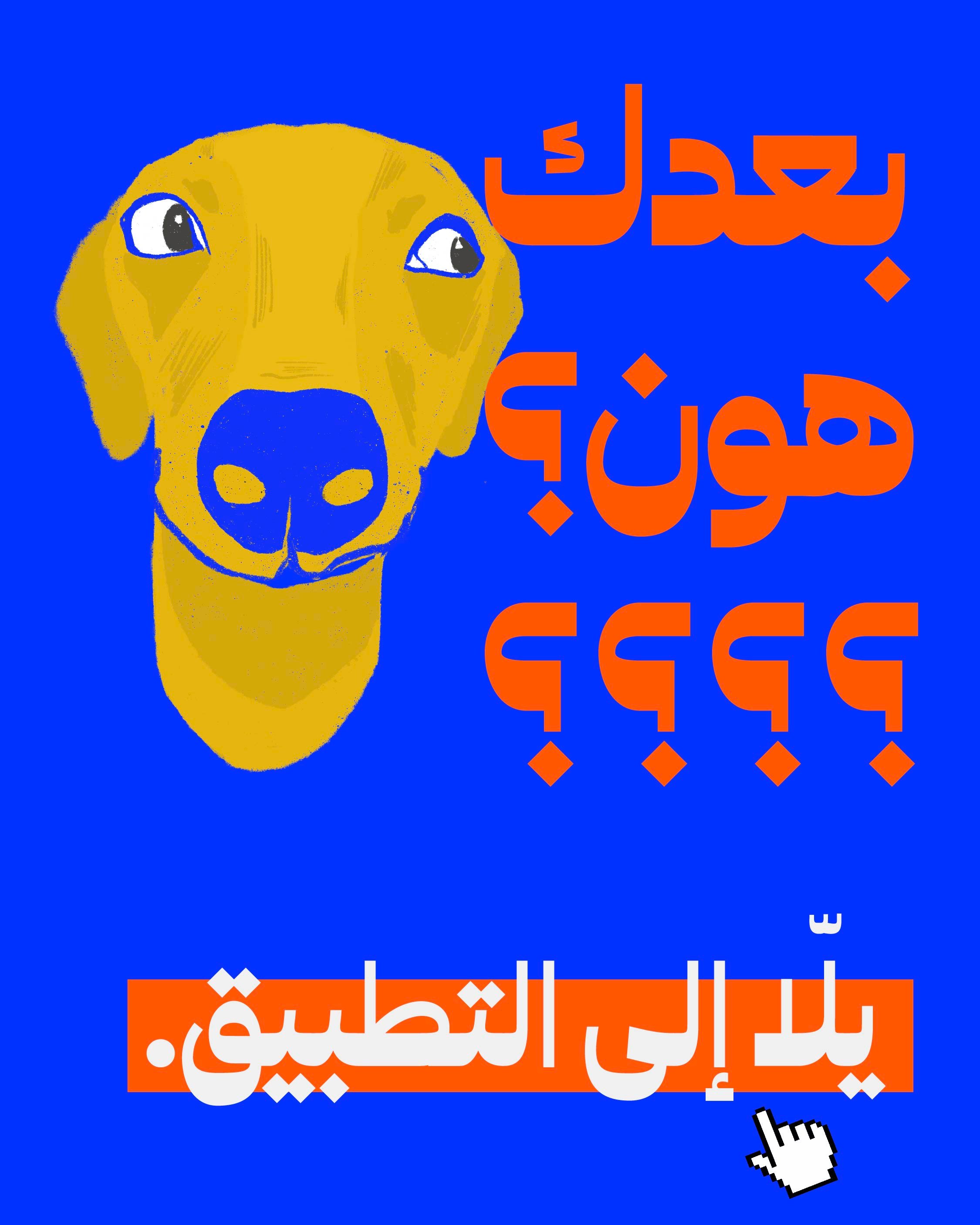قال لي صديقي الإيزيدي، إنني لست حرّةً بما فيه الكفاية للتعبير عن رأيي السياسي. حينها، واجهته بدليل، وقلت له عن صديقة مشتركة، سنّية: "انظر، إنها تعبّر بكل أريحية وطلاقة عما يجول في خلدها من آراء سياسية".
أجابني: "هي من الأكثرية، لن يلومها أحد، أما أنتِ فأقلية".
أمعنتُ التفكير فعلاً في ما تحدث به، وفي نمط التفكير السلبي هذا عن الشعور بعدم أحقية التعبير عن الرأي، أو الخوف من مطرقة الحكم السلبي أو ممارسة الإرهاب على الرأي.
قد لا يكون الأمر محض صدفة… أو عرفاً توارثته الأجيال عبر التربية الاجتماعية لتحفظ بقاءها. فالانكماش النفسي، خير من العنف الجسدي سابقاً، وعنف الحكم السلبي في الوقت الحالي.
وهذا الأمر طبعاً لا ينطبق فقط على الأقلية، وإنما على أيّ فئة أو إنسان يشعر بالضعف والخوف.
الاعتياد على العبودية
أتذكّر في هذا السياق توصيف الفيلسوف الفرنسي إتيان دو لا بويسي، في كتابه "مقالة في العبودية المختارة"، حين تساءل: "كيف أمكن لعدد قليل من الناس أن يستعبدوا أمّةً كاملةً؟". كان جوابه أنّ الشعوب تتعوّد الطاعة، ثم تحبّها، حتى تصبح جزءاً من تكوينها النفسي.
مرات عدة فتحت حوارات صغيرةً مع زملاء ينتمون بالمولد إلى الأكثرية، ولا سيّما عن المجازر الأخيرة التي ضربت الساحل. هناك رأي سائد يرى أنه انتقام من ممارسة استبدادية لنظام الأسد، حيث إنهم، وكما يحلو للبعض، يربطون النظام بالطائفة العلوية.
أنا أرى أنّ للعنف الأخير بعداً أعمق، وممارسات النظام هي جزء من الصورة الكبيرة، لكن النظام لم يكن علوياً. ببحث صغير على غوغل نستطيع أن نفهم أنه تحالف بين رزمة من المستفيدين من الجميع، تحالف بين عائلته وبعض العائلات المتنفذة والأوليغارشية السنّية. كما أن العنف كان قائماً على سرديات دينية بررت وسمحت بعدم الشعور بالذنب تجاه العنف الممارس.
في حين أنّ الدين قد لا يكون كافياً بحد ذاته للتسبب في العنف، فإن بعض أنماط العنف لا يمكنها أن تكون كذلك بدون القوالب العقائدية... ولا يمكن فهم معاملة داعش الوحشية للغاية للإيزيديين ولا مشاركة السكان المحليين في هذه الفظائع فهماً كاملاً، دون تسليط الضوء على كيف قدّمت المعتقدات الدينية مبررات فريدةً لهذا العنف
قدّم غونِش مراد تيزكور، حامل كرسي جلال طالباني للدراسات الكردية والأستاذ في مدرسة السياسة والأمن والشؤون الدولية في جامعة سنترال فلوريدا، ورقةً بحثيةً بعنوان "إعادة النظر في أطروحة العنف الديني: الأقليات في الشرق الأوسط"، وذلك في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية لعام 2019.
يقول فيها: "في حين أنّ الدين قد لا يكون كافياً بحد ذاته للتسبب في العنف، فإن بعض أنماط العنف لا يمكنها أن تكون كذلك بدون القوالب العقائدية والمبررات الخطابية للدين، وبناءً على ذلك لا يمكن فهم معاملة داعش الوحشية للغاية للإيزيديين ولا مشاركة السكان المحليين في هذه الفظائع فهماً كاملاً، دون تسليط الضوء على كيف قدّمت المعتقدات الدينية مبررات فريدةً لهذا العنف. تلعب المبررات الدينية دوراً حاسماً في التغلب على النفور البشري من إيذاء الآخرين جسدياً".
يقول لي صديق آخر: "الناس محتقنة، وما حدث أقل بكثير من المتوقع"، سألته: "وشو خص العلويين، للانتقام إذا ثلث أرباع الوزراء والضباط سنّة، وقائد الجيش عماد الفريج بـ2012 سنّي تركماني؟". تريث قليلاً محاولاً أن يصوغ حججاً مقنعةً: "إنتِ بتعرفي فوق كل وزير كان ضابط، يقله شو يعمل".
طبعاً بدأ بجملة " إنتِ بتعرفي"، وكأنه يريد أن يقطع الطريق على أي نقاش آخر مخالف، وأن يقول إننا متفقون ومنتهون من القصة، وإن كل ضابط هو علوي وكل علوي هو ضابط".
أجبته:" مع إنه البيوت فقيرة كتير بالساحل، وكانت بعضها لضباط… يعني الوزير والضابط السنّي أُجبر على الفساد، وينشال عن ظهره المسؤولية".
يقول: "إي مجبور وإلا بيقتلوه... المسؤولية الأخلاقية مغيّبة عنده قدام نعمة الحياة".
كنت أستطيع أن أجيبه بأنّ هذا الوزير هو من لهث ليستلم وزارةً، وأنّ الاستفادة تمت بالتواطؤ بين الطرفين، وأنه ليس بالضرورة أن يكون كل ضابط علوياً"، ولنا أمثلة واضحة من فهد جاسم الفريج، ومحمد إبراهيم الشعار السنّي الذي وُلد في الحفة في اللاذقية، وتولّى رئاسة الشرطة العسكرية قبل أن يصبح وزيراً للداخلية من 2011 إلى 2018، ومحمد خالد الرحمون من خان شيخون في إدلب والذي ارتبط اسمه بمسؤوليات أمنية وجرائم في الغوطة ودمشق، وعلي مملوك وهو سنّي دمشقي حسب bbc، وكان مدير مكتب الأمن الوطني، والقائمة تطول.
هل كل هؤلاء واجهة؟ هل هم بريئون مجبرون على الشر؟ ألم يكونوا شركاء أبداً في الخراب؟
مع الزمن تترسخ "العبودية النفسية" عند الأقليات. وهنا، الحرية تتحوّل، إلى فراغ مرعب للشخص المعتاد على الخضوع. وكأنه خرج من كوكب الأرض إلى الفضاء، معلّق هناك دون وزن، دون توجيه، ودون أمان.
القتل كان متبادلاً بين السلطة والمعارضة، والمعارضة قُدّم لها الدعم على حسب ما صرح به لبرنامج "بلا قيود" على "بي بي سي عربي" في عام 2016، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري آنذاك حمد بن جاسم، مفيداً بأنّ قطر ودولاً أخرى شاركت في تسليح المعارضة منذ 2012، بينما اليوم القتل يظهر باتجاه واحد وليس متبادلاً.
تنتهي هذه الدردشة كما غيرها من الدردشات القصيرة، بالصمت، وانعدام الجلد على الاستمرار في النقاش.
جينات الصمت المتوارثة
الصمت كان دوماً هو السيد في مثل هذه النقاشات، أو حتى المحاباة، فأنا هنا أقلية أو هكذا كنت أفكر، فأسكت ولا أتحدث بكامل ما أريد. فهل كان الأمر جينات اجتماعيةً موروثةً أو ضعفاً وخوفاً؟
ولكن من أين يأتي الخوف؟ أليس هناك شعور داخلي مُهدد للوجود يستدعي الخوف؟
الخوف يستدعي الخضوع والانحناء بغرض النجاة، ومع الزمن تترسخ ما يمكن أن نطلق عليها "العبودية النفسية"، تتأسس كبناء متين، حين يتعرض الإنسان لخضوع طويل الأمد، يصبح معه غير قادر على تخيّل نفسه حرّاً.
هنا، الحرية تتحوّل، بالنسبة إليه، إلى فراغ مرعب. وكأنه خرج للتو من كوكب الأرض إلى الفضاء فجأةً. هو معلّق هناك دون وزن، دون توجيه، ودون أمان.
في مثل تلك الحالة، يعشق هذا الإنسان العبودية، يريد العودة إليها، ويعود! لأنه يشعر بشيء من الأمان النسبي، كما يتجنب رعب الاختيار واللايقين، وعبء المسؤولية والتفكير.
فالاختيار متعب ومخيف، والتفكير مرهق، ويصعّب على الإنسان أن يُخرج دماغه من "راحة الطاعة" والعادة، برغم المشقّة النفسية بسبب الإذلال اليومي الذي يتعرض له.
الإذلال يتأصّل، يصبح جزءاً أصيلاً من النفس، ويبني لنفسه جدراناً وسدوداً منيعة. وهكذا تتشكل "التمسحة" و"الجلد السميك" كخط دفاع خلّبي، للتواؤم والتكيّف مع حالة الإذلال. وهذه ليست صفات مدانةً بقدر ما هي آليات دفاع نفسية متكرّسة.
صديقي آزاد لديه هذه المهارة، فلم يعد يسمع، استطاع أن ينجو مراراً من أي جدل بيزنطي، وكنت أتمنى أن ألبس "جلده السميك".
"عبودية ناعمة" في لاوعي الأقليات
يظهر لدينا وجه آخر للعبودية، أكثر نعومةً، لكنه أشدّ تعقيداً. "عبودية سلّالة" تتسلّل إلى تكوين الفرد العميق، كما لو أنها تنتقل عبر جينات اجتماعية، لا بيولوجية.
فحتى بعد انقشاع الظلم وتحسّن الأوضاع، تبقى أدران "العبودية الناعمة" عالقةً في لاوعي الفرد، حين كان أجداده يُعاملون كإنسان من درجات ثانية وثالثة، حين طوّر أجداده حالة "الذمية" ليحفظوا بقاءهم من الأكثرية المتربّصة.
التحدث بنبرة خجولة، محاباة الأكثرية، ومحاولة إثبات أنه جيد بما فيه الكفاية "ليُقبل"، ليست أخلاقاً، لكنها طاعة موروثة نتيجة احتكاك طويل بالمهانة، تسلّلت عبر الأجيال واستقرّت.
كما أنها الحاجة إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة ما.
يحدثنا غوستاف لوبون، الطبيب وعالم الاجتماع الفرنسي، في كتابه "سيكولوجية الجماهير" الذي قدّمه عام 1895، عن أنّ الجماهير تميل إلى الانصياع للقادة الذين يظهرون هيبةً وقوة، ما يؤدي إلى العبودية النفسية، حيث يفقد الأفراد تفكيرهم النقدي، وينبع ذلك من الحاجة إلى الانتماء والشعور بالأمان داخل الجماعة.
في حالتنا، هذه الأقلية تنصاع تحت وطأة إرهاب جماعة من الأكثرية، وتحتاج إلى الشعور بالانتماء والأمان داخلها. لذلك، طوّرت "الذمية". وحلقة أنماط التفكير السلبية هذه لن تكسر بسهولة، لأنّ الأجيال تتناقلها عبر التربية، ولكن ربما بوتيرة أقلّ أو أكثر.
اقتلاع "العبودية الناعمة" من اللاوعي الجمعي ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى المقاومة، والزمن الطويل. والهياج المؤقت بعد امتلاك القوة لا يندرج ضمن مسار ترميم الروح وشفائها، بل هو حالة ذُهان، ونشوة انتقامية، لا تلبث أن تختفي مع تراجع القوة. ومع هذا، فهو لا يعني عدم مشروعية الغضب أو الحراك
يشرح علم النفس الإكلينيكي "العبودية النفسية" من هذا المنظور، بأنها منظور تقييد الفرد بأنماط تفكير سلبية، حيث يتعرض الفرد للتلاعب والسيطرة، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والشعور بالعجز.
وفقدان الثقة بالنفس لدى الأقلية، هو شعور متجذّر في حاجتها المزمنة إلى إثبات أنها جيدة بما يكفي لتُقبَل.
بينما تقول الكاتبة الأمريكية جوي ديغروي، من أصل إفريقي، في كتابها "متلازمة العبودية ما بعد الصدمة: إرث أمريكا من الأذى المستمر والشفاء"، الصادر عام 2005، إنّ "الصدمة التي لا تُعالَج تنتقل"، أي أنّ الصدمة الجمعية لا تزول مع الزمن بل تتسرّب إلى اللاوعي الجمعي وتشكّل أنماط السلوك والتفكير إذا لم يُعترف بها ويُعالج أثرها.
تقول ديغروي: "كانت الأمهات يقللن من شأن مواهب أبنائهن لحمايتهم من البيض، فيقلن: إنه بطيء الفهم حتى لو كان لامعاً"، وهو ما تفسره ديغروي بالانكماش النفسي، حيث طوّرت العائلات آليةً لحماية أبنائهنّ عبر إظهارهم بمظهر غير مهدِّد للآخر.
ليس مستحيلاً
ومع هذا، فاقتلاع "العبودية الناعمة" من اللاوعي الجمعي ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى المقاومة، والزمن الطويل.
وبعض الفئات من الأقلية لديها روح مكسورة، دونية، وتحتاج إلى قرون لتنهض.
والهياج المؤقت بعد امتلاك القوة لا يندرج ضمن مسار ترميم الروح وشفائها، بل هو حالة ذُهان، ونشوة انتقامية، لا تلبث أن تختفي مع تراجع القوة. ومع هذا، فهو لا يعني عدم مشروعية الغضب أو الحراك.
برغم تحررهم وإلغاء نظام العبودية رسمياً عام 1865، إلا أن الأمريكيون من أصول إفريقية، بقوا بلا تحرر نفسي سريع، واستمرت العملية النفسية قروناً. وما زالت مستمرةً، وإن بشكل أقلّ.
الروح القوية الكاملة تحتاج إلى تراكم لقرون مديدة، مع ترسيخ لأفكارها مرةً بعد أخرى، مع الانتباه إلى أنها ليست قاعدةً، وقد تتجاوز بحراك فاعل حقيقي عامل الزمن الطويل.
وهناك أمثلة على النموذجين، فالأمريكيون من أصول إفريقية، برغم تحررهم القانوني وإلغاء نظام العبودية رسمياً عام 1865 في الولايات المتحدة، بقوا بلا تحرر نفسي سريع، واستمرت العملية النفسية قروناً. وبقيت النظرة الدونية التي تسلّلت إلى وعي البعض داخل الجماعة، وما زالت مستمرةً، وإن بشكل أقلّ.
هنا، تشير الصحافية الأمريكية أنتونيا هيلتون في كتابها "الجنون: العِرق والاضطراب العقلي في مصحّ جيم كرو"، الصادر في 2024، إلى تطور العبودية.
فبعد إلغاء نظام العبودية، استمر التمييز الاجتماعي، حيث لم يُعامل السود كأجساد، وإنما كعقول مشكوك في صحتها، وتحتاج إلى إعادة تأهيل. فمفاهيم الجنون كانت تُستخدم لتجريم سلوك الفرد العادي أو مقاومة الظلم.
تحدثت الكاتبة عن مستشفى كراونسفيل في ولاية ماريلاند الأمريكية، حيث كان المشفى مخصصاً للسود، وافتُتح عام 1911، في حقبة قوانين جيم كرو العنصرية بعد إلغاء العبودية. وفيه استُخدم الطب النفسي للسيطرة على السود وتهميشهم حتى من بعد تحررهم من العبودية.
أما اليهود في أوروبا الغربية، فكانوا مثالاً جيداً عن الخروج الأسرع من العبودية النفسية، حيث عانوا قروناً من التهميش فالمحرقة، لكنهم خرجوا، والسبب يعود لوجود تراث تعليمي قوي ومجتمعات مترابطة استثمرت جيداً في إبراز سرديتها عالمياً، بالإضافة إلى وعي داخلي عميق بالهوية والانتماء، وإلى دعم أوروبي خارجي متعاطف.
عوامل مؤثرة ستخلق بيئةً مناسبةً للخروج من العبودية النفسية، أبرزها وجود بنية ثقافية متماسكة واستعداد جماعي للتحرر. كما أنّ حجم العنف وتكراره سيكونان عاملاً ضاغطاً، لكنّ الإرادة الجمعية الواعية هي القادرة على كسر هذه الحلقة، إن توفّرت البيئة المناسبة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.