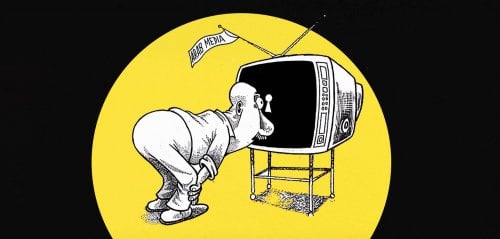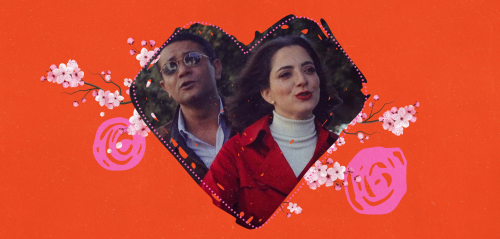يقول عالم الاجتماع السويدي جدعون سيوبيرغ إن مدن ما قبل الثورة الصناعية لم يكن بمقدورها البقاء والازدهار دون نظام سياسي قوي يدعمها، حسبما ينقل عنه عبد الجبار ناجي في كتابه "دراسات في تاريخ المدن العربية والإسلامية".
استمدت عواصم العصور الوسطى أهميتها من الملوك الذين حكموها، وجعلوها حصوناً مؤمّنة لسكنهم، فانجذب إليها السكان للاحتماء بها والاستفادة من مجاورة الحاكم. فالمدينة في أوضح تفاسيرها ظاهرة سياسية، حسبما يرى المفكر الأمريكي كينيث إي بولدينغ في دراسته "موت المدينة: نظرة مخيفة إلى ما بعد الحضارة".
ووفقاً لتلك النظرية نستطيع تفسير ضعف العواصم، بل موتها أحياناً، بموت الحكام الذين أسسوها أو سكنوها. ويجري هذا الموت على يد ملوك جدد أرادوا الانتقام أو تحقير الحكام السابقين عليهم، بمحوِ أثرهم أو الاستهانة به، ولم يكن هناك أثر للملوك أهم من المدن التي سكنوها.
يمكن رصد ذلك في حضارات مختلفة، لكننا نرصده من خلال أربع عواصم عربية (القاهرة، المنصورية، سامراء، المدائن) تعرضت للتخريب، وأحياناً للتدمير على يد ملوك استولوا عليها. فالمدينة وإن دانت للملِك الجديد، فإن روح سلفه تسكن مبانيها وفضاءاتها، ولا ينبغي لتلك الروح أن تستمر، بل تشوه أو تدمر كلياً.
المدائن، أهم مراكز الحكم في العالم تحولت إلى حظيرة أغنام
المدائن عاصمة الفرس (الدولة الساسانية)، أهم عواصم زمانها بجانب القسطنطينية، تعرضت للتحقير على يد العرب الذي حولوها إلى قرية صغيرة. العرب سموا المدائن باسمها لأنها تكونت من سبع مدن، ما يدل على اتساعها. تلك المدن هي: طيسفون، أسبانير، رومية، وجنديو خسره، وبهرسير، وساباط، ودَرْزِيجان، حسبما وثقت بلقيس عيدان لويس الربيعي في دراستها "المدائن في كتب الرحالة الجغرافيين العرب: دراسة تاريخية حضارية".
مصير المدينة غالباً ما يعكس مصير الحكام؛ فحين يموت الحاكم، تموت المدينة أو تُشوّه لتحجب أثره
حين هزم العرب الفرس ودخلوا المدائن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واستولوا على كل ما كان في إيوان كسرى من تحف وذخائر، تقرر تولية روزْبه الأصفهاني (الصحابي سلمان الفارسي) عليها. كان سلمان زاهداً، وزُهدهُ وإن كان جذاباً لشخصه، ولكنه انعكس بالسلب على المدينة، التي زهدت الجمال على يديه.

يصف المسعودي في "مروج الذهب" حال سلمان بعد توليه المدائن، فيقول: "كان يلبس الصوف ويركب الحمار ببرذعة بغير أكاف، ويأكل خبز الشعير".
كان راتب سلمان السنوي خمسة آلاف درهم، لكنه كان يوزعه على الفقراء، ويعيش من عمله في صناعة السلال من الخوص، حسبما ينقل هادي العلوي في كتابه "شخصيات غير قلقة في الإسلام".
لم يسكن سلمان القصرَ الساساني (إيوان كسرى)، بل عاش في مسكن عادي مع "العوام"، كما يطلق على الشعوب في القرون الوسطى، وكان مقرّ حكمه المسجد. في المقابل تحول إيوان كسرى بكل فخامته ومهابته إلى حظيرة مواشٍ، حيث صار مسكناً لرعاة الغنم يبيتون فيه مع أغنامهم، كما ينقل العلوي.
أُهملت المدائن وهجرها الناس باتجاه مدن جديدة أسسها العرب، وهي الكوفة والبصرة في بداية العهد الإسلامي، ثم بغداد في زمن العباسيين، واضمحلت المدائن متحولة إلى قرية صغيرة يسكنها الفلاحون، كما وصفها القزويني (القرن السابع الهجري) في كتابه "آثار البلاد وأخبار العباد".

ويوضح ياقوت الحموي في معجم البلدان، أن أعظم تخريب متعمد نال إيوان كسرى كان على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (ت 158هـ)، حيث نقل أعمدته وأحجاره إلى عاصمته الجديدة بغداد، لبناء قصره.
خراب المدائن جعل البحتري، الشاعر العربي الشهير، يرثيها في القرن الثالث الهجري، في قصيدته (سينية البحتري)، ومنها البيت البليغ الذي يتباكى عليها كأطلال، وفي نفس الوقت يصف أسطوريتها وعظم جمالها، فيقول: "لَيسَ يُدرَى أَصُنعُ إِنسٍ لِجِنٍّ/سَكَنوهُ، أَم صُنعُ جِنٍّ لِإِنسِ". فهو من جانب يتعجب من خرابها حتى صارت كأنها مسكن للجن، ومن جانب يراها جميلة حد الاعتقاد أنها من صنع الجن.
سامراء،" ماتت كما مات فيلٌ/تُستَلُّ منه العظامُ"
حين تولى المعتصم بن هارون الرشيد الخلافةَ (218هـ) كان يقيم في بغداد عاصمة الدولة، ولكنه استقدم آلاف المماليك الأتراك لتقوية مركزه أمام المناوئين، وبسببهم بنى سامراء، وبسببهم أيضاً انتهت سامراء.
كان الأتراك كثيري المشاكل مع أهل بغداد، فأراد المعتصم إنهاء تلك المشاكل، ولذلك بنى عاصمة سياسية عسكرية يقيم فيها وأجهزة حكمه وجيشه، بعيداً عن العرب، فاختار موضعاً في الصحراء لبناء مدينته، وسماها "سُرَّ من رأى"، وذلك عام 221هـ/836م، أي بعد توليه الخلافة بثلاثة أعوام، حسبما يحكي اليعقوبي في "كتاب البلدان".
احتوت سامراء في البداية على قصره "باب العامة" ودواوين الحكم والجامع المشهور بمئذنته الملوِيَّة، والسوق، وأحياء لسكن قادته وجنودهم.

قصر الخليفة ضم بركة ماء (بحيرة صناعية) بلغ طول ضلعها نحو 125 متراً، ومن جمال البِركة مدحها البحتري في قصيدة:
يحسبها أنها من فَضلُ رتبتها/تُعَدُّ واحدةً والبحرُ ثانيها
ما بالُ دِجْلة كالغَيْرَى تنافسها/في الحسنِ طَوراً، وأطواراً تباهيها
توسعت المدينة أكثر في عهد الخليفة الواثق، ثم المتوكل، الذي بلغت في عهده قمة اتساعها وجمالها، حتى امتدت على طول 24 كيلومتراً، على ضفتَي نهر دجلة، وهي مساحة شاسعة قياساً بمدن القرون الوسطى، بحسب ما وثقت هيئة الآثار العراقية القديمة في كتاب عن سامراء. ومن جمالها قال فيها ابن الجهم، حسبما ينقل الحموي:
بَدائِعٌ لم تَرَها فارسٌ/ولا الرّوم في طول أعمارها
ولكنها بدأت في التراجع، بعد قتل المتوكل على يد الأتراك، واستبدادهم بالمدينة وبأمر الخلافة عموماً، فعمت الاضطرابات والفتن في العهود القصيرة التي حكم خلالها كلّ من الخلفاء: المنتصر، المستعين، المعتز، والمهتدي، حتى جاء المعتمد (256هـ/869م) وحاول السيطرة على الأمور، فلم يستطع، فأعاد مقر الخلافة إلى بغداد، في محاولة لتحجيم الأتراك.

بعد ذلك أُهملت سامراء، وبعد أن كانوا يسمونها "سُرَّ مَن رأى" أضحوا يسمونَها "ساء من رأى"، وبعد أن تسابق الشعراء لمدحها، استرسلوا في رثاء أطلالها، بحسب اليعقوبي. وقد رثاها الشاعر العباسي ابن المعتز في القرن الثالث الهجري، معتبراً أنها ماتت فجأة:
قد أقْفَرَت سُرّ من رأى/وما لشيءٍ دوامُ
فالنقضُ يحمل منها/كأنها آجامُ
ماتت كما مات فيلٌ/تُستَلُّ منه العظامُ
المنصورية، معدومة النظير، طمس بنو هلال حسنها
المنصورية هي العاصمة الأقل شعبية بين عواصم الفاطميين (القاهرة، المهدية، المنصورية)، سميت باسمها نسبة إلى الخليفة المنصور، الذي أمر ببنائها عام 337هـ/949م، كعاصمة للدولة عوضاً عن المهدية التي عانت من الحصار أكثر من مرة، بشكل جعل أباه الخليفة القائم بأمر الله يفكر في عاصمة جديدة بالقرب من القيروان مصدر المؤامرات ضد الفاطميين. فلما تولى المنصور الحكمَ شرع في بناء المنصورية، التي حين اكتملت التصقت بالقيروان وصارت جزءاً منها، حسبما نقل غفران محمد الدعمي وصلاح الدين محسن عن "المسالك والممالك" للبكري، في دراستهما "مدينة المنصورية في العصر الفاطمي".

الجغرافي ابن حوقل البغدادي وصف جمالها قائلاً: "عجيبة الأبنية، واسعة الأفنية، معدومة النظير"، بحسب "تاريخ الخلفاء الفاطميين"، للداعي إدريس عماد الدين. وعن سرعة إنجاز المنصور بناءها، قال ابن حوقل أيضاً: "اختطّ أحسن بلد في أسرع أمد".
ونفهم من عماد الدين أن المدينة سعت 14 ألف منزل لأسر قبيلة كتامة البربرية وحدها، حيث أمرهم المنصور بسكنها وتعميرها.
اتخذت المنصورية شكلاً دائريا ًمثل بغداد، وأُنشئ بها الأسواق والقصور والمساجد، وأمر المنصور بنقل تجار القيروان إليها، خاصة وأن المدينتين التحمتا ببعضهما.

وكان قصر المنصور في المدينة أعجوبة، حد أنه احتوى بركة مياه (بحيرة صناعية) ضخمة أيضاً، رآها الشاعر التونسي علي بن محمد الإيادي، الذي خدم في بلاط المنصور، كالبحر، حسبما نقل عنه القاضي النعمان في "المجالس والمسايرات":
تحفُّ بقصرٍ ذي قصورٍ كأنما/ترى البحرَ في أرجائِه وهو متأَقُ
له بركة للماء ملء فضائه/تخبّ بقطريها العيونُ وتعنقُ
وقال غفران محمد الدعمي وصلاح الدين محسن (وهما معنيان في دراستهما بهندسة المدينة) إن مساحة البحيرة كانت 170 متراً طولاً، وعرضها 65 متراً، رغم أن المدينة لم تكن ساحلية.
وكانت المدينة تحصل على مياهها من الآبار، واحتوت على 300 حمام عام، بحسب "المسالك والممالك"، ما يدل على اتساعها ونظافة أهلها.

سور المدينة كان له خمسة أبواب، هي: الشرقي، القبلي، كتامة، زويلة، الفتوح. ونفس البابين الأخيرين (زويلة والفتوح) أطلق الفاطميون أسمَيهما على بابين من أبواب القاهرة التي أسسها المعز ابن المنصور، في ما بعد.
حين توفي المنصور وتولى ابنه المعز، استولى الفاطميون على مصر، وبنيت بها عاصمة جديدة هي القاهرة، لتصير العاصمة الثالثة بعد المهدية والمنصورية. انتقل المعز إلى القاهرة وترك المنصورية كعاصمة لولاية إفريقية (تونس) تحت إمرة بلقين بن زيري، وصار الحكم له ولأولاده من بعده (الزيريين) في تونس.
ظلت المنصورية تحت سيطرة الفاطميين حتى تمرد واليها ابن عذارى، وبايع الخليفة العباسي السني، منشقاً عن الفاطميين، الذين لم يجدوا حلاً للانتقام إلا عن طريق قبائل بني هلال وبني سليم.
ويحكي ابن خلدون في تاريخه كيف استغل الفاطميون هؤلاء البدو المشهورين بالعنف في الانتقام، ولكن انتقامهم كان تدميراً، حتى أن المنصورية تحولت إلى أطلال.
قبائل بنو هلال وبنو سليم كانت تحترف الإغارة والسلب والنهب في شبه الجزيرة العربية، وحين تمدد نفوذ الفاطميين في الشام وشبه الجزيرة أسكنهم الخليفة الفاطمي العزيز بالله صعيدَ مصر، شرقي نهر النيل، واشترط عليهم ألا يعبروه نحو الغرب.
في التاريخ، لا يُمحى مجرد آثار الحُكم، بل يُمحى التاريخ نفسه أحياناً، حيث تتحول العواصم التي كانت مآثر حضارية إلى أطلال أو قرى مهجورة، نتيجة صراعات السلطة
ظلت تلك القبائل على تلك الحال حتى قرر الخليفة المستنصر استغلالهم لاسترداد تونس، وقال لهم إن كل ما تطاله أيديهم من بلاد المغرب سيكون لهم. يصف ابن خلدون ما حل بالقيروان والمنصورية على أيدي تلك القبائل قائلاً: "دخلوا البلد واستباحوه واكتسحوا المكاسب وخربوا المباني وعاثوا في محاسنها، وطمَسوا من الحسن والروْنَق معالمها"، وتحولت المنصورية من وقتها إلى أطلال.
القاهرة، المدينة التي احتقرها صلاح الدين الأيوبي
العاصمة المصرية بشكلها الحالي والتي تسمى القاهرة، ليست هي المقصودة من هذه الفقرة، وإنما حي القاهرة الفاطمية تحديداً، الذي كان مدينة في حد ذاته.
في كتابات المؤرخين المصريين مثل المقريزي وابن إياس، هناك مدينة تسمى "مصر"، هي نتاج مدن سابقة (الفسطاط، العسكر، القطائع) وأخرى تسمى "القاهرة" التي بناها الفاطميون، والمدينتان صارتا في ما بعد مدينة واحدة.
يمكن تتبع رحلة تشويه القاهرة الفاطمية من خلال كتاب المؤرخ أيمن فؤاد سيد "القاهرة: خططها وتطورها العمراني". كانت القاهرة بحسب هذا البحث/الكتاب محاطة بسور له تسعة أبواب، واحتوت على دواوين وقصور للقادة وأحياء سكنية للقبائل التي جاءت مع المعز من تونس، وثكنات للجيش، فضلاً عن الجامع الأزهر، والقصر الكبير (قصر الحكم) والقصر الصغير التابع للخاصة الفاطمية، ومكتبة دار الحكمة التي احتوت على أكثر من مليون ونصف المليون كتاب، ولم تنافسها بالعالم كله إلا دار الحكمة في بغداد.

القصر الكبير كان يسكنه وحده 12 ألف إنسان، وكانت له تسعة أبواب، منها "باب الذهب"، الذي كانت دعامتاه من الذهب، وضمت أسوار القصر 12 قصراً تتخللها بساتين وفساقي مياه، وقاعة بها ضريح نقل إليه رأس الحسين بن علي (مسجد الحسين الشهير الآن)، وتجاوزت مساحة القصر الإجمالية 240 ألف متر مربع.
بعد انقلاب صلاح الدين الأيوبي وإلغائه الخلافة الفاطمية (567هـ/1171م)، اتبع سياسة بدت تحقيرية لعاصمة الفاطميين، أولها أنه رفض الإقامة بقصر الحكم، وفضل الاستمرار في الإقامة بدار الوزارة، التي كان يقيم بها كوزير للفاطميين.
أعطى صلاح الدين القصر الكبير لقادته، قسموه في ما بينهم، وبعضهم شرع في تخريبه، بهدم أجزاء منه ونقلها لبناء قصور جديدة، خاصة وأن كثيراً من أعمدته وحوائطه كانت من أحجار كريمة.
كما دمر صلاح الدين دار الحكمة، وتخلص من كتبها، إما بإهدائها أو بيعها أو بإعدامها، وسمح للمصريين بالبناء في القاهرة بلا تخطيط دقيق.
ظل تخريب القاهرة مستمراً طوال العهد الأيوبي ثم المملوكي، وخلال العصرين الملتحمين، قضى السلاطين على كثير من معالم الفاطميين، حتى مقابرهم نُبِشَت في العصر المملوكي ليقام مكانها "خان الخليلي" الذي ما زال قائماً. وذلك لأن صلاح الدين قرر بناء مقر جديد للحكم، وهو قلعة الجبل، التي بناها فوق جبل المقطم، فصارت هي مقر الحكم للأيوبيين والمماليك والعثمانيين من بعده.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.