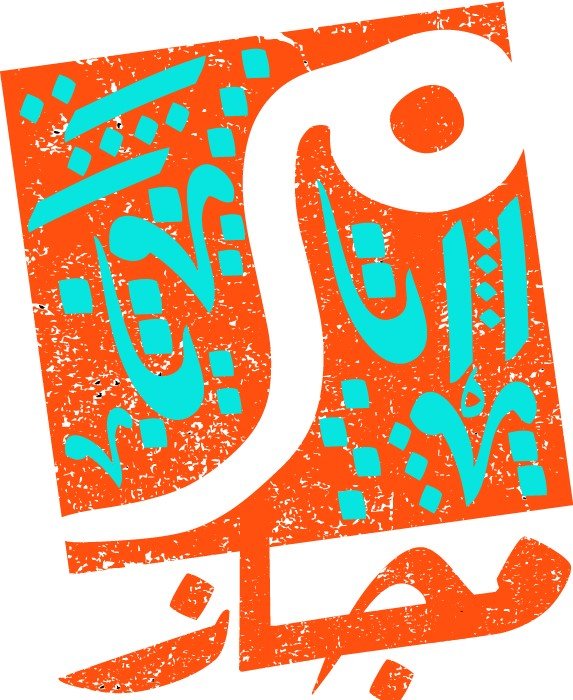 تصميم حروفي لكلمة مجاز
تصميم حروفي لكلمة مجاز
أجلد ذاتي مؤخراً حول اختياراتي. قابلت منذ أسبوع أحد زملاء المدرسة في شارع بيتي. سألني:"بتعمل إيه في حياتك؟". لم أملك إجابة حاضرة على هذا السؤال. كسرت لحظة الصمت الغريبة قائلًا: "بروح التكليف وأرجع البيت". باغتني:" طيب مش ناوي تروح القاهرة وتعمل شوية فلوس حلوين؟". أجبته بعد وهلة: "إن شاء الله"، ثم صعدت إلى بيتي كي أتناول الغداء وأنام.
واتتني فرصة العمل في القاهرة وقت إعلان نتيجة توزيع تكليفي. أؤجر شقة في محيط السيدة زينب وأذهب لعملي الحكومي صباحاً، ثم أبحث عن آخر خاص في المساء كي أسد مصاريفي. سألت الكثير من الأصدقاء حول آرائهم المختلفة، لكنني لم أسأل نفسي عما أريده.
أجمعوا مع اختلاف خلفياتهم: "لو مش مضطر متجيش". فكّرت أن لانتقالي إلى القاهرة ثمنا آخر غير مادي، لا أدري إن كنت أقدر عليه، فشقلبة حياتي، من وظيفة واحدة تسد مصاريفي الأساسية، متيحة لي وقتاً للقراءة والكتابة، إلى حياة عملية بالكامل، أمر لا أقبله. أرغب بالاستقلال، لكن بتضحية مقبولة، تحافظ على مسار حياتي الذي أستكشفه.
حين يسألني أي من أفراد عائلتي مؤخراً: "لقيت شغل جنب الحكومة؟"، أهز رأسي نافيا وأقول: "ربنا يسهل". يتكرّر السؤال فأرغب أحياناً في الرد: "المستشفى اللي بروحها الصبح ديه تعتبر ايه؟"، لكنني أحفظ إجابتهم الحاضرة دوماً: "مفيش حد بيكوّن نفسه من التكليف بس"، ويليها وصلة عقد المقارنات بيني وبين زملائي الذين يعملون صباحاً في المستشفى الحكومي، وليلاً في إحدى الصيدليات أو المستشفيات الخاصة، ثم تنتهي بـ: "أنت مش أحسن منهم في حاجة"، فأجيب بـ "نعم".
أتعثر أحياناً بالمستلقين على الرصيف المقابل للمستشفى في انتظار المرضى. يراني عامل الأمن، يفتح البوابة دون أن أنطق: "اتفضل يا دكتور"، أردّد: "صباح الخير... شكراً"، لاعناً في سرّي اللقب الذي لا أحصل منه سوى على فتح بوابات المستشفيات... مجاز
*****
صنعت مساري الخاص لبلوغ عملي. أقطع شارع سينما أوديون إلى نهايته. أعبر شريط الترام وأسير في شارع "طيبة"، متأملا المباني القديمة التي يتخلّلها برج "الصابرين" شامخ الطول. أنتهي من قهوتي التي أشربها من المج الحراري، حتى أرى لافتة خضراء "شارع المدرسة السويسرية"، يعلوها إعلان لصيدلية؛ فأتذكر لعنتي العملية مع بلوغي نهاية الشارع.
أخرج إلى شارع بورسعيد. أحتمي بسور مدرستي السابقة من ظل الشمس، ناظراً إلى "جبانة الشاطبي" الأثرية وجوارها قصر الثقافة. أفكر كثيراً عما كانت ستؤول إليه حياتي إن لم أحب القراءة أو الكتابة.
أدرك قربي من مقر عملي الحالي، حين ألمح كتلاً بشرية مترسّبة أمام بوابات المستشفى. أكاد أتعثر أحياناً بالمستلقين على الرصيف المقابل للمستشفى في انتظار المرضى. أخشى مصيرهم إن لم أجنِ مالاً كافياً خلال فترة شبابي كما توصيني عائلتي. يراني عامل الأمن، يفتح البوابة دون أن أنطق: "اتفضل يا دكتور"، أردّد: "صباح الخير... شكراً"، لاعناً في سرّي اللقب الذي لا أحصل منه سوى على فتح بوابات المستشفيات.
*****
تقول أمي: "أنت حبيت حياة الصرمحة خلاص". أستنكر ما تقوله، لكنني في داخلي أصدقه. لم أكمل دراسة الماجستير. استلمت تكليفي في مكان قريب من بيتي، وبعدد ساعات قليلة، كي أتمكن من التفرّغ لعمل ما أحبه. لكنني سئمت العمل الحكومي بكل تفاصيله: البصمة الصباحية، الأحاديث حول جو الصيف الخانق، انقطاعات الكهرباء في المناطق المختلفة، عمل الصيدليات الممل، وأخيراً شغل البيت ورعاية الأطفال. أفكر فيما سأفعله اليوم بعد نهاية العمل وأتجنب الإجابة الحقيقية: "لا شيء".
أسير لفترات طويلة على الكورنيش، وفي أحيان أخرى في الشوارع الجانبية المتفرعة منه أو شارع بورسعيد أو أبو قير. أعود للمنزل منهكاً من الشمس والعرق. أتناول غدائي وأنام بضع ساعات، ثم أخرج إلى أحد الكافيهات بصحبة لابتوب وكتاب. أسعد لنشر مقالة أو قصّة جديدة لي، لكن سرعان ما تتبخر فرحتي ببحثي المضني عما كانت ستؤول إليه حياتي الثقافية والعملية لو كنت انتقلت إلى القاهرة حين واتتني الفرصة.
ربما أهجر البلد ذات يوم إلى أخرى يكفل لي راتبي بها ستوديو صغيراً ووقتاً للكتابة والقراءة، وحتى يتحقق ذلك، فالصرمحة حل مناسب لقتل الوقت، والوقت يتكوّم أمامي كجثة... مجاز
*****
أخرج من بار بعد منتصف الليل بقليل. يمكنني السير إلى حيث أقيم، لكنني لا أثق في قدمي، كي لا تلفت أنظار أي من "حبايبنا" المنتشرين في شوارع وسط البلد. أحاول إيقاف تاكسي لكن يبدو أن المنطقة التي أمكث بها ملعونة بالنسبة لهم، إثر شوارعها الضيقة والملتوية. يخبرني أحدهم بعد وقوفه والتقاط أنفه لرائحة أنفاسي بأنه مستعد لأخذي إلى حيث أريد مقابل خمسين جنيهاً، في مشوار لا يستغرق ربع ساعة سيراً على الأقدام. أرفض وأفضل المخاطرة مترنّحاً إلى المنزل.
تتضخم بنايات وسط البلد في نظري. أسير ملتصقاً ببواباتها، متلفتاً يميناً ويساراً كل خمس دقائق، خائفاً من ظلي. أتخيل أن هناك من يراقبني. أعدو من أمام منصبة الكتب في الميدان خائفاً من التابع المجهول. أتعثّر قبيل عبوري الشارع. أسمع من ينادي. أنهض وأعدو بكل سرعتي نحو شارع القصر العيني. أخشى أن يوقفني أحدهم فيفتّش هاتفي، ويجد ما لا يسرّ، أو يشم رائحة أنفاسي وأقضي ليلتي ضيفاً معه. ألعن غبائي إثر عدم سيري في شوارع جانبية بدلاً من الرئيسية كي لا ألفت الأنظار.
أكره القاهرة حين تبدأ في إظهار أنيابها لي. أفضلها منشغلة عني حين تكون مكتظة بالبشر صباحاً، غير عابئة بمن يسير نصف واع في شوارعها. أفكر إن كانت علاقتي بها ستختلف إن استحالت من مجرد زيارة كل أسبوعين، للصرمحة في شوارعها وباراتها، إلى عمل روتيني. أبلغ مكان إقامتي، ملتقطاً أنفاسي بصعوبة، موقناً أنني لن أحب حياتي في القاهرة إن انتقلت إليها.
*****
أشتّت نفسي عن وحدتي بتليفون لأحد الأصدقاء. يشجّعني أحدهم على الكتابة، يخبرني آخر ألا أدخر من مرتبي الهزيل شيئاً، ويؤكد ثالث أن الحصول على وظيفة ثانية لن يضيف لدخلي الفارق الكبير في مقابل تضحيتي بوقت القراءة والكتابة. أعرف في داخلي أن الحياة لا يمكن لها الاستمرار على هذا المنوال، إلا إن تصالحت مع استحالة استقلالي المادي عن عائلتي.
أسافر للقاهرة. أتفقّد أصدقائي وأسير وحدي في شوارع وسط البلد. أتخيل حياة موازية في أحد البيوت القديمة بها. لكل اختيار ثمن، لكنني أرفض دفع ثمن ما أعيشه. أسعى للسفر مؤخراً بكل ما أوتيت من مجهود؛ هرباً من وطن يرفض أن يقدم لي وظيفة واحدة تضمن لي راتباً أقتات منه دون الحاجة إلى عائلتي.
أفكر: "وظيفة واحدة لن تكفيني". أقف أمام تلك الحقيقة عاجزاً. أنظر لأقراني سعيداً بنجاحاتهم وأفشل في تقليد أي منها، فأكتب لأشتت نفسي عن الحقيقة الجامدة، لعلها تتزلزل أو أتناساها. ربما أهجر البلد ذات يوم إلى أخرى يكفل لي راتبي بها ستوديو صغيراً ووقتاً للكتابة والقراءة، وحتى يتحقق ذلك، فالصرمحة حل مناسب لقتل الوقت، والوقت يتكوّم أمامي كجثة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


