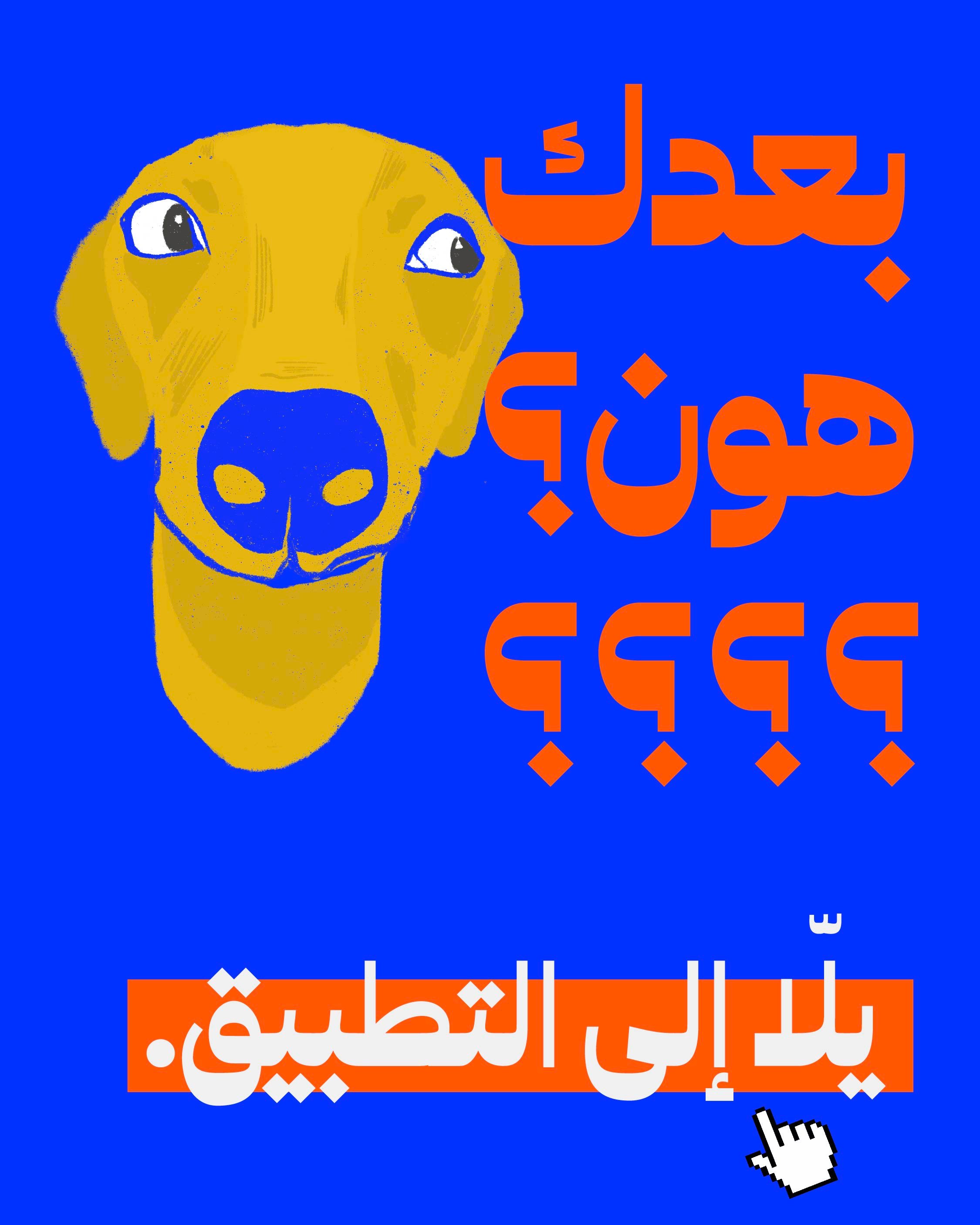في صباح يوم عادي من عام 1943، استيقظ سائق القطار البولندي ستيفان كوشاريك، وتناول إفطاره مع عائلته، ثم توجَّه إلى عمله كما يفعل كلَّ يوم. لم يكن ستيفان نازياً أو مجرماً بطبيعته، بل كان رجلاً عاديّاً يحاول إطعام عائلته في ظروف الحرب الصعبة. عمل ستيفان في ذلك اليوم كان يتضمّن قيادة قِطارات الترحيل المُحمَّلة بالآلاف من اليهود، من محطّة القطارات المحليّة إلى بوابة مركز القتل في تريبلينكا. بحلول نهاية ذلك اليوم، كان ستيفان قد ساهم في عمليّة إبادة جماعية راح ضحيّتها مئات الأشخاص، دون أن يطلق رصاصةً واحدةً أو يرتكب عُنفاً مباشراً.
تفاهة الشرّ كآليَّة عالمية للعنف المُنظَّم
هذه القصّة الحقيقية، المُسجّلة في أرشيف متحف الهولوكوست الأمريكي، تُلخِّص جوهر ما أطلقت عليه الفيلسوفة حنّة آرندِت "تفاهة الشر"، أي قدرة الأشخاص العاديين على المشاركة في أفظع الجرائم دون أن يكونوا شخصياتٍ استثنائيّةً، بل من خلال سلسلة من القرارات الصغيرة والتبريرات البسيطة التي تحوِّلهم إلى أدوات في منظومة أكبر من العنف المُنظَّم.
يستند مفهوم "تفاهة الشرّ" إلى ملاحظات آرندت، في أثناء حضورها محاكمة "أدولف آيخمان" في القدس عام 1961، كموفدة من قبل جريدة "ذي نيويوركر"، لتقوم بعدها بتجميع مقالاتها وملاحظاتها حول المُحاكمة عام 1963، في كتاب بعنوان "أيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشرّ". آيخمان، الذي كان مسؤولاً عن تنسيق عمليَّات ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة النازية، لم يظهر في المحكمة كشخصيّة شيطانية أو مجرم استثنائي، بل كموظف بيروقراطي عادي يتميّز بضحالة فكريّة ملحوظة. هذا التناقض بين "عاديّة" الشخص وفداحة الجرائم المُرتَكَبة دفع آرندت إلى إعادة النظر جذرياً في الفهم التقليدي لطبيعة الشر.
ما يجعل الحالة السورية مقلقةً بشكل خاص، هو أنَّ آليّات تفاهة الشرّ تعمل الآن في بيئة فوضوية أكثر، وأقلَّ تنظيماً من النظام الشمولي السابق. في عهد النظام الساقط، كان هناك هيكل بيروقراطي "يمكن" السيطرة عليه. أمَّا الآن، فالعنف يحدث من خلال ديناميكيات جماعيّة تصعب السيطرة عليها أو توجيهها
"الغولاغ السوفياتي" ونظام العنف البيروقراطي
تُقدِّم تجربة "الغولاغ السوفييتي" (Gulag)، في عهد ستالين (1924-1953)، مثالاً كلاسيكياً على كيفية تحوّل نظام بيروقراطي كامل إلى آلة للعُنف المُنظَّم، مُعتمداً على مشاركة آلاف الأفراد العاديين الذين لم يكونوا بالضرورة مؤمنين بالأيديولوجيا الشيوعية أو متعطِّشين إلى الدماء. الغولاغ، الذي ضمّ في ذروته أكثر من 2.5 ملايين سجين موزَّعين على مئات المعسكرات أغلبها في سيبيريا، لم يكن مُجرَّد نظام سجون، بل منظومة اقتصادية واجتماعية تطلَّبت مشاركة عشرات الآلاف من الموظفين والحراس والإداريين.
ما يجعل تجربة الغولاغ مفيدةً بشكلٍ خاص لفهم "تفاهة الشر"، هي الطريقة التي تمكّن بها النظام السوفياتي من تجنيد فلاحين وعُمّال ومثقفين صغار، وتحويلهم إلى أدوات في منظومة القمع. هؤلاء الأفراد وجدوا أنفسهم مشاركين في نظام يعرفون أنّه ظالم، مدفوعين بمزيج من الحاجة الاقتصادية والخوف من السلطة والرغبة في الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية.
لإتمام المهمات بنجاح، طوَّرت الدولة آليّات للتبرير الذاتي. إحدى هذه الآليات كانت "تجريد الضحايا من إنسانيتهم" من خلال تصنيفهم كـ"أعداء للشعب" أو "طفيليات اجتماعية" تستحق العقاب. هذا الخطاب كان عمليّة برمجة نفسية مكّنت الحُرّاس من التعامل مع السجناء "كأشياء وليس كبشر".
آليّة أخرى مُهمة تمثّلت في "تجزئة المسؤولية" داخل الهيكل البيروقراطي للغولاغ. الموظف الذي يكتب تقريراً عن "انخفاض الإنتاجية" لا يرى نفسه مسؤولاً عن قرار تقليل حصص الطعام الذي قد يتخذه مسؤول آخر بناءً على تقريره. والحارس الذي ينفذ أمر التعذيب والعزل الانفرادي بحق البعض، لا يرى نفسه مسؤولاً عن القرار الإداري الذي أصدره مسؤول في مكتب بعيد. هذا التقسيم للعمل والمسؤولية خفف من الضغط النفسي على الأفراد وجعل من السهل عليهم المُشاركة في نظام يعرفون أنّه ظالم.
رجال عاديّون
تجربة ألمانيا النازيّة تقدِّم أوضح الأمثلة التاريخية على كيفية تحوّل أفراد عاديين إلى مرتكبي جرائم إبادة جماعية. الدراسة التي قام بها المؤرّخ كريستوفر براوننغ، حول "الكتيبة الاحتياطية 101" من الشرطة الألمانية، في كتاب بعنوان "رجال عاديّون" عام 1992، تكشف كيف تحوّل 500 رجل "عادي" في متوسط العمر، معظمهم من الطبقة العاملة والمتوسّطة، وليسوا أعضاء في الحزب النازي إلى قَتَلة جماعيين مسؤولين عن مقتل أكثر من 83،000 يهودي في بولندا.
ما يجعل هذه الحالة استثنائيةً في قيمتها التحليليّة، هو أنَّ براوننغ اعتمد على شهادات مُفصَّلة من أفراد الكتيبة أنفسهم، مُسجَّلة في محاكمات ما بعد الحرب. هذه الشهادات تكشف عن العمليات النفسية الداخلية التي مكَّنت هؤلاء الرجال من ارتكاب جرائم فظيعة، وقدّمت نافذةً نادرةً على آليّات "تفاهة الشر" في العمل.
في تموز/ يوليو 1942، وصلت الكتيبة 101 إلى قرية يوزيفوف البولندية، مع أوامر بقتل جميع اليهود في القرية (نحو 1،800 شخص)، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. الرائد فيلهلم تراب (قائد الكتيبة)، جمع رجاله وأخبرهم بالمهمة، لكنّه أضاف شيئاً غير مسبوق: "أيّ رجل يشعر أنَّه غير قادر على تنفيذ هذه المهمة يمكنه التراجع دون عقاب".
من بين 500 رجل، تراجع 12 فقط. الباقون، برغم عدم وجود إكراه مباشر، شاركوا في مذبحة استمرت يوماً كاملاً. شهادات هؤلاء الرجال تكشف عن مجموعة من الدوافع والتبريرات التي مكّنتهم من المشاركة في هذه الجريمة. بعضهم قال إنّه لم يُرِد أن يبدو "جباناً" أمام زملائه. آخرون برروا أفعالهم بأنَّهم "يُنفذون الأوامر"، أو أنَّ "شخصاً آخر سيفعل ذلك إذا لم يفعلوه هم". البعض اعتمد على التبرير الأيديولوجي بأنَّ اليهود "أعداء ألمانيا".
حالة ستيفان كوشاريك، سائق القطار البولندي الذي تحدّثنا عنه في بداية المقال، تُقدِّم مثالاً آخر على كيفية مشاركة المدنيين العاديين في آلة القتل النازية دون أن يكونوا جنوداً أو نازيين متعصبين. كوشاريك لم يكن يقتل أحداً بيديه، لكن عمله في نقل قطارات الترحيل كان جزءاً لا يتجزأ من عملية الإبادة. في شهادته، يبرر كوشاريك أفعاله بأنَّه "كان مجرد سائق قطار يؤدي عمله"، وأنَّه "لم يكن يعرف ما يحدث في المعسكرات".
شهادة ستيفان توضح لنا أمراً بالغ الأهميّة، وهو أنَّ العنف لا يحدث دفعةً واحدةً، بل يتراكم عبر سلسة من الخطوات الصغيرة، كلّ منها تبدو "معقولة" أو حتى "ضرورية" في سياقها المحدود. والتبريرات التي استخدمها تكشف عن آليّة نفسية دفاعيّة، هي "الجهل المُتعمَّد" أو رفض رؤية العواقب الكاملة للأفعال. كوشاريك كان يعرف أنَّه ينقل أشخاصاً إلى معسكرات، وكان يرى حالتهم المُزرية، لكنّه اختار عدم التفكير في مصيرهم النهائي. هذا الاختيار الواعي لعدم التفكير هو جوهر ما تعنيه آرندت بـ"تفاهة الشرّ".
الأيديولوجيا أداة وليست مُحرّكاً
مُنذ ظهور طالبان في التسعينيات وحتَّى عودتها إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021، أظهرت الحركة قدرةً ملحوظةً على تجنيد آلاف الشباب الريفيين الفقراء وتحويلهم إلى أدوات في منظومة عنف تستهدف المدنيين الأبرياء.
مقاومة "تفاهة الشرّ" مسؤولية فرديّة قبل أن تكون مؤسسية. كُلُّ فردٍ في المجتمع يواجه يومياً خيارات صغيرةً بين التفكير وعدم التفكير، بين التساؤل والامتثال، وبين التعاطف واللامبالاة. هذه الخيارات الفرديَّة، عندما تتراكم عبر ملايين الأشخاص، تُشكِّل الفرق بين مجتمع عادل وآخر يغرق في العنف والظلم
معظم مُقاتلي طالبان انضموا إلى الحركة لأسباب عمليَّة أكثر منها أيديولوجية. الفقر والبطالة وانعدام الفرص التعليمية والاقتصادية دفعت الشباب الأفغاني للانضمام إلى طالبان كوسيلة للحصول على دخل ثابت ومكانة اجتماعية. الأيديولوجيا الدينية جاءت لاحقاً كإطار لتبرير الأفعال، وليس كدافع أساسي للانضمام.
تقرير أكاديمي في العام 2021، حول مواقف طالبان من التعليم، يكشف عن كيفيّة تطوّر الحركة من مجموعة محليَّة تُركز على "الأمن والنظام" إلى نظام بيروقراطي مُعقَّد يمارس العنف المنهجي ضد المدنيين. في البداية، ركَّزت طالبان على "استعادة الأمن"، وهو هدف حظي بدعم شعبي واسع في مجتمع دمَّرته الحرب الأهلية والاحتلالات الأجنبية. لكن تدريجياً، تحوّل هذا الهدف "النبيل" إلى مُبرر لممارسة عنف واسع ضد أيّ شخصٍ يُعدّ "مخالفاً" للنظام الجديد.
هذا التحوّل التدريجي من "الإصلاح" إلى "القمع" يكشف عن آليّة مهمة في تفاهة الشر. الأهداف النبيلة يمكن أن تُستخدم لتبرير الوسائل الإجرامية، وتدريجياً تصبح الوسائل هي الهدف. المقاتل الذي انضم إلى طالبان "لاستعادة الأمن"، يجد نفسه يشارك في عمليّات إعدام علنية للنساء المُتّهمات بـ"التعطُّر"، أو في حرق المدارس التي تُعلِّم البنات، أو في جلد الرجال الذين لا يطيلون لِحاهم بما فيه الكفاية.
كسابقيهم، طوَّر مُنظّرو حركة طالبان آليات نفسيةً مشابهةً لتلك التي استخدمها مرتكبو الجرائم في السياقات الأخرى، أهمها "تجريد الضحايا من إنسانيتهم" من خلال تصنيفهم كـ"كُفَّار" أو "منحرفين" أو "عُملاء للغرب". هذا التجريد يجعل من السهل على المُقاتل أن يرى في الضحيّة "عدوّاً للإسلام" يستحق العقاب، وليس إنساناً عاديّاً مثله تماماً.
آليّة أخرى هي "الاعتماد على السلطة الدينية" لتبرير الأفعال. المقاتل العادي لا يحتاج إلى فهم التفاصيل الفقهية المُعقّدة، بل يكفي أن يثق بأنَّ "العلماء" قد أفتوا بأنّ هذا العمل "جهاد" أو "أمر بالمعروف ونهي عن المنكر". هذا الاعتماد على السلطة الدينية المختزلة ببعض المشايخ يعفي الفرد من المسؤولية الأخلاقية المباشرة عن أفعاله.
سوريا في مرآة التجارب السابقة
خلال عقود من حكم نظام الأسد، تمكّن النظام السوري من تجنيد آلاف الأفراد العاديين في منظومة القمع من خلال آليّات تشبه سابقاتها، وقد انضم العديد من أبناء سوريا، خاصةً من الطائفة العلويّة، إلى الأجهزة الأمنية لأسباب اقتصادية واجتماعية، ثم استخدموا المظالم التاريخية والخوف من الآخر والأيديولوجيا القومية أو الطائفية لتبرير مشاركتهم في أعمال القمع.
الضابط الذي يأمر بالاعتقال، والعنصر الذي يُنفِّذ الاعتقال، والسائق الذي يوصل المُعتقلين، والحارس الذي يشرف على السجن، والمحقق الذي يمارس التعذيب، والأفراد الذين قاموا بعمليات دفن جماعية لجثث القتلى... كُلٌّ من هؤلاء كان يؤدّي دوراً مُحدداً في سلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية التي تخفف من الشعور بالمسؤولية الفرديّة. هذا التقسيم للعمل مكَّن كل مشارك من تبرير أفعاله بأنَّه "يُنفِّذ الأوامر" أو "يؤدّي واجبه الوظيفي".
اللغة التقنية والمُجرَّدة لعبت دوراً محورياً في هذه العملية. الاعتقال التعسفي أصبح "إجراء احترازياً"، والتعذيب أصبح "استجواباً"، والقتل خارج القانون أصبح "تصفيةً لعناصر إرهابية". هذه اللغة البيروقراطية الباردة أخفت الواقع الإنساني للضحايا، وحوّلتهم إلى مجرّد ملفات إداريّة لا أشخاص لديهم عائلات وأحبّاء وأحلام وحياة خارج جحيم الحرب والمعتقلات. تماماً كما حوَّلت البيروقراطية النازية اليهود إلى "مشكلة لوجستية" يجب حلّها، أو كما حوّلت بيروقراطية الغولاغ السجناء إلى "وحدات إنتاج" تجب إدارتها.
لكن الجانب الأكثر إثارةً للتساؤل في وقتنا الراهن، يتعلق باستمرارية هذه الآليّات حتّى بعد سقوط النظام، وفي طليعتها الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس 2025، حيث قتلت ميليشيات تابعة للسلطة الجديدة أكثر من 1،500 مدني علوي.
استناداً إلى شهادات الناجين من المذبحة، أشار تقرير لوكالة "رويترز"، في حزيران/ يونيو 2025، إلى أنَّ المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن انتمائهم الطائفي قبل قتلهم، ويحمّلونهم مسؤولية جرائم النظام السابق. هذا السلوك يعكس آليّةً مشابهةً لما وصفته آرندت بـ"غياب القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين الأفراد والأنظمة".
تغيير النظام السياسي وحده غير كافٍ لضمان انتهاء الانتهاكات الجماعية. العدالة الانتقالية يجب أن تتجاوز محاسبة القادة والمسؤولين الكبار لتشمل فهماً عميقاً للآليّات التي مكّنت الأفراد العاديين من المشاركة في الجرائم، وتطوير إستراتيجيات تعليمية وإعلامية وقانونية فعَّالة لمنع تكرارها
الوضع في السويداء لم يكن أفضل حالاً. الاشتباكات التي اندلعت في تموز/ يوليو 2025، بين الدروز والعشائر البدوية وما تبعها من مواجهات مع قوات الجيش والأمن العام والجماعات العشائرية وأسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص وفقاً لما نقلته "رويترز" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تكشف كيف تم تصنيف الدروز "أعداء للوطن والشعب"، بسبب رفض البعض منهم لعقلية السلطة الجديدة في إدارة الحكم. فتمّ تحويل أزمة إداريّة سياسية من كِلا الطرفين إلى أزمة هوياتيّة طائفية بامتياز.
ما يجعل الحالة السورية مقلقةً بشكل خاص، هو أنَّ آليّات تفاهة الشرّ تعمل الآن في بيئة فوضوية أكثر، وأقلَّ تنظيماً من النظام الشمولي السابق. في عهد النظام الساقط، كان هناك هيكل بيروقراطي "يمكن" السيطرة عليه. أمَّا الآن، فالعنف يحدث من خلال ديناميكيات جماعيّة تصعب السيطرة عليها أو توجيهها.
الجذر المشترك للشرّ
التحليل المُقارن للحالات التاريخيَّة المختلفة، من الغولاغ السوفياتي إلى الهولوكوست النازي إلى تجربة طالبان في أفغانستان وصولاً إلى الحالة السورية، يكشف عن نمط مشترك يتجاوز الاختلافات الثقافية والسياسية والأيديولوجية. هذا النمط يتمحور حول عدم قدرة الأفراد على ممارسة ما تسميه آرندت "التفكير" كنشاط إنساني أساسي. هذا التفكير لا يعني القدرة على التحليل المنطقي أو حل المشكلات التقنيَّة، بل القدرة على التساؤل الأخلاقي النقدي والتأمّل في عواقب الأفعال والتعاطف مع مُعاناة الآخرين. ستيفان كوشاريك، سائق القطار البولندي، كان قادراً على تشغيل القطار وإصلاحه بكفاءة تقنيّة عالية، لكنَّه لم يكن قادراً على التفكير في المعنى الأخلاقي لما يفعله. فيلهلم تراب، عضو الكتيبة النازيّة، كان قادراً على التخطيط العسكري وعلى استخدام الأسلحة الألمانية الأحدث في العالم في ذلك الوقت، لكنّه لم يكن قادراً على التساؤل حول شرعيّة هذه الأوامر أخلاقياً.
لكن لا يمكن لهذه الآليّة أن تعمل بمعزل عن سلطة عنفيّة تعمل على تجزئة المسؤولية داخل البنى البيروقراطية أو الاجتماعية، حيث يصبح كل فردٍ مسؤولاً عن جزءٍ صغير من العملية الإجرامية دون رؤية شاملة لعواقبها النهائية. وتستخدم لغةً تقنيّةً ومجرّدةً تخفي الطبيعة الإنسانية للضحايا وتحوِّلهم إلى مُجرَّد أرقام أو فئات غير مرغوب فيها. بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر خارجية للشرعية (خارج العقل والتفكير الإنساني الحر) سواء كانت أوامر رسميةً، أو ضغوطاً اجتماعيةً، أو تبريرات أيديولوجيةً، تعفي الفرد من المسؤولية الأخلاقية المباشرة عن أفعاله. وأخيراً غياب نظام قانوني قضائي مُستقلّ يُجرِّم المرتكبين ويحاسبهم على أفعالهم.
هذا الدرس له تداعيات عميقة على فهمنا لعمليات بناء السلام والعدالة الانتقالية. تغيير النظام السياسي وحده غير كافٍ لضمان انتهاء الانتهاكات الجماعية. العدالة الانتقالية يجب أن تتجاوز محاسبة القادة والمسؤولين الكبار لتشمل فهماً عميقاً للآليّات التي مكّنت الأفراد العاديين من المشاركة في الجرائم، وتطوير إستراتيجيات تعليمية وإعلامية وقانونية فعَّالة لمنع تكرارها.
الأهم من هذا كلّه، فهم أنَّ مقاومة "تفاهة الشرّ" مسؤولية فرديّة قبل أن تكون مؤسسية. كُلُّ فردٍ في المجتمع يواجه يومياً خيارات صغيرةً بين التفكير وعدم التفكير، بين التساؤل والامتثال، وبين التعاطف واللامبالاة. هذه الخيارات الفرديَّة، عندما تتراكم عبر ملايين الأشخاص، تُشكِّل الفرق بين مجتمع عادل وآخر يغرق في العنف والظلم. فهْم هذه الحقيقة هو الخطوة الأولى نحو بناء مجتمعات أكثر عدالةً وإنسانيةً، ليس في سوريا فقط، بل في كُلِّ مكانٍ يواجه فيه الإنسان إغراء التخلّي عن مسؤوليته الأخلاقية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.