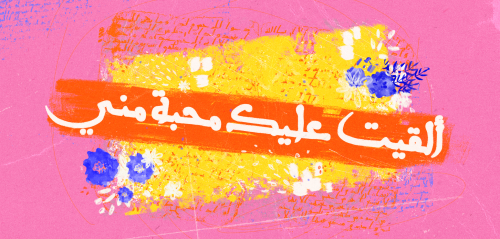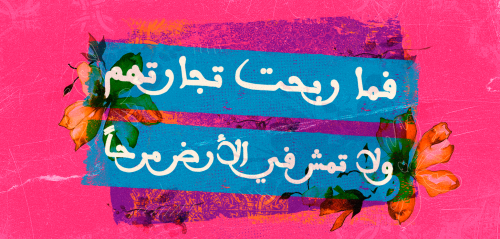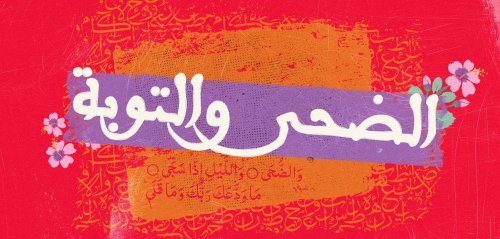تندرج هذه المادة ضمن ملف "هنا نفتح القرآن معاً، ويشعّ الحبّ"، في رصيف22.
اتفق المفسرون المسلمون على تقسيم الآيات القرآنية إلى نوعين متمايزين؛ عُرف القسم الأول منهما بالمُحكم، وهو ما لا يحتمل إلا وجهاً تفسيرياً واحداً، بينما عُرف الأخير بالمتشابه، وهو ما احتمل وجوهاً تفسيريةً مختلفةً.
على مرّ القرون، شهدت الآيات المختصة بصفات الله جدلاً واسعاً بين المفسرين والمتكلمين والفقهاء. في هذا السياق، حظيت الآية الحادية عشرة من سورة "الشورى" "فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، بأهمية كبرى في المدونات التفسيرية، حيث تم تأويلها بأشكال متباينة تتوافق مع القواعد الاعتقادية المُتفق عليها في كل مذهب.
صورة الله في المُتخيّل الكتابي
حظي التصوّر الكتابي، اليهودي والمسيحي، للإله باعتبارية في النصوص المقدسة. في اليهودية، صُوّرت الذات الإلهية في شخص يهوه/إلوهيم، الإله القومي لبني إسرائيل، ومنعت التوراة تصويره أو تجسيده بأي صورة من الصور. في هذا السياق، وردت بعض النصوص التي أضفت على الإله بعداً روحياً مخالفاً للشكل المادي التقليدي. من ذلك ما ورد في سفر التثنية: "فاعلم اليوم وَردِّد في قلبك أنَّ الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل، ليس سواه".
اتفق المفسرون المسلمون على تقسيم الآيات القرآنية إلى نوعين متمايزين، عُرف القسم الأول منهما بالمُحكم، وهو ما لا يحتمل إلا وجهاً تفسيرياً واحداً، بينما عُرف الأخير بالمتشابه، وهو ما احتمل وجوهاً تفسيريةً مختلفةً
في المسيحية، تم تصوير الذات الإلهية في شكل ثلاثة أقانيم مختلفة، الآب والابن والروح القدس، لإله واحد عظيم. وبينما أشارت أسفار العهد الجديد، ومنها رؤيا يوحنا، إلى الطبيعة النورانية الإعجازية للآب، فقد أتاح الاعتقاد بالتجسد الأرضي ليسوع الفرصة لانتشار العديد من الأيقونات واللوحات والجداريات التي ظهر فيها الثالوث المقدس في مئات الكنائس المسيحية حول العالم. برغم ذلك، بقي الاعتقاد بتنزيه الذات الإلهية حاضراً في العقل المسيحي الجمعي. يقول اللاهوتي المصري عبد الفادي القاهراني، في كتابه "رب المجد"، شارحاً أصول هذا الاعتقاد: "إن الله فوق أفكارنا وتصوراتنا واصطلاحاتنا. ولكنه تعالى، تنازل لأجل تعليمنا، فنسب في الوحي إلى ذاته الكريمة، بعض ما يُنسب للبشر، على طريق المجاز، كالوجه واليد والفم وما نحو ذلك، وفوق هذا نسب إلى نفسه في الوحي بعض الانفعالات النفسية كالرضى والغضب وغيرهما، مقرباً ذاته لأفهامنا المحدودة، بالتعبيرات المحدودة، مع أنه متعالٍ عن كل ما يقع تحته البشر".
بين المعتزلة وأهل السنّة
تطرق العديد من اللغويين المسلمين إلى شرح الآية الحادية عشرة من سورة الشورى، فبيّنوا أن ما جاء في المقطع الثاني منها "ليس كمثله شيء"، قد حمل تأكيداً مضاعفاً على تنزيه الذات الإلهية عن كل ما في الكون من موجودات. على سبيل المثال، يذكر أبو هلال العسكري المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري، في كتابه "معجم الفروق اللغوية" التالي: "... ليس في الكلام شيء يصلح في المماثلة إلا الكاف والمثل، فأما الشبه والنظير فهما من جنس المثل ولهذا قال الله تعالى ‘ليس كمثله شيء’، فأدخل الكاف على المثل، وهما الاسمان اللذان جُعلا للمماثلة فنفى بهما الشبه عن نفسه فأكد النفي بذلك".
إذا ما تطرقنا إلى الجدل الكلامي الأصولي المرتبط بهذا المقطع، لوجدنا أن المسلمين اتّبعوا مناهج عدة للتعاطي مع مضمون الآية. يتمثل الطريق الأول في الفكر المعتزلي الذي ذهب أصحابه إلى الاعتقاد بحتمية التنزيه الكامل لله عزّ وجلّ، بحيث لا يتبادر إلى الذهن وقوع التشابه بين الإله والمخلوق بأي طريقة من الطرق، وبأي شكل من الأشكال. اعتمد المعتزلة على "ليس كمثله شيء" في نفي المماثلة والمشابهة بين الله وأي من الكائنات والمخلوقات. كما رفضوا حمل الآيات القرآنية التي تصف الله بالسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الصفات على ظاهرها، وقالوا إن: جميع تلك الآيات من المتشابه الذي ينبغي تأويله في ضوء المعنى المركزي الذي حملته الآية. في هذا المعنى يذكر المفسر التونسي الطاهر بن عاشور في كتابه "التحرير والتنوير": "كانَتْ هَذِهِ الآيَةُ أصْلاً في تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعالى عَنِ الجَوارِحِ والحَواسِّ والأعْضاءِ عِنْدَ أهْلِ التَّأْوِيلِ/المعتزلة".
أخذ أهل الحديث بالتفسيرات المباشرة للآيات القرآنية المتعلقة بالصفات الإلهية، ووفّقوا بين تلك التفسيرات من جهة وبين المعنى العام لـ"ليس كمثله شيء" من جهة أخرى.
تتضح مركزية تلك الآية في الفكر المعتزلي في بعض الأخبار التاريخية المُختلف على صحتها. من ذلك ما ذكره عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في "شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني"، من أن أحمد بن أبي دؤاد، وهو واحد من كبار علماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري، قد اقترح على الخليفة العباسي عبد الله المأمون، أن يكتب على كسوة الكعبة: "ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم"، بحيث يغيّر الآية حتى لا يثبت السميع البصير. بحسب تلك الرواية، رفض المأمون تنفيذ ذلك المقترح لأنه خشي أن يتهمه المسلمون بتحريف القرآن. الأمر نفسه تكرر عقب وفاة المأمون، وتحديداً في فترة خلافة المعتصم بالله. يذكر شمس الدين الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء"، أن الخليفة المعتصم كتب على كسوة الكعبة "ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير"، الأمر الذي يوضح تأثّر المعتصم بالفكر المعتزلي في تلك الفترة.
على الجانب المقابل، أخذ أهل الحديث بالتفسيرات المباشرة للآيات القرآنية المتعلقة بالصفات الإلهية، ووفّقوا بين تلك التفسيرات من جهة وبين المعنى العام لـ"ليس كمثله شيء" من جهة أخرى؛ على سبيل المثال، قال ابن أبي العزّ الدمشقي في شرحه للعقيدة الطحاوية: "إن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته". كذلك عمل بعض العلماء على ربط الآية بمفهوم التوحيد الخالص، وباعدوا بينها وبين العقائد المرتبطة بصفات الذات الإلهية وماهيتها، من ذلك ما ذكره ابن القيم الجوزية في تفسيره لتلك الآية: "إنما قُصد به -يقصد الآية- نفي أن يكون معه -أي الله- شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم؛ كما يفعل المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله، وعلوّه على خلقه، وتكلّمه بكتبه، وتكلّمه لرسله، ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصّحو".
تأويلات أخرى
إلى جانب التناول الجدلي المعتزلي-السنّي، ظهرت العديد من التأويلات الأخرى للآية. من ذلك التناول الشيعي الذي ترددت أصداؤه في المدوّنات الإمامية منسوباً إلى الأئمة الاثني عشر. على سبيل المثال، ينقل محمد بن يعقوب الكليني، في كتابه "الكافي"، عن الإمام جعفر الصادق، تفسيره للآية بأن الله "لَا يُحَدُّ، وَلَا يُحَسُّ، وَلَا يُجَسُّ، وَلا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ، وَلَا الْحَوَاسُّ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شيء، وَلَا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ، وَلَا تَخْطِيطٌ وَلَا تَحْدِيدٌ...". المعنى نفسه، ورد على لسان الإمام موسى الكاظم، عندما سُئل عن ماهية الذات الإلهية، فأجاب: "سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم ولا صورة".
تطرق العديد من اللغويين المسلمين إلى شرح الآية الحادية عشرة من سورة "الشورى"، فبيّنوا أن ما جاء في المقطع الثاني منها "ليس كمثله شيء"، قد حمل تأكيداً مضاعفاً على تنزيه الذات الإلهية عن كل ما في الكون من موجودات
من جهة أخرى، ظهر التأويل الصوفي الروحاني للآية في كتابات الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، لا سيما في موسوعته الكبرى المسماة "الفتوحات المكية". بشكل عام، اتخذ ابن عربي من الآية الحادية عشرة من سورة الشورى مدخلاً لتصوره الذاتي عن ماهية الذات الإلهية، ومن ثم لم يكن من الغريب أن يضعها -أي الآية- في كتابه كأول الآيات القرآنية. في مواضع أخرى من الكتاب، ساق ابن عربي الآية في سبيل شرح بعض من آرائه المعقدة، لا سيما في مبحثَي وحدة الوجود والعلاقة بين الخالق والمخلوقات. في هذا السياق، يقول ابن عربي في أحد المواضع: "كل الأشياء فانية فيه هالكة، فلا شيء يماثله في الشيئية والوجود". وفي موضع آخر من الكتاب، يقول: "ما هو ميت ولا حي... فمن خلق الموت والحياة لا ينعت بهما فقد كان ولا هما".
على صعيد آخر، لا يمكن التغافل عن التأويل التاريخي لتلك الآية. يعمل هذا النوع من التأويل على توضيح السياقات الاجتماعية والثقافية التي شهدت نزول تلك الآية. في كتابه "التحرير والتنوير"، وضح الطاهر ابن عاشور ملابسات نزول الآية فذكر أن العرب الجاهليين اعتادوا أن ينسبوا البنات إلى الله دوناً عن الرجال. ومن ثم تعمدت الآية الحديث عن الزواج بين المتشابهين -الرجال والنساء- وما ينتج عن هذا الزواج من نسل. وبعدها لفتت الآية النظر إلى اختلاف الذات الإلهية عن الطبيعة الإنسانية، وبيّنت أنه من غير المعقول أن تحدث المزاوجة بين الإنسان والذات الإلهية غير المتشابهة مع أي شيء من الموجودات.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.