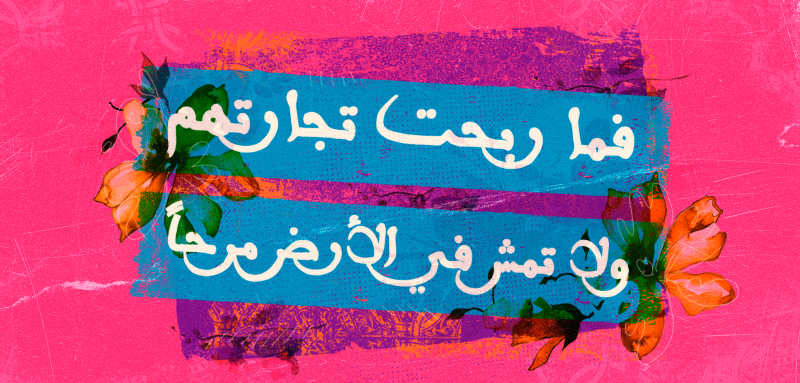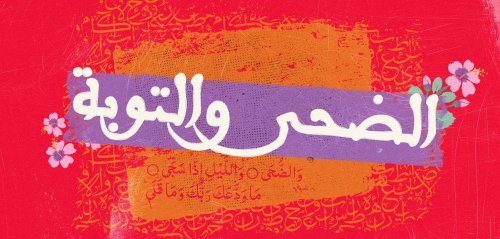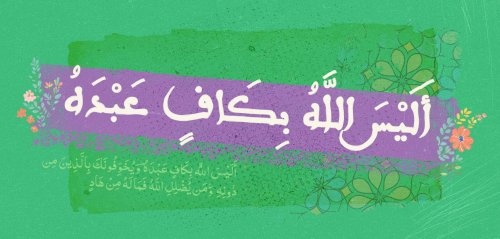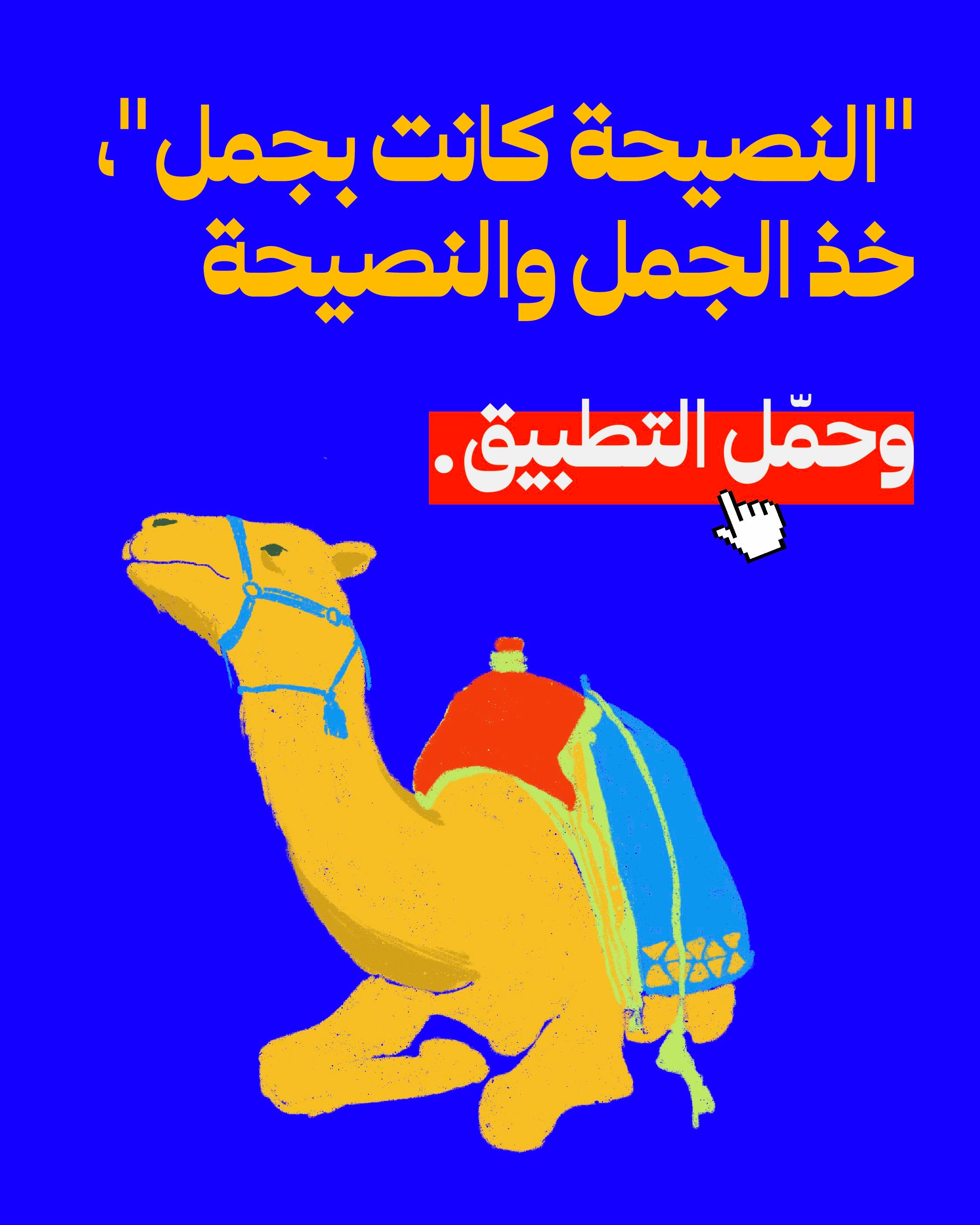تندرج هذه المادة ضمن ملف "هنا نفتح القرآن معاً، ويشعّ الحبّ"، في رصيف22.
كثيرة آيات النصّ القرآني التي تستوقفني خلال تلاوتي المصحف. غالبيتها خرجت من بين دفتي كتاب المسلمين المُقدّس ورسخت في ذهني وعلى لساني منذ أن كنت طفلاً، دون أن أعرف أنها مصطلحات قرآنية. حتى أنني أتذكر حين كنت طالباً في المرحلة الإعدادية وعزمت النية على الانتهاء من قراءة القرآن كاملاً لأول مرة في حياتي. حينها، استغربتُ كثيراً من كثرة المصطلحات القرآنية الجارية على لساني دون أن أعلم أنها قرآنية!
في ما ثلاثة نصوص أروي فيها تجربتي الشخصية مع تلك الآيات، ومحاولاتي تبيّن جمالياتها عبر عدد من كتب التفسير وعلوم اللغة.
"أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين"
تكاد كتب التفسير تُجمع على أنها نزلت في المنافقين الذين رفضوا الإيمان بالإسلام وتمسّكوا بالكُفر به. برغم ذلك، فإن صياغتها العامة سمحت للكثيرين باستخدامها في سياقات أخرى أبعد قليلاً من خانتَي الكفر والإيمان، بل ربما كوسيلة للتنابذ بين فريقٍ وآخر وقد وصلت أحياناً إلى المتعاركين في ساحات السياسة، وهو ما جعلها رائجةً كثيراً على ألسنة المتقاتلين في المسرح السياسي في مصر خلال الفترة الساخنة التي عشناها بين ثورة كانون الثاني/يناير وتظاهرات 30 حزيران/يونيو.
كثيرة آيات النصّ القرآني التي تستوقفني خلال تلاوتي المصحف. غالبيتها خرجت من بين دفتي كتاب المسلمين المُقدّس ورسخت في ذهني وعلى لساني منذ أن كنت طفلاً، دون أن أعرف أنها مصطلحات قرآنية
في هذه الآية حضر الوصف القرآني ببلاغة ووضوح مباشر مشبّهاً رفض الإيمان بصفقة تجارية يعقدها الواحد منّا وهو متحمّس ضامنٌ لنتيجتها، لكنه في الواقع يقود نفسه إلى خسارة مؤكدة.
في علوم اللغة، هذا الوصف يُسمّى "الاستعارة المرشحة" التي تأتي مصحوبةً بما يلائم المُستعار منه أو المُشبّه به، فاعتبرت الخيارات الحياتية نوعاً شبيهاً بعمليات البيع والشراء، ويُعدّ هذا النوع من الاستعارات أكثر بلاغةً من تصنيفها الآخر "الاستعارة المُجرّدة".
عن استخدام هذه "التقنية اللغوية" في هذه الآية تحديداً، علّق الزمخشري في كتابه "الكشاف"، قائلاً: "هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهو أن تُساق كلمة المجاز ثم تُقفى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن لم ترَ كلاماً أحسن منه ديباجةً وأكثر رونقاً".
وبحسب الفرّاء، فإن الصياغة القرآنية جعلت التجارة فاعلاً برغم أنها من المفترض أن تكون مفعولاً به، فالرابح هو التاجر أما التجارة فهي مربوح به، لكن الآية تخلّت عن هذه التراتبية المنطقية حتى تكون أقرب إلى بعض التعبيرات العربية الشائعة في زمن البعثة، مثل "ربح البيع" و"خسر البيع"، وهذا ما أسماه نصر حامد أبو زيد انتماء القرآن العام إلى الفضاء اللغوي العربي وتأثّره الشديد به، حسب ما نقل عنه جمال عُمر، في كتابه "هكذا تكلم نصر أبو زيد". وهو ما يُمكن الزيادة عليه بالتأكيد على استعمال النشاط التجاري؛ لا الزراعة ولا الصناعة ولا الطب، لأنها كانت المصدر الأهم لكسب الرزق والجاه والثروة وقتها وليس أي نشاط آخر.
في كتابهما "في علوم القرآن: دراسات ومحاضرات"، قدّم محمد عبد السلام كفافي وعبد الله الشريف، تفسيراً بديعاً ومخيفاً لهذه الآية: "لقد حسبوا الضلالة كسباً، فخسروا في هذا الحساب، ولم يقف الأمر عند حرمانهم من الربح، بل إنهم خسروا رأس مالهم وهي عقولهم، فلم تعد هذه العقول قادرةً على الاهتداء إلى العقائد الصحيحة، بل أصابها ما جعلها عاجزةً عن كسب تلك العقائد".
بفضل هذا التشبيه الدقيق تتجلّى هنا واحدة من أبشع العقوبات الإلهية –حسب ما أعتقد- ضد بعض "خلقه"، حينما يُسلّط عليهم العمى الأخلاقي الذي يجعلهم ينزلقون في درك المعاصي وهم يحسبون "أنهم يُحسنون صُنعاً".
المفارقة الكبرى عندي في هذا التشبيه، أن الخسارة من البيع والشراء تتبيّن نتيجتها ولو بعد حين، وقد تتعلّم منها في اتخاذ قرارات أكثر نجاحاً في المستقبل. أما "الخسارة الإيمانية" بهذا الشكل، فتحتاج إلى مجهود إنساني جارف لتشخيصها والنجاة منها.
هذا التسلسل الذهني كان يقودني دوماً إلى آفاق تفكيرية أكثر توسعاً وإثارةً للقلق كلما استحضرتُ هذه الآية في ذهني قبل النوم؛ كيف أضمن أنني أسير على الطريق الصحيح مهما كنت مقتنعاً بأنه صحيح؟ كيف أعرف أنني لا أشتري "الضلالة" بعدما اعتقدت خطأً أنها "هدى"؟ كيف أؤمن من شرِّ نفسي ألا تكون قد ارتكبت من المعاصي حدّاً جعلها تستحقُّ العقاب الإلهي الصارم بـ"التغييب الأخلاقي"؟
بكل أسف لم أصل إلى ذلك اليقين يوماً، ويبدو أنني لن أصل إليه قطّ.
"وَلَا تَمْشِ في الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً"
ذات يومٍ، كتبتُ مقالاً جميلاً أعجبني بشدة، حتى أنني قرأته عشر مرات متتالية وأرسلته إلى أبي قائلاً: انظر صنيعة ابنك. عندها، بلغ فخري بنفسي أوجَه، فكتبتُ على حسابي في فيسبوك: "إنه خرق الأرض وبلغ الجبال طولاً". أردتُ من هذه العبارة السير على خُطى التعبير القرآني الذي دعا البشر إلى عدم الخيلاء، لأنهم لن يطولوا الجبال أبداً مهما فردوا قاماتهم ولن يخرقوا الأرض مهما دبّوا عليها بأقدامهم.
هذه الآية من التعبيرات القرآنية التي لا تفارق مخيلتي، بسبب ذلك التشبيه المذهل الذي يصوّر الأمر كأفضل ما يكون، حتى باتت أقرب التعبيرات إلى ذهني دلالةً على الغرور الذي قد يقود صاحبه إلى الهلاك يوماً دون أن يدري.
أتت هذه الآية ضمن ما يُمكننا تسميته بالوصايا الأخلاقية القرآنية التي دعت إليها سورة الإسراء، بدءاً من عدم الكفر بالله والرفق بالوالدين انتهاءً بعدم "المشي في الأرض مرحاً" باعتباره "سيئةً عند ربك مكروهاً".
توّج هذا القول الموقف المُتحفظ الذي اتخذته الشريعة الإسلامية من "التكبّر"، والذي دلّلت عليه بأدلة كثيرة أقل شهرةً من الآية، منها سلوكيات النبي نفسه وتحديداً عند المشي الذي نُظر إليه في ذلك الوقت كمقياس أساسي لحجم الخيلاء التي تملأ الإنسان.
فبحسب ما رُوي عن النبي، كانت مشيته أبعد ما تكون عن مشية الخيلاء. حكى أبو هريرة أنه كان يمشي "كأنما الشمس تجري في وجهِهِ، وما رأيت أحداً أسرع في مشيتِهِ من الرّسول، كأنما الأرض تطوى له. إنا نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث". هذا القول أيّدته مروية أخرى وصفت مشي الرسول بأنه كان "إذا مشى يتكفأ تكفؤاً كأنما ينحطُّ من صبب"، أيضاً نُقل عن النبي قوله "مَن تعظّم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان".
ووفق ما يذكر عالم اللغة الفلسطيني محمد جواد النوري، في كتابه "إضاءات قرآنية - دراسة لغوية"، فإن هذه الآية خلّدت كيف أن طريقة مشي الإنسان تعكس دواخله النفسية وتُعدُّ مرآةً صادقةً لأعماقه.
في كتابه، اعتبر النوري أن طريقة المشي المتزنة من "مكارم الأخلاق" التي تخلق علاقةً وطيدةً بين الإنسان ومجتمعه.
في تشرين الأول/أكتوبر 1981، كتبت الأديبة غادة السمان، مقالاً حادّاً بليغاً بعنوان "حاكموهم"، ينتقد الأثرياء العرب الذين ينفقون أموالهم ببذخ خلال رحلات الصيف في أوروبا، اختتمته بفقرة تقول: "’لا تمشِ في الأرض مرحاً إنّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً’. ليت البلاد العربية كلها تكتب هذه الآية الكريمة داخل طائراتها ليقرأها الذين يمشون في الأرض مرحاً، لكنه إجراء لن يكفي للأسف، فما حيلتنا أمام الطائرات الخاصة؟".
"وإذا مسَّ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضرٍّ مسّه"
هل يُمكنكم أن تتخيّلوا أن الله يشتكي من أحد خلقه؟
لا أعلم إن كان هذا التعبير يخرج بنا من مجال الأدب مع الذات العُليا، لكن هذا أول مفهوم كان يصل إلى عقلي عند قراءة تلك الآية الكريمة التي تُظهر -برأيي على الأقل- تبرماً إلهياً من ذلك الإنسان، المخلوق المُحبب إلى الإله والذي حظي بعناية ربانية أغضبت مخلوقات أخرى، وبرغم ذلك فإن نفسه عصية على الطاعة ولا تلهث بالدعاء إلا عند الحاجة!
ذلك الأسلوب المنافي للّياقة عبّر القرآن عنه بشكلٍ سلبي في مواضع أخرى منها: "وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه الشر فذو دعاءٍ عريض"، وأيضاً في قوله: "ولئن أذقناه رحمة منّا من بعد ضراء مسته ليقولنَّ هذا لي".
اعتبر الفيلسوف الشيعي السيد محمد حسين الطباطبائي، في كتابه "الميزان في تفسير القرآن"، أن "مسّ الضر" أبعث للإنسان على الخضوع وعبادته من قلبه، لهذا أكثر الخطاب القرآني من تقديم الضر على النفع عند حديثه عن علاقة الإنسان بإلهه مثل قوله "اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً"، وأيضاً في قوله "ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً".
وحسب ما ذكر الدكتور عبد الرحمن أبو موسى في كتابه "صور من بلاغة القرآن الكريم"، فإن هذه الآية شهدت أسلوباً بيانياً مميزاً بعدما جمع فيها الله بين التعريف والتنكير؛ في البداية عرّف "الضُرّ"، وبعدها قدّمه منكراً لإظهار الفارق بين رؤية الإنسان له في كلا الحالتين.
"وَلَا تَمْشِ في الْأَرْضِ مَرَحاً"... هذه الآية من التعبيرات القرآنية التي لا تفارق مخيلتي، بسبب ذلك التشبيه المذهل الذي يصوّر الأمر كأفضل ما يكون، حتى باتت أقرب التعبيرات إلى ذهني دلالةً على الغرور الذي قد يقود صاحبه إلى الهلاك يوماً دون أن يدري
في الحالة الأولى كان الإنسان مصاباً فاستحوذ عليه "الضر" بشكلٍ كامل وبات معرفة لا يمكن تجاهلها استحوذت على جميع حواسه، وفور أن استجاب الله له و"كشف عنه"، توارى هذا الضرّ بعيداً وابتعد عن محور اهتماماته وأصبح نكرةً لا قيمة له لا تُقلق أحداً.
يضيف أبو موسى: "لما كشف الله عن الإنسان البلاء نسي بسبب خساسة طبعه ما كان يعاني منه فظهر له أنه لم يعِش في ‘الضر الحقيقي’ الذي توقّع أن يهلكه، بل كان في مجرد ‘ضر’ ضئيل التأثير أصابه مثلما أصاب غيره، وهو ما يبرر ظهوره في المرة الثانية مضافاً إلى الإنسان، أما في المرة الأولى فظهر معرفاً بالألف واللام دلالةً على جسامته وخطورته".
وفي بحثها "سياقات الابتلاء بالخير والشر في القرآن الكريم"، أضافت الدكتورة رباب صالح، بُعداً بيانياً آخر في هذه الآية بعدما فرّقت بين موضعي استخدام "إذا" و"لما"، فالأولى تُستخدم إذا كان الموضوع في المستقبل ويُتوقع حدوثه، والثانية تشير إلى الماضي وتحقق حدوث الفعل.
وبحسب ما كتبه المفكر الإسلامي الراحل سيد قطب، في كتابه "التصوير الفني في القرآن"، فإنه اعتبر هذه الآية من النماذج القرآنية التي تختصر الجنس الإنساني كله.
يقول قطب: "تجتمع كل عناصر الصدق النفسي والتناسق الفني، فالإنسان هكذا حقاً، حين يمسّه الضر وتتعطل فيه دفعة الحياة يلتفت إلى الخلف ويتذكر القوة الكبرى ويلجأ إليها"، فإذا انكشف الضر وزالت عوائق الحياة انطلقت الحيوية في كيانه وكفَّ عن الالتفات إلى الوراء".
وبحسب قطب، فإن الإطالة في وصف حالة الدعوة دلالة على عِظم تأثير الضرر على الإنسان حتى أنه استمرَّ يدعو الله أيّاً كانت حالة جسده؛ قائماً أو جالساً، لكن فور فتح الحاجز وتدفق تيار الحياة فإن الإنسان يـ"مرّ" كان شيئاً لم يكن قد أوقفه وأعجزه أصلاً، وهي الحالة الإنسانية المعقدة التي عبّر عنها الله أيضاً في مواضع أخرى من القرآن مثل وصفه الإنسان بأنه "إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً"، أو قوله "ولئن أذقْناهُ نعماءَ بعدَ ضَرّاء مسّتْه ليقولنّ ذَهبَ السَّيئات عنّي، إنّه لفرحٍ فَخُور".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.