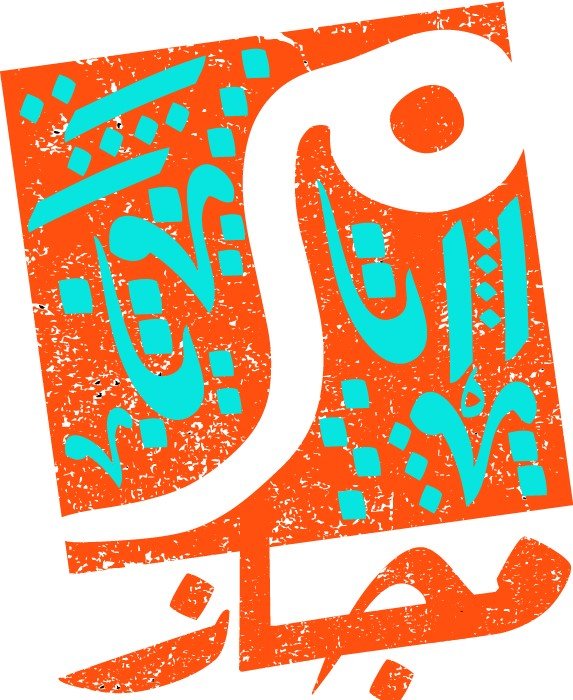
السبت من كل أسبوع كان موعدها. تأتي معه بقفتها الخوص، ثوبها الأسود الفضفاض وشاشها الملفوف حول رأسها بعناية لا تخلو من أناقة، تطل من أسفله تربيعتها البيضاء التي انحسرت عن غرّة شعر نامت برقة على جبينها العريض؛ فأضفت على وجهها وسيم التقاطيع -الذي صبغته أشعة الشمس بسمار محبب- بريقاً وجاذبية جعلتها تخترق القلب من أول طلة.
هي الخالة زينب أو"أم محـمد الدلالة" التي كانت تطوف شوارع قريتنا الصغيرة مع ظهيرة كل سبت، في طقس مكرّر مقدس، لا تخالفه إلا لطارئ. فمع حلول الظهيرة، كان يأتيني صوتها قبل طلتها منادياً على بضاعتها بدلال واضح وإيقاع فريد: "معايا الملايات والفوط المحلاوي. معايا مناديل بترتر. معايا لوازم العرايس الحلوين"، فأجري عليها لتمنحني "كيس عسلية بالسمسم"، تحمله لي خصيصاً وتهديني إياه دوناً عن أطفال القرية فور تراني. وتواصل نداءها: "معايا الملايات والفوط المحلاوي...".
فهكذا كانت تعلن عن بضاعة اكتظت بها قفة استقرت فوق رأسها، لا تنزلها إلا إذا نادتها إحدى الفلاحات، فتقترب وتجلس أمام بيتها، توزع ضحكاتها، وتزكي بضاعتها، وتطمئن على أحوال البنات؛ حيث كانت أغلب الفلاحات يشترين بضاعتها "شواراً" لبناتهن "اللي على وش جواز"، بالقسط؛ فتوفر لها النسوة بعض القروش كل أسبوع، تأخذها أم محـمد وتقبلها وتلمس بها جبهتها، قبل أن تدسها في كيس قماشي صغير خبأته في صدرها، كانت تعلقه في عنقها دوماً.
كانت أم محـمد امرأة حنوناً، "جدعة" كما يصفها أهل القرية، تقدر ظروفهم، لم تقف يوماً على باب أحدهم مطالبة بثمن ما اشتراه إذا ما تأخر في سداد القسط. لم تضايق أحداً بكلمة، أو تجرحه بتلميح، فقد كانت تبيع الفرحة للجميع قبل أن تبيع بضاعتها.
و"الأهم من الفلوس سترة البنات": هكذا كانت تجبر بخواطرهن، وتطمئن كل عروس أنها سوف تقتني ما تتمناه، بجملتها التي كانت ترددها دوماً: "سيبيها على الله وعليا.. مَقضيَّة بأمر الله".
"كده تهون عليك زينب يا محـمد؟": هكذا كانت تردّد زينب لأيام طويلة وهي تجوب الحقول، وعلى شط الترعة القديمة، وعلى جانبي المصرف الكبير، تبحث عن الحبيب الذي لم تروِ ظمأها من حبه بعد... مجاز
كانت أم محـمد امرأة أربعينية، ورثت عن أبيها أرضاً تدرّ لها دخلاً يكفيها ويفيض، عاشت وحيدة، لا أحد يطرق بابها، فقرّرت أن تطوف القرى وتدخل هي كل بيت بطريقتها. لم تعمل بالدلالة احتياجاً، لكنها كانت تتصدق بمالها على روح أب حنون وزوج عاشق، تركاها تعاني مرّ الوحشة، دون أن تخبر أحداً، فمن استطاع الدفع دفع، ومن عجز عذرته وأعانته وقضت حاجته دون أجر.
"الفلاحين غلابة، الله يعينهم": هكذا كانت تقول لأمي التي ارتبطت معها بصداقة طويلة؛ فكانت كل أسبوع، ومع نهاية "لفتها" في شوارع القرية، وقبل أن تغادرها، تأتي إلينا، تضع قفتها عند عتبة الدار، وتجلس على البلاط الملون بعيداً عن الحصير، تتلمّس بعضاً من برودته، علها تخفّف عن جسدها ارتفاع حرارته وفورانه.
تخلع شاشها، فأجلس أمامها أتامل تربيعتها التي غزلت أطرافها بالخرز والترتر ببراعة، وغرتها التي تساوت شعراتها بإتقان بالغ، وأشتهي "بنسها" (دبابيس شعرها) الملونة. تقدم لها أمي وجبة "على ما قسم"، كما كانت تصفها بخجل، وهي تضع أطباق الطعام في كل مرة أمامها بحب وتصر أن تأكل لأنها "من صباحية النهار بتلفي في الشارع".
تأكل أم محـمد بامتنان، ثم تعد أمي كوبين من الشاي، وتجلسان معاً تتبادلان الأخبار، وبعد أن تنتهي كل منهما من الاطمئنان على أحوال الأخرى، تخرج الخالة من قفتها دفتراً صغيراً، وتطلب من أمي أن تدوّن لها ما باعته خلال يومها، وما قبضته من أقساط، وما طلب منها إحضاره المرة المقبلة؛ فلم تكن زينب تعرف القراءة والكتابة، لكنها كانت ذكية تجيد العمليات الحسابية وتمتلك ذاكرة قوية.
لا أعرف متى بدأت علاقة أمي بها، تلك العلاقة القوية التي جعلتها تختصها بهذه المهمة من بين نساء القرية، فكان هناك من بينهن من يجدن القراءة والكتابة أيضاً. لم تكن الكتابة وتدوين الحسابات والطلبات هي كل ما اختصتها به، لكنها اختصتها أيضاً بحكايتها التي بدأت في سردها بمجرد أن سألتها أمي ذات "عصرية" عن ابنها محـمد، لتعرف أمي يومها لأول مرة، وبعد سنوات طويلة، أن محـمداً لم يكن ابنها، ولكنه كان زوجها الحبيب.
حكت زينب عن محـمد، ابن الجيران الذي وقعت في غرامه صبية صغيرة، تفتحت عيناها على رجولته التي كانت تتفجر مع الوقت، فتنت بغيرته عليها التي كانت واضحة للجميع؛ حرصه الدائم على سلامتها، وسيره خلفها لحمايتها إذا ما ذهبت إلى أي مكان دون أن تطلب منه ذلك، لم يكن حينها ينطق بكلمة، أو يقلل المسافة التي تفصل بينهما خطوة، لكن عينيه إذا ما التقتا بعينيها فجأة كانتا تحكيان لها الكثير.
عرف الكل في قريتها غرام محـمد بها وعشقها له الذي كان يتضح في كل مرة يكتسي فيها وجهها بحمرة الخجل إذا ما مرّ في مكان كانت فيه صدفة.
كانت زينب الابنة الوحيدة لكبير قريتها، وكان محـمد ابن فلاح فقير؛ لذلك لم يجرؤ على الكلام. لكن الكبير حينما استشعر غرام ابنته بالعاشق الولهان، قرّر أن يمنحها تأشيرة الدخول لدنيا السعادة؛ فلأنه يعلم أن محـمداً كان رجلاً يؤتمن، وأن أباه، بالرغم من فقره، كان عزيز النفس؛ أرسل إليهما وقال لهما: "اخطب لبنتك"، ففرحت زينب لكن فرحة محـمد كانت أكبر.
تزوجها وعاشا معاً في بيت أبيها، الذي عاش وحيداً بعد موت أمها صغيرة، فملآه حبّاً وأنساً وسعادة. لكن الحكاية كما لو كانت حلماً سرعان ما انتهى ذات صباح، بعد أن استيقظت منه زينب على وجع لم يغادر قلبها رغم السنين.
فذات ليلة خرج محـمد ليروي أرضه، ولم يعد. جنّت زينب؛ فـ "النهار شقشق ومحـمد لسه مارجعش"، هكذا أخبرت أباها وهي توقظه من نومه قلقة. أرسل خفراءه إلى الأرض، فلم يجدوا له أثراً، والأرض لم تروَ من الأساس. جنّت زينب؛ تركت بيت أبيها وطافت في الحقول بحثاً عنه أياماً، حتى قالوا لها "أكيد النداهة ندهته وخدته عندها".
تفسير كان كسكين ضربوها في قلبها بكل قسوة، فكيف لمحـمد بكل الحب الذي غمرها به أن يلتفت إلى غيرها، حتى لو كانت "جِنيَّة"؟ كيف أغوته بنت الملاعين، وأخذته من أحضانها ليلاً؟ كيف هانت عليه زينب وألقى بجسده الفتي في أحضان امرأة غيرها؟ كيف استطاعت عيناه أن تريا امرأة أخرى، وهو الذي كان دائماً يردّد لها: "مافيش غيرك ست تغويني"؟ كيف كذب؟ كيف ضعف؟ كيف استسهل البعد والغياب؟!
*****
"كده تهون عليك زينب يا محـمد؟": هكذا كانت تردّد زينب لأيام طويلة وهي تجوب الحقول، وعلى شط الترعة القديمة، وعلى جانبي المصرف الكبير، تبحث عن الحبيب الذي لم تروِ ظمأها من حبه بعد، تلتمس أثره.
عرف الكل في قريتها غرام محـمد بها وعشقها له الذي كان يتضح في كل مرة يكتسي فيها وجهها بحمرة الخجل إذا ما مرّ في مكان كانت فيه صدفة... مجاز
قال لها أهل القرية: "النداهة لما بتزهق من حد بترجَّعه.. هايرجع يا زينب".
وراحت زينب تنتظر على أمل. شهور مضت وزينب لا تخلع الأسود ولا تمل من البحث والسؤال، حتى طرق محـمد بابها ذات ليلة بالفعل. لكنه عندما عاد، لم يكن كما غاب؛ فقد كان على هيئة غير الهيئة، ضعيفاً، مريضاً، يردّد كلمات غير مفهومة. وبرغم الفجأة والوجع على هيئته، احتضنته بقوة، وعاتبته بحب: "كنت فين كل ده يا محـمد؟". نظر إليها، ثم فارق الحياة بين يديها دون أن يجيب عن سؤالها بكلمات ترضيها.
مات محـمد بين يدي زينب دون أن تعرف سر غيابه. صارت حكاية محـمد والنداهة حكاية ترويها النساء، بينما تبكيه زينب بحرقة قلب لم تذقها من قبل. بكت حتى ذابت في الوجع وأصبحت وجعاً يمشي على الأرض، حزن عليها أبوها، ومات كمداً، تركها هو الآخر؛ كادت تجنّ، قضت أشهراً طويلة وحيدة في دارها يعتصرها الحزن، لا يطرق أحد بابها؛ فقد اعتبرها أهل قريتها شؤماً وفال نحس.
ابتعد عنها الناس ولم يكن لها أحد بعد أبيها، حتى زارها محـمد في المنام، وأخبرها أنها عاشت تهديه الفرحة فلا يليق بها كل هذا الحزن. ليلتها فقط تذوقت من جديد طعم الابتسام، ونهضت من فراشها، تقاوم، وتتحدى. فتحت أبواب بيتها، وخرجت للناس، فهي بنت الكبير التي لا يليق بها الغمز واللمز. واجهتهم قوية عنيدة، فأخرست الألسنة، وقرّرت أن تطوف القرى والنجوع تحقق الأحلام وتوزع السعادة مع "الملايات والفوط المحلاوي، والمناديل أم ترتر، ولوازم العرايس الحلوين". وإذا ما سألها أحد عن اسمها، أجابت بحب: "أنا أم محـمد".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





