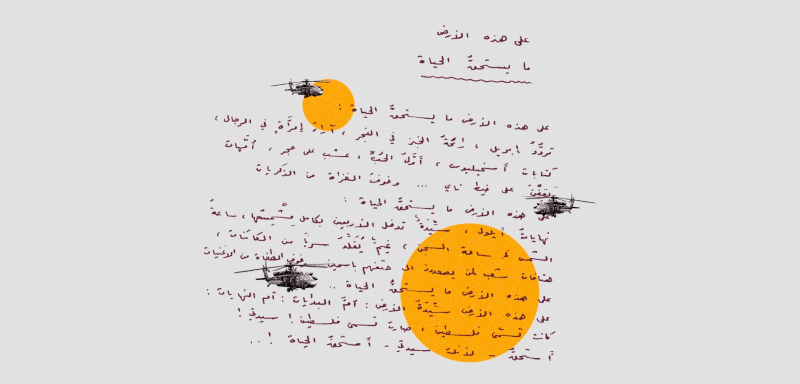الكلمات هي الأخرى خرساء، ومتشحة بالسواد؛ فما الذي ستفعله البلاغة العربية اليوم من خطابات قومية صارت خانعة وهزيلة؟ أو قصائد انغلقت على نفسها طويلاً؟ ما الذي تفعله الكتابة في وجه المجازر والإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي، التي تقترفها إسرائيل في حق قطاع غزة؟
النيران تلتهم الجميع. إنها تحرق اللغة العربية ذاتها عبر البيانات الغربية التي تعطي إسرائيل حق الدفاع عن نفسها أمام المدنيين ، أصحاب الأرض والحق. اللغة تُعادينا، ونحن نتواطأ أيضاً. إذاً، بأي لغة نكتب إبادة غزة؟ هل نكتب بلغة الجحيم؟
عند هذا الحد، يأتي الشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي لا يزال صوته حياً وسط الحرب الدامية، ليدعونا للتوقف عن الكتابة بلغة "الندب"، فغزة كما عرفها هو وأدرك سرَّها لا تُحب النواح. إنها تعرف شيئاً واحداً فقط: "المقاومة"؛ فالغارات التي سوت أكثر من 60 حياً سكنياً بالأرض، لا يُمكنها أن تقتل الهوية، هوية الإنسان الفلسطيني المقاوم منذ الأزل.
بيد أن هذه الهوية تحتاج إلى من يُدافع عنها ويُثبتها في الأعماق، إزاء محاولات تذويبها في مياه العولمة، وكذلك عبر سياسات التغريب الهادفة إلى نزع الهوية عن الفلسطيني والعربي، وهو ما انعكس بشكل سلبي على حضور القضية الفلسطينية في الكتابات الأدبية، فانزوى الأدب المقاوم بعيداً عن أعين محبي أدب الكتابة الذاتية، والنصوص المفتوحة المتحررة من فكرة الأجناس الأدبية. وصار الأدب الفلسطيني المقاوم شيئاً من الماضي، تماماً مثلما ينظر البعض إلى القضية الفلسطينية كشيءٍ قديم، انتهى مع العصر الجديد، عصر الانفتاح والتطبيع، والسماوات المفتوحة، والمواطن العالمي، حتى أن كلمة "الهوية" صارت "سُبة" في وجه من يؤمن بها.
صار الأدب الفلسطيني المقاوم شيئاً من الماضي، تماماً مثلما ينظر البعض إلى القضية الفلسطينية كشيءٍ قديم، انتهى مع العصر الجديد، عصر الانفتاح والتطبيع، والسماوات المفتوحة، والمواطن العالمي
لا يزال هناك أدب مقاوم للسياسات الإسرائيلية في فلسطين، حتى من جانب أدباء المهجر، ولعلنا هنا يجب أن نذكر رواية الكاتبة الفلسطينية المقيمة في العاصمة الألمانية برلين، عدنية شبلي، حيث رفض معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تكريم الكاتبة ومنحها الجائزة التي فازت بها عن روايتها "تفضيل ثانوي" التي تسرد بها رؤيتها لأحداث 1948. اُتهمت عدنية بمعاداة السامية، وواجهت هجوماً في برلين التي روجت ومولت وأقامت مؤسسات للدفاع عن حرية التعبير؛ هذه الحرية التي تكاد تصبح اليوم نقيض كلّ ما يمت بصِلة للحرية الإنسانية وليس لحرية التعبير فقط.
وبرغم ما طال الأدب المقاوم من تهميش، وإقصاء، إثر عمليات السلام التي وقعتها بعض الدول العربية مع دولة إسرائيل، وما ترتب على ذلك من تقويض للقضية الفلسطينية، إلا أن مسيرة الأدب الفلسطيني زاخرة بالكثير من الأسماء اللامعة، و كانت فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، مُحركهم صوب الكتابة، بل كانت هي روايتهم الحقيقية، التي قدم بعضهم حياته ثمناً لها وعلى رأس هؤلاء غسان كنفاني الذي اغتاله الموساد مع ابنة أخته في بيروت. وإميل حبيبي في روايته المهمة التي تغوص في أعماق الجُرح الفلسطيني "الوقائع الغريبة لاختفاء سعيد أبي النحس". وإبراهيم نصر الله صاحب المشروع الأدبي في توثيق السردية الفلسطينية وتاريخها.
ومن الأصوات النسائية، نذكر سحر خليفة في روايتها "ربيع حار"، وكذلك الكاتبة المصرية رضوى عاشور في روايتها "الطنطورية"، وهناك الكثير من الروائيين العرب الذين انشغلوا بالقضية الفلسطينية وربما كانت قضيتهم الكبرى مثل الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل صاحب رواية "على عهدة حنظلة" وهي توثيق لحياة المناضل الفلسطيني ناجي العلي الذي اغتيل في لندن عام 1987، كما أن "باب الشمس" للروائي اللبناني إلياس خوري، تعد من أهم الأعمال الأدبية التي وثقت القضية الفلسطينية.
"غزة من مواليد النار ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على الديار"
نعود إلى غزة التي تُقصف الآن. ولأنها لا تُحب النواح والبكاء، فعلينا أن نذهب إلى محمود درويش، لأنه من اكتشف سرّها في نصه الملحمي الحارق، الذي يصلح أن يكون وثيقة أو معلقة على صدر غزة المقاوم. "صمت من أجل غزة"، تحت هذا العنوان، كتب درويش نصه ضمن نصوص كتابه "يوميات الحزن العادي". إنه يُقدم غزة المقاومة، المتجردة من الخطابات الجوفاء، والقصائد، غزة التي لا تعرف شيئاً سوى إحكام قبضتها على عنق المحتل، لأنها تريده أن يخرج من ثيابها، تريده أن يرحل وفقط، يقول درويش: "تُحيط خاصرتها بالألغام وتنفجر، لا هو موت ولا هو انتحار. إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة. منذ سنوات ولحم غزة يتطاير شظايا قذائف. لا هو سحر ولا هو أعجوبة. إنه سلاح غزة في الدفاع عن بقائها و في استنزاف عدوها".
وكلما ابتهجت إسرائيل بانتصاراتها في ذبح غزة، مراهنة على الزمن الذي ربما يدفعها للاستسلام، كانت تنفجر من جديد وتخدش وجهها لأن "الزمن في غزة ليس عنصراً محايداً. إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل ولكنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة. الزمن هناك لا يأخذ الأطفال تواً من الطفولة إلى الشيخوخة ولكنه يجعلهم رجالاً في أول لقاء مع العدو. ليس الزمن في غزة استرخاء إنه اقتحام الظهيرة المشتعلة".
يُخبرنا درويش أن القيمة الوحيدة لمن هو تحت الاحتلال هي مقدرته على مقاومة الاحتلال، أما غزة فقد أدمنت هذه القيمة النبيلة القاسية، فهي لم تتعلمها من الكتب الدراسية أو تأخذها من أفواه المثقفين، ولا من الأناشيد والقصائد لكنها تعلمتها بالتجربة الحية، ولم يكن ذلك في يوم من الأيام للدعاية والتصوير، فغزة تكره الكاميرات، إنها تُقدم نفسها كما هي بلا تجميل، لأنها لا تعبأ بصورتها أمام أحد، "إن غزة لا تتباهى بثوريتها، إنها تُقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها وتسكب دمها. وغزة لا تتقن الخطابة. ليس لغزة حنجرة. مسام جلدها هي التي تتكلم عرقاً ودماً وحرائق. من هنا يكرهها العدو حتى القتل ويخافها حتى الجريمة ويسعى إلى إغراقها في البحر أو في الصحراء أو في الدم".
وليست غزة بالنسبة لدرويش أجمل وأرقى المدن، ولكنها الأكثر قدرة على تعكير مزاج العدو، لأنها "برتقال ملغوم وأطفال بلا طفولة، وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء بلا رغبات ولأنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأكثرنا جدارة بالحب".
وغزة التي لا تُتقن الخطابات، خالية من الشعر، بل هي لا تُحب القصائد، تلك القصائد التي جفت على الشفاه، فيما قد أتمت إسرائيل بناء المدن والحصون والمستوطنات: "إن غزة تُحرر نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد، وحين نلتقي بها- ذات حلم- ربما لن تعرفنا. لأن غزة من مواليد النار ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على الديار".
سرّ غزة كما يقول درويش ليس لغزاً بل يكمن في مقاومتها الشعبية المتلاحمة، هذه المقاومة التي لم تتحول إلى وظيفة أو مؤسسة، ومن ثم فحتى لو انتصر عليها الأعداء وزرعوا الدبابات في أحشاء أطفالها، فغزة "لن تُكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة نعم، ولن تستسلم، لكنها ستستمر في الانفجار".
هكذا رأى محمود درويش روح غزة المقاوم، التي يتمزق لحمها للآن وهي منكبة على الجوع والرفض والعطش والحصار، دون أن تستسلم أو تنسى هدفها وهو النضال لطرد المحتل، أما غسان كنفاني هذا المناضل الذي سخر قلمه من أجل قضية بلاده، فكان دائماً في جحيم المعركة، هو الذي خلد الكثيرين والكثيرات من أبناء وطنه في أعماله الأدبية ومن بينهم "نادية" الصبية ابنة الـ13 عاماً التي كانت تحت القصف هي وأفراد أسرتها، وجراء ذلك بُترت ساقها أثناء إحدى الغارات على غزة.
يُخلد غسان اسم هذه الصبية ومأساتها في قصته القصيرة "ورقة من غزة"، ومنها نقرأ:"لن أنسى ساق نادية المبتورة من أعلى الفخذ. لا، ولن أنسى الحزن الذي جلل وجهها، والدمع في تقاطيعه الحلوة إلى الأبد. لقد خرجتُ يومئذٍ من المستشفى إلى شوارع غزة وأنا أشد باحتقار صارخ على 'الجنيهين' اللذين أحضرتهما معي لأعطي نادية إياهما. كانت الشمس الساطعة تملأ الشوارع بلون الدم".
"كتبوا مشروع سينا بالحبر وسنمحو مشروع سينا بالدم"
ما الذي كان سيفعله الشاعر المناضل معين بسيسو لو كان بيننا الآن، ورأى الحي الذي شهد طفولته وهو يُسوى بالأرض، وتحت أنقاضه تلاميذ مدرسة مخيم "البريج"؟! هذا الشاعر الذي ولد في حي الشجاعية بغزة عام 1926، وكانت غزة -كما قال محمود درويش- "ملكية شخصية لمعين بسيسو، والشعر عالمه الخاص. بدونه كانت غزة ستكون ناقصة".
لبسيسو رحلة نضالية طويلة مع قضية وطنه، لقد كان دائماً في جحيم المعركة، منخرطاً في العمل السياسي والحزبي، مُعلماً بالمجان للطلبة اللاجئين في غزة بعد النكبة، شاعراً ثورياً، حتى أنه وهو في أحد القطارات المتجهة من القاهرة إلى غزة كتب يقول:"لقد كانت قضبان القطار تكتب منشوراً جديداً، وكانت هذه قصيدتي الثورية التي ذهبت بها إلى وطني".
أما مسرحيته "شمشون ودليلة"، المستلهمة من الأسطورة الشهيرة، فما أحوجنا اليوم إليها. في هذه المسرحية الشعرية: "لوت غزة ذات يوم قرني شمشون وأرغمت هذا الثور الصهيوني الذي كان في عضلاته أول بذور الصهيونية، والذي كان يربط قصاصات النيران في ذيول بنات آوي ويُطلقها في زمن الحصاد، لتحرق قمح أجدادنا الفلسطينيين القدامى، أرغمته على أن يفعل رغم إرادته شيئاً مفيداً؛ أن يجر طاحون المعصرة، وأن يكتب معادلة موته: السُم الصهيوني ضد الزيت الفلسطيني".
برغم ما طال الأدب المقاوم من تهميش وإقصاء، إلا أن مسيرة الأدب الفلسطيني زاخرة بالكثير من الأسماء اللامعة، و كانت فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، مُحركهم صوب الكتابة، بل كانت هي روايتهم الحقيقية
كان بسيسو شاهداً على أول غارة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة في منتصف الخمسينيات، لإجبار اللائجين على قبول مشروع توطينهم في شبه جزيرة سيناء. يحكي معين وقائع هذه الفترة في كتابه "دفاتر فلسطينية"، يقول: "بدأ عصر الغارات الإسرائيلية على المخيمات، في الوقت الذي اكتشف فيه قباطنة وكالة غوث اللائجين جزيرة وسط رمال سيناء تصلح لتوطين وإسكان اللاجئين في قطاع غزة. وهكذا بدأت أول غارة إسرائيلية على مخيم البريج. حينما توقف بنا الباص في ذلك الصباح أمام بوابة مدرسة البريج. كانت الغارة الإسرائيلية قد تم تنفيذها، 26 قتيلاً وعشرات الجرحى والكثير من البيوت التي تم نسفها".
بعد هذه الغارة على مخيم البريج، انخرط بسيسو في العمل السياسي الحزبي، حيث كان سكرتيراً للحزب الشيوعي الفلسطيني في غزة، وهو الحزب الذي خاض مناضلوه كفاحاً مريراً من أجل إسقاط مشروع التوطين حتى أن معين يحكي في مذكراته أنه أثناء كتابته للمنشور الرافض للتوطين ظل عدة أيام دون أن يتناول الطعام، وكذلك لم يكن يعبأ بنفسه أو حالته، حتى أنه قابل أحد تلاميذه وهو في طريقه لطباعة المنشورات، فطلب منه هذا الطالب مبلغاً من المال وكان معين مُفلساً، فمنحه حذاءه الجديد، ليبيعه، ومشى الشاعر حافياً في الوحل.
كان معين بسيسو على رأس من هندسوا وفجروا انتفاضة مارس التاريخية ضد مشروع إسكان وتوطين اللاجئين في شبه جزيرة سيناء عام 1955، وكان أول شهيد فلسطيني يسقط رمياً بالرصاص في الشارع هو شهيد الحزب الشيوعي في قطاع غزة "حسني بلال". سقط وهو محتضناً شعار الحزب: "كتبوا مشروع سينا بالحبر وسنمحو مشروع سينا بالدم". وهذا هو الشعار الذي يرفعه قطاع غزة اليوم، وهم يتعرضون لإبادة جماعية رافضين الخروج من أرضهم وتصفية قضيتهم.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.