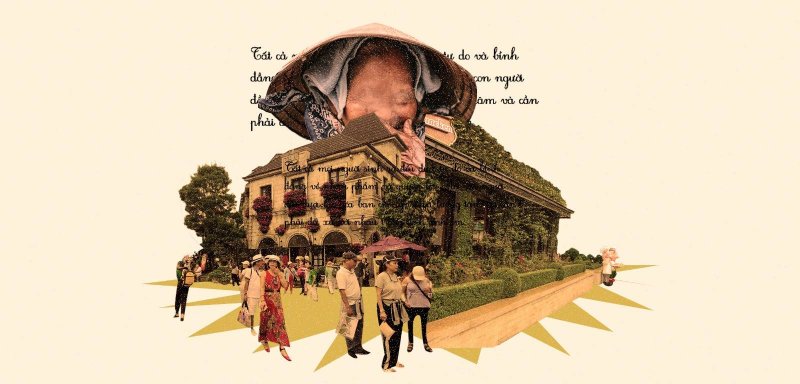لماذا ذهبتُ إلى فيتنام؟ ماذا حدث لي، عندما وصلتني رسائل عبر بريدي الإلكتروني، كانت كلها عبارة عن رفض لفيلمي القصير في المهرجانات السينمائية، واحداً تلو الآخر؟ لم يكن لدي سوى القليل من المال في حسابي. حينها رأيت إعلاناً عن رحلة إلى فيتنام، وقررت الذهاب إلى هناك برغم الظروف.
كنت مكتئبةً بسبب هجرة أقرب صديقاتي، وكذلك لرفض فيلمي في المهرجانات، ولما كنت أعيشه وسط تردّي الوضع في إيران. كل هذه الأمور جعلتني أرغب في أن أكون في مكان آخر في العالم غير إيران، وإن لفترة قصيرة. ومن المنطقي، أن أذهب إلى مدن جميلة وسياحية معروفة، كإسطنبول أو موسكو أو أي مكان آخر، لكنني اخترت فيتنام. ولقد اقترضت كل الأموال اللازمة لهذه السفرة من أصدقائي، وغادرت إلى ذاك البلد.
تفاجأ الجميع عندما أخبرتهم برغبتي في الذهاب إلى فيتنام، إذ لم يكن أحد لديه فكرة عن هذا البلد، غير الأحداث والأخبار المتعلقة بسنوات الحرب فيه. أراد الناس من حولي أن يعرفوا لماذا أريد أن أنفق الكثير من المال، للسفر إلى بلد دمّرته الحرب؟
 مدينة "هوي أن" في الليل
مدينة "هوي أن" في الليل
كنت أعلم بالطبع أن فيتنام لم تعد تلك الأراضي الجميلة، التي كانت عليها قبل خمسة عقود. لكن ما أذهلني، وشجعني على الذهاب إلى هناك، هو أسلوب الحرب والمقاومة لدى الفيتناميين/ات، حيث كنت أرغب في مقابلة الأشخاص الذين رأيت مثلهم، في فيلم "القيامة الآن" للمخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، وفي أفلام أخرى مماثلة. وللوصول إلى هناك، سافرت من طهران إلى مطار دبي، ومن هناك إلى مدينة هو تشي منه (سايغون).
هو تشي منه
على الرغم من أننا وصلنا ليلاً، وكنا منهكين جداً، إذ بقينا في الطريق لمدة يوم تقريباً، إلا أننا تغلبنا على التعب وسرنا للتسكع في شارع "واكينك" (المشي)، في مدينة هو تشي منه. كانت هذه المدينة ساهرةً ومستيقظةً في الليل، وحول هذا الموضوع قال قائد رحلتنا: "هو تشي منه مدينة لا تنام". وكان شارع المشي والشوارع المحيطة به مليئةً بالسياح الذين يجلسون على مقاعد فيتنامية، ويحدقون في كل من يمر بجانبهم، ويشربون البيرة من البراميل الكبيرة التي كانت أمامهم. هذا هو أول لقاء لنا بفيتنام، وغداً من المفترض أن نبدأ بالتعرف على تاريخ البلد.
تفاجأ الجميع عندما أخبرتهم برغبتي في الذهاب إلى فيتنام، إذ لم يكن أحد لديه فكرة عن هذا البلد، غير الأحداث والأخبار المتعلقة بسنوات الحرب فيه. أراد الناس من حولي أن يعرفوا لماذا أريد أن أنفق الكثير من المال، للسفر إلى بلد دمّرته الحرب؟
في اليوم التالي، وقبل أي شيء آخر، ذهبنا لزيارة مكتب بريد هو تشي منه، الذي صممه المهندس الفرنسي الشهير غوستاف إيفل. بعد ذلك ذهبنا إلى قصر الاستقلال، وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة منذ اتخاذ القرارات المصيرية في هذا المكان، إلا أنني خلال تواجدي فيه، شعرت بقلق الشعب الفيتنامي.
 مكتب بريد هو تشي منه
مكتب بريد هو تشي منه
لطالما أثارت الأماكن التاريخية إعجابي، ففي أثناء تواجدي فيها، أتخيل الأصوات والأحداث التي جرت في تلك الأماكن، وحدث لي الأمر نفسه وأنا أتجول في هذا القصر. كانت جميع هواتف القصر ترنّ على مسمعي، كما تخيلت المشي القلق والأصوات المرتعشة لعمال القصر، وهم يعيشون اللحظات الحساسة في تاريخ البلد، وخاصة في الطابق السفلي من القصر، الذي كان بمثابة مخبأ، ولم تكن في أي جزء منه طقوس الطوابق العليا من القصر؛ لا ممراته الإسمنتية الضيقة ولا جوّه البارد، ولا مطبخه الذي ذكرني بمطابخ السجون.
 قصر الاستقلال
قصر الاستقلال
ثم ذهبنا إلى أنفاق كوتشي، المكان الذي قرأت وسمعت عنه الكثير. هذا المكان، عبارة عن أنفاق ضيقة ومظلمة تحت الأرض، اعتادت العصابة الفيتنامية، المرور منها والاختباء فيها، من الأعداء الأمريكيين والفيتناميين الآخرين، وكانت الأنفاق ضيقةً جداً إلى درجة أنها لم تكن مناسبةً إلا للفيتناميين، نظراً إلى قصر قامتهم، إذ كان من المستحيل على الأمريكيين الدخول إليها.
وبينما كان القائد المحلي للرحلة يشرح عن هذه الأنفاق، لم أستطع مقاومة رغبتي وقفزت في أحدها. كان أطول من الأنفاق الأخرى. وقبل أن يتمكن قائد الرحلة من إيقافي، دخلت النفق ولم أكن أسمع سوى صوته وهو يصرخ: "حشرات! الحشرات! لاااااا". أشعلت مصباح هاتفي، ورأيت أمامي تماماً خفاشاً يحدّق بي.
 تمثال مقاتلة فيتنامية
تمثال مقاتلة فيتنامية
كان النفق مبللاً. ولم يكن هناك طريق إلى النور، حيث من المفترض أن أخرج من الجانب الآخر من النفق، لكن لم أكن أعلم أن النفق سوف ينقسم إلى اتجاهات عدة وسوف أضطر إلى تجربة الاتجاهات كلها. هنا صرخت مرات عدة: "ما هو الطريق الصحيح؟". لكن صوتي لم يصل إلى الأعلى، ولم أسمع صوتاً من هناك. لقد كنت مرتبكةً بعض الشيء وواصلت تجربة الطرق، ولا أعرف لماذا في تلك اللحظة، لم أفكر في أي شيء غير قطرات الدم والعرق التي تساقطت من الفيتناميين/ات، خلال مرورهم من هذه الأنفاق. وفي الأخير رأيت في نهاية أحد الطرق النور وسمعت صوت قائد الرحلة الإيراني وهو يصرخ باسمي، وتمكنت من الخروج بسلام.
كانت تجربتي هذه مثيرةً جداً، ولو أنها كانت الوحيدة لي في هذه الرحلة. بعد ذلك تنقلنا بين الغابات الكثيفة حيث تقع أنفاق كوتشي، وكان صوت طلقات الرصاص، الذي كان يُطلق من وسائل تسلية السائحين، يُسمع باستمرار. شرح القائد المحلي بكل حماسة، نوعية الفخاخ الغريبة والمبتكرة الفيتنامية، التي كانت مليئةً بالشفار والأشواك الكبيرة، كما لو كان يستمتع في كل مرة، وهو يتخيل فيها الحوادث التي جلبتها هذه الفخاخ للأعداء.
وعندما قدّم المرشد السياحي المحلي، شرحاً لكيفية صنع الفيتناميين أحذيتهم من إطارات سيارات الاحتلال الفرنسي ومعاطفهم المطرية من نسيج المظلات الأمريكية التي سقطت من الطائرات الأمريكية، فلا يسعني إلا أن أُعجب بهم أكثر.
وفي طريق عودتي من أنفاق كوتشي، تمنيت لو أننا نحن الإيرانيين، كنا نعرف طرقاً مبتكرةً للقتال ضد غزاة أرضنا، المحتلين الذين يبدون وكأنهم من الداخل ولكن ليس لديهم أي انتماء لهذه الأرض وشعبها، لا بل لم يبالوا حتى إذا كانت إيران وشعبها سيتحولون إلى رماد، ودعيت حتى نتعرف على كيفية طرد هؤلاء الغزاة واللصوص، وأن تكون لدينا روح المقاومة مثل الفيتناميين/ات، وأن نضربهم ولو قليلاً، كي يكون شعورنا بالخسارة أقل قسوةً.
دا نانغ
غادرنا مدينة هو تشي منه، متجهين إلى مدينة دا نانغ. كانت هذه المدينة هادئةً وجميلةً، حينما كنا نحلق فوق سحابها. تخيلت أننا سندخل مدينةً سحريةً، حيث اتخذت الغيوم أشكال غيوم مدينة سحرية مليئة بالعمالقة، وكنت أحدق من نافذة الطائرة، وكانت كل قطعة من السحب تشبه شيئاً ما. عندما هبطت الطائرة، عرفت أنني لم أكن مخطئة في هذا الشأن، إذ كان يعم الهدوء والروحانية في مدينة دا نانغ، التي تشبه أجواؤها أجواء المدن السحرية.
 القرية الفرنسية
القرية الفرنسية
من معالم هذه المدينة، القرية الواقعة على قمة الجبال، والتي كانت في السابق مقر إقامة الأثرياء الفرنسيين الذين احتلوا فيتنام وعاشوا فيها لأجيال، بعيداً عن صخب المدن الكبيرة وضجيجها.
وعندما ركبنا التلفريك متجهين نحو القرية، تمكنت من رؤية المنازل الفرنسية من الأعلى، وتذكرت مشاهد من فيلم "القيامة الآن". وبعد رؤية "الجسر الذهبي"، الذي لم يكن قديماً جداً، صعدنا إلى الأعلى قليلاً بالجندول ودخلنا حديقة الزهور التي كانت تُسمّى بالفرنسية " Jardin D'amour".
 "الجسر الذهبي"
"الجسر الذهبي"
إن التجول في حديقة الزهور التي كانت تقع أعلى الجبال العالية، وبين السحاب، مع أصوات المناجاة والأناشيد الدينية القادمة من المعابد المحيطة، يلهمك بأنك تمشي في الجنة، كما لو أن الملائكة قد التقطوا جزءاً من السماء أو من العالم العلوي، ووضعوه في هذه التلال. كان كل شيء هادئاً وجميلاً هناك.
أصبحت القرية الآن مليئةً بالمقاهي والمطاعم التي تستضيف السياح، ولكن يمكنني أن أتخيلها دون هذه الضجة، عندما كان عدد قليل من الناس، والأثرياء الفرنسيين، يعيشون هناك في صمت وسلام. كان الفرنسيون/ ات يرون أن هذه القرية الجميلة والنقية، برمتها ملك لهم. كنت جالسةً على سلالم الساحة وسط القرية، غارقةً في هذه الأفكار، وعندها التقط لي رفيقي في الرحلة صورةً، وقال ضاحكاً: "بهذه القبعة الفرنسية والوجه العبوس، تبدين وكأنك من المستعمرين".
هوي أن
لم نشبع من الاستمتاع بمنظر التلال وحديقة الزهور والقرية الفرنسية، لكن نظراً إلى وقتنا المحدود، خرجنا من دا نانغ، متجهين إلى مدينة "هوي أن" الصغيرة والصاخبة.
 مدينة "هوي أن" في الليل
مدينة "هوي أن" في الليل
ما كان لافتاً في هذه المدينة، وجعلها منطقةً تجذب السياح، هو أنها كانت بعيدةً عن المدن الأخرى، ولم تُدمَّر خلال فترة حرب فيتنام، وظل نسيجها قائماً وعماراتها القديمة سليمةً حتى اليوم. بنايات هذه المدينة، عبارة عن مزيج من الهندسة المعمارية اليابانية والصينية والفرنسية.
إن المشي في شوارع هوي أن، المزدحمة، وسط كل الفوانيس الملونة والسياح السعداء، جعلني أشعر وكأنني أسير في عالم من القصص الخيالية. كان جوّها في الليل، مليئاً بالألوان ويشبه لوحات الرسام الهولندي فان خوخ
إن المشي في شوارع هوي أن، المزدحمة، وسط كل الفوانيس الملونة والسياح السعداء، جعلني أشعر وكأنني أسير في عالم من القصص الخيالية. كان جوّها في الليل، مليئاً بالألوان ويشبه لوحات الرسام الهولندي فان غوغ.
هانوي
كانت الرحلة على وشك الانتهاء، وانتقلنا إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، التي كان من المفترض أن نزورها خلال رحلتنا، والتي يقع فيها قبر الزعيم الفيتنامي هو تشي منه، ويشكل هذا المقام أحد أبرز معالم هذه المدينة.
بعد استقرارنا في العاصمة، ذهبنا إلى المقام وكان الجو حاراً جداً، خاصةً أن المرشد المحلي، أعلمنا بأننا علينا ارتداء ملابس ذات أكتاف مغطاة، والحرص على عدم إظهار ركبنا، وعندما جاء دورنا لزيارة قبر الزعيم الفيتنامي، دخلنا بصمت، وأخذنا لفةً بسيطةً حول مومياء هو تشي منه، التي كانت محاطةً بالجنود الفيتناميين.
 قبر الزعيم الفيتنامي هو تشي منه
قبر الزعيم الفيتنامي هو تشي منه
لقد كان شعوراً غريباً، أن ترى مومياء شخص كان له هذا التأثير الهائل على هذه البلاد، التي منحها استقلالها. فرؤيته محنطاً، كانت تجربةً مختلفةً تماماً، عن رؤية مقابر الآخرين، حيث تشعر بأنه كان بنفسه هناك ويراقبك.
اليوم الأخير من الرحلة، كان يوماً رائعاً، إذ ركبنا سفينةً سياحيةً أخذتنا حول خليج "ها لونج"، ورأينا من خلال هذه الرحلة البحرية، جمال فيتنام وجنوب شرق آسيا. كان لهذه الرحلة تأثير كبير عليّ، إلى درجة أنني ما زلت أحلم كل ليلة، بركوب تلك السفينة والإبحار بها عبر هذا الخليج الخلّاب، وكأنني أدوس على سحب سحرية، فعلى حد تعبير الشاعر الإيراني شمس لنكرودي:
"لقد عدتُ من السفر
ولكن السفر
لم يعد مني".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.