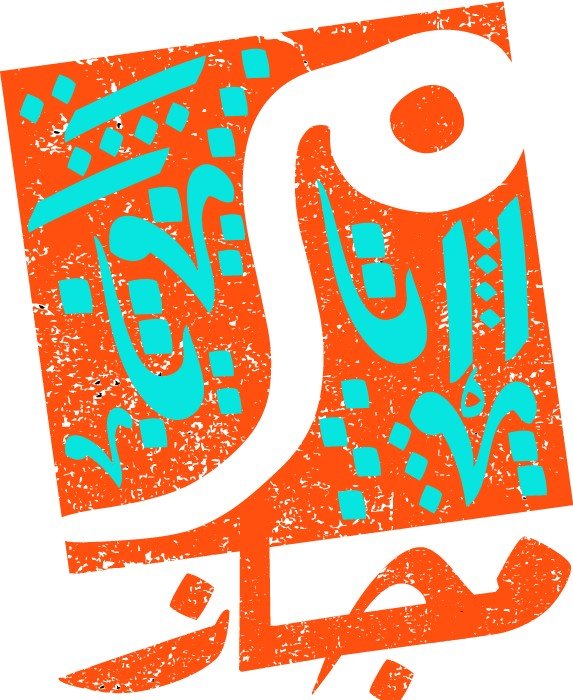
جمع الله الخصال الكريهة كلها، ثم كساها عظاماً ولحماً، وقال: فلتكن هذه الخصال إنساناً، فكان أبي، وأبي رجل متديّن يعرف عن الله ما يجعل تخيّل اقتران صفاته بمعرفته عن صفات الله أمراً مستحيلاً.
حدثني أبي كثيراً عن الشياطين، وعندما كبرتُ قليلاً عرفتُ أن شياطين أبي ملائكة لي، وأن الشيطان الوحيد الذي بليتُ به هو أبي. كان يحدثني عن الرمضاء وهو نار متأججة؛ كان أبي أصلب من ألفي عود حنطة. كانت الدنيا تموت على أبوابه، والحوريات تذبل وتتآكل، والغربان الناعقة تجد مكاناً في قلبه، للصراخ، والشنق، والحرائق، والموت، كان يحاول ألا يقع في أي خطأ وكانت هذه مصيبته الأولى، ألقى نفسه في أحضان المثالية المزيفة، فغرق فيها حتى قُذِفَ من الناحية الأُخرى.
أما أمي فكانت امرأة بسيطة، إذا حضر الدين غاب عقلُها، جمعت من الشيم خيرها، فهي عطوفةً وكريمةً بالشكل الذي يثير الحزن أحياناً، والشفقة أحياناً أخرى، كانت تتخفى في المساء لتتخلص من دموعها بسرعة وبخفة قبل أن يراها أحد، كانت تحفر السماء الأولى في الصباح، تدفن فيها ذكرياتها، وتهيل السحاب.
هكذا كنتُ أظن وأرى الحياة، غير أن المواقف كانت لا تنفك في إثبات أن الأبيض والأسود نظرة طفولية لا يُمكن أن تستقيم رؤية صحيحة لمن يعتمد على هذه التصورات الحادة والمُتطرّفة، فأبي الذي تتكسّر أغصان الأشجار بخطاه في الغابة يجلس قلقاً منزوياً عندما تُصيب أسهم المرض أحد إخوتي، وها هو يجري ليل نهار في ماراثون الحياة اللانهائي حتى يوفر للعائلة متطلبات الحياة، أما أمي فالأمر لا يختلف كثيراً، يبدأ الاختلاف الحقيقي عند أبي وأمي وأقاربي وأصدقائي ومعظم من ولدوا في مصر عندما نذكُر الدين، مربط الفرس لفهم التغيرات العديدة التي تطرأ على البشر حولك، والمُبرر الوحيد لسيناريوهات يفعل فيها من تعرفهم أفعال أبعد ما تكون عنهم.
لم أتفرّغ للمسجد بشكلٍ كامل، بل من المفارقات العجيبة أني كُنتُ أُحب خلال هذه المرحلة، أحببتُ أكثر من فتاة وبأكثر من طريقة، لكن وعلى الرغم من الدين الذي يتم غمري فيه مرةً في الصباح ومرةً في المساء، كنتُ أُنحي مبادئي قليلاً بنظرة من عين حسناء... مجاز
منذ عدت أيام ذهبت لمكتبة بعيدة قليلاً عن منزلي وذلك لشراء عدة أقلام، تفاجأتُ وقتها بصاحب المكتبة وهو يسألني بعدما رأى السماعات في أذني: "بتسمع أغاني؟"، رددتُ عليه سريعاً: "أغاني، أيوة". ابتسم الرجُل بِخُبثٍ وهو يُخبرني أن لديه مقطعاً لي وأنا صغير على الكمبيوتر خاصته. لم أفهم ما يقصد، لكن قفزت في رأسي ذكرى رُبما هي ما يتحدث عنه، طلبتُ منه المقطع وأعطيته هاتفي حتى ينقله.
أخذتُ الأقلام والهاتف وذهبتُ سريعاً إلى المنزل، وصلتُ الهاتف باللابتوب وبحثتُ عن المقطع وقمتُ بتشغيله.
بدأ المقطع بخلفيات طبيعية يسهل تركيبها على برامج المونتاج وبصوت أناشيد دينية أرجعتني سنوات إلى الخلف، أناشيد دينية بلا موسيقى، وبدلاً من اللحن نسمع همهمات المُنشد الطويلة والمتصلة، بعد هذه المقدمة ظهر على الشاشة طفل وبدأ يقرأ القرآن بصوتٍ جميل، وهنا تأكدتُ من المقطع الذي بين يدي. سحبتُ الشريط السُفلي إلى الأمام إلى أن ظهرتُ أنا، طفل في الصف الرابع الابتدائي، يرتدي قُفطاناً أبيض ويقف في المسجد وسط حشوداً من الناس، وفي يده ميكروفون كبير، ويقوم بتسميع 20 حديثاً نبوياً بالعنعنة الكاملة لهم. تذكرتُ طفولتي ولم أرتح لما أرى، خرجتُ من المقطع وحذفته لكني تذكرتُ كل شيء .
الطفل الذي هرب من الروضة للمزرعة ليكتشف غياهبها، لم يسلم من حركات التدين التي اجتاحت مصر في بداية الألفينات، التيار السلفي على وجه الخصوص هو الذي انتشر في أنحاء حياتي. كان تلفاز المنزل به 32 قناة فقط، وجميعهم قنوات دينية، مثل: الرحمة، والناس، والرسالة، وصفا، ووصال، والحافظ، وغيرهم، كان المنزل خالياً من الصور والمنحوتات، وذلك حتى نُعطي إشارة خضراء للملائكة وتدخل المنزل، الكثير من الحياة كان حراماً، الموسيقى حرام، والأغاني حرام، والتسليم على الإناث حرام، والرسم الذي يُجسّد الروح حرام، ورسم العيون حرام، والاحتفاظ بالصور حرام، والسياسة حرام، والديمقراطية حرام، والمبالغة في التحريم حرام !
أتذكر في طفولتي وأمي تُعد الساندوتشات للذهاب لدرس ديني مُعين نقضي فيه ساعاتٍ وساعات، وأتذكر الأناشيد الدينية الجهادية التي كُنا نحفظها عن ظهر قلب مثل: أخي أنت حرٌ وراء السدود ، وسوف نبقى هنا، وسنخوض معاركنا معهم، والقول قول الصوارم، وغيرهم الكثير والكثير من الأناشيد. أتذكر فقرة الدعاء في نهاية كل درسٍ ديني في المسجد أو على قناة دينية على التلفاز، وأتذكر الدُعاء على المختلف والكافر، كنا ندعي الله أن يُرمّل النساء، ويُيتم الأطفال، ويُشرّد الرجال ويقتلهم، هكذا كان دأبُنا، هكذا كان دينُنا.
*****
ومع هذا لم أتفرّغ للمسجد بشكلٍ كامل، بل من المفارقات العجيبة أني كُنتُ أُحب خلال هذه المرحلة، أحببتُ أكثر من فتاة وبأكثر من طريقة، كُنا أطفالاً بالطبع، لكن وعلى الرغم من الدين الذي يتم غمري فيه مرةً في الصباح ومرةً في المساء، كنتُ أُنحي مبادئي قليلاً بنظرة من عين حسناء.
في بداية المرحلة الابتدائية، كانت الفتاة الجميلة، حبيبةً للفصل بأكمله، المُشكلة الحقيقية تكمُن في من ستختاره الفتاة. في فصلنا كان هُناك ثلاث حسناوات، محبُوبات من الجميع، وقعتُ مع الجميع في البداية، قبل أن أرى في رنا ما يراه الجميع في الفتيات الثلاث. بدأت قصتي مع رنا حينما طلب منا مُدرس العلوم أن نُغير أماكن مقاعدنا، وشاءت الأقدار أن أجلس أمام رنا بعدما كنتُ أجلس في صفٍ للفتيان فقط، بعد أيام كنتُ أنا ورنا أصدقاء جيدين، وكانت تُنادين "بحبيبي" على سبيل المُزاح. كنتُ أشعر حينها بالذنب وبالخوف، بالذنب لأني أعيش في المدرسة معيشة غير التي يعلموني إياها في المسجد، وكنتُ أشعر بالخوف، لأني كنتُ أرى أنه بانتهاء المرحلة الابتدائية، ستختفي الفتاة التي أُحبُّها، وبهذا سيتحول الحب إلى ذكرى مؤلمة وحزينة.
فجأةً خفتت شُعلة رنا، ووجدتُ نفسي فريسة بين يدي هُدى، الفتاة التي أحببتُها لسنتين، وحلمتُ بها مراتٍ ومرات، الكثير من أحلامي كانت تتحقق، وسبّب لي هذا مُشكلة كبيرة في سنٍ كبير، فبعدما بدأت أفكاري بالتغير، وبعدما نشبت عداوة بيني وبين العوالم الميتافيزيقية، والتفسيرات الغيبية، كان العائق الوحيد الذي يؤرق نومي هو أحلام هدى، هذه الأحلام التي حدثت في المرحلة الابتدائية، وتحققت.
في النهاية وجدتُ تفسيراً منطقياً لتحقُقها، لكن قبل الأحلام، وقبل هُدى، كان شيوخ المسجد الذي ترعرعتُ فيه يرون فيّ نواةٍ لخطيبٍ في المستقبل، وكنتُ أحلمُ أنا نفسي بذلك، ولم أكن أتخيل أن بعد سنوات فقط سيكره هذا الطفل السلفية وشيوخها، قبل حتى أن يعرف طريق العقل والبحث والحُجة والمنطق.
*****
كانت الرؤية ضبابية ومظلمة بعض الشيء، كنت أمشي على مهلٍ وكأن أحدهم نفضني للتو من أربع زجاجات بيرة، تحسست الشارع الطويل، ودققتُ كثيراً حتى برزت المعالم وملامح المكان تدريجياً، إنه مسجد العليم، المسجد الذي يقع على بُعد شارعين من منزلي، ماذا أفعل هنا؟ لا أعرف.
أكملت المشي حتى اعترضت شجرة ضخمة طريقي، سلم الأسفلت الأرض لعشب أخضر مُسالم. نظرتُ للشجرة والأرض، فلم أفهم شيئاً، لكني وجدتُ بجوار الشجرة باباً، قمتُ بطرقه عدة مرات حتى فتحت لي امرأة، ومن خلف المرأة كانت تقف هدى. كانت هدى أجمل من صورتها في المدرسة، أول مرّة أرى شعرها بلا حجاب، شعر أسود فاحم يمكن أن يُربك ستيفين هوكينج، كانت ترتدي بنطلوناً أزرق، وقميصاً أزرق، دخلت إلى منزلها، وكانت أمها تتحدث إليَّ.
لا أفهم ما يحدث، وفجأةً، يقطع حبل أفكاري صوت مدحت يقول لوالدة هُدى إني أُحب ابنتها، وقع عليّ كلامه ككرة من الجليد، ابتلعتني وتجمّدتُ بداخلها، نظرتُ إلى هدى، وأمتلأ جسدي بالرعب من ردة فعل أمها، وفجأةً استيقظتُ من النوم.
*****
مع مرور الوقت صرتُ أذهب للمسجد بمفردي، لا أنتظر أبي ولا أمي ولا ساندويتشات المُربى، أنتظرُ آذان الظهر وأذهب إلى المسجد، هذا يُحدّثنا في الفقه، وهذا في العقيدة، وهذا يحمل كتاب تفسير، وصديقي يشغله سؤال في التوحيد، وآخر يحمل هم ورده اليومي الذي يجب تسميعه، كانت هذه حياتي أنا والكثير من الأطفال في الإجازة الصيفية، كنا نجلس اليوم من أوله إلى آخره لنتعلم، ولنستعد حتى نكون دُعاة المُستقبل.
تختلف هذه الأوقات كثيراً في أوقات الدراسة، فحينها نذهب إلى المسجد مرات قليلة، بل قد نحاول الحفاظ على وجودنا في مواقيت الصلوات فقط، وكنوع من التشجيع، كان هناك دفتر في المسجد به أسماؤنا، وفي كل مرة نذهب إلى هناك لنصلي كنا نسجل أمام الاسم، وهكذا كانت ترتفع درجاتنا درجة أخرى، وبهذا نكون قد فُزنا بحسناتٍ في السماء وبهدية آخر الشهر من الشيخ على الأرض، وفي الغالب تكون الهدية قميص كُرة قدم لأحد المشاهير، أو قد نأخذ مسبحة أو عطراً برائحة المسك.
قال مدحت لهدى إني أحبّها. وذهبتُ أنا لإنكار كل شيء، ولكن ردّت هي بهدوء ودلال غير مُصطنع: "حتى لو كلامه بجد مفيش مشكلة"، لكني أنا، طفل المساجد الأبله، لم أستغل الفرصة، وظللت أُنكر كل شيء... مجاز
في بعض السنوات اختلف جدول وجودنا في المسجد بشكلٍ كبير، فحتى في وقت المدارس أصبحنا نجلس في المسجد طوال الوقت، وذلك لأن المشايخ وقتها قرّروا أن يقسموا أنفسهم على المواد الدراسية لنا ويقومون بشرحها مقابل مادي بسيط. كانت شخصيات الشيوخ الذين نتعامل معهم متباينة ومختلفة إلى حد كبير، فهناك الشيخ حسين، وهو رجل بلغ من العمر أرذله، كُتلة ضئيلة من الهرم والخرف، لا يمكن أن يُركز في شيء إلا تسميع القرآن لنا، وكنتُ أسمع دائماً أنه كان من أمهر حفظة القرآن، وكان تلميذاً لعلماء كبار أجلّاء، لكن لم أشهد معه غير هذه المرحلة التي يأكله فيها الزمن ببطء وبلا شفقة.
كان لدينا أيضاً الشيخ محمود كان رجلاً بشوشاً ضاحكاً يُفسّر القرآن ويقتل الوقت بسرعة ومهارة، مثله مثل الشيخ صابر وجلسات العقيدة، وعلى النقيض كان هناك الشيخ سميح، الذي لم يكن يسمح للدقائق بأن تمر، كان يتلاعب بنسيج الزمكان، ويجعل الزمن في جلسته غير الزمن في باقي كوكب الأرض، ومع هذا كان ينظر دائماً إلى ساعته، ويطيل التحديق فيها، ثم ينظر إلينا بجدية وبوجهٍ خشبية ويقول لنا حكمته المُكررة: "إذا رأيتُم الشيخ ينظر إلى الساعة، فاعلموا أنه يُريد للمجلس أن ينتهي حتى يغادر، لذلك لا يجب أن توصلوا الشيخ إلى هذه المرحلة". دائماً ما كان يرى أننا نصنع الضوضاء ولا نجلس كما يريد، ما يجعله يتأفف وينتظر رحيله بفارغ الصبر.
*****
تسللت أشعة الشمس كالقطط من زجاج غرفتي، استيقظتُ وفي رأسي بعضُ الخوف والجمال المُريح الهادئ، كنتُ خائفاً من مدحت الذي وشى بي لوالدة هُدى، لكني كنتُ منتشياً بهُدى نفسها، التي رأيتها عن قرب بلا حجاب وبقميصٍ قصير الأكمام، بل سَمِعَت من مدحت أني أُحبُّها. قمتُ من السرير وارتديتُ ملابس المدرسة وذهبت مُسرعاً قبل أن يبدأ الطابور الصباحي. كنتُ المسؤول عن الإذاعة المدرسية، في المساء أقوم بكتابة المقدمة لكل فقرة، وأتفق مع التلاميذ عن دور كل واحد منهم، وفي الغالب كنت أقوم بقراءة الحديث أو أخبر الطلاب بمعلومة جديدة، لكن لم تكن هذه الأشياء كلها مُهمة في الحقيقة، فخلف الإذاعة يوجد شيء أهم بكثير: هُدى. كانت الإذاعة الصباحية وسيلة أخرى للتقرّب من الفتاة التي رأيتُها بلون السماء وبجمال الطبيعة. المشكلة المتكرّرة التي واجهتني هي كيف سأُرتب فقرة هُدى وفقرتي في الإذاعة، كنتُ يومياً أحاول وضعها بعدي مُباشرةً أو قبلي مُباشرةً، وذلك لزيادة فُرص حديثنا ومُزاحنا، وبالطبع حتى تقرأ عليَّ ما ستقوله مرات ومرات.
في هذا اليوم انتهت الإذاعة الصباحي على خير، وبدأ اليوم الدراسي على خير، حتى أتت الحصة الثالثة، ووقتها عرفنا أن المُدرس غائب لظرفٍ شخصي، جاء مُدرس آخر وأخبرنا أنها ستكون حصة ألعاب، فرحنا جميعاً، وارتفع صوت الصراخ والهتاف والضحك، ونزلنا إلى حوش المدرسة نحمد الله على هذه النعم.
كنتُ أمين الفصل، وذلك بتزكية من مُدرس اللغة العربي الذي كان يرى أني أنجب تلاميذه، خصوصاً بعدما رآني أُصلي بجواره في المسجد صلاة الفجر، بل رشحني مُعلم العربية لأكون أمين المدرسة، وبالفعل ذهبت عدة مرات مع الأخصائية الاجتماعية إلى نادي المُعلمين في الإسكندرية، وذلك في تجمّع ضخم لكل المدارس تقريباً، وهناك كانوا ينتخبون أمين مدارس المُحافظة بأكملها.
كنتُ منبهراً بكل ما يحدث، وبمهارة الطلاب الآخرين، وانطلاقهم وتحدثهم على المسرح، غير أني قررت بعد ذلك أني سأمكث في الفصل لأرى حبيبتي أكثر، وبالفعل اتفقتُ مع راشد، وهو ابن مُعلمة للغة العربية أيضاً، أن يذهب مكاني، وقد وافق ووافقت الأخصائية الاجتماعية، وجلستُ أنتظرُ فرصةً تُقرّبُني من هدى .
المُهم أني كنتُ أمين الفصل، ويأتي مع هذا بعض المسؤوليات مثل التأكد من نزول جميع الطلاب لحوش المدرسة وإغلاق الفصل بالمفتاح حتى لا يأخذ أحد شيئاً لا يخصه، بعد إغلاق الفصل، كنت أتجه مباشرةً لهدى وأخبرها أني على وشك البدء في لعب مباراة كرة قدم، وأخاف أن يقع المفتاح من جيبي، لذلك أريد منها أن تحمله معها حتى نهاية الحصة.
شرعتُ أبحثُ عنها هذا اليوم أيضاً لكني لم أجدها، عرفتُ بعد ذلك أنها مع صديقاتها في الجنينة الكبيرة الموجودة بجوار سور المدرسة الذي يُطل على مسجد الضياء بشكلٍ مباشر، ذهبتُ لها هناك، وحينما كدتُ اقترب ظهر لي مدحت من الفراغ فجأةً وبدون مقدمات، أخبرني أنه سيخبرها أني أُحبها. ارتعبت. هذه المرة أنا على يقين أني في الواقع، لكن على كل حال لا أظن أنه يملك الشجاعة الكافية؛ لكن لماذا يتقدم نحوها بِخُطى جادة. الأرض تتكسّر أسفل قدمي والماء ينهمر من وجهي نتيجة للقلق الذي يأكلني، لا أعرف ماذا سيحدث خلال الثواني القادمة، لكني وبشكلٍ لا إرادي تراجعتُ للوراء، وجريتُ بعيداً عن مدحت وهدى وصديقاتها.
مرت خمس دقائق وأنا لا أعرف هل كان يتحدث بجدية أم مجرد مُزاح أحمق آخر. فكرتُ وقتها في النتائج: أنا الشاب المتدين الذي يُحبه المعلمون، سيعرف الجميع فجأة أني أُحب فتاة وأتحدث عنها. طمأنتُ نفسي أن هذا لن يحدث، وذهبتُ ثانية إلى مكان هُدى ومدحت؛ حدث ما كنتُ أخاف منها، اندفعت صديقاتها نحوي، وأخبرنني أنهم في طريقهم لمديرة المدرسة ليُخبرنها أني أُحب هدى. جاءت ردة فعلي سريعةً وبدون تفكير، وذلك حيثُ بدأت بالصراخ في وجههم، وأنكرتُ الأمر بأكمله، بل وأخبرتهم أن سأذهب إلى المديرة لأخبرها أنهن يقلن عني هذا الكلام، وهنا هدأن قليلاً، وذهبتُ أنا لهُدى لإنكار كل شيء، ولكن ردّت هي بهدوء ودلال غير مُصطنع: "حتى لو كلامه بجد مفيش مشكلة"، لكني أنا، طفل المساجد الأبله، لم أستغل الفرصة، وظللت أُنكر كل شيء.
*****
في المسجد كانت كُل الأشياء مثالية، لا يفصل بيننا وبين الجنة إلا الموت، كنا نعلم أن البشر فئات كثيرة، بل المسلمون أنفسهم فئات كثيرة، كُلهم في النار إلا ما أنا ومشايخي عليه في المسجد. كنتُ أفكر كثيراً في تصرفاتي خارج المسجد، فكيف لمن يحمل قلبه القرآن أن تبدأ فتاة في مُزاحمة المقدس فيه، على الرغم من التساؤلات إلا أني كنتُ أسير بخُطى حثيثة باتجاه المستقبل الذي أريده، وهو أن أكون خطيباً في المسجد، وأتذكر هُنا مرةً كنتُ أعتكفُ فيها حينما أتى شيخٌ إلينا وسألنا عما نحلم به، وكنا جميعاً نجاوب إجابات لا تخرج خارج إطار الدين والمسجد، على الرغم من أننا جميعاً في هذا الوقت كنا ندرس ونحيا حياة خارج المسجد، إلا أنه كان المسيطر الأول على حياتنا، لكن أتذكر أن انسلاخي عن هذه الحياة كان عبارة عن صدمات متتالية.
ففي أحد المرات وجدتُ اثنين من أبناء أحد أهم الشيوخ لدينا، وهما يتفقدان حجم عضوهما الذكري، وبعد مدة ليست ببعيدة علمتُ أن الكثير من زملائي يعرفون هذه التصرفات، بل وهناك من يشارك فيها، بل هناك من يشرب السجائر ويجرب المخدرات... مجاز
كانت الصدمة الأولى غريبة وغير متوقعة نوعاً ما، ففي أحد المرات وجدتُ اثنين من أبناء أحد أهم الشيوخ لدينا، وهما يتفقدان حجم عضوهما الذكري، وبعد مدة ليست ببعيدة علمتُ أن الكثير من زملائي يعرفون هذه التصرفات، بل وهناك من يشارك فيها، ربما هذه الأفعال حتمية على بيئات ذكورية بحتة لا توجد بها رائحة لامرأة؛ كما عرفتُ أن أفعالهم السيئة لا تقتصر على الفضول الجنسي الناتج من الكبت المتواصل، بل هناك من يشرب السجائر ويجرب المخدرات.
لم تتكون الصدمة هنا بسبب الأفعال التي أذكرها بقدر ما تكونت بسبب الأشخاص، ففي بيتي وبيت زملائي يتحدث أهلنا معنا عن المشايخ الكبار، وعن أولادهم، بل ويضعونهم قدوةً لنا: أنظر إلى ابن الشيخ فلان، وأسمع حلاوة صوت ابن كذا وكذا في قراءة القرآن، وفجأةً تكتشف أن كل هذا الوهم مبني على هواء، وأن أطفال المشايخ ليسوا ملائكة، بل ويتسلل إلى نفسك بعض الغرور لأنه يبدو أنك أنت نفسك أفضل منهم بكثير.
حتى الآن المشايخ ملائكة، وفكرتُ في أنهم سيظلون كذلك، إلى أن سافرتُ معهم في رحلة مُدتها ثلاثة أيام في الضبعة على طريق الساحل الشمالي في الإسكندرية، في هذه الرحلة فقط، قرّرتُ أن أبتعد عن المسجد بالشكل الذي أعرفه، لكني ظللت على تواصل به حتى أتت ثورة يناير التي قرّرت أن تغير أشياء كثيرة في المجتمع المصري، ومنها تعرية رموز التيار السلفي الذي كنتُ قد عريتُه بيني وبين نفسي في رحلة الضبعة.
*****
بعدما انهيتُ المرحلة الابتدائية والإعدادية، ودخلتُ إلى المدرسة الثانوية، تغيّر تفكيري بشكلٍ كبير. عرفتُ الكتب والمكتبات، وبنيتُ صداقات قوية مع العلماء حول العالم، أصبحت أجلس معهم في غرفتي أكثر من جلوسي مع أي أحد آخر. كان الفضول يحرقني على مهل وكنت أتشوّق لمعرفة كل جديد.
في بداية هذه المرحلة، بدأت أقفز من مرحلة إلى مرحلة، رحلة صاحبني فيها الألم وقرر أن ينحت هو معالم حياتي الجديدة، خلال هذه المرحلة كنتُ على خلاف كبير مع معظم التفسيرات الروحانية للأشياء، وبالطبع كانت الأحلام والرؤى والفناجين والكفوف من الأشياء التي توقفت عن تصديقها، لكن ظلت هناك ذكرى لا تُفارقني ولا تُريحني أبداً وهي أحلام المرحلة الابتدائية.
حلمتُ بهدى مراتٍ ومرات وتحققت جميعها، فها أنا أذهب لبيتها في نومي في مكانٍ به أشجارٍ وزرع، مع صديق معين، ويقرّر بلا سبب أن يعترف لها بحبي، وفي اليوم ذاته أرى هدى في مكانٍ به أشجار وزرع، وأمامي الصديق نفسه الذي يقرّر أن يعترف لها الاعتراف نفسه، بل ها هي ترتدي ملابس المدرسة، بنطال أزرق، وقميص أزرق. إنه الحلم بحذافيره.
ظللتُ أفكر في هذا الحلم وأحلام كثيرة أخرى خاصةً وأن علاقتي بالأحلام بها غرابة يصعب تصديقها. في أحد الأيام عرفت حل اللغز، المفتاح الذي يجب أن أتعامل به مع الأحلام لفهمها. فجأةً يا صديقي يُضيء مصباح في رأسك وينفرج كل شيء، أو تتشكل المعارف التي تُبحر فيها حتى تنبثق لك فكرة جديدة .
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


