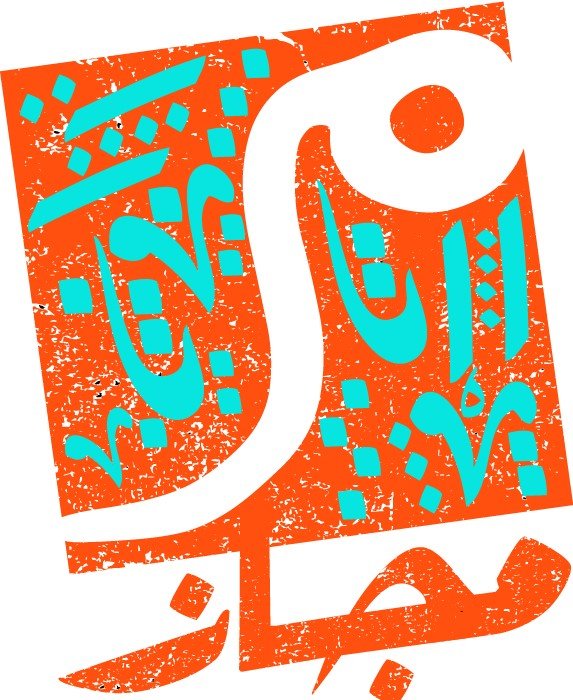
غادرت خلود صباح اليوم إلى الإسكندرية. ستمضي نهاية الأسبوع هناك لتزور أمها وتحضر زفاف صديقة عمرها. قالت إنها ستعود إما مساء السبت أو صباح الأحد. في الحقيقة، لا فارق لديّ على الإطلاق. أمام الباب ودّعتني بابتسامة وقبلة في الهواء، فتمنيت لها رحلة سعيدة.
تصغرني بنحو تسع سنوات. أثار هذا حذري الشديد في البداية. صارت الثلاثينية الضجرة الميالة للهدوء داخلي تتحسّس مسدسها من نزق العشرينيات وفوضاها. في لقائنا الأول قلت لها بوضوح إن أهم شيء لديّ هو الهدوء والنظام. أنا أعمل من المنزل، وفيه أمضي أغلب وقتي، ولا أحتمل الفوضى أو الصخب نهائياً، وأقدّس مساحتي الشخصية. لهذا لا أسكن مع أصدقائي، ولا أصادق رفيقاتي في السكن. الودّ والاحترام موجودان دوماً بالطبع، لكن من مسافة. أكدّت لي أنها أيضاً تحب الهدوء والنظام وتمضي أغلب وقتها خارج البيت، وتحترم المساحات الشخصية.
*****
شريكة سكن مثالية، على الأقل حتى الآن. هادئة ومسؤولة كما اتضح في عشرتنا القصيرة على مدار الأسابيع السابقة. وجودها خفيف جداً أكاد لا أشعر به، وهو المطلوب تماماً. تغادر كل يوم في الثانية ظهراً، ولا تعود قبل الواحدة فجراً، حين أنام أنا، ونكاد لا نلتقي إلا في عطلة نهاية الأسبوع.
في بعض الأحيان، تأتي تقى، صديقتها المقرّبة، لإمضاء أحد يومي العطلة أو كليهما معها/معنا، فيختل نظام البيت الهادئ قليلاً؛ لكنهما والشهادة لله، تمضيان أغلب الوقت في غرفتها أو تخرجان للتنزه، ومع بداية أسبوع العمل الجديد يعود كل حيّ لحاله، ويعود البيت دار مسنين أنيقة لنزيلة واحدة.
أثناء إفراغ أمتعتها سألتني ببراءة: "انت إيه موقفك من الصراصير؟" قلت ضاحكة: "موقف لا أحسد عليه". "إيه دا بجد؟ طب بتعملي إيه لو طلع لك صرصار؟"... مجاز
كان يوم وصول خلود صاخباً، وتململت كثيراً لهذا التغيير المفاجئ. ظلت غرفتها خالية لنحو شهر ونصف بعد أن غادرت هدير، رفيقتي السابقة في البيت، وارتحت كثيراً في العيش بمفردي. لو لم يكن الإيجار يتجاوز ميزانيّتي لما فكرت في البحث عن ساكنة جديدة.
يومها أتت أختها واثنتين من صديقاتها لمساعدتها في نقل أغراضها وتبديد رهبة المكان الجديد. ظللن يرحن ويجئن ويثرثرن وترن هواتفهن بصوت عالٍ طوال النهار، ثم أمضين ليلتهن معها، وفي اليوم التالي أعددن غداء منزلياً فاخراً ودعين المزيد من الأصدقاء والصديقات للاحتفال بانتقالها لـ "بيتها" الجديد، فانسحبت إلى غرفتي بانتظار انفضاض هذا المولد، وعودة الحياة لإيقاعها/إيقاعي الطبيعي.
أثناء إفراغ أمتعتها سألتني ببراءة: "انت إيه موقفك من الصراصير؟"
قلت ضاحكة: "موقف لا أحسد عليه"
"إيه دا بجد؟ same! طب بتعملي إيه لو طلع لك صرصار؟"
أخبرتها أننا نحكم غلق النوافذ والأبواب ونبقي المطبخ نظيفاً، وإن استطاع صرصور رزيل التسلل للبيت بعد كل هذا كانت هدير تقتله، وهو ما لم يحدث سوى مرتين فقط في عام ونصف".
"وهنعمل إيه لو طلع لنا صرصار واحنا لوحدنا؟" سألت بقلق.
"هنسيب له البيت طبعاً"، قلت ضاحكة، ثم طمأنتها أن بوسعنا، إن حصل، أن نستدعي عبد الله البواب ليقتله.
في عطلتها/نا الثالثة، اقترحت عليّ أن نخرج نحن الثلاثة، أنا وهي وتقى، للعشاء معاً والتعرّف على بعض بشكل أفضل. بعد كأسي نبيذ أخذ الحديث طابعاً أكثر حميمية. تكلّمنا عن الحب - طبعاً - والغربة والمجتمع وحياة السكن المستقل المشترك مع الغرباء.
سألتني باستحياء لمَ لم أعد للعيش في بيت والدتي بعد طلاقي. أخبرتها أننا جميعاً نصل لمرحلة معيّنة في حياتنا نحتاج فيها لهندسة عوالمنا وفقاً لإيقاعاتنا نحن، لا الآخرين. في السنوات الأخيرة، تفاقم هوس "هندسة العالم" هذا، فصرت أختار كل ما في حياتي بعناية شديدة. العمل الحر لا الدوامات الثابتة. حياة اجتماعية تتراوح - بمزاجي - بين ليالٍ متتالية من السهرات الصاخبة، وأسابيع طويلة من البقاء في البيت. أما في البيت نفسه، فكل شيء يسير وفقاً لتفضيلاتي، حتى مع وجود شريكة سكن. أطهو لنفسي الأصناف التي أحبها أو أطلب طعاماً جاهزاً. أختار المنظفات التي أحب رائحتها. أنعم بالصمت التام أو أبدّده إن شئت بفيلم أو مسلسل أو بعض الموسيقى. لست مضطرة للتواصل مع أحد، أو مشاركة آخر في شؤوني اليومية. عالم مهندَس بعناية، سعة شخص واحد.
وحيدة من جديد
كان سفرها للإسكندرية يعني المزيد من الخصوصية والبراح. فور مغادرتها، خلعت كامل ثيابي وأمضيت النهار كله عارية تماماً، كعادتي كلما خلا البيت عليّ. في المساء، أمام المرآة الكبيرة في غرفتي، وقفت أتأمل فخذيّ. عرف السليوليت طريقه إليهما مرة أخرى. من ضلفة الدولاب العليا أخرجت الفرشاة الجافة، وفركتهما بها في دوائر، من أسفل لأعلى، لتنشيط الدورة الليمفاوية، ثم أخذت حماماً بارداً.
في الغرفة، ألقيت روب الاستحمام على السرير، ووقفت مرة أخرى عارية أمام المرآة، أدلّك جسمي بالكريم، وأفكّر في إمكانية التزامي بفقرة الفرشاة الجافة تلك كروتين ليلي جديد. في الليلة الماضية، كنت أفكر أن إفراطي في هندسة عالمي الخاص يفقدني مرونة التعامل مع العالم الكبير. خطرت ببالي آية "من اتبع هواه وكان أمره فرطاً". ساءلت نفسي: هل صار أمري فرطاً؟ لم أصل لإجابة نهائية، لكنني نويت إجبار نفسي على إدخال بعض التعديلات المزعجة، فقط لأعتاد التعامل مع المنغصات الطبيعية في الحياة، دون أن أفقد صوابي كلما سار شيء على غير هواي. ربما عليّ حمل نفسي على العودة لممارسة الرياضة أيضاً، لكن واحدة واحدة.
*****
نظرة عابرة ألقيتها على السرير بحثاً عن قميص نومي، جعلتني أقفز هلعاً. كان هناك، يتحرّك بفضول وثقة على فراشي، عابراً فوق روب الاستحمام الذي خلعته منذ دقائق، باتجاه رأس السرير: صرصار.
من أين جاء؟ كيف وصل إلى فراشي؟ ومنذ متى وهو هنا؟ ركل الخوف والقرف أحشائي فتجمّدت أطرافي وانعقد لساني للحظة، وشعرت كما لو كنت في مواجهة الموت نفسه. الله أكبر الله أكبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أنت طلعت لي منين؟
جليتش مريع في عالمي المهندس بعناية. الأبواب، طبعاً، مغلقة والنوافذ أيضاً والزبالة في الخارج والحوض فارغ ونظيف، وكل الاحتياطات اللازم اتخاذها لئلا نصل لتلك اللحظة المريعة متّخذة بالفعل. من أين أتى "هباب البرك" هذا؟
غالبت قرفي ولم أحوّل عيني من عليه. لن أسمح له بأن يختفي هنا، في غرفتي، وفي محيط فراشي. كطلقات مدفع آلي في يد أعمى مذعور انطلقت الأفكار في رأسي. هل أغلق الغرفة وأبيت ليلتي في الصالة؟ ماذا لو خرج لي؟ أهاتف عبد الله ليقتله؟ تجاوزنا منتصف الليل وعبد الله الآن في سابع نومة. أبيت عند يسرا حتى يصبح الصباح فأكلّم عبد الله ليقتله؟ لكنني عارية، ولن أجرؤ على الاقتراب من الدولاب الملاصق للسرير لارتداء ملابسي، ربما كان هذا الزفت يطير. لو لمسني سأموت، أعلم هذا تماماً.
ردّ صوت رزين: "الصراصير لا تقتل. ليس عقرباً ولا حية"، فصاح صوت آخر مذعور: "سأموت بأزمة قلبية. سيتوقف قلبي خوفاً، وتعود خلود بعد أيام لتجدني ميتة، وعارية، وعلى جسدي صرصار مقزّز لا يفهم شيئاً".
كانت فرصنا في قتل أحدنا الآخر هذه الليلة متكافئة تماماً. بحركة عشوائية واحدة يمكنه أن يصيبني بأزمة قلبية تنهي حياتي، وبرشة سريعة من بخاخ سام يمكنني إنهاء حياته... مجاز
الموت وحيدة هو ثاني أسوأ مخاوفي
قبل أن تصل خلود بأيام، كنت في فراشي، أعاني نوبة مفاجئة من نوبات المرارة. للحق، لم تكن مفاجئة تماماً. كنت أمرّ بضغط عصبي مهول، أبحث عن ساكنة جديدة وأصلح ما أفسدته هدير، وأخوض مهاترات مع شركة الإنترنت ومع صاحبة البيت، وهناك طبعاً ضغط الشغل، وضغط الحياة اليومية كامرأة وحيدة في بلد تضيق يوماً بعد يوم، وتركض نحو الإفلاس بسرعة جنونية. كنت أعرف أن مرارتي لن تحتمل. حرفياً.
بدأ الألم النافذ بعد منتصف الليل، كعادته. عارية تماماً، كعادتي، وجدت نفسي ممددة في سريري، لا أحتمل امتلاء رئتيّ بالهواء مع كل نفس. سيف عريض مغروس في كبدي، تحرّكه يد عابثة شديدة القسوة، فينخر جانبي الأيمن وينفذ من ظهري، ويشلّ حركتي وتفكيري تماماً. لا أقوى على النهوض وارتداء ملابسي للذهاب للطبيب. لا أقوى على مدّ ذراعي للكومود لالتقاط الموبايل وطلب المساعدة، أو حتى على تناول شربة ماء.
ثم ظهر شبح راندا.
عرفتها منذ ثماني سنوات. كانت أول من قابلته حين ذهبت لاستلام تكليفي في مستشفى حكومي بمدينة نائية جميلة. تكبرني بثماني أعوام، صعيدية، جدعة، عنيدة، يخشى الجميع بأسها فيعملون لها ألف حساب، ولا يجرؤ أحد على معارضتها. جبارة، لكنها في الوقت نفسه، طيّبة القلب، لا تقبل الظلم ولا تتردّد في نصرة المظاليم وردّ الحق لأصحابه.
أحبتني منذ لقائنا الأول، وساعدتني كثيراً في إنهاء أوراق تعييني وعرّفتني على الجميع، وسرعان ما صرنا صديقتين.
اخترت أنا الابتعاد عن حوارات السكن المشترك في المستشفى فاستأجرت لي بيتاً، أما هي فكانت تحتمل قرف سكن الأطباء بالمستشفى، لتوفّر أقساط شقتها في القاهرة. كانت وحيدة تماماً، غريبة أينما حلّت، لم يسبق لها الزواج، ولم تدم لها قصة حب أكثر من شهور معدودة، ينفطر بعدها قلبها، كل مرة، كما لو كانت الأولى. كان هذا يذيقها سموم لسان أمها وأقاربها، ويحاصرها بنظرات هي بين الشفقة والشماتة.
كانت تعاني من قرحة في المعدة، ومع الإفراط في التدخين والقهوة، وطعام المستشفى القذر، والضغط العصبي المستمر، ظلت حالتها تتدهور بمرور السنوات إلى أن دقّت إحدى الممرضات باب غرفتها في السكن ذات صباح لتجدها ميتة. ثقب في جدار المعدة. أمضت ليلتها الأخيرة في الدنيا وحيدة، تتألم، ثم رحلت. كنت قد أنهيت سنوات تكليفي وعدت إلى القاهرة حين وصلني الخبر.
شبح راندا رفيقي المعتاد في نوبات المرارة الليلية. ضيف يأتي بلا استئذان ليقتحم هذا العالم الذي بالغت في هندسته وانتقاء روّاده. يظل يطوف بفراشي في بذلته الطبية الزرقاء، يشعل سيجارة تلو الأخرى صامتاً متجهماً، أو يستلقي بجواري على السرير مقلّداً تشنجات يدي على الوسادة، أو يضرب رأسه في الجدار كلما وددت أن أفعل، إلى أن يغمى عليّ من فرط الألم، فيختفي.
خلعت كامل ثيابي وأمضيت النهار كله عارية تماماً. أمام المرآة الكبيرة في غرفتي، وقفت أتأمل فخذيّ. عرف السليوليت طريقه إليهما مرة أخرى. من ضلفة الدولاب العليا أخرجت الفرشاة الجافة، وفركتهما بها في دوائر، من أسفل لأعلى، لتنشيط الدورة الليمفاوية، ثم أخذت حماماً بارداً... مجاز
*****
أمام الصرصور، عاودني خوف الموت وحيدة مرة أخرى، ولمحت شبح راندا يطل برأسه من باب الغرفة. ظللت أبسمل وأكبّر، ومرّت الدقائق ببطء، إلى أن انحسر هلعي، وما إن تمالكت نفسي حتى رفعت رأسي لسقف الغرفة ورحت أعاتب الله بصوت عالِ: "كده برضو يا رب؟ عايز تنشّف دمي؟"
سألتني راندا: "مش لو كان معاكي راجل دلوقت، كان قتلهولك؟ بدل مانت واقفة تكلمي نفسك كده؟!"
أجبت بانفعال: "كان ممكن هو كمان يبقى بيخاف من الصراصير، كان يبقى إزاي الحال؟ أكيد كان هيحسّ بضغط إنه متوقع منه ما يخافش من الصراصير لمجرد إنه راجل. وبعدين هي دي وظيفة الرجالة يعني؟ عادي على فكرة لو كان معايا شغالة في البيت أو أي حد ما بيخافش من الصراصير كان هيؤدّي نفس المهمة. أنت نفسك لو كنتِ هنا كنتِ قتلتيه".
ردّت بنفاد صبر: "هتديني محاضرة في الجندر بروح أهلك؟ هنعمل إيه دلوقت؟"
إلهام إلهيّ ساقني للمطبخ، وبسرعة عدت ببخاخة الإكتومثرين. يُباع في الصيدليات كعلاج للجرب، لكنه في الحقيقة مبيد حشري ممتاز وممتد المفعول. أستخدمه في بدايات الصيف لتفادي هجمات النمل. هل يفلح مع زائري البني المقزّز؟ لنرى.
عدت للغرفة لأجده يتسلّل لفجوة صغيرة بين المرتبة ورأس السرير. عالجته برشات سريعة وأنا أردّد: "بسم الله المُميت"، فانتفض وسقط عبر الفجوة إلى داخل سحّارة السرير، ولم أعد أراه.
دقائق أخرى مرّت بين الذكر والتردد. هل مات؟ لن أعرف إلا إن رفعت المرتبة ونظرت أسفل السرير. هل أنا مستعدة لفعل ذلك؟ ماذا لو لم يمت؟ ماذا لو طار في وجهي؟ لو لمسني سأموت!
أجاب صوت جديد، حاسم وضجر ومألوف قليلاً: "مش هتموتي لأ. انت مش بسكوتة. سيبك من دور الفتاة المرهفة دا، واقلبي المرتبة عشان تعرفي تنامي".
رددت كلمات الصوت الحاسمة بصوت عال: "أنا مش بسكوتة، ومش هموت لأ. وبعدين حتى لو مت هيحصل إيه يعني؟ دا الموت راحة". هزّت راندا رأسها موافقة.
لكنني لم أستطع حمل نفسي على رفع المرتبة. ربما كان متشبثاً بجانبها السفلي ولمسته يدي إن فعلت. استجمعت شجاعتي وكوّمت الوسائد والروب على الأرض، وذهبت إلى الحمام لأحضر الممسحة، لأحاول استخدام يدها الخشبية الطويلة في رفع المرتبة من مسافة.
مصمصت راندا شفتيها: "مش لو كان معاكي راجل كان رفع معاكي المرتبة ع الأقل؟ ولا دي كمان فيها محاضرة؟"
أجبت بعصبية: "لو كان معي أي شخص على الإطلاق لساعدني في رفع المرتبة. ارحميني".
بطرف عصا الممسحة الطويلة حاولت عبثاً تحريك المرتبة الثقيلة، فكادت تنكسر، وسرعان ما اتضح لي غباء الفكرة. بالنسبة لشخص مهووس بهندسة العالم، تقديراتي الهندسية مخزية. طيب طيب. لابد مما ليس منه بد. سأحاول رفعها بيدي والأمر لله، فقط لنخبّط على جوانب السرير قليلاً، علّه يسقط إن كان ما زال متشبثاً بشيء.
بضع دقات عشوائية ثم حاولت تحريك المرتبة قليلاً بشكل يسمح لي بكشف مثلث أكبر من الفجوة التي تسلل من خلالها. أنظر داخل السرير، لا شيء سوى الغبار. دفعة مذعورة أخرى تكشف مساحة أوسع من المُلل الخشبية وتحتها السحارة، غارقة في الظلام. أحضر الموبايل وأضيء الكشاف بيد مرتعشة، فلا أجد له أثراً.
أقول لنفسي على الأرجح مات. الإكتومثرين فعّال جداً. لكن ماذا لو لم تكن تلك الجرعة كافية؟ قرأت مقالاً عن فقدان الصراصير الألمانية لحساسيتها للإكتومثرين بسبب فرط استخدام الناس له هناك. ماذا لو كان هذا الزفت من أصول ألمانية؟ ماذا لو نجا وخرج من مكمنه واستيقظت في منتصف الليل لأجده يزحف على ذراعي؟ سأموت فوراً!
بعناء شديد أزحت جزءاً أكبر من المرتبة حتى مالت عن أحد جانبي السرير، كاشفة مساحة أوسع من السحارة. صوّبت كشّاف الموبايل مرة أخرى، ومجدداً، لم أجد له أثراً. نظرت خلف السرير، لا أثر أيضاً. خلف الكومود الصغير؟ لا شيء. هل كان هناك صرصار أصلاً، أم تراني توهّمت كل هذا؟ هل جننت؟
رفعت راندا كتفيها في لامبالاة وقالت: "جايز"، وعلى باب الغرفة، ظهر شبح آخر، هزّ رأسه باسماً أن "أيوه".
والجنون هو أسوأ مخاوفي على الإطلاق
رأيته مرة وحيدة منذ سنوات. صباح خريفي عادي جداً هفّت فيه نفسي إلى سندوتشات الفول والطعمية الطازجة ونسائم الفجر الباردة، وبعد دقائق كنت أقطع شارع النصر باتجاه مطعمي المفضّل. أمامي كشك سجائر حوله مجموعة شباب، تنظر باتجاهي وتهزأ بوضوح من شيء ما. التفت ورائي فرأيته. كان يصغرني بأعوام، وجه وديع وملابس عادية. ليس مشرّداً كما يبدو من هيئته، لكنه بادي الجنون. يحجل بخطوات غير متزنة هي أقرب للرقص، موزعاً ابتساماته المجنونة على العابرين دون تمييز. تلاقت عينانا حين التفتّ له فمنحني ابتسامة مجنونة وحقيقية تماماً. نظرة واحدة على وجهه كانت كافية لأعلم أنه ليس هنا. لا يرى ما نراه. كان في عالمه الخاص، وبدا سعيداً وخفيفاً، لكن ما فطر قلبي حقاً أنه كان وحيداً تماماً في عالمه هذا. ليس معه سوى أشباح من نسج خياله. زلزل منظره كياني، فشهقت بالبكاء. سبقني بخطوات والتفت لي مرة أخرى، رآني أبكي فاتسعت ابتسامته المجنونة ثم مضى في طريقه. ظللت أبكي إلى أن عدت إلى البيت، وانضم مجنون الفجر لقائمة أشباحي.
كانت وحيدة تماماً، غريبة أينما حلّت، لم يسبق لها الزواج، ولم تدم لها قصة حب أكثر من شهور معدودة، ينفطر بعدها قلبها، كل مرة، كما لو كانت الأولى. كان هذا يذيقها سموم لسان أمها وأقاربها، ويحاصرها بنظرات هي بين الشفقة والشماتة... مجاز
*****
بظهوره على باب غرفتي، لم تعد المسألة مسألة عودة الصرصار، في حالة إنه لم يمت، بل التأكد من وجوده ابتداءً، ومن أنني لم أجنّ بعد. بقوة أكبر دفعت المرتبة دفعة أخرى حتى سقطت من على السرير، وانكشفت السحارة، ورأيته. تنفّست الصعداء، وابتسم شبح مجنون الفجر ابتسامة مجنونة أخيرة وتلاشى، أما راندا فاقتربت لتراه معي.
مقلوباً على ظهره يتشنّج فتتحرك شواربه وأقدامه المقزّزة في كل اتجاه. غمرني القرف، لكني بالرغم من ذلك أمعنت النظر لأرى ما إذا كان يموت فعلاً أم أنها حالة عابرة سيقوم منها عازماً على الانتقام. رأيت طريقاً قصيراً حفرته تشنجّاته في الغبار المتراكم تحت السرير. سامحك الله يا رضا، هل عليّ أن أطلب منك في كل مرة رفع المرتبة وتنظيف السحارة؟ ألا تعلمين أنه جزء أساسي من تنظيف الغرفة؟ تذكرت أمي، وتفتيشها الصارم على كل ركن وزاوية في البيت بعد أن تأمرنا بتنظيفه، ورفضها التام للاستعانة بخادمة. لو رأت هذا المنظر تحت سرير لأقامت القيامة.
ما العمل الآن يا راندا؟ أتركه يحتضر وأطلب من رضا إزالة جثته وتنظيف السحّارة في المرة القادمة؟ لكن اليوم الأربعاء، ورضا لن تأتي قبل صباح السبت، وأنا لن أنام فوق جثّة صرصار أبداً. فأل سيء.
*****
"ما تشيليه ياختي؟": قالت أمي بحسم واحتقار، فتلاشت الغرفة من حولي ووجدت نفسي على سّلم بيتنا القديم في الزيتون.
أخاف الصراصير منذ عرفت بوجودها. صرصار على السلّم كان كافياً تماماً لشلّ حركتي لدقائق، تتبعها عودتي للبيت باكية معتذرة عن قضاء المشوار الذي أُرسلت فيه. كم سخرت أمي وضحكت وزجرت، ولكنها في أغلب الأحيان كانت تنزل معي فتقتله لي وتزيحه من طريقي، وتتركني أتابع مشواري.
كنت في الثامنة تقريباً حين قررت أن تضع حداً لتلك "المياعة". عدت إليها ذات نهار ممتقعة الوجه بسبب صرصار على سلّمنا، فأمسكتني من يدي ونزلت معي وقتلته أمامي، ثم أمرتني بكنس جثته ورميها في الزبالة. كدت أفقد وعيي رعباً، وتوسلّت إليها أن تعفيني من تلك المهمة المقززة، لكنها أصرّت، وسرعان ما تحوّل الأمر لمسألة حياة أو موت.
أحضرَت الجاروف وأغلقَت باب البيت دوني، وأعلنت بحسم أنني لو لم أتخلّص من جثة القتيل فلن تسمح لي بدخول البيت ثانية. صدّقت تهديدها طبعاً، وهل يكذّب الطفل أمه الغاضبة؟ وقفت على السلّم أبكي وأرتجف وأحلّفها بكل غالٍ أن تعفيني من هذا الرعب، فأبت، وحين ضاقت بضوضائي فتحت الباب لتصفعني وتؤكد على أن عودتي للحياة معهم رهن بالتخلّص هذا الشيء البني القذر.
للحظة، فكّرت في إمكانية الحياة وحدي، بعيداً عن البيت، ولكنني سرعان ما استبعدتها تماماً، وبمزيج من الرعب والغضب هبطت درجات السلّم ببطء حتى صارت بيننا درجتان، ووقفت لدقائق أحدّق في جثته المقلوبة على ظهرها. انقلبت بطني وكدت أتقيأ لكنني لم أفعل. فردت ذراعي على طوله ومددت يداً مرتعشة بالجاروف، وحاولت التقاطه، لكن الوغد بدأ في التشنج ما إن لامسته حافة الجاروف، فصرخت وعدت جرياً لباب البيت أولول: "يا ماما، لسه ما ماتش". أتاني صوتها جافاً جباراً من خلف الباب: "أديله ضربة كمان بالشبشب وارميه". بالطبع لن أفعل. كانت أخبرتني أن انقلاب الصرصار على ظهره يعني أن موته صار مسألة وقت. سأنتظر.
مرّت الدقائق طويلة مميتة على كلينا. ظللنا نتشنّج - أنا وهو - إلى أن سكنت حركته أخيراً. بقرف الدنيا كرّرت المحاولة إلى أن استقر فوق الجاروف، وبخطوات سريعة مذعورة حذرة من أن يسقط من الجاروف فنعيد المأساة من أولها، صعدت السلم وألقيته في صندوق القمامة الكبير أمام باب البيت، وشرعت أطرق الباب بهستيريا، وأنا أخشى أن يخرج - بمعجزة ما – ليطاردني: "يا ماما، رميته خلاص افتحيلي والنبي". خرجَت وتأكدت مما قلته، وبعدها فقط، سمحت لي بالدخول، ولا أذكر شيئاً مما حدث بعدها.
*****
تراجعت راندا لتفسح المجال لأمي، وبلهجة آمرة قالت الأخيرة "ارميه وإلا مش هتنامي تاني. لا الليلة ولا أي ليلة". بخطوات أقل اضطراباً ذهبت لإحضار المكنسة والجاروف، وعدت لأراقب تشنجاته مرة أخرى.
تصيب المادة الفعالة في الإكتومثرين قنوات الصوديوم في الخلايا العصبية، فتسبب شللاً وتشنجات قوية تؤدي للوفاة. يحدث هذا في الحشرات فقط لأن أجسامها لا تستطيع تكسيره والتخلّص منه، أما الحيوانات والبشر، فلا. لطالما أدهشتني تلك الفكرة ووجدت فيها شاعرية ما: ما يقتلنا، ببساطة، هو ما نعجز عن تفكيكه والتخلّص منه. للحظة أشفقت عليه. هل يتألّم الآن؟ هل تتألم الصراصير؟ هل يعني تعطّل قنوات الصوديوم في جهازه العصبي تعطل قدرته على الشعور بالألم أيضاً؟ لا أدري. فكّرت في البحث عن الموضوع بعد انقشاع هذه الغمّة. ظلت أرجله تتقلص وتنفرد ويهتزّ جسده على الأرض، ثم يسكن قليلاً، ثم يعود للتشنج مرة أخرى. على الأرجح سيموت، وسأنجو.
كانت فرصنا في قتل أحدنا الآخر هذه الليلة متكافئة تماماً. بحركة عشوائية واحدة يمكنه أن يصيبني بأزمة قلبية تنهي حياتي، وبرشة سريعة من بخاخ سام يمكنني إنهاء حياته. معركة بلا اشتباك حقيقي بين أطراف لا تكن أية ضغائن حقيقية لبعضها. الأمر وما فيه أن وجوده يؤزّم وجودي، ووجودي يهدّد وجوده، والصدفة التعيسة التي حكمت بتقاطع طريقينا تحتم على أحدنا أن يفسح المجال للآخر للأبد. لم تكن مسألة حجم أو قوّة. قلت لنفسي، أو له: "كنت شجاعاً، أيها المسكين المقزز، والبقاء هنا للأجبن".
دقائق طويلة أخرى حوّلت ترقّبي المذعور إلى ضجر. حتّام ستتشنج طيب؟ يا أخي مُت وخلّصنا! حملت البخاخ وعالجته ببضع رشات سريعة، انتفض على إثرها، ثم لا شيء. استمرت التشنجات أقوى من ذي قبل. يادي المصيبة. أنا آسفة فعلاً.
‑ يا ماما.. لسّه ما ماتش!
‑ اديله ضربة كمان بالشبشب وارميه
بالطبع لن أضربه بالشبشب يا ماما! أنا أحب هذا الشبشب ولو ضربته به فلن أستطيع ارتداءه مرة أخرى. ثم إن ضربه يعني الاقتراب منه. كلا. بعد تردّد، تناولت المكنسة ورفعتها في الهواء ووقفت أهندس الضربة الأخيرة. عليّ اختيار الفراغ المناسب بين ملل السرير بحيث أسدد ضربة واحدة فعّالة، دون أن أضطر للاقتراب كثيراً في حال انقلب وطار في وجهي. الفراغ بين الخشبة الأولى والثانية يمنحني تسديدة عمودية قاتلة لكن سيكون عليّ أن أقف فوقه تماماً. الفراغ بين الثانية والثالثة يترك لي مساحة أكبر للهروب، لكنه لن يسمح بضربة قاتلة. أعمل إيه؟
"الأول. ضربة واحدة ونخلص. حتى لو طار في وشك مش هتموتي": قالت ماما بحنان، فاستجمعت شجاعتي وضربته.
مات.
"ما تشيليه ياختي؟": قالت أمي بحسم واحتقار، فتلاشت الغرفة من حولي ووجدت نفسي على سّلم بيتنا القديم في الزيتون... مجاز
هل من الضروري أن أتخلّص من جثته بنفسي؟ ألا يمكننا تركه حتى تأتي رضا؟ ألقت ماما نظرة غاضبة على التراب المتراكم في السحارة، ولم تعلّق. معك حق، سأزيله الآن، وأنظف السحارة بالمرة.
مررت المكنسة من الفتحة الأوسع وشرعت أراكم الغبار حول جثته فراحت تختفي شيئاً فشيئاً. إيه ده؟ والله فكرة! صرت أحرك المكنسة أبعد وأجمع المزيد من الغبار حتي اختفى تماماً. واريته التراب، حرفياً. لم أعد أراه، فتراجع شعوري بالتقزّز. ما أجمل العماء وما أسهل خداع النفس! هي الآن كومة تراب، مجرد كومة تراب عليّ التخلص منها. يبدو هذا معقولاً. صارت حركاتي أكثر ثباتاً.
أخيراً، مددت ذراعي بطوله عبر ألواح الخشب حتي استقر طرف الجاروف بالكاد على الأرض، وشرعت بحذر شديد أراكم التراب الذي يخفي الجثة المقززة فوقه، وبخطوات سريعة حذرة من سكب ما في الجاروف وإعادة المأساة من أولها، ركضت إلى المطبخ وقلبت الجاروف في صندوق القمامة. يا ساتر! أخيراً؟
في غرفتي جمعت كل ما على السرير من أغطيته ووضعتها في الغسالة، وفرشت ملاءة جديدة، وعدت لآخذ حماماً آخر. هل لمحته خلود يوم أتت لتسكن الغرفة الأخرى؟ ألهذا سألت عن موقفي من الصراصير؟ يبدو احتمالاً بعيداً. على الأرجح لن أذكر لها شيئاً مما جرى الليلة. قد يخلق هذا حميمية أنا في أتم الغنى عنها.
*****
خرجت من الحمام، ومرة أخرى، وقفت أمام المرآة أطالع فخذيّ العاريين وأدلّك جسدي بالكريم. هل اختفى السليوليت؟ بالطبع لا، لكنه سيفعل إن واظبت على هذا الروتين الليلي الجديد. ربما على أيضاً أن أبدأ روتيناً يومياً لرفع الأثقال. أبغض الچيم كثيراً، لكن من يدري؟ ربما احتجت لرفع المرتبة وحدي مرة أخرى. تمددت على السرير في نشوة من الزهو والانعتاق. كانت راندا قد غادرت، لكن أمي أطلّت برأسها من الباب معابثة: "ومين بقى اللي هيرمي كيس الزبالة؟"
يا الله! كيس الزبالة. ماذا لو حاولت حمله للخارج وانفتح مني لأي سبب؟ ماذا لو لم...
"رضا": قلت بحسم، "رضا هترميه لما تيجي. تصبحي على خير يا ماما".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


