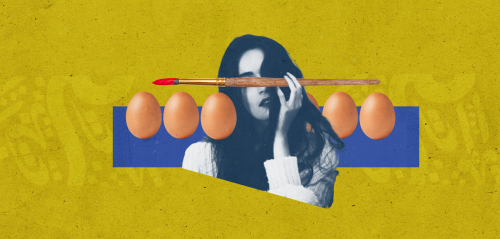كنت في الثانية عشر من عمري، حين استطاع أبي، المعلم في مدرسة حكومية، شراء دراجة هوائية لنا، نحن أبناءه الخمسة. "بي أم إكس" زرقاء لمّاعة بمقاس 20، كانت التجسيد الأول لأحلامنا جميعاً، وأحلامي خاصّة، تلك التي دفعت ثمنها عاماً ونصف من المفاوضات و"الزنّ" وشرح الأبيات الشعرية الجاهلية وتفسير القرآن والإعراب.
أحلامي التي فشلت بامتطاء صهوتها على أرض الواقع، بينما كنت أقودها أثناء النوم ببراعة لا يشق لها غبار. اليوم أعي أن الطفل يخطئ في فصل الواقع عن الخيال حتى يتمّ السادسة، وأعي أنني احتجت ما يقارب ضعف ذلك العمر.
في ظهيرة ما من ذلك الصيف، شعرت بما لم يمكنني احتماله من الإهانة والرفض ونفاد الصبر، أنزلت الدراجة إلى الطريق الخاوي المعبّد أمام المنزل، وسمحت لنفسي، خلال قيلولة أبي وسكان القرية جميعاً، بأن أسقط وتتخدّش ساقاي في سبيل توازن مؤقت، فلحظة السقوط يمكن أن نجعلها بطولية إذا لم يشهدها أحد، أما في حال وجود شاهد قادر على تحويل الأمر إلى طرفة مخزية تتناقلها الألسن فلن تكون كذلك.
لذا بدأت أقود وأنا أشعر أن عيوناً كثيرة لا أراها تحدّق بي من خلف النوافذ فتربكني، ثم تهزّ أكتافها وتكتم ضحكاتها كلما وقعتُ، فاستسلمتُ إلى غير رجعة، وعرّجت بالدراجة على الدرجات الثلاث التي تفصل باب بيتنا عن الطريق، وأغلقت بابنا الحديدي الأسود إلى الأبد، بحذر لا يوقظ أحداً يستطلع من خلاله خسارتي.
تذرّعت بكبرياء أبله عزوفي عن تعلم قيادة الدراجة الهوائية، ولمّحت بحياء إلى التغيّر الذي بدأ يطال جسدي لتبرير الأمر، فأنا "عم صير صبية"، ورغم أنني كنت أغبط في سرّي اللواتي لا يكترثن للسقوط أمام عيون الآخرين، إلا أنني كنت أبرّر لنفسي الاستسلام، فبنات صفي بالكاد انتزعنني من التصنيف في القسم الطفولي الأقل شأناً، ذاك الذي لم يتأهّل جسده بما يكفي ليسمع حكاياهنّ، فكيف إذا عرفت المصنِّفات بأنني أسقط عن الدراجة؟
عندما سألتني ابنتي: "ماما أيمت رح تجيبيلي بسكليت"، أجبتها كما أجابني مسؤول القروض: "بعد عشرة أيام"، رأيتها في تلك اللحظة تنظر نحو السماء بحبّ كبير: "عشرة أيام بس"، ثم ترسل نحوها قبلاً متلاحقة: "شكراً الك يا الله لان رح تخلي الماما تجبلي بسكليت بعد عشر أيام، بحبك كتير"
هذا الفعل سيحول حتماً بيني وبين انضمامي إلى مجالسهنّ الخاصة وأحاديثهن الماجنة، فهو يتنافى مع الرزان والتؤدة والوقار الخارجيين الذين فرضنهن على أنفسهنّ وعلينا، والذين لا يتماشون أبداً مع تموّج هرموناتنا وتذبذب شخصياتنا وتطرّف الأفكار في رؤوسنا.
بقيت لسنوات طويلة أستيقظ منتشية كلما حلمت بأنني أقود دراجة كبيرة في حارات قريتي المتعرّجة، خاصة إذا ما تشجّعت وأفلتّ المقود، تاركة ليدي حرية التعامد مع جسدي المتوازن، ولجديلتين لم أمتلكهما فرصة طيران إلى الخلف فرضته فيزياء السرعة، لكن النشوة كانت تتحوّل بعد ساعات إلى لوم مبطّن لأبي وتنصّل من مسؤولية فعل الانهزام.
فاقد الشيء يعطيه دون سؤال
أشهر قليلة مضت على إتمام طفلتي عامها السادس، تزامن هذا الصيف مع رغبة أقرانها باقتناء درجات هوائية، والبدء بمرحلة ترويض التوازن والاستشفاء السريع من نتائج فقدانه للعودة إلى خوض غياهب المتعة. رأيتها تحدّق بهم، وتركض خلفهم ضاحكة، ورأيت نفسي في صباح اليوم التالي أبدأ معاملة حكومية رتيبة لاستخراج قرض يؤهّلني لشراء دراجة لها، فهي طيلة الليل الفائت كانت تصيح في نومها "جدو امسكني"، كما كانت تقول له عصراً وهو يحاول تدريبها على دراجة أحدهم، في وقت استراحته.
مخاض جمل القرض سينجب فأراً يؤهّلني لشراء دراجة صغيرة مستعملة، لكنه لم ينته حتى لحظة كتابتي هذه السطور، وعندما سألتني ابنتي: "ماما أيمت رح تجيبيلي بسكليت"، أجبتها كما أجابني مسؤول القروض في ذلك اليوم: "بعد عشرة أيام"، رأيتها في تلك اللحظة تنظر نحو السماء بحب كبير: "عشرة أيام بس"، ثم ترسل نحوها قبلاً متلاحقة: "شكراً الك يا الله لان رح تخلي الماما تجبلي بسكليت بعد عشر أيام، بحبك كتير".
"لماذا لم يشتر لي أبي دراجة في طفولتي؟"
كنت كثيراً ما أسأل نفسي هذا السؤال فلا أجد له جواباً، ولكن في تلك اللحظة عرفت أن السرّ وراء تأخر أبي لم يكن بسبب عدم رضاه عن قدرتي في تحليل الشعور العاطفي للأبيات الشعرية، ولا عن سخطه لتقصيري في البحث داخل المعجم عن مرادفات لكلمات يختارها من الآيات القرآنية، ولا عن تأخّر إخوتي في حفظ جدول الضرب وقراءة الساعة.
إن السر وراء تأخر أبي كان شيئاً فرضه ما لا يمكن لصغير في بلادنا أن يفهمه، ولا لكبير. إنه نظرة البلاد الدونية للأطفال، متعتهم المهمّشة، اختياراتهم المهملة، وأحلامهم غير المدرجة على قوائم الأولويات. إنه الاحتقار اللعين لصحّتهم النفسية ونبذ حقهم في اللعب تحت مسمّى الرفاهية، وحصر مفهوم حياتهم الكريمة في مأكل ومأوى.
أبي لم يختصر الطريق ولم يقترض ليشتري لنا دراجة، إلا أنني بتّ اليوم أدرك أنه فعل كل ما بوسعه ليجعلنا نرقص على إيقاع حركة الخرز الملون في أسلاك عجلاتها. أنا أسامح أبي اليوم، وأجزم له لو أنه جرّب متعة الانزلاق التي جرّبتها في أحلامي والانسياب الذي كنت أعبر به الأزقة، لكان نظر إلى الطعام والشراب والتعليم على أنها أشياء ثانوية أمام لحظة الحرية والانعتاق تلك.
يقول سيغموند فرويد: "إننا نحب ونكره، ونخاف ونشجع، ونشمئز ونقبل، ونفعل ونترك، عواطف كَمُنَت فينا منذ الطفولة، ولا ندري بها، إلا بعد التحليل الشاق"، وبناء على ذلك ندرك أننا جميعاً نتاج طفولتنا، أفكارنا ومواقفنا وردود أفعالنا كبالغين ليست أكثر من انعكاس ما رغبنا به وقتذاك، فحصلنا أو لم نحصل عليه، وما رغبنا عنه فأدرَكنا أو نجونا منه، دون ذلك، الله وحده يعلم، وما تبقّى من ذاكرة أبي أيضاً، أي طفولة عاشها لتترتب أولوياته بهذا الشكل.
بقيت لسنوات طويلة أستيقظ منتشية كلما حلمت بأنني أقود دراجة كبيرة في حارات قريتي المتعرّجة، خاصة إذا ما تشجّعت وأفلتّ المقود، تاركة ليدي حرية التعامد مع جسدي المتوازن، ولجديلتين لم أمتلكهما فرصة طيران إلى الخلف فرضته فيزياء السرعة
إن علماء النفس ومدربي الحياة مصرّون على أننا نتفاعل مع كثير من الأحداث والمواقف كما يفعل "الأنا الطفل"، يدعون هذا بالطفل الداخلي، وينسبون إليه الطريقة التي نستجيب بها للمحرّضات. إنهم محقون! ففي قريتنا صبية تعمل في مكان أبعد من أن يُذهب إليه سيراً وأقرب من أن يُذهب إليه بالمواصلات، تمتطي دراجتها غير آبهة بما قد تكوّر وتدوّر، وتعلّق على ظهرها حقيبة لا تمنعه من الاستقامة، تحفظ ابنة الاثني عشر ربيعاً التي تسكنني مواعيد ذهابها وإيابها، وتجادلني بوقاحة المراهقات لأترك كل شيء وأقف على نافذة الغرفة المطلة على الطريق وأشاهدها.
ابنة الاثني عشر ربيعاً التي تسكنني تزجّني اليوم كثيراً في حلبات التجارب، فهي تدرك بخبرة المتمرّس مرارة الندم على البقاء في الجانب الآمن، وصعوبة الرضوخ ودفع أي ثمن مقابل النجاة من رؤية الآخرين لي وأنا أسقط، أنا اليوم أسقط بفخر وشجاعة، فتنفض عني غبار التمرّغ في التجربة، وتقول لي: "الندم على ما فعلناه أفضل من الندم على ما لم نفعله".
ابنة الاثني عشر عاماً ذاتها، تعد لي البقع الزرقاء على فخذي طفلتي وساقيها، وتحسدها على عناد ورثته عنها وشجاعة تفوقت بها عليها، وتشاهد مئة مرة متتالية مقطع فيديو بثوانِ تسع لصغيرتها تقود دراجة مستعارة، بتوازن يكاد ينتهي بالسقوط لكنه لا يفعل، تتبعه ضحكة فخورة من الصغيرة وشعور بالنصر والإنجاز، ثم تعود إلى نسختها الثلاثينية، لتحدق في السماء وترسل القبل متوسلة دامعة وتقول: "شكراً يا الله لأنك رح تخليني جبلها بسكليت بعد عشر أيام، بحبك كتير".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.