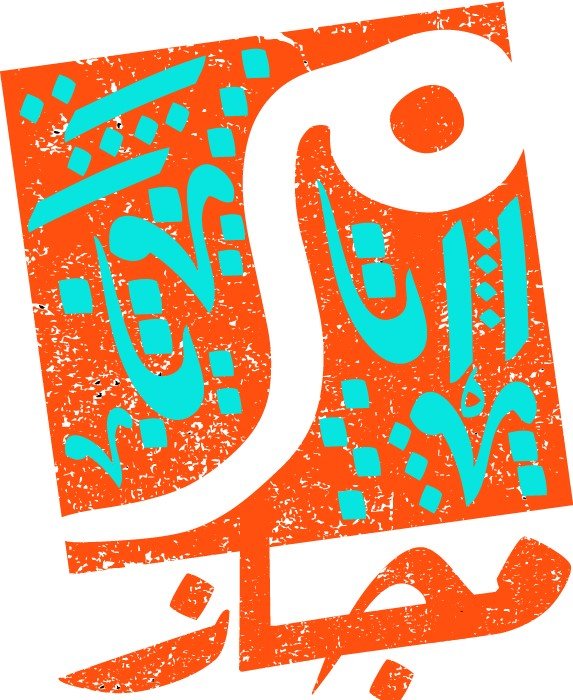 الخائف
الخائف
"الخوف جلباب العارفين"، علي بن أبي طالب.
(الأسماء الواردة في هذا النص هي أسماء وهميّة لناس حقيقيّين)
الله هو أستاذ النّفس الأوّل، هو من علّمنا الخوف. لابأس إن خفت منه، ليس عليك أن تسقط عليه الحبّ دائماً أو أن تلطّف صورته لدى العامّة. الله هوأن ترتعب، هو "وإِذَا البِحَارُ سُجِّرَت"، هو أن تقضي حياتك قلقاً من سعير النار، وأن ترهب الموت لأنّك ربّما تحترق. الله هو أن تخاف، أن تتأدّب في خوفك...
لا شيء يربطني بتلك المرحلة المبكرة من الحياة إلّا صوت والدي وهو ينغّم الصّلاة في بيتنا المتكوّر على ذاته في حارة صيدا. كان قائداً في كشّافة المهدي، ولم يكن يغيّر زيّ الكشاف الرّسمي حتّى ينتهي من صلاته. يقف في وسط غرفة الجلوس وينشد الصّلاة على مسمعنا جميعاً. كنت صغيرة، أمرّ بين قدميه اللّتين تستقيمان على سجّادة الله، ويداه متهدلتان إلى الأسفل.
هكذا عرفت الصّلاة وهكذا صلّيتها لاحقاً، ولكنّني لم أضف لها ألحاناً مثله. هو لا يملك صوتاً جميلاً، هكذا فكّرت، بل يعرف كيف يقفّي في المغنى وفي التّلاوة وفي التّجويد على الرّغم أنّه لم يتعلّم التّجويد يوماً. كنت أمرّ بينه وبين صلاته مذهولة بإنشاده. وأحياناً أدوس عليها خطأً بحذائي المنزليّ الخفيف.
لم يكن يصرخ عليّ في تلك اللّحظة، لم يتذمّر حتّى من دلعي الزّائد. الآن توقّف والدي عن الصّلاة، المرّة الوحيدة التي رأيته يصلّي مغلقاً الباب عليه كانت بعد الاعتداءات الإسرائيليّة على غزّة العام الفائت. انتبهت نهارها أنّه لم يعد يقفّي، لم يعد يطيل كلمة "الضّالين" ويشدّ على النّون. في ذلك النّهار سألته عن الأيام الخوالي تلك، استعجب من ذلك وبدا غير عالمٍ تماماً بأنّه كان يلحّن الصّلاة إلى هذا الحدّ. عرفت وقتها أنّ والدي لم يمارس الصّلاة في كلّ مراحلها بل قفز مباشرةً إلى مرحلة الشّجن. لم يعلّمنا ولو لمرّة ما هو الخطأ والصّواب، هو نفسه لم يلتفت إلى ذلك. كان رجلاً كادحاً، يخرج إلى عمله في السّادسة صباحاً ويعود في وقتٍ متأخّر من اللّيل، حين نكون أنا وإخوتي في وسط حصّتنا من النّوم.
لاحقاً، عندما كبرت أكثر، دست على سجادة صلاة أمّي، فكبَّرَت بصوت مرتفع. أرعبتني. الله أكبر. الخطأ الوحيد الذي لم يفعله أبي أنّه لم يؤدّبنا، كان يدلّلنا ويعارض والدتي دائماً في تربيتها، ولا يزال يفعل ذلك حتّى اليوم. لذلك لم يعد يصلّي، ربما العنصر الأساس في علاقته مع الله لطالما كان مفقوداً: الخوف.
الله هوأن ترتعب، هو "وإِذَا البِحَارُ سُجِّرَت"، هو أن تقضي حياتك قلقاً من سعير النار، وأن ترهب الموت لأنّك ربّما تحترق. الله هو أن تخاف، أن تتأدّب في خوفك... مجاز
حي الجلاجيق
وُلدت في بيت صغير في حارة صيدا في حيّ الحوطة. يطلقون عليه اسم "حي الجلاجيق"، وما يزال يتلصق به هذا الإسم حتّى اليوم كونه حيّاً فقيراً، وسكّانه يتوارثون بيوته عبر الأجيال من حفيد إلى حفيد، رغم مساحة البيوت الضّيّقة والتصاقها ببعضها البعض. وأحياناً تتوارثه أجيال لا تعرف بعضها.
من بين كلّ العشوائيات التي رأيتها، امتداداً من الشّام إلى بيروت، هذا الحيّ هو الأكثر عشوائيّة في بيوته. ماذا يعني أن تبني منزلاً وتصمّم له حمّاماً في الخارج، في الشّارع تماماً؟ من أرشيف جدّتي ليلى أنّه كان بيتاً صغيراً لعائلة صغيرة أصولها ليست من صيدا. سكنوا في البيت بعد أن كان مهجوراً لسنوات، وهو ملك لبيت عزّالدّين. تركه أصحابه في التّسعينيات بعد الحرب الأهليّة، ولم نعد نعرف عنهم شيئاً. أمّا السّاكنون الجدد فهم من بيت بركات. في ربيع 2007 استيقظت أم علي بركات على صوت حفيف ما أمام البيت، آتٍ من صوب الحمّام الّذي يبدو لوهلة حمّاماً أمريكيّاً عموميّاً. يبدو دائماً كانزياحٍ في الحيّ، دخيل على المشهد الفقير. وجدَت صبيّاً وصبيّة في أوائل عمرهما، يمارسان الجنس الفموي.
ردّة فعلها الأولى - كما سردتها للحارة- لم تكن متوقّعة. أغلقت باب الحمام وبدأت تضربه وتهزّه بيديها حتّى استفاق أهل الحيّ على صوت الهزهزة والتّخبيط. تقول واصفةً تلك اللّحظة بأنّها لحظة لا وعي، ذُهلَت من المشهد الحميم الّذي كانت تفتقده في بيتها مع زوجها الّذي صار في ما بعد من كبار المخاتير في صيدا. لم يتوقّف الخبر عن الانتشار حتّى وصل إلى أبواب الحسينيّة، لم توقفه سوى مخترة أبو علي بركات بعد ثلاثة أعوام على الحدث. حتّى أنّهم ألحقوا الواقعة بعائلة أخرى لا ترتبط بعائلة بركات.
هناك وجوه أحفظها جيّداً من ذاكرة ذلك الحيّ، ما زالت كما هي حتّى اليوم. تسكن في ذات البيوت وتعمل في ذات المهام. أذكر الصّبيّ الذّي يبدو عالقاً في عمره دائماً، لا يكبر شكلاً أبداً ويرتدي نفس الكنزة البيضاء التي كان يرتديها منذ عشر سنوات. لا أعرف مرضه ولكنّني سمعت النّسوة يتحدّثن مرّة أنّ من مثله أعمارهم قصيرة جدّاً، ولكنّهم على الحالين دعوا له بطول العمر.
أفكّر بمن فكّر أنّ الله مخلوق، ولكن الله هو الّذي خلقَ كلمة "خلق"، كيف يُخلّق من شيء هو خلقه؟
رويدة سيّدة مشغرة الأولى، جدّتي التي ماتت صغيرة بسبب السّرطان الذي حصلت عليه عندما كتبوا لها السّحر على ورقة وزرعوها في المنزل. كانت امرأة بيضاء، بشرتها لمّاعة مليئة بالشّامات الصّغار، هذا ما ورّثته لأمّي. عاشرَت مرضها لسبع سنوات، في السّنة السّابعة فقدَت بصرها والقدرة على المشي، وماتت واقفة في بيت جدّي الّذي صار في ما بعد بيتاً لزوجته الجديدة.
لم ترَ المرأة موتها، أحسَّت به فقط. لم ترَ موتها، ولا الغرفة التي فارقت فيها الرّوح ولا البيت الّذي سكنته امرأة من بعدها. هذا فنّ الموت المريب. بعدما كبرت عرفت رويدة أكثر ولاحظت ملامحي التي صارت تشبه ملامحها. ملامح مشغريّة مجبولة بهذه الأرض الصّلبة. ورثت هوسها بالنّظافة، وشخصيّتها التي كانت سيّدة حتّى على نفسها، ولبست الحجاب كما كانت ترتديه. صرت أذكّر والدتي بأمّها كثيراً، أؤلمها بذلك، ولعلّني آنستها أيضاً، علّ الله يقتل ناسه ليخلق بشراً آخرين على هيئاتهم كي يظلوا محيطين بأحبّائهم دوماً، كمن يعزّيهم في مأساتهم.
كنت الفراشة البيضاء الزّائرة، أنا أمّ أمّي، هذا ما فكّرت به. أمّي التي علّمتني الخوف، وعلّمتني أن أتحرّر منه. كلّ ذلك بدأ من صرخة غضب واحدة، لحظة التّأدّب الأولى. فيما بعد اكتشفت الخوف البشريّ أكثر من الأحذية.
مسلسلات أم معين
أحذية المزارعين، والأحذية الجلديّة الواسعة، كنت أراقبها في أقدام عمّال المسلخة في حارة صيدا كلّما ذهبت لأحضر اللّحمة الطّريّة إلى البيت. كانت توصّيني أن أحضرها من ملحمة الشّاميّة في حارّة صيدا. تعطيني التّعليمات الدقيقة والجمل التي عليّ أن أنطق بها بسبب خجلي وانطوائيّتي المفرطة، وتسألني: "فهمتِ؟". أهزّ برأسي وأعبر الحيّ الضّيّق القديم.
تقف أم معين وهي تشاهد أفلامها على التّلفاز في باحتها المكشوفة. كان لأم معين اسم آخر: "أم المسلسلات". "العشق الممنوع"، "الأوراق المتساقطة"، "نور ومهنّد". كانت تشاهد المسلسلات التّركيّة بكثرة، تحفظها تفصيلاً. مررت بجانبها، سلّمت عليها ولكنّها لم تعرني انتباهاً، أظنّ أنّها لم تتعرّف عليّ.
كانت "أم معين" بالنّسبة لي امرأة مركّبة، كان ذلك بسبب اسمها. لم أكن أفهم فكرة أنّ كلمة أم معين تعني أنّها أم لولدٍ اسمه معين. كنت أظنّ من شدّة الطّلاقة التي يُذكر بها اسمها بين العامّة أنّه اسم مركّب. عرفتها ولكنّني لم أعرف معيناً. مررت وكانت تضرب الشّاشة الصّغيرة بشحاطتها البلاستيك البيضاء التي أحضرتها معها من الحجّ. تلصّصت على ما كانت تشاهد، فرأيت إحدى القنوات تعرض أحداث معركة وادي الحجير في 2006. كانت تضرب الجنود الإسرائيليّين.
علّ الله يقتل ناسه ليخلق بشراً آخرين على هيئاتهم كي يظلوا محيطين بأحبّائهم دوماً، كمن يعزّيهم في مأساتهم... مجاز
ما زالت تحتفظ أم معين بأحذيتها التي لم تعد ترتديها. لم تعد تعرف أو تميّز فعل ارتداء الأحذية، بدأت تنسى أسس فعل الحياة. لكنّها استخدمَتها لأغراض أخرى، أغراض تهمّها. ومع الوقت ظلّت تحتفظ بها، ولكن بدون طاقةٍ لرميها أو لضرب الذّاكرة بها، صارت تشاهد المسلسلات هامدةً، لا شيء يستفزّها. حين أراها الآن أفكّر بمن خلق الكلمات. من قال إنّ الأحرف هي الأحرف، وأنّ الواو صوتها "واو" مليء بالضّم. أفكّر بمن قال إنّ الحذاء اسمه "حذاء" وأنّ الكون خُلقَ من انفجار عظيم لطبيعة عظيمة. أفكّر بمن فكّر أنّ الله مخلوق، ولكن الله هو الّذي خلقَ كلمة "خلق"، كيف يُخلّق من شيء هو خلقه؟
أفكّر بكلّ ما نست أم معين. نست فعل الشّغف، الغضب، التّذكّر، الفطرة، أداء المصطلحات، لكن إلّا الخوف. ما زالت تذكّرنا بمعين الّذي تركته في فلسطين بعد النّكبة. حين نسألها عنه تقول إنّها نسته وتضحك، كما تنسى حجاب رأسها، وتقول إنّ الجميع مثل أولادها. تضحك من شدّة خوفها، أين تركَت ابنها؟ هل مازال فلسطينيّاً أم جنّدوه لصالحهم؟ لقد نست كلّ شيء من فطرة الحياة، إلّا الخوف على فلسطينيّة طفلها المنسيّ قصداً.
وأكمل المشي إلى المسلخ، أركّز على أقدامهم. ومن شدّة لهوي لا أعير انتباهاً لما أوصتني أمّي. أقف بانتظار اللّحمة كي تتجهّز لي، أقف متأمّلة الأحذية. انقسمت الأحذية بين صفراء وسوداء. "المعلّم" كما كانوا ينادونه هناك، يرتدي الجزمة السّوداء الطّويلة، يبدو جلدها أصلياً، أمّا العمّال لديه فأحذيتهم صفراء، ومن شدّة شفافيّتها ورقّتها تستطيع رؤية أقدامهم العارية داخلها.
كنت أفكّر بأنّها أحذية خارقة، يدوسون بها في دماء الحيوان المذبوح على الأرض، وفي المياه هنا وهناك، وكأنّ كلّ شيء كان حُرّاً، مثل المشي في حقلٍ واسع وتحسّس التّربة المبلّلة كما خلقها ربّها.
كان مشهداً قاسياً، والرّائحة الممتزجة بين اللّحمة والدّماء كانت أقسى. وأمرّ بعدها على "بيت التّموين"، أحمل معي ربطة خبز كبيرة وأمشي إلى البيت عائدةً، أفكّر بالخوف الّذي تصيبني به هذه المَشاهد. عندما كنت أزور بيت جدّتي، كنت الوحيدة التي تخلع حذاءها على الباب. أركض إلى منزلها، وأثناء الرّكض أخلعه عن قدميّ بعفويّة. كانت تعرف جدّتي أنّني أرتاح هكذا، رغم أنّها، بعكس كلّ الجدّات، كانت تكره أن نصفّ لها الأحذية على باب البيت. اليوم، صار كلّ شيء كبيراً. نحن صرنا كباراً، ومقاسات أقدامنا صارت أكبر.
جدتي ليلى
"كبرنا"، هكذا أتحجّج حين تسألني عن حذائي الّذي دخلت به إلى منزلها، دلالة على استعجالي. تعرف أنّ كلّ شيء في هذا العمر صار سريعاً. كبرنا، وصرنا أسرع. صرنا نرمي العناقات سريعاً ونستبدل القبل الثّلاث بقبلة واحدة ونمشي، هذا يكفي. صارت تعرف أنّني أحمل المسؤوليّات فوق كتفيّ، أكبر من عمري الصّغير بكثير وتبكي. تبكي هذه الجدّة الكبيرة التي أبعدت عنّي التّعب بعينيها. اليوم صار نظرها ضعيفاً، لا عيون لتخيّط لي الراحة بها، ولا طاقة كي تشلح عنّي حذائي حين أصل إلى باب البيت.
يحكي أبي عن الاحتلال الإسرائيليّ كما يحكي كبار قادة المقاومة معهم، بتصغير يكاد يرتقي إلى الاختفاء
لقد أحببت الأحذية، وأحببت كيف يحمينا هذا الاختراع البسيط من آلام مبرحة، وأحببت جدّتي ليلى التي آلمتها أيّامي السّريعة. في ما بعد لم يبقَ هناك بيت. خرجَت ليلى من منزلها بعد أن انتهت من تزويج أبنائها. هجرته وهي توصي المستأجرين الجدد بالانتباه إلى مدخل البيت وإلى كبسة الجرس التي كتبَت عليها بخطّ يدها المتعرّج اسم جدّي "مصطفى". خرجَت إلى منزلنا حاملة زرّيعتها على يدها، بدَت مثل ماتيلدا ضائعة في المدينة. تتعكّز على خسائرها تاركة المنزل لوحدته وللمستأجرين الجدد.
بينما أفتّش بين أغراضها كي أنبش الذّكريات لم أجد سوى صورة تذكار لجدّي وفرشاة شعرها القديمة ودواء السّكّري والنّظارات التي تساعدها على قراءة القرآن. وضعتهم في كيس كبير منفرد. هذه أغراضها، هذا كلّ ما صارت تملك. في كلّ شهرٍ يتّصل بها المستأجر ويشكو من تشقّق جدران البيت المستمرّ، مع أنّ الطّقس صيف والشّمس تعتدي على البيت من كلّ جوانبه. الدّار مستوحش، فقد رحل أهله. تقول ليلى.
تحكي ليلى عن الحرب بخوف كبير، تحكي وكأنّ الحرب لاتزال حيّةً وقائمة حتّى اليوم. عاشت ليلى الحرب في الشّيّاح، ولحتميّة القدر عدت بعد عشرين عاماً لأسكن أنا في الشّيّاح، أحمل تاريخها في ذاكرتي. جدّتي امرأة جبانة على الرّغم من جبروتها ولكن الحرب كسرَتها. لم يكسرها موت أمّها بين يديها، ولا تسلّط إخوتها عليها، ولا من سلب منها حقّها في الميراث. لم يكسرها موت زوجها في حادث سيرٍ بسيط جدّاً، ولا تشرّدها في غرفة صغيرة مع خمسة أطفال. ولكن الحرب فعلَت.
الله هو أن تخاف، أن تتأدّب في خوفك. غنٍّ له الصّلاة، اصنع لها ألحاناً، وصلِّ لغزّة سرّاً وأنت تردّ الباب على من قد يلحظون خوفك، ولا تصالح. لا تصالح... مجاز
وهي ليست الحرب بذاتها بل ردّة فعل الخوف الطّبيعيّ. ماتزال تعاني من الآثار الجسديّة لخوفها حتّى اليوم. القولون والضّغط والقلق الدّائم. في الشّياح إفراط في الذّكور، لا نساء ليمشين على الأرصفة ليلاً ويطلقن ضحكات قديمة عالية وينفخن دخان سجائر أنثويّة رفيعة. في الشّيّاح مشهد قديم واحد لليلى نفسها التي هدّها الخوف، وهي تجلس في بيتها في شارع عبد الكريم الخليل مشرّعة باب البيت للمارّة، واضعةً صورة لها في صباها وهي تقف بين أحجار الأرض التي اشترتها مع جدّي في حومين. ملامحها جادّة تماماً، مرتديةً كولون ضيّقاً وهي تدخّن سيجارة عريضة. عريضة كأصابع النّساء الوسطى المرفوعة.
لم ترَ المرأة موتها، أحسَّت به فقط. لم ترَ موتها، ولا الغرفة التي فارقت فيها الرّوح ولا البيت الّذي سكنته امرأة من بعدها. هذا فنّ الموت المريب
لم يبقَ من ليلى إلّا تلك الصّورة، ما بقي منها اليوم هو ما تنبّهني إليه دائماً. لم تعترض على مكان سكني في الشّيّاح، لم تذكر بلطجيّة الحيّ والبيوت العشوائيّة والأسلحة المتفلّتة. لم تتذمّر من الحشرات التي تأكل المكان بلحم ناسه وقطط شوارعه، كما أنّها لم تبدِ خوفاً ولو كان مستتراً من العصابة التي تشكّلَت حديثاً في المنطقة. لم تعترض ليلى على مكان سكني في الشّياح، إلّا على طول الدَّرَج. كلّما تذكّرت عدد درجات الطّوابق العشرة ينتفض شيء ما في ملامحها. أعرف أنّها تفكّر في لحظتها كيف سأهرب إن عادت الحرب كما هرَبَت هي في وقت أقلّ، على درجٍ بهذا الطّول. وتأمرني أن أغادر المكان بسرعة.
خوف أبي القديم
في 17 تشرين خرَجَ شعار "فليسقط خوفنا"، كما في ثورة 25 يناير "لم يبقَ إلّا عدوٌّ واحد فلنهزمه، ألا وهو الخوف". من بعد هذا الشّعار انتشرت صور للمتظاهرين علانيّةً حاملين شعارات أخرى وكتبوا عليها "كسروا خوفهم"، ولكن هل يمكن أن ينتهي الخوف تماماً، وهل من ماتوا فاتحين صدورهم للرّصاص الحيّ ماتوا متغلّبين على خوفهم تماماً؟ هؤلاء انتصروا شعاراتٍ وكلاماً.
يحكي أبي عن الاحتلال الإسرائيليّ كما يحكي كبار قادة المقاومة معهم، بتصغير يكاد يرتقي إلى الاختفاء. مشهد واحد أيضاً، الخميني عابس دائماً، ملامحه لا تستريح. تلك واجهته لمن انشغلوا في مراقبته دائماً، وهو يعرفهم. ليس نحن ولا العامّة ولا الشّعوب ولا رفاقه من القادة، بل الأعداء الّذين مسكوا الشّرق من ابتسامة ساهية. الخميني عابس دائماً كيلا يريح خوف العدوّ ولو للحظةٍ.
يحكي أبي وكأنّه ينتشل خوفنا الّذي لم ينبت أصلاً بداخلنا حتّى يصير ظاهراً. يمنع خوفنا من الولادة، لذلك حاول ألا يحكي لنا عنه أبداً. في عام 2006 نصب لي في بيتنا في حيّ الحوطة أرجوحةَ حمراء. مشهد واحد أيضاً، صوت قادم من البعيد لكنّه يقترب. صوت الغارة الإسرائيليّة تقترب لكي تقطع من فوق بيتنا. كنت جالسة على الأرجوحة، سمعت الصّوت ولم أعرف ماذا أفعل أو ماذا أحسُّ. فنظرت إليه كمن تحاول إلتقاط شعورٍ ما، ملامحه وهو يركض نحوي من البعيد ظلّت باردة على حالها. لكنّه نَشَلني من الأرجوحة كمن ينتشل غضباً ورعباً عقد فضّة من العنق. علقت قدمي في الأرجوحة، وفي تلك اللّحظة بالتّحديد رأيت ارتجاف يديه الّذي لا يمكن أن تلتقطه طائرة. شعرت برغبة عارمة بالبكاء، غصصت. وبلعت غصّتي حتّى كدت أختنق بها.
عندما رأيت خوف أبي المكبوت فهمت، تلذّذت بالخوف الحقيقيّ للمرّة الأولى وفهمت أنّ أبي العبد الخائف دائماً، هو الّذي كبرّنا بشكلٍ سليم، ولكنّني ابتلعت خوفي مثله حتّى لا تراني الطّائرة العابرة. ودمع الخوف لا يريح الخوف بداخلك على عكس كلّ المشاعر الباقية، بل يشعله.
الله هو أن تخاف، أن تتأدّب في خوفك. ولكن لا تظهر الخوف حتّى أمامه. غنٍّ له الصّلاة، اصنع لها ألحاناً، وصلِّ لغزّة سرّاً وأنت تردّ الباب على من قد يلحظون خوفك، ولا تصالح. لا تصالح.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


