لستُ روائياً ولم أكتب روايةً قط. كنتُ أحاول مراراً أن أصف يومنا الممزوج بالخيال في حياتنا الاستثنائية في مخيم نهر البارد/ شمال لبنان. ماذا يعني لنا المخيم؟ وما هي رمزيّته؟
أحاول أن ألتقط التفاصيل المثيرة للدهشة دائماً، من نكبة الكهرباء إلى نكبة الغلاء، حتى حرب 2007 في المخيم. حاولت مراراً أن أجسدها في قالب روائي ولم أستطع. أكتفي دائماً بالقصائد والنصوص التي تنحاز إلى رصدِ الومضة الإبداعية وليس سرد التفاصيل.
قرأتُ روايات كثيرة للكاتب الكولمبي، غابرييل غارسيا ماركيز، واكتشفت الواقعية السحرية في أسلوبه، ما ألهمني في الكتابة عن واقعنا في مخيّمات. شعرتُ بأنّ روايته قوية بجميع تفاصيلها ومشاهدها وأبطالها. شعرتُ بأنّها هي نحن، نحن أبطالها في المخيم، فبدأت أعيش روايتي قبل كتابتها، كالذي يحلم وهو مستيقظ، أو كالذي يقيم داخل روايته.
أحاول أن ألتقط التفاصيل المثيرة للدهشة دائماً، من نكبة الكهرباء إلى نكبة الغلاء، حتى حرب 2007 في المخيم. حاولت مراراً أن أجسدها في قالب روائي ولم أستطع. أكتفي دائماً بالقصائد والنصوص التي تنحاز إلى رصدِ الومضة الإبداعية وليس سرد التفاصيل
وحدي أتمشى على شاطئ البحر المحاذي للمخيم في منطقة الكورنيش "العبدة" الشمالي المؤدي إلى الحدود السورية. أنظر إلى البحر الذي يعانق المخيم من جهتين، حيث أنابيب الصرف الصحي تصب في البحر، والأطفال يلعبون على الصخور التي تلامس حيطان البيوت القديمة للحي البحري.
حين أرى هذا المشهد، أتذكّرُ أنّي رأيت مشهداً يشبه هذا المشهد من قبل. أحاول استرجاعه بينما أتمشى، فأتذكر أنّي كنت قد كتبتهُ قبل يومين في أحد النصوص. وعندما أدخل شارعاً يؤدّي إلى الحي القديم في المخيم، وأرى على الحيطان أقوال الروائيين والشعراء الفلسطينيين، ينتابني الشعور ذاته بأنّنا نعيش في الرواية الواقعية المكتوبة على الحيطان بكل تفاصيلها.
وحين أستيقظ صباحاً وأشرب القهوة على وقع الضجيج الآتي من الشارع المقابل، وأفتحُ النافذة على البيوت المعلبة بعضها فوق بعض، والصراخ الذي لا جهة له، تخطر على بالي مقدمة النص الشعري الذي كنت أكتبه وأخفيه بحجة أنّهُ لم يكتمل بعد. ينتابني شعورٌ مسبقٌ بأنّي أنوي الاستمرار في المشهد الواقعي كي أكمل المشهد المتخيل مكتوباً، فهل نحن فعلاً نعيش فيما نكتب؟
رواية الفلسطيني الطويلة لم تنته بعد، من يوميات منفاه إلى أصغر التفاصيل في حياته، من فنجان قهوته الصباحي إلى لهاثه وراء لقمة العيش. لا خيار أمام اللاجئ سوى التدريب الدائم على سرد ما يعيش لكي يبقى في ذاكرة الأجيال القادمة. لكل جيل يوميات مختلفة في الرواية الواحدة، ولكل جيل رحلته الخاصة التي يمرّ بها في المخيم، من معاناة ومغامرات ومواقف، والسؤال الدائم عن الهوية، أو الإحساس الدائم باللجوء.
أنا من الجيل الثالث الذي جرّب الكتابة مراراً عن الواقع الملموس في المخيم، وجرّبت أيضاً الواقعية السحرية في الكتابة، وكأنّي أتخيل نفسي ماركيز في المخيم. كنتُ أحلم دائماً بأن أكون ماركيز في المخيم، وأعيش تراجيديا الرواية الكاملة، وألتقي أبطالي في الواقع والخيال
أنا من الجيل الثالث الذي جرّب الكتابة مراراً عن الواقع الملموس في المخيم، وجرّبت أيضاً الواقعية السحرية في الكتابة، وكأنّي أتخيل نفسي ماركيز في المخيم. كنتُ أحلم دائماً بأن أكون ماركيز في المخيم، وأعيش تراجيديا الرواية الكاملة، وألتقي أبطالي في الواقع والخيال.
حين كتبت عن "المرأة التي صرخت في الشارع من شدّة الفقر والضيق"، ثمّ وضعتُ القلم، وخرجت في صباح اليوم التالي من البيت، ووجدتُ امرأة تصرخ بسبب ضيق الحال بين أفراد عائلتها في شارع بالحي القديم، تذكرت أنّي كتبت هذا المشهد ليلاً. هذا يعني أنّنا شعبٌ يقيم في روايته، أو رواية تقيم في شعبها، وقلت لنفسي: "ربما يجسد هذا المقطع ما نعيشهُ في مرحلة من مراحل نكبتنا".
بعد فترة، رأيتُ فتاة في العشرين من عمرها تسأل امرأة في الثمانين عن حياتها في فلسطين قبل الـ1948، "كيف كانت الحياة في قريتها؟". وكانت المرأة تجيبها بطلاقة مستذكرةً التفاصيل المملة، ثمّ سألت المرأة الفتاة: "لماذا تريدين معرفة كل هذه التفاصيل؟" فأجابتها الفتاة بعفويةٍ: "لأنّ هذه الذاكرة يجب أن تعيش وأن تظل حية من أجل الأجيال القادمة".
عدتُ إلى نصّي الذي يحتوي على المشهد ذاته وأكملت كتابته بعد أن اتضحت معالمه في الواقع، وتأكدت أنّ هذه الرواية الواقعية هي فيلم طويل عن حياة أناس يعيشون في روايتهم، عليهم فقط أن يعيشوها بصدقيّة المشاعر.
الرواية الحقيقية هي أنْ تصافح أبطال روايتك في الواقع، وأن تلتقط التفاصيل لتكتبها على الورق، وبعد فترةٍ تصطدم بها في الواقع.
قال لي صديقي يوماً إنّ روايته تستند إلى ما قرأه من أوراق ووثائق وصلت إليه من فلسطين.فكتب عن بطله "علوان". وبعد فترةٍ، وهو في مجلس عزاء في صيدا / جنوب لبنان، صافحه رجل بقوة، فاستغرب ذلك وكأنّه يعرفه منذ زمن، وسألهُ: من تكون؟
أجاب: أنا "علوان" بطل روايتك، هل تعرفني؟
فصافحه صديقي بشدة، وكأنّه يسألهُ: متى خرجت من الرواية؟
الرواية الحقيقية هي أنْ تصافح أبطال روايتك في الواقع، وأن تلتقط التفاصيل لتكتبها على الورق، وبعد فترةٍ تصطدم بها في الواقع. وإن دلّت على شيءٍ، فإنّها تدلُّ على قوّة التشابه بين ما نعيشه وما نكتبهُ. وكما يقولون دائماً: "المعركة اليوم هي معركة روايات بين ذاكرة مكتوبة بخط اليد وبين ذاكرة محفورة حفراً في العقول والأذهان"، أي هي الذاكرة الملموسة التي لا فرق بين كتابتها وبين وجودها معك في الواقع.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






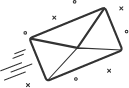
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومينتعليقا على ماذكره بالمنشور فإن لدولة الإمارات وأذكر منها دبي بالتحديد لديها منظومة أحترام كبار...
مستخدم مجهول -
منذ 5 أيامالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا
Jong Lona -
منذ 5 أيامأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...
ghdr brhm -
منذ 6 أيام❤️❤️
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ أسبوعجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ أسبوعمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.