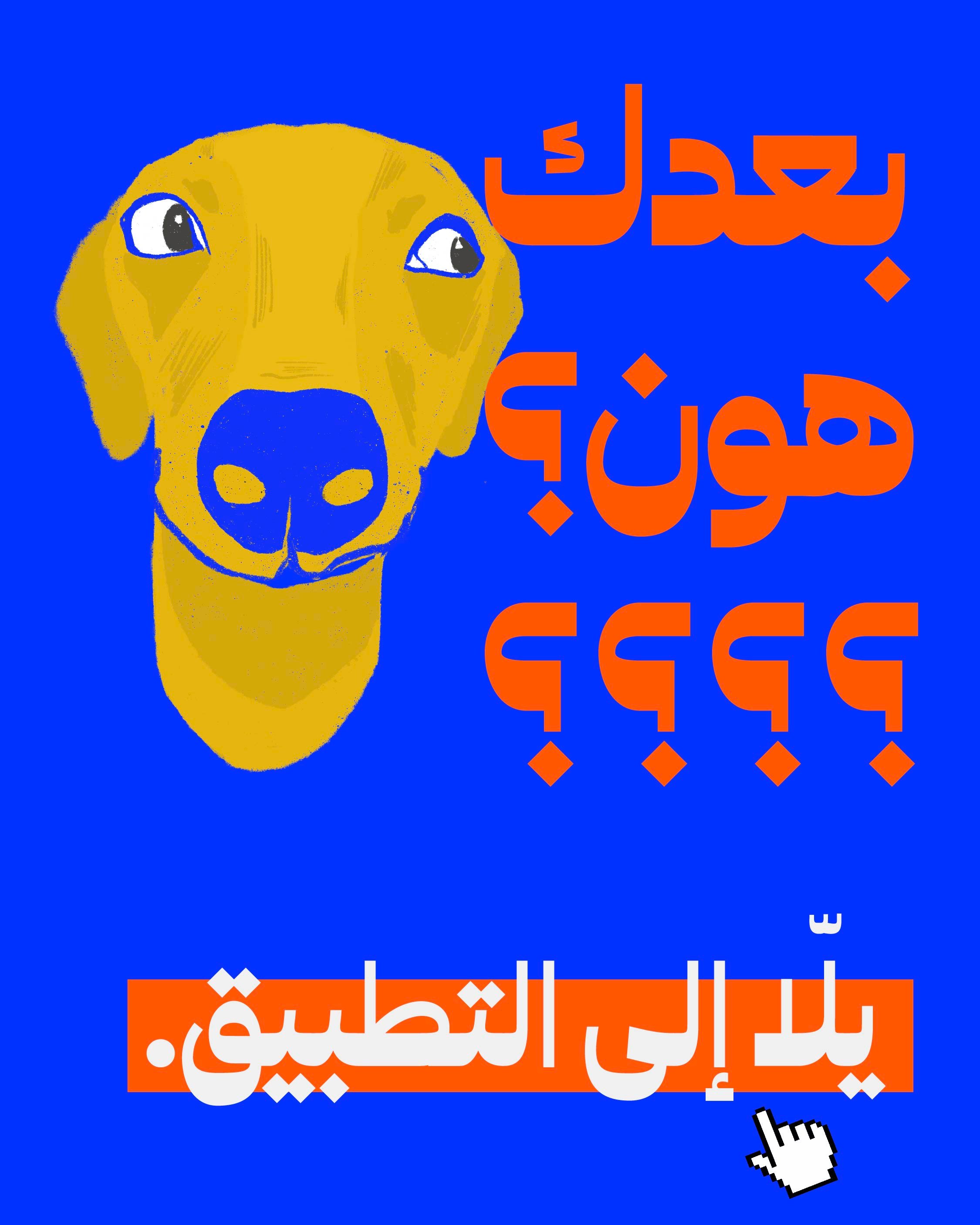منذ أن ظهر المغول على أطراف العالم الإسلامي في القرن السابع الهجري، مثّلوا في الوعي العربي والإسلامي نقيضاً للمدنية والاستقرار. ارتبط اسمهم بالاجتياح والخراب وسقوط العاصمة العباسية بغداد في سنة 656هـ، وبسلسلة طويلة من المذابح التي خلّفت أثراً نفسياً بالغاً في المخيال الإسلامي الجمعي. ولكن، وبعد أقل من نصف قرن على تلك الكارثة، شهدت خريطة القوة تحولاً غير متوقع، وذلك بعدما اعتنق الإيلْخان (الحاكم/السلطان) المغولي غازان خان الإسلامَ، لتتحول الدولة المغولية الإيلخانية في فارس والعراق إلى دولة ذات هوية سياسية ودينية إسلامية واضحة.
في الواقع، لم يكن هذا التحول حدثاً روحياً فحسب، بل كان في حقيقته نقطةَ تحولٍ مفصلية أعادت صياغة علاقة المغول بالعالم الإسلامي من جهة، وبالمماليك في مصر والشام من جهة أخرى. فإسلام غازان جاء في سياق سياسي تنافسي، ولم يكن مجرد تحول وجداني أو شخصي. ولذا، فإن دراسة تلك اللحظة تكشف عن تفاعل معقد بين الدين، والسلطة، والشرعية في الشرق الإسلامي الوسيط.
من تيموجين إلى غازان خان
شكّل ظهور المغول في سهول منغوليا خلال القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري) نقطة تحوّل كبرى في تاريخ آسيا والعالم الإسلامي. ففي سنة 1206م تمكّن تيموجين من توحيد القبائل المتناثرة تحت رايته، واتخذ لقب جنكيز خان، أي "القائد الأعظم". انطلقت جيوش جنكيز خان في سلسلة من الحملات المدمّرة، اعتمدت على التنظيم العسكري الدقيق، والانضباط الصارم، والاستفادة من سرعة الخيل والرماة المهرة. خلال سنوات قليلة، اجتاح المغول الممالك المحيطة بهم، فأسقطوا ممالك الشمال الصيني، ثم توجّهوا نحو آسيا الوسطى حيث دمّروا خوارزم، وقضوا على واحدة من أهم دول العالم الإسلامي آنذاك.
أثارت الفظائع التي ارتكبها المغول في مَرْو وبَلْخ ونيسابور والرَّي حالة من الذعر الثقافي والحضاري. فقد تعاملت المصادر الإسلامية مع الحدث بوصفه نكبة كونية، ورأت أن ما جرى كان "عقاباً إلهياً" لحالة الانقسام والضعف التي أصابت ديار الإسلام. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن الدولة المغولية لم تكن مجرد قوة تخريبية؛ فقد أظهرت قدرة لافتة على الاستيعاب الإداري، فاستعانت بخبرات الإيرانيين والصينيين في إدارة الأقاليم، وسمحت باستمرار النخب الدينية والعلمية، طالما أقرت بالسلطة العليا للخان.
لم يكن إسلام غازان نهاية عصر المغول المغيرين، بل بداية صراع جديد أشد تعقيداً، حين أصبح الخصم يرتدي عباءة الدين ذاته الذي يدّعي الدفاع عنه
بعد موت جنكيز خان في سنة 1227م، توزعت الإمبراطورية بين أبنائه وأحفاده، فظهرت العديد من الدول ومنها القبيلة الذهبية في سهول روسيا، والدولة الجغتائية في آسيا الوسطى، فضلاً عن أسرة يوان التي مدت نفوذها على مساحات واسعة من الصين. ورغم وحدة الدم، فقد دخلت هذه الكيانات في صراعات متكررة، وتباينت مواقفها من العالم الإسلامي. ففي حين استمرت بعض الفروع في سياسة العدوان، ظهرت لدى بعضها الآخر نزعات تدريجية نحو التفاهم أو الاستفادة من الإطار الحضاري الإسلامي.
في خمسينيات القرن الثالث عشر الميلادي، أسّس حفيد جنكيز خان، هولاكو بن تولوي الدولة الإيلخانية في إيران والعراق بعد حملته العسكرية المظفرة التي أسقط فيها دولة الإسماعيلية النزارية في أَلَموت الواقعة شمال غرب إيران، وبعد اجتياح بغداد في سنة 1258م.
اتسمت بدايات الحكم الإيلخاني بسياسة السيطرة العسكرية المباشرة والاعتماد على النخب الإيرانية في الإدارة والجباية، بينما ظلّ الإيلخانات على دياناتهم البوذية والشامانية؛ الأمر الذي خلق توتراً مستمراً بينهم وبين المجتمعات الإسلامية الخاضعة لهم.
عند نهاية القرن السابع الهجري، كان المغول في إيران في وضع مضطرب. فقد تنازع أمراء البيت الإيلخاني في ما بينهم، وانهارت الروابط المركزية التي أسسها هولاكو. وكانت القبائل، والوزراء، والقادة العسكريون يسحبون السلطة إلى اتجاهات متناقضة. في هذه الظروف العصيبة ظهر غازان خان، وتمكن في سنين معدودة من توطيد دعائم سلطته والقضاء على جميع منافسيه، وذلك بعدما أعلن اعتناقه للإسلام واتبع سياسة إصلاحية تهدف إلى تثبيت الشرعية وبناء دولة أكثر استقراراً.
لماذا أسلم غازان خان؟
تذكر العديد من المصادر التاريخية أن سنة 694هـ/1295م، قد شهدت اعتناق الأمير غازان بن أرغون الإسلام. وترجح بعض الروايات أن ذلك الحدث قد وقع بعد أن اهتدى الأمير المغولي إلى طريق الحق، وغير اسمه إلى "محمود" على يد الشيخ الشيعي إبراهيم بن محمد الحموي الجويني. وفقاً لتلك الروايات، فإن تحول البوصلة الدينية لغازان قد تم لدوافع شخصية روحية محضة؛ ما يؤكده مثلاً كتاب "ذيل كشف الظنون" لآغا بُزُرك طهراني.
تقدم القراءة المتأنية لبعض المصادر التاريخية صورة مخالفة؛ على سبيل المثال، يذكر الدكتور الباز العريني في كتابه "المغول"، أن السبب الرئيس في إسلام غازان، هو أن أحد الأمراء المغول المسلمين، ويُدعى نوروز، قد وعد غازان بالنصرة والتأييد في رحلة سعيِه للوصول إلى العرش، في حال أن تحول للإسلام. من هنا، فإن تحول غازان خان للإسلام قد وقع، بالأساس، بسبب دوافع براغماتية متعلقة بالوصول إلى السلطة.
هناك وجهة نظر أخرى أشار إليها المؤرخ رشيد الدين الهمذاني -وهو الوزير الأقرب لغازان خان- في كتابه "جامع التواريخ". ذكر الهمذاني نصاً: "ما كان اعتناق السلطان -يقصد غازان خان- للدين إلا نظراً لما رأى من انتظام العالم به، وما يكون للملك من ثبات في ظله".
يمكن تفهم تلك الإشارة بالعودة إلى دراسة خرائط القوى في الشرق الإسلامي في القرن الثالث عشر الميلادي. كان المماليك في القاهرة يمثلون أنفسهم بوصفهم حماة العالم الإسلامي بعد صدِّهم المغولَ في معركة عين جالوت (658هـ). أما المغول الإيلخانيون، الذين حكموا أرضاً ذات أغلبية مسلمة في إيران والعراق، فقد ظلوا في موقع الغريب الحاكم بقوة الحديد والنار. لم يكن الشعب يرى فيهم أبناء البلد، ولا أولياء الشرع. هنا أدرك غازان أن الإسلام هو الطريق الوحيد لتحويل السيطرة المعتمدة على القوة العسكرية إلى سيادة مستقرة تستمد ديمومتها من الشرعية الدينية.
أثر إسلام غازان على المشهد السياسي
ما إن أعلن غازان اعتناق الإسلام سنة 694هـ حتى بدأ في تطوير خطاب سياسي جديد تجاه المماليك. فقد صار الصراع بين الطرفين يُقدَّم في ثوب حرب أهلية داخل الأمة الإسلامية، وليس حرباً بين المسلمين والوثنيين.
ما بين سيوف المماليك ومراسيم الإيلخانيين، أدرك العقل الإسلامي أن الخطر لا يأتي دائماً من خارج الأسوار، بل أحياناً عبر باب الشرعية نفسها
بادر غازان خان إلى استغلال الوضع الجديد قُبيل تحريك جيوشه لغزو بلاد الشام، وذلك عندما بعث برسائل مباشرة إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، يطلب فيها الاعتراف بشرعيته ويعرض التعاون. لكن المماليك رأوا في ذلك محاولة للاستيلاء على مصر والشام تحت شعار إسلامي. في كتابه "السلوك لمعرفة دول الملوك" أورد المؤرخ تقي الدين المقريزي نصاً مهماً تتضح فيه معالم خطة غازان التوسعية في تلك المرحلة: "كتب غازان إلى السلطان الناصر يقول: نحن وإياكم من أمّة محمد، فهلمّوا إلى الطاعة، ولا تكونوا سبب الفتنة".
بطبيعة الحال، رُفض طلب غازان من قِبل السلطات المملوكية، وكان جوابهم أن الشرعية الدينية لا تُكتسب بمجرد الإسلام، وإنما بـحماية الحرمين، وحراسة الثغور، وإقامة العدل. رغم ذلك، عقّد إسلام غازان من تقييم المواجهات العسكرية بين الطرفين المتحاربين؛ إذ لم يعد الخطاب الديني التقليدي قادراً على اختزال الصراع بين المماليك والمغول إلى ثنائية "مسلم/كافر"، وإن كانت المعارك الكبرى، مثل وادي الخزندار (699هـ) وشقحب (702هـ)، قد حافظت على رمزية المماليك كمدافعين عن الشام.
أثر التحول المغولي على الفكر الفقهي والسياسي الإسلامي
وضع إسلام غازان الفقه الإسلامي أمام سؤال بالغ الإحراج: هل يجوز قتال حاكم مسلم إذا كان عدوانه ظالماً؟ وهل يُعامَل المغول بعد إسلامهم كـمسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، أم يُنظر إليهم بوصفهم مسلمين بالاسم فقط؟
في الحقيقة، أعاد هذا السؤال إحياء العديد من الأسئلة الجدلية التي كانت قد ظهرت زمن الفتنة الكبرى والحرب الأهلية التي اندلعت بين المسلمين في القرن الأول الهجري، ولكنه الآن صار يرتبط بدولة كبرى لها جيش ونظام.
في هذا السياق، برز اسم شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني (المتوفى سنة 728هـ) بوصفه الصوتَ الأكثر وضوحاً في معالجة المسألة. تبنى ابن تيمية وجهة النظر المملوكية التي ترفض التفرقة بين الإسلام كرسالة روحية، والشريعة كأوامر لا يمكن التغافل عن تطبيقها. فذكر في إحدى رسائله أن هؤلاء القوم -يقصد المغول- قد دخلوا في الإسلام، ولكنهم ما زالوا يحكمون بغير ما أنزل الله، والقتال معهم إنما هو قتال من يقاتل المسلمين، لا قتال من أجل الدين، وذلك بحسب ما ورد في "الفتاوى الكبرى".
من هنا، وبناءً على رأي ابن تيمية، فإن إسلام غازان لا يُلغي حكم مقاومته إذا كان ظالماً أو معتدياً. وهذه الفكرة ستصبح لاحقاً حجرَ أساس في الفكر السياسي السني الجمعي، وستظهر أشدّ وضوحاً في أدبيات الإصلاح الإسلامي خلال القرن التاسع عشر.
من جهة أخرى، سيتم تطوير تلك الفكرة على يد بعض الجماعات الإسلامية الداعية للخروج على الدولة بالسلاح بدعوى تعطيل العمل بالشريعة في سبعينيات القرن العشرين، وظهر ذلك بأوضح صوره في كتاب "الفريضة الغائبة" لمحمد عبد السلام فرج، والذي استند فيه مؤلفه للفتوى "الماردينية" والتي ناقش فيها ابن تيمية بعض الأحكام الفقهية المرتبطة ببلدة "ماردين" عقب سقوطها بيد المغول.
على الجانب الآخر، استجاب العديد من علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية في إيران والعراق لدعوى إسلام غازان خان. خصوصاً بعدما ظهر ميل خلفاء غازان لاعتناق الإسلام الشيعي على وجه الخصوص. في هذا السياق، احتضن البلاط الإيلخاني العلامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (المتوفى سنة 726هـ)، باعتباره أحد أهم متكلمي الإمامية في تلك الحقبة. وأُتيحت الفرصة للحلّي لنشر أسس وتعاليم المذهب الشيعي على نطاق واسع في شتى أنحاء العراق وإيران. ورمز ذلك للارتباط الوثيق المنعقد بين الدين والسياسة داخل المجتمعات الإسلامية. فإذا كان المماليك قد عملوا على الدمج بين مشروعهم السلطوي والمذهب السني الأرثوذكسي، فإن الإيلخانيين قد ساروا على الدرب ذاته، عندما حاولوا صبغة مشروعهم التوسعي بصبغة دينية شيعية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.