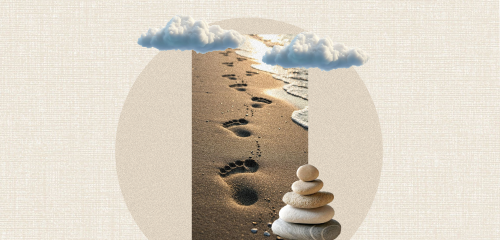ثمة شيء في الضخامة يربكنا. حين نرفع أعيننا إلى برجٍ زجاجيٍّ يتلألأ في سماء المدينة، أو حين نجلس أمام شاشة عملاقة تحيط بنا من كل الجهات، نشعر أنّ أجسادنا تتضاءل فجأةً، وأنّ أنفاسنا تتباطأ، وأنّ المعنى يلوّح من بعيد كأنّه يسكن في الأعلى، لا فينا.
الميغالوس
نحن ورثة حساسية قديمة؛ الإغريق كانوا يسمّون ذلك "الميغالوس"، أي العظيم، وكانوا يرون فيه سموّ النفس وعلوّها. ومنذ ذلك الحين صار الكبير هو اللغة الأولى للقوة والخلود.
الأهرام التي تتحدّى الزمن، والكولوسيوم الذي يحشد الجماهير، والمعابد التي تطعن السماء، والأهرامات نفسها في واحدٍ من معانيها الشاعرية رسالةٌ من فرعون، الذي يعلم في داخله أنّه فان، رسالةٌ تقول إنّه يعلو على الموت.
في الماضي كان السعي وراء الخلود ببناء المعابد العظيمة محاولة للهروب من الفناء. أما اليوم، فلم يعد الأمر مجرد طموح لتجاوز الموت، بل مواجهة مباشرة معه في أكثر صوره قسوةً. فالأخبار المتدفقة بلا توقف تجعلنا نرى تفاصيل الموت يومياً، وكأننا نلمسه عن قرب
وبينما كان التعبير عن العظمة والخلود قديماً ينبع من رغبة إنسانية في تجاوز الفناء، فقد تحوّلت هذه الرغبة في العصر الحديث إلى مواجهة حقيقية مع الموت بكل أبعاده وأشكاله. صرنا أقرب إلى مفهوم الموت وقد لامسه كلٌّ منّا بصورته الأكثر قبحاً من خلال أخبار لا تمرّ ثانيةٌ دون إتاحة معرفة أدقّ تفاصيله.
كل تلك الأسئلة حول الموت تؤكّد عدم تأكُّد المعنى عموماً، ولا سيّما معنى الكبير، خصوصاً بعدما أثبتت الحروب أنّ الضخامة تعني قنابل نوويةً، وجيوشاً جرّارةً، ودروناتٍ صغيرةً تُصيب أهدافاً كبيرةً على كرسيٍّ في بيتٍ مهدّم.
الرأسمالية
أثبت كلّ ذلك أنّه قادرٌ على تدمير المعنى بدلاً من توليده. وعليه، تحوّلت فكرة أنّ الفرد صغيرٌ جداً بينما الإله أو الجماعة أو الملك هم الكبار إلى شيءٍ نسبيٍّ؛ فالضخامة نفسها باتت تؤثّر في ضآلة الفرد ولا تضمن له مكانةً أو معنىً.
وبالرغم من ذلك، لا تزال الرأسمالية تعيد تدوير الفكرة نفسها. الأكبر يعني الأفضل، والأكثر صدقاً، والأكثر حضوراً. يكفي أن تدخل متجراً لتجد العبارة تتكرّر على كل إعلان: "أكبر شاشة"، "أكبر عرض"، و"أكبر تخفيض".
لكن، أيّ معنىً هذا الذي لا يظهر إلّا إذا صعد على أكتاف الضخامة؟ أليس المعنى الحقيقي، إذا كان له وجودٌ أصلاً، يفترض أن يكون قادراً على الظهور حتّى في أصغر زاويةٍ من حياتنا؟
ما زالت الرأسمالية تسوّق الفكرة نفسها: الكبير هو الأفضل. يكفي أن تدخل متجراً لتجد العبارات تلاحقك في كل زاوية: "أكبر شاشة"، "أكبر عرض"، و"أكبر تخفيض".
كان هايدغر يعرف أنّ الوجود لا ينكشف إلّا في فسحة. الكلمة التي استعملها، "Lichtung"، تعني حرفياً فسحةً في الغابة؛ المكان الذي ينفتح فيه الضوء بعدما كان كلّ شيءٍ محجوباً بالأشجار الكثيفة. والفسحة هنا ليست مجرّد فراغ، بل هي الشرط الذي يجعل أيّ ظهورٍ ممكناً. ما من برجٍ شاهقٍ إلّا يحتاج إلى فضاءٍ يحيط به ليظهر، وما من جبلٍ إلّا يستدعي سماءً فوقه ليأخذ معناه.
هذا يعني أنّ الضخامة مدينةٌ دائماً لهشاشة أصغر منها وأضعف، وكأنّ الفضاء المحيط هو ما يبرزها لا هي ذاتها. والمفارقة هنا أنّ ما هو أضخم يحتاج دائماً إلى شيءٍ أصغر، أكثر هشاشةً، يكشفه: الهواء الذي يتخلّل الغابة، والنافذة الصغيرة التي يدخل منها ضوء النهار. كأنّ الوجود يقول لنا: لا تنخدعوا بالقوة الظاهرة؛ فالقوة لا تُرى إلّا بفضل ضعف يسبقها.
فلسفة الأشياء الصغيرة
يفكّر فتحي المسكيني، في كتابه "فلسفة الأشياء الصغيرة" المنشور في 2024، في أنّ الفلسفة لا تبدأ من الأبراج والمعابد، بل من تلك الأشياء التي نتجاوزها عادةً بلا انتباه: علبة كبريتٍ منسيّةٍ في درج، شقّ ضوءٍ يتسلّل من نافذة ضيّقة، وفنجان قهوة يتكرّر كل صباح.
هذه التفاصيل ليست مجرّد هوامش، بل مفاتيح لفهم هشاشتنا. نحن لا نحتاج دائماً إلى ما يبهرنا، بل إلى ما يذكّرنا بأنّنا لسنا خالدين. أنفاسنا نفسها هشّة، وروائح القهوة أو دخان الكبريت أو صرير بابٍ قديم هي التي تحفر في ذاكرتنا شعوراً بوجودنا. الكبير يُخدِّرنا، أمّا الصغير فيوقظنا.
لكنّ الإنسان يفضّل أن يُخدِّر نفسه. نحبّ الأشياء الكبيرة لأنّها، بتعبير جيجيك، "فِتِشيّات" تملأ فراغنا. البرج ليس برجاً فقط، بل قناعٌ يحجب خواءنا الداخلي. الشاشة العملاقة ليست مجرّد تكنولوجيا، بل ستارةٌ تغطّي عجزنا عن الإصغاء إلى الصمت. نحن نحبّ الضخم لأنّه يخدعنا، يجعلنا نعتقد أنّنا أقوياء، وأنّنا نشارك في معنىً أعظم، بينما الحقيقة أنّنا نتشبّث بواجهةٍ ساطعة كي لا نرى هشاشتنا.
يُكمل جيجيك ويقول إنّ الأيديولوجيا تعمل تماماً بهذه الطريقة؛ تخلق لنا موضوعاً كبيراً نُفتن به لكي لا نواجه ضعفنا الحقيقي. ننسحب خلف الأفكار الكبيرة، ونتحدّث عن حياةِ الله وموتِه، برغم أنّ كلاً منّا يملك أسئلته التي قد تكون أكثر خصوصيّةً وآنيّة.
هل الضخامة علامةٌ على التقدّم؟
ماذا عن سؤال الحجم؟ أو بطريقةٍ أخرى: هل الضخامة علامةٌ على التقدّم؟
هنا يدخل شوماخر بفكرته البسيطة. يقول إنّ الحجم سؤالٌ لا مجرّد قياس. في مقالته "A Question of Size" المنشورة في 1975، يذكّرنا بأنّ المجتمعات الحديثة فقدت حسّها الأصيل بالتناسب. نحن نبني مؤسّساتٍ ومصانعَ ومدناً أكبر فأكبر، ثم نتساءل لماذا يزداد شعور الإنسان بالاغتراب.
يذكّرنا فتحي المسكيني في كتابه "فلسفة الأشياء الصغيرة" أن السعادة لا تنبثق من الأبراج والمعابد وحدها، بل من تفاصيل مهملة نمرّ بها بلا انتباه: علبة كبريت منسية في درج، خيط ضوء يتسلل من نافذة ضيقة، أو فنجان قهوة يتكرر كل صباح. هناك يسكن المعنى.
يرى شوماخر أنّ الضخامة ليست علامةً على التقدّم، بل على فقدان المعنى. حين يتضخّم كلّ شيءٍ حول الإنسان يتقلّص هو نفسه، ويصير مجرّد ترس صغير في آلةٍ هائلة. الصغير، عنده، ليس ضعفاً بل مقياساً للإنسانية. كلّ ما يتجاوز قدرة الإنسان على الفهم والمشاركة يصير وحشاً يبتلعه.
المؤسّسات العملاقة، والمدن الضخمة، والشركات العابرة للقارّات، لأنّها تكبر بلا نهايةٍ تفقد إنسانيّتها، والمجتمعات التي تتضخّم تتحوّل إلى آلاتٍ تبتلع الأفراد. كلّها تبدو في النهاية مظاهرَ قوة، لكنّها في الحقيقة علاماتُ عجزٍ لأنّها تلغي الفرد وتستبدله بأرقام وإحصاءات.
في المقابل، ما هو صغيرٌ يتيح مشاركةً حقيقيّةً: مجتمعٌ محلّي، عملٌ يدوي، وعلاقاتٌ عميقةٌ مع مجموعة صغيرة من البشر حولنا. هناك يجد الإنسان نفسه، لا حيث يذوب في ضخامةٍ لا يسيطر عليها وليست له يدٌ فيها. لا نحتاج أن نعيش في أكبر المدن، ولا أن نملك أكبر الشاشات كي نشعر بالمعنى. المعنى يتولّد في المكان الذي يمكننا أن نلمسه ونفهمه ونشارك فيه.
لكن ما الذي يسعدنا؟
إدموند بيرك، قبل شوماخر بقرون، وفي مقالته "تحقيقٌ فلسفيٌّ حول أصل أفكارنا عن السامي والجميل" المنشورة في 1759، فرّق بين نوعين من التجربة الجماليّة عبر مفهومي "السامي" و"الجميل". السامي يدهشنا ويرهبنا، كما يفعل الجبل الشاهق أو البحر الذي لا نرى نهايته. الجميل، في المقابل، يمنحنا ألفةً وطمأنينةً، مثل زهرة صغيرة، وابتسامةِ طفلٍ، وغرفةٍ دافئة.
يرى شوماخر أن الضخامة ليست علامة تقدم، بل دليلاً على ضياع المعنى. فكلما تضخّم العالم من حول الإنسان، تقلّص هو نفسه، وتحوّل إلى ترس صغير في آلة عملاقة.
الضخامة تنتمي إلى السامي؛ تثير خوفاً وانبهاراً في آنٍ واحد، لكنّها تتركنا غرباء عن أنفسنا لأنّ السامي يفوق مخيّلتنا. أمّا الجميل فهو ما يعيدنا إلى البيت، وإلى تفاصيلَ صغيرةٍ تجعلنا نشعر أنّ العالم قريبٌ وودود.
هنا نفهم لماذا قد يكون الصغير أكثر عمقاً من الكبير؛ لأنّه لا يرعبنا ولا يبعدنا عن ذواتنا، بل يضع هشاشتنا في الضوء، ويواجهنا بأنّنا لن نستطيع أن نسيطر ولا أن نشارك غالباً في إنتاج شيءٍ ضخم.
في النهاية، يكشف هذا التوتّر أنّنا نعيش بين قوتين متعارضتين: الانبهار بالضخم والإنصات إلى الصغير. الأبراج الزجاجيّة تظلّ تضيء سماء المدن، والشاشات العملاقة تظلّلنا وتجذب عيوننا. لكن ما يمنحنا حميميّة العيش ليس تلك الأضواء، بل ما يُهمَل عادةً: تفصيلةٌ صغيرة، حركةٌ عابرة، صوتُ خطواتٍ في ممرٍّ ضيّق، ورائحةُ قهوةٍ تتسلّل من المطبخ كلّ صباح. الكبير يبهرنا لكنّه يتركنا غرباء، أمّا الصغير فيعيدنا إلى حدودنا البشريّة القابلة للكسر، والأكثر حقيقيّةً.
ربّما لم نعد بحاجةٍ إلى عبادة الكبير. لم نعد بحاجةٍ إلى أن نرفع رؤوسنا أمام الأبراج كي نشعر أنّنا موجودون. ما نحتاجه هو الإصغاء المتأني إلى تفصيلةٍ صغيرة؛ شيءٍ عابرٍ يضع هشاشتنا في الضوء بلا خجل. الضخامة ستبقى قناعاً، لكنّ الصغير هو الذي يكشف، ببطءٍ وصدق، أنّ وجودنا لا يحتاج إلى معبدٍ شاهقٍ كي يبرّر نفسه، بل إلى فسحةِ ضوءٍ ضيّقةٍ تكفي لأن نقول: نحن هنا
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.