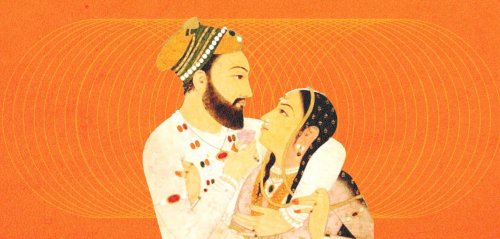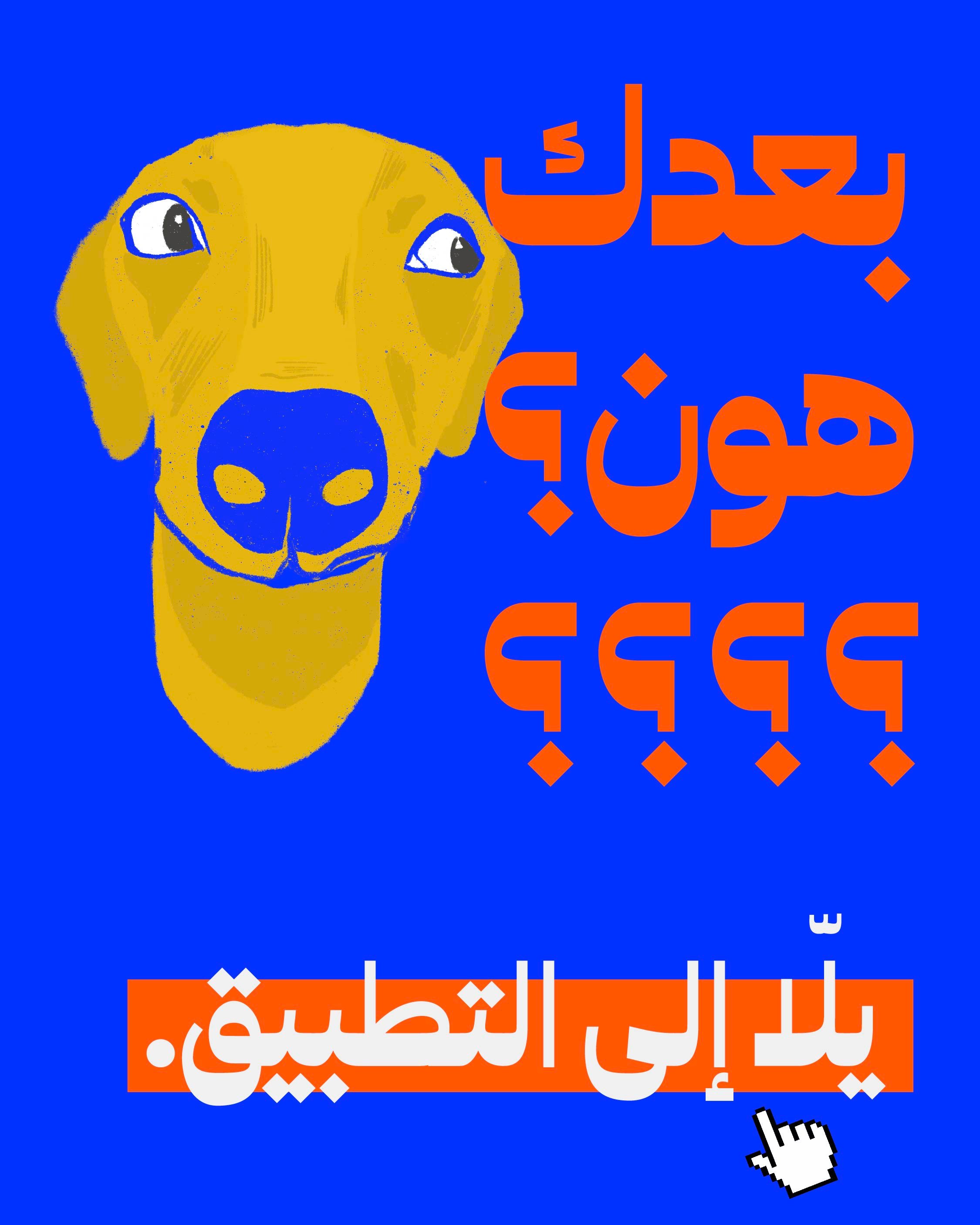حلقة وصل ندر أن تتكرر كثيراً في التاريخ الأندلسي، زيجة جمعت بين المعسكرين المتضادين: المسلمين المتجذرين في البلاد منذ عقود وجيرانهم الألداء الفرنجة الذين يتمنون الخلاص منهم اليوم قبل غداً.
كثيرة هي الزيجات التي جمعت بين العرب والإسبانيات بين طوائف الشعب، لكن قليلة هي التي جرت بين صفوف نخبة الأمراء وغالباً ما كانت بين حاكم مسلم وأميرة إسبانية رغَبتا عائلتاهما في توطيد علاقتهما معاً، لكن الأقل هو العكس، وقد تكون قصتنا هنا هي المثال النادر لها؛ أي أن تقدِم امرأة عربية مسلمة على الفرار من بلاط قومها إلى حُضن مملكة قشتالة (المملكة المسيحية الصاعدة في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية)، حيث تزوجت من أميرها وأنجبا ولداً قاد حروباً ضد المسلمين.
كان مُقدراً لتلك الأميرة العربية أن تعيش حياة وديعة في أحد القصور المُسلمة التي تربت فيها، لكن تعقيدات السياسة حصلت والحرب كان لها رأي آخر، فأجبرتها على التنكّر لأصولها وتقمّص أصول أخرى عاشت بها حيناً وماتت عليها.
في بلاط المعتمد
وفقاً لأرجح الآراء وُلدت الأميرة زائدة (زايدة) بين عامَي 1071م و1073م. تباينت كُتب التاريخ في تبيان الهوية الدقيقة لتلك الأميرة العربية؛ فتارة هي ابنة المعتمد بن عباد ملك إشبيلية أو زوجة ابنه أبي الفتح المأمون، أو أنها أميرة أموية استُقدمت إلى البلاط الإشبيلي لعقد قرانها على أحد شباب النخبة الحاكمة. قيل عنها في الأدبيات الإسبانية إنها كانت فائقة الجمال، عظيمة الثقافة، بارعة في الشعر والأدب.
لم تكن زائدة مجرد أميرة هاربة من خراب مملكة، بل كانت شاهدة على انكسار حضارتين
وفقاً لدراسة "زائدة: ملكة قشتالة وليون" للباحثة الإسبانية المتخصصة في التاريخ الأندلسي، كارمن باناديرو ديلجادو، فإن الأميرة لم تكن عبادية ولا أموية، وإنما تنتمي لأسرة بني هود، وهي أسرة استقرت في بلدة دانية (مدينة ساحلية شمال شرق الأندلس)، إلا أن الأميرة تربّت في سرقسطة. بحسب تلك النظرية فهي قريبة عماد الدولة منذر بن المقتدر المُلقب بالحاجب، الذي كان ملكاً على بلدتَي لاردة ودانية بين عامَي 1081م و1090م.
وتضيف كارمن أنه وفق ترتيبات غير معروفة، وبينما كانت زائدة في سِن الـ15 انتقلت إلى بلاط بني عباد في قرطبة لتتزوّج من ابن المعتمد الرابع الفتح المأمون سنة 1089م تقريباً.
لحظة وصول الأميرة زائدة إلى قرطبة -حينها كانت تتبع إشبيلية إدارياً- كانت المدينة تعيش أوضاعاً قلقة؛ ففي عام 1090م اجتاح المرابطون شبه الجزيرة الإيبيرية بقيادة يوسف بن تاشفين على وقع صدمة سقوط طليطلة في أيدي جيوش ألفونسو السادس، وسرعان ما أخذت ممالك الطوائف تسقط في أيديهم مملكة تلو الأخرى، بدءاً بمملكة غرناطة، حيث اقتُلع الأمير عبد الله بن بلقين بن باديس الصنهاجي من حُكمها، وبعدما صُودرت ممتلكاته نُفي مع باقي أفراد اسرته إلى أغمات (قرب مراكش في المغرب)، حيث عاش بقية حياته.
بعدها أتى الدور على قرطبة، ففرض عليها المرابطون حصاراً شديداً صمدت خلاله المدينة قرابة ثلاثة أشهر حتى سقطت في أيديهم يوم الثالث من شهر صفر سنة 484هـ (27 آذار/مارس 1091م)، وقتلوا الأمير الفتح المأمون وحزّوا رأسه ووضعوه فوق رمح، حسبما ورد في كتاب "شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس في العصر الإسلامي (التاريخ السياسي والحضاري)" لسحر السيد.
تلك الشهور الثلاثة مرت على البلاط المعتمدي المُحاصر داخل قرطبة وكأنها ثلاثة قرون، ومن بين أفراد البلاط كانت زائدة التي استغلّت تلك الفترة لإعداد خطة احتياطية تنفذها حال سقوط قلعتها.
بحسبة بسيطة أدركت زائدة أن الفرار إلى إشبيلية لن يفيد كثيراً، فلا بد من أنها ستلاقي المصير نفسه على أيدي جحافل المرابطين؛ لذا لجأت لأبعد اختيار كان يُمكن أن يخطر على ذهن أحد، وهو الهرب إلى ألفونسو، ملك قشتالة وليون، وفقاً لما ورد في كتاب "المرأة في المجتمع الاندلسي" لراوية عبدالحميد شافع.
بحسب ديلجادو فإن تلك الخطوة حظيت بتشجيع الملك المعتمد نفسه، فحثَّ الأميرة على الهرب، حتى تلعب دور الوساطة مع ألفونسو لعلها تقنعه بإرسال مدد يعينه على قتال المرابطين، وتُجدد علاقة التعاون العسكري بينهما التي مكّنت ألفونسو من الاستيلاء على طليطلة دون تدخل من قرطبة أو إشبيلية.
لا نعرف على وجه اليقين مدى نجاح الأميرة زائدة في مهمتها، لكن تُوجد إشارات يُمكن الاستنتاج منها نجاحها في جرِّ القشتاليين إلى ذلك الصراع من خلال سطور قليلة وردت في كتب التاريخ تحدثت عن جيش قشتالي تحرّك بالفعل لنجدة قرطبة، لكن المرابطين هزموه عند "حصن المدوّر" قُرب قرطبة.
في 1091م/484هـ سقطت إشبيلية بيد المرابطين ونُفي المعتمد إلى بلاد المغرب هو الآخر وأبرز رجالات بني عماد، وأصبحت الأميرة زائدة وحيدة في دنيا الأندلس وكُتب عليها البقاء في البلاط القشتالي إلى ما لانهاية.
توضح سحر السيد في كتابها "تاريخ بطليموس الإسلامية وغرب الاندلس في العصر الإسلامي": "امتلأ قلب زايدة بالحقد على قتلة زوجها وسجّاني أبيه فيما بعد، والظاهر أن حقدها على المرابطين دفعها إلى اللجوء إلى طليطلة والدخول في كنف ألفونسو ملك قشتالة".
في بلاط قشتالة
في ذلك الوقت كان الملك ألفونسو في سن الخمسين تزوّج ثلاث مرات ولم يُرزق إلا بفتيات، وكان يتوق بشدة إلى ولدٍ ذكر يخلقه على حُكم ممالكه. بعد فترة قصيرة من وصول الأميرة زائدة توفيت زوجته دونا كونستانثا دي بورغونيا ومرضت زوجته الأخرى دونا بيرتا بشدة حتى ماتت هي الأخرى.
وهنا يجب التأكيد على أن الملك ألفونسو أظهر قدراً ما من التسامح مع المسلمين من رعيته في المناطق الخاضعة له، حتى أنه أمر بسكِّ بعض النقود عليها حروف عربية، كما أنه امتلك رؤية واسعة للزواج، فقبله اقتصرت العائلة المالكة في أغلب زيجاتها على قاطنات بلادهم، أما ألفونسو فتزوج فرنسيات وإيطاليات وأخيراً مسلمة!
بجانب ذلك فإن كثيرين -لا نعرف إن كانت الأميرة زائدة منهم أم لا- لا يعلمون أن ألفونسو مرّ بموقف مشابه حينما كان أميراً صغيراً؛ فبعدما تُوفي والده فرديناند الأول، ملك قشتالة وليون قرابة عام 1065م، استولى أخواه غارسيا الثاني وسانشو الثاني على ميراثه وحقه في الحُكم، فنزح إلى الممالك الإسلامية بالأندلس، حيث عاش بضع سنوات في إشبيلية وطليطلة، اطلع فيها على الكثير من العادات الإسلامية ولم يعد إلى موطنه إلا بعد وفاة أخوَيه ليُصبح ملكاً بدلاً منهما.
بسبب تلك الظروف ربما كان ألفونسو هو أقدر رجال مملكته على فهم الوضع العجيب الذي مرّت به الأميرة زائدة ودفعها للجوء لمملكة مسيحية هرباً من جيوش المسلمين من دينها!
بعض الروايات الإسبانية بالغت في الأمر وادّعت أن الأميرة المسلمة كانت قد كتمت في نفسها الحبَّ تجاه ألفونسو منذ أن كانت في قصرها المعتمدي بعدما بلغتها أنباء شجاعته وقوته، وهي قصص عسيرة إن لم تكن مستحيلة التصديق.
لكن ما وقع يقيناً، وفق ديلجادو، هو أن إعجاباً متزايداً نما بين ألفونسو وزائدة تحوّل إلى "علاقة غير شرعية" -أو زواج عُرفي غير رسمي وفق تعاليم الكنيسة على اختلاف وصف المؤرخين- أنجبت خلاله بين عامي 1095 و1097 الابن الذكر الذي طالما حلم به ألفونسو والذي منحه اسم سانشو.
بفضل ذلك الصبي تعززت مكانة الأميرة الأندلسية في البلاط القشتالي، وهي العلاقة التي لم تكن محل ترحيب من الكنيسة الكاثوليكية ولا أزواج بنات الملك من البرغونيين المتشددين كاثوليكياً (سلالة فرنسية نبيلة عاشت في منطقة برغندي شرق فرنسا) بسبب أصول الزوجة الإسلامية.
رغم ذلك واصلت زائدة مساعيها لتعزيز علاقتها بالملك، فاعتنقت المسيحية، وحوّلت اسمها إلى "إيزابيل". هنا لم يعد هناك أي عائق يحول بينها وبين الارتباط الرسمي بألفونسو. وفي 14 أيار/مايو 1100م تزوّج ألفونسو السادس منها وأصبحت زوجته الرابعة وملكة قشتالة وليون، بينما أصبح ابنهما سانشو وريثاً شرعياً للعرش.
أضافت زائدة لمسة عربية على البلاط المسيحي؛ اعتاد الملك الاجتماع برجال الفكر والفلاسفة وارتدى العديد من رجال الحاشية ملابس على الطراز العربي. أيضاً نقلت إلى الإسبانيات عادة تغطية الوجه بخمار لا يُظهر إلا عينيها. استمرت تلك العادة منتشرة في إسبانيا، بينما حُرّمت على نساء الموريسكيين بعد سقوط الممالك الإسلامية، وفق ما ذكرته خديجة قروعي في كتابها "ظواهر اجتماعية مسيحية وإسلامية في الأندلس".
بحسب نقش على عملة قديمة عيّن ألفونسو ولدَه حاكماً على طليطلة سنة 1107م، ومنحه سُلطة توقيع الفرمانات الملكية، ما يعكس مكانته -ومكانة أمه بالتبعية- المتصاعدة آنذاك؛ تلك المكانة التي أفقدت أوراكا، ابنة ألفونسو الكبرى المتزوّجة من الكونت ريموندو دي بورغوني، حقوقَها الملكية التي كانت مقررة لها، وأشعلت صراعاً كبيراً بينها وبين أخيها "ابن المسلمة". ربما لعب هذا الصراع المكتوم دوراً في الوفاة الغامضة التي لاحقت سانشو في عُمر مبكر (12 أو 13 سنة).
في ربيع 1108م، هاجمت قوات المرابطين حصن أُقليش الخاضع لسلطة قشتالة، وبسبب تقدم سن الملك ألفونسو، لم يخرج بنفسه إلى الحملة، فأُرسلت التعزيزات بقيادة وريثه الأمير سانشو، وهي قيادة اسمية فقط لقلة عمره، بينما كانت القيادة الفعلية بيد القائد العسكري ألفار فانييث، وكان برفقة الأمير لحماية الكونت غارسيا أوردييث، كونت نَخيرة (مدينة تقع شمال إسبانيا حالياً) ووصي ولي العهد الذي حينها كان بالكاد يتعلّم ركوب الخيل!
وعن تلك الواقعة ورد في كتاب المؤرخ المراكشي ابن عذارى "البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب" ما نصّه: "خلال ذلك وصل إلى حصلن إقليش ولد الملك من زوج المأمون التي كانت تنصرت بنحو سبعة آلاف فارس".
وبحسب كتاب "التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم" لعبد الهادي التازي، ففي 30 أيار/مايو 1108م، وقعت معركة إقليش التي حقق فيها المرابطون انتصاراً كبيراً، ورغم أن سانشو لم يشارك بها، إلا أنه تعرّض لكمين بعدها، قُتل فيه مع حاميه الكونت غارسيا.
وكأنما كُتب على الأميرة زائدة ألا تنجو من براثن المرابطين أبداً، فرغم أن رحلة هروبها منهم أدخلتها التاريخ من أوسع أبوابه، إلا أن تلك الرحلة -بالنسبة لها- كانت حافلة بالألم والفقد، وبالتأكيد فإنها تمنّت لو لم تقع وعاشت حياة هادئة في قصر أندلسي في كنف أمير معتمدي حتى تموت فيرثيها الشعراء بالعربية بدلاً من اللاتينية.
لكنها لسوء الحظ وقعت في أتون لعبة سياسية لم تدعها لحالها أبداً، سواءً في بلاد الإسلام أو حتى المسيحية؛ فبعد قليل من الرحيل المفاجئ لابنها، ماتت زائدة بشكلٍ محير أيضاً؛ لها شاهدا قبر حفر اسمها باللاتينية عليهما؛ الأول في دير "سان بنيتو دي ساهاغون"، كُتب عليه: "حين ولدت سانشو توفيت الملكة زائدة، بعدما ولدت وهي متألمة"، أي أنها ماتت بسبب متاعب حملها من ابنها الذي مات وهو ابن 12 سنة! والنقش الثاني في بهو الملوك في دير "سان إيسيدورو" (Salón de los Reyes) في ليون، ويقول: "هنا ترقد الملكة إليزابيث زوجة الملك ألفونسو ابنة ملك إشبيلية، التي كانت تُدعى سابقاً زائدة".
لا نملك تفسيراً لوجود نقشين ولا للادعاء الكاذب بأنها ماتت بعد إنجاب ابنها سانشو.
في سطور زائدة تختبئ مفارقة التاريخ الأندلسي كله؛ حيث يتحول الدم الملكي إلى لعنة، والحب إلى سلاح سياسي، والأمومة إلى طريق مكسو بالأشواك
قد تكون خرجت من الولادة بمتاعب صحية عانت بسببها لسنوات، أو في عملية إنجاب طفل آخر غير سانشو، أو قد تكون وفاة ابنها أثرت عليها إلى حدٍّ عجّلت أو أضرّت بولادتها، وقد تكون وفاتها شبه المتزامنة مع ابنها ترتيباً ليُفسح المجال أمام أوراكا للاعتلاء على عرش والدها المُسن دون أن تفسح المجال لـ"ابن المسلمة" بحُكم المملكة المسيحية.
تلك الوفيات المتتالية مثّلت راحة كبيرة للبلاط القشتالي الذي كان يسيطر عليه البرغونيون تماماً. وبعد عام واحد من رحيل زائدة، في 1 تموز/يوليو 1109، توفي ملك قشتالة وليون، فانتقلت السُلطة إلى ابنته معلنة سيطرة البرغونيين على مملكة قشتالة وليون لأكثر من قرنين من الزمان.
محاولات نفي تلك الزيجة
قادت بعض الطوائف الكنسية مثل الكلونيون (رهبان دور كلوني التي كان لهم نفوذ كبير في الممالك الإسبانية وعلى صِلة كبيرة بييت بورغونيا) والكمبوستليون (أتباع كاتدرائية "سانتياغو دي كومبوستيلا" المركز الديني الأهم في قشتالة وليون وقتها) محاولات لردم التراب على تلك الزيجة والاكتفاء بحصر زائدة في دور العشيقة والمحظية، وهو ما يتناقض مع ما كتبه الملك ألفونسو بنفسه خلال عهده في أحد مراسيمه التي جاء فيه "زوجتي إيزابيل وابننا سانشو".
بسبب رغبتهم في الحفاظ على نقاء السلالة الملكية، صوّرت تلك الطوائف في أدبياتها شخصية الملكة على أنها مجرد جارية أخرى للملك وليس أكثر.
ضمن هذه المحاولات كُتب نقش مزور أن إيزابيل هي "ابنة لويس ملك فرنسا"، وهذا أمر مستحيل لأن الملك لويس السادس لم يتولَّ حُكم فرنسا إلا عام 1108م أي بعد ثماني سنوات كاملة من زواج ألفونسو وزائدة/إيزابيل، كما أن جميع السجلات الملكية الفرنسية تخلو من ذِكر ابنة للملك بهذا الاسم.
على الجانب الآخر فإن بعض المؤرخين المسلمين لم يستطيعوا هضم فكرة قبول أميرة مسلمة بالارتداد والتنصّر والزواج بملك مسيحي واعتبروها مُنكراً من المنكرات دفع بعضهم لضربها مثالاً للعبرة مثلما فعل الونشريشي في كتابه "المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب"، وتحدّث فيه عن مخاوفه على نساء المسلمين بقوله: "متى يأمن ذو زوجة أو ابنة أو قريبة أن يعثر عليها أحد من كلاب الأعداء وخنازير البعداء فيغرّها في نفسها وفي دينها ويستولي عليها كما حدث لكنّة المعتمد بن عباد وما لها من الأولاد، أعاذنا الله من البلاء وشماتة الأعداء".
أما محمد المغراوي فلقد ادّعى في بحثه "جوانب من تاريخ النساء بالأندلس" أن "الغالب أنها أمَة من أصول إسبانية كانت زوجة للمأمون، فضّلت الالتحاق بقومها بعد مقتل زوجها"، وهي رواية انفرد بها المغراوي ولم يذكرها مرجع تاريخي إسباني أو عربي.
هذا الموقف لخَصّه ببراعة محمد عبدالله عنان في كتابه "دولة الإسلام في الأندلس" بقوله: "الظاهر أن المؤرخين المسلمين قد شعروا بما يكتنف هذه القصة من إيلام لنفوسهم الكريمة، فآثروا الإغضاء عنها واعتبارها حادثاً لا أهمية له من الناحية التاريخية".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.