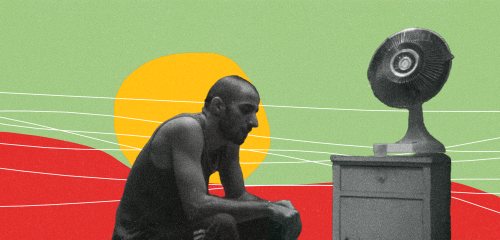منذ سنوات وأنا أعيش في إيران، هذا البلد الواسع الذي يضم ملايين المهاجرين والأجانب من أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا وباكستان، وصولاً إلى جاليات أصغر من إفريقيا وآسيا الوسطى.
بلد غني ومتنوع، لكنه معقّد أيضاً، وكلما طالت إقامتي فيه اكتشفت طبقة جديدة من ظاهرة حيّرتني في بداياتي لأسميها فيما بعد بـ "العنصرية المزاجية". ليست منظّمة كما في دول أخرى، ولا قائمة على تاريخ أو قوانين وأيديولوجيا واضحة. هي شيء لحظي، تشوبه السياسة والحالة الاقتصادية، يتبدل من حيّ إلى آخر، ويتغيّر بتغير لهجتك، لون عينيك، مظهرك، وضعك القانوني، وحتى رأي الناس في ما حصل في "دمشق" ومن بقي ومن سقط.
رغم تجاربي الكثيرة، إلا أنني لم أكتب عن هذا الموضوع من قبل، لأن العلاقة مع هذا البلد والكتابة عنها أثناء تواجدك بها ليست بهذه البساطة. أحب إيران، ففيها درست وعملت وتعلمت ووجدت فرصاً لم تكن ممكنة في سوريا، وأنا مدين لها بالكثير. وما أكتبه هنا ليس هجوماً ولا دفاعاً، بل محاولة لفهم ما عشته وسعياً لتوثيق تجربة خضتها هنا بلا تضخيم ولا تجميل، كأي سوري يعيش يومياً بين الحب والامتنان من جهة، وبين نظرات غريبة لا يعرف سببها من جهة أخرى.
هي رواية لتجربة طويلة، أضعها كما هي، قبل أن أدخل إلى تفاصيلها الثقيلة. نوع العنصرية التي قد تواجهها في إيران لا يحتاج إلى أيديولوجيا… تكفي لهجتك، لون عينيك، موقفك السياسي، أو الحي الذي تسكنه كي تتغير نظرة الناس إليك في ثوانٍ".
أتوجد في سوريا عيون ملوّنة؟
أعيش في حي شرق طهران، حيّ معروف بأنه وجهة للأفغان أولاً، وللمهاجرين الإيرانيين من القرى والأرياف النائية ثانياً. حي بسيط يناسب دخلي، متعب من ناحية الخدمات لا يشبه الأحياء المرفهة في شمال العاصمة، مليء بالوجوه التي أنهكتها الحياة، وفيه قصص لم تُروَ عن كفاح البشر وبقايا أحلامهم الصغيرة.
في إحدى العيادات، نظرت طبيبة العيون إلى زوجتي وسألتني بابتسامة صادقة مندهشة: "أيوجد في سوريا عيون ملوّنة وشُقْر وبشرة بيضاء؟" لم تكن تدرك أن ما قالته يكشف فجوة عميقة في الصورة الذهنية بين الإيرانيين عن سوريا والسوريين
كأي شخص يعيش هنا، عليّ الذهاب إلى السوق والحلاق والصيدلية والتعامل مع الجيران والباعة، أحياناً بمفردي وأحياناً مع زوجتي، أعاشر الناس باحتياط يومياً، وهنا تبدأ زوبعة من الأسئلة بلا توقف: من أين أنت؟ سوريا؟ مستحيل. وزوجتك؟ سورية أيضاً؟
أيوجد في سوريا عيون ملوّنة وشُقْر وبشرة بيضاء؟ في إحدى العيادات، نظرت طبيبة العيون إلى زوجتي وسألتني السؤال الأخير بابتسامة صادقة مندهشة، لكنها لم تكن تدرك أن ما قالته يكشف فجوة عميقة في الصورة الذهنية بين الإيرانيين عن سوريا والسوريين. قلت لها: "مع أنك طبيبة، إلا أن السوشال ميديا لوحدها أثبتت أن أبسط الناس يعرفون اليوم أكثر مما تتصورين".
إيران بتعدد سكان تجاوز 89 مليون نسمة تستضيف قرابة ستة ملايين مهاجر. معظمهم أفغان، إلى جانب جاليات عراقية ولبنانية وسورية وباكستانية، وهنود وصينيون وروس وأفارقة وأوربيون. ومع هذا التنوع الكبير، تبقى الغرابة في السؤال شبه اليومي الذي يسمعه السوري خصوصاً: هل يوجد في سوريا عيون ملوّنة؟ هل يوجد شَقْراوات؟ هل توجد بشرة بيضاء؟ وكأن سوريا في خيال البعض ليست إلا خيمة في صحراء بعيدة.
جزء من هذا الجهل سببه قلة التعامل المباشر مع السوريين مقارنة بالأفغان والانعزال الذي يطبق على الإيرانيين لأسباب لا يسعني ذكرها الآن، لكنني أصطدم كل يوم بنظرات تُشبه نظرة شخص اكتشف صدفة أن الورد متعدد الألوان.
زوجتي تعاني من حساسية مزمنة بسبب تلوث الهواء في طهران، وفي زيارة لمستوصف قريب من منزلنا لاحظ الطبيب دون التمعن في شكلنا لهجتي الغريبة فسأل مباشرة: "أفغان هستين؟" (أأنتم أفغان؟) حين أخبرته أننا سوريون، انقلبت معاملته تماماً من التعالي إلى التواضع، ابتسم وجلس بشكل أريح، وسأل عن سبب عدم تحدثها الفارسية وأسئلة أخرى كغيره من الإيرانيين. ليعود لي الشعور مجدداً أن هويتنا تتغير في أعين الآخرين هنا وفق شكلنا ولهجتنا ولباسنا، وحتى لون بشرتنا، وكأن هذه العناصر وحدها تمنحنا أو تحرمنا من الاحترام والمكانة. فهل كوني أفغانياً أو فقيراً أو إيرانياً فررت من ويلات القرى النائية أو لا أشبه الصورة النمطية، يحرمني من الوصول إلى حقوقي كإنسان كما يحصل عليها غيري؟
"في كل مرة يسألونني: من أين أنت؟ كنت أسمع سؤالاً آخر مخفياً: إلى أي صورة تنتمي؟ فالحكم هنا جاهز قبل أن تبدأ الحكاية".
قد تبدو الأسئلة بسيطة أو تافهة للبعض، لكن تخيّل أن تعيش هنا سبع سنوات، وتواجهها يومياً، خصوصاً في بلد تتحرك فيه السياسة في كل زاوية: في الحي، في السوق، في المواصلات. كانوا يسألوننا سابقاً - أي قبل سقوط النظام- هل تحب بشار أم تكرهه؟ أما اليوم هل تحب "الجولاني" أم تكرهه؟ أسئلة من هذا النوع تنهك العقل والفكر، وتزيد شعورك بالغربة حتى لو كنت تعيش أفضل عيشة. قد يأتي أحد ويسألني ماذا تفعل أنت كسوري في بلد كإيران يبعد مئات الكيلومترات عن بلدك الأم؟ فأنا لن أسالك ماذا تفعل أنت في تركيا أو أميركا أو في أستراليا.. لأنني أعرف الإجابة وهي السياسة يا صديقي.
في كل مرة يسألونني: من أين أنت؟ كنت أسمع سؤالاً آخر مخفياً: إلى أي صورة تنتمي؟ فالحكم هنا جاهز قبل أن تبدأ الحكاية.
عندما يعطيك مدير المبنى موقف سيارة… بعد أن يسقط الأسد
مدير المبنى الذي أسكن فيه رجل خمسيني، يميني من التيار الأصولي، لكنه على النقيض أب لابنة تعيش في كندا. كانت علاقتي به محدودة، لا تتجاوز دفع الفواتير وطلبات تخص المبنى. كنا نتجنب الحديث بالعربية أمامه وأمام الجيران، على مبدأ "الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح"، حتى لا نفتح على أنفسنا باب الأسئلة التي لا تنتهي. لم يكن يعرف أنني سوري. بعد سقوط نظام الأسد عرف بطريقته الخاصة كما يفعل سكان أي مبنى، حيث ينتقل الخبر من نافذة إلى شرفة.
هل كرهني؟ من حسن حظي لا. تقرّب مني أكثر. فالرجل يعادي الحكومة الجديدة في سوريا كما يفعل كثير من الأصوليين هنا، ولأول مرة شعرت أن السياسة قد تُطعمك "لقمة هنية" من حيث لا تحتسب.
الغريب أن الرجل نفسه، الذي رفض طوال عامين أن يمنحني موقف سيارة لساعة واحدة، فقط لأنه لم يكن يعرف خلفيتي، عاد وأعطاني كراجاً دائماً لاستقبال ضيوفي. أكثر من ذلك، بعد أن عرف بأنني محسوب على الأقليات عرض علي شقة ابنته المغتربة بعدما علم أنني أنوي الانتقال من الحي. هذا التناقض يضحكني ويؤلمني. بعض الناس هنا تتعامل بمنطق "من وين؟ ومع مين؟ وعلى أي لون تبدو؟" وكأن السياسة ميزان حرارة يقيسون به علاقتهم بالآخرين حتى داخل الممرات الضيقة.
منذ فترة ليست طويلة كنت عائداً إلى المنزل برفقة زوجتي في سيارة أجرة. ما إن فتحت لها الباب وقلت "تفضلي حبيبتي" حتى التقط السائق اللغة بسرعة. عقد حاجبيه وبدأ يسأل، وما إن عرف أنني سوري حتى تغير لونه كأنه ابتلع جمرة. قال بحدّة: "شو عم تعمل بإيران؟ روح لعند الجولاني. قدمنا آلاف الشهداء لبشار… وآخر الشي سرق مصارينا وهرب".
هنا لم أستطع أن ألتزم الصمت. قلت له: "وهل أنا من أرسلكم إلى بلدي واجبر حكومتك على التدخل في شأن لا يعنيها؟". بدا عليه الارتباك، سكت، ثم تابع الطريق بصمت يشبه من "بلع لسانه".
حين علم سائق الأجرة أنني سوري انفجر باتهامات عن الجولاني وبشار وأموال الإيرانيين المسروقة في سوريا، رددت بأنني لم أطلب من بلاده التدخل، فارتبك وصمت. قبل الوصول قال إنه يمزح، فابتسمتُ… لأن الخوف هنا كثيراً ما يتنكر في هيئة مزاح
قبل أن نصل، التفت وقال إنه كان يمزح. ابتسمت… لا لأنني صدقته، بل لأنني تعلمت أن بعض المزاح هنا يُقال ليغطي خوفاً، وبعض الصمت أبلغ من الكلام.
الصمت الذي آلمنا أكثر من الحرب نفسها
كنت أظن دائماً أن أصعب ما يعيشه السوري في إيران هو نظرة موظّف بنك أو سؤال جار أو طبيب فضولي أو ذلك النوع من العنصرية اليومية التي تأتي وتذهب حسب المزاج العام، إلى أن اكتشفت لاحقاً أن ما يصيبك بالوجع الحقيقي ليس ما يفعله الآخرون من حولك بقدر ما تفعله الجهة التي تحمل أنت جنسيتها، وحين يصبح الصمت أثقل من أي كلمة، وأكثر جرحاً من أي نظرة.
في 13 حزيران/ يونيو الماضي وخلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، تحركت السفارات الأجنبية في طهران كما لو أن المدينة على وشك الانهيار. السفارات اشتغلت بأقصى طاقتها: إجلاء عاجل لرعاياها براً وبحراً وجواً، تنسيق على مدار الساعة، رسائل طمأنة إلى كل مواطن في هذا البلد المترامي.
كل الدول تقريباً سارعت إلى جمع رعاياها وإخراجهم من الأراضي الإيرانية، حتى الدول الصغيرة التي لا يسمع بها أحد كان لها بيان أو على الأقل "تغريدة". ما عدا سوريا التي كان صمتها أعلى من الانفجارات، كأنها غير معنية، رغم وجود آلاف الطلاب والنازحين والعاملين والصحفيين والمرضى والزوار خصوصاً في طهران التي أخلاها أكثر سكانها بعد أيام من الحرب بسبب ضراوة وعشوائية القصف، لم يصدر بيان واحد بحقهم، ولا حتى جملة باردة عبر وكالة رسمية ولا تصريح غير مباشر، وكأننا مجرد أرقام عابرة في مدينة لا تحتاج أحداً ولا ينتظرها أحد.
عندما قامت الحرب بين إيران وإسرائيل سارعت كل دول العالم لحماية رعاياها، إلا سوريا، التي حافظت على صمت ثقيل كإغلاق باب في وجهك، كأنك لم تولد باسم هذا الوطن.
إلى اليوم يرافقني صمت بلدي الذي أعيش باسمه هنا، وأحمل جواز سفره، وندفع ثمن صورته في كل يوم، وأراه أقسى من أي موقف سياسي. كان بإمكان أحد أن يقول: "نحن هنا، نتابع، قلوبنا معكم". لم يتفوه أحد بكلمة. كان التشدد السياسي سيد الموقف. أعترف أن في صدري جرحاً لا أعرف كيف يلتئم، شعرت أننا، نحن السوريين هنا، بلا ظهر ولا صوت ولا حتى كلمة مواساة. وكأنك في بحر عميق، والكل يلوّح بقوارب الإنقاذ إلا المركب الذي كتب عليه اسم بلدك.
قد يتحملك الآخرون أو يضيقون بك، قد يجهلونك أو يسألونك أسئلة سخيفة، لكن حين يختفي صوت بلدك تماماً، تشعر أنك تقف في منتصف الطريق بلا ظل ولا سند، وكأنك لست منتمياً لأي مكان على الإطلاق. ومن المفارقات أن كل الحكومات في المنطقة كانت تتحدث—ولو مجاملة—عن حماية رعاياها، بينما حافظت الحكومة السورية الجديدة على صمت ثقيل يشبه إغلاق باب في وجهك من دون حتى النظر إليك.
عندما قامت الحرب بين إيران وإسرائيل سارعت كل دول العالم لحماية رعاياها، إلا سوريا، التي حافظت على صمت ثقيل كإغلاق باب في وجهك، كأنك لم تولد باسم هذا الوطن.
بين الحب والخذلان
إيران ليست بلداً بسيطاً. فيها الطيبة التي تدهشك، وفيها القسوة التي تربكك، فيها من يفتح لك بيته قبل قلبه، وفيها الذين قد يجرحونك بسؤال واحد. عنصريتها ليست عنصرية كراهية ولا خوف. هي خليط من جهل، من مناطقية، من سياسة تتبدل كل سنة، من صور نمطية مسبقة، ومن مزاج عام يشبه طقس طهران: شمس حارقة في الصباح، وبرد يلسع العظم في المساء.
وأما عن سوريا، فهي بلد واسع أيضاً، فيه العرب والكرد والشركس والتركمان والسريان والأرمن. فيه السمر، وفيه الشقر، وفيه كل ما يمكن أن تتوقعه من تنوع. لكن سؤالي هنا: لماذا يبدو السوري اليوم في إيران وكأنه كائن غريب؟ أليست هذه البلد كغيرها من البلدان التي تحتضن أجانب من جنسيات مختلفة؟ ربما لأننا جئنا في توقيت سياسي سيء. ربما لأن سقوط حليفهم جعل الكثيرين ينظرون إلينا بريبة. وربما لأن السوري، مثل الأفغاني، أصبح في مخيلة البعض رمزاً للفقر والحرب واللجوء… وليس ابن أرض عمرها آلاف السنين.
لا أكتب هذا المقال لأجل فتح باب خصومة، بل لأجل فتح نافذة. البلدان تُفهم بالروايات. وما أكتبه هنا هو رواية واحدة فقط، من سوري عاش سنوات طويلة في طهران، أحبها وعاش تفاصيلها، وواجه أيضاً ما لم يفهمه أحد من قبل. ليست المشكلة أننا مهاجرون، المشكلة أن الناس هنا يتخيلون أنهم يعرفون كل شيء عنا. وربما حان الوقت لنروي قصتنا بلساننا، وبهدوء، ومن دون خوف.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.