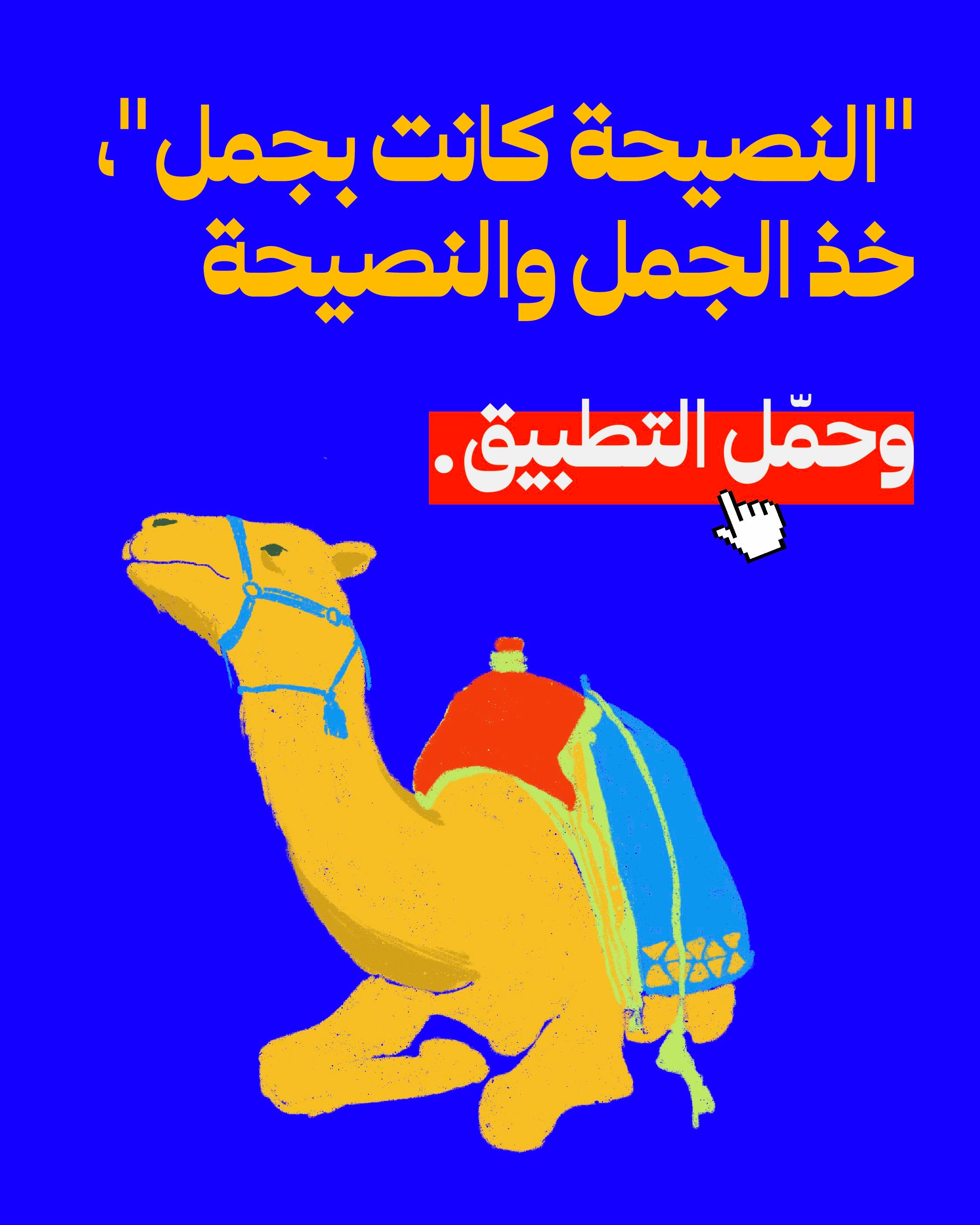"رقبة قزازة وقلبي فيها انحشر/شربت كاس واثنين وخامس عشر/صاحبت ناس م الخمرة تصبح وحوش/وصاحبت ناس م الخمرة تصبح بشر/وعجبي".
تذكرت هذه الرباعية الشهيرة لصلاح جاهين وأنا أطالع قصة يحكيها نوبار باشا (1825–1899) عن القائد إبراهيم باشا (1789–1848)، ابن محمد علي، قائلاً في مذكراته: "كنت قد رأيت إبراهيم قبل ذلك في حالة سكر، وتحت تأثير الخمرة ينغمس في الحديث عن المواقع الحربية التي خاضها. كانت جبهته العريضة يسطع عليها الضوء، بينما كانت عيونه الزرقاء الشفافة تتلألآن... لكن هذه المرة لم أر شيئاً يشبه ذلك، رأيت شفتيه وذقنه غير طبيعيتَين إطلاقاً، بل من شدة سكرِه أصبحت تميل بزاوية، ثقلت معه قدرته على الحديث، لقد اختفى الإنسان، وحلّ محله الوحش الكاسر".
استَشهدت الباحثة والمؤرخة المصرية الدكتورة زينب البكري بهذه الفقرة لتؤكد أن تداول الخمور في المحروسة (مصر) خلال القرن التاسع عشر لم يقتصر على فئة أو طائفة أو طبقة اجتماعية، وإنما امتد من الحاكم أو الوالي محمد علي نفسه، حيث اعتاد شرب زجاجة نبيذ قبل النوم بغرض التداوي وإزالة الأرق، إلى طبقات كبار الموظفين والأفندية وحتى الصنايعية والحرفيين والحرافيش.
وربطت زينب في كتابها "المشروبات الروحية في القرن التاسع عشر بين الإباحة والتجريم" الصادر أخيراً عن دار المرايا بالقاهرة، بين الجرائم التي ترتكب بسبب الخمور والسكر وبين بيوت الهوى أو "الكرخانات" التي جرى تقنينها لفترة طويلة قبل قرار إغلاقها النهائي عام 1949، وفق ما يورد الدكتور عماد هلال في كتابه "البغايا في مصر: دراسة تاريخية اجتماعية (1834 - 1949)".
في مصر القرن التاسع عشر، لم يقتصر شرب الخمر على طبقة معينة، بل كان شائعاً بين الحكام والموظفين والفقراء، مما يعكس علاقة المجتمع بالخمر رغم التحريم الديني
تتبعت الباحثة في كتابها الذي جاء في أكثر من 330 صفحة، قصةَ الخمور في القرن التاسع عشر، على عدة مستويات، كيف دخلت إلى مصر عن طريق القناصل والتجار الأجانب، وكيف كان يتم تصنيعها من مواد متعددة على اختلاف أنواعها، مثل البيرة والبراندي والأنبذة والويسكي. وتوضح كيفية تصنيع كل نوع بحسب ما أوردته الكتب التاريخية والطرائق العلمية المعملية؛ فتفرق مثلاً بين الإيثانول (الكحول الإيثلي) الموجود في كافة المشروبات الكحولية ويمكن هضمه دون أن يفقد الإنسان الوعي، والميثانول (الكحول المثيلي)، وهو نوع شديد السمية، ويعرف بالكحول الخشبي.
وأورد الكتاب تصنيفات للمشروبات الكحولية المخمرة والمشروبات المقطرة مثل عرق العنب، والبراندي وهو المشروب الكحولي الناتج عن تقطير نبيذ العنب، والزبيب والروم الناتج عن تخمير عصير القصب، والجن أو "الجنفير" الناتج عن تقطير مخمر نقيع الغلال، والويسكي والشمبانيا والمشروبات العنبرية (الليكرات)، وهي مشروبات روحية محلاة بالسكر أو عصير الفاكهة.
وبحسب ما ذكره الكتاب نقلاً عن كتب التراث والمعاجم، فقد سميت الخمر خمراً من الخِمار، وهو الحجاب الذي يغيّب العقل، وأوردت الكثير من الأمثلة عن الخمر في التراث الديني، بينما انتشر مصطلح "المشروبات الروحية" بين الأوروبيين لاعتقادهم أنها تساعدهم في التواصل مع الأرواح، لذا يَعتقد من يشربونها أنهم في عالم آخر غير الذي يعيشون فيه.
وأشارت إلى الفارق في التعامل مع الخمر بين المسيحيين، الذين يعتبرونه جزءاً من رمزية السرّ المقدس، فيما اختلفت المذاهب الإسلامية حول تعريف الخمر وعلاقة التحريم بطريقة التصنيع، مثل غليان مكوناتها حتى "القذف بالزبد"، وتواترت العديد من اشتراطات العلماء والفقهاء الذين انتهوا إلى تحريم الخمر، خصوصاً على مذاهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، بينما أباح أبو حنيفة النعمان شربَ النبيذ، وفق ما يورده الكتاب نقلاً عن مراجع تراثية.
ومن الطرائف التي يضمها الكتاب وصفات لصناعة الخمور من كتب الرحالة، مثل التركي أوليا جلبي، صاحب كتاب "سياحة نامة"، متحدثاً عن "خمر البانجو"، قائلاً: "ينقع الحشيش مع العسل التركي، ويتخمر ليلة، ويصفى في الصباح بمنخل، فيصبح خمراً خضراء اللون".
وتؤكد الكاتبة أن تعاطي الخمور في مصر المملوكية انتشر بين الخاصة والعامة، وحصل التجار الأجانب على مميزات خاصة مكنتهم من جلب الخمور في سفنهم وإنزالها إلى فنادقهم، ولكن تم تجريم بعض الممارسات ومحاولة تقنينها بعد انتشار الحوادث الناجمة عن السكر.
وانطلقت الكاتبة في عملها الذي يعدّ خلاصة رسالة دكتوراة في التاريخ الاجتماعي، بعد رسالة الماجستير التي أنجزتها من قبل حول "عامة القاهرة" في القرن التاسع عشر، من مفارقة تداول الخمر في بلد إسلامي هو مركز الخلافة العثمانية، وأوردت في هذا الصدد انتقاد زوجة أحد القناصل الأجانب لمسؤول تركي كبير دعاها وزوجها لحفل، وكان يشرب الخمر، فسألته أليس غريباً أن تتناول الخمر وهو محرم في دينكم، ليرد عليها: "إن تحريم الخمر أمر حكيم للغاية، لكنه يقتصر على عامة الناس، ولم يكن النبي محمد قد منع أولئك الذين يعرفون كيف يتناولونه باعتدال".
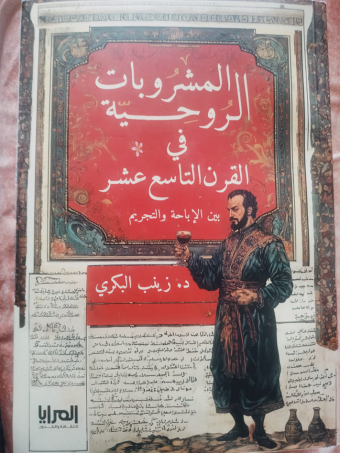
وعن اختيارها للخمور في القرن التاسع عشر موضوعاً لرسالة دكتوراه تقول زينب البكري لرصيف22: "جاءت الفكرة أثناء إعدادي لأطروحة الماجستير، وقتها وجدت نصين وثائقيين مثيرين للجدل، الأول يتعلق بضبط أحد السكارى في شوارع القاهرة، والثاني يتعلق بتحصيل عوائد الخمور، وفكرت: كيف تشدد السلطة الحاكمة في ضبط السكارى، وفي الوقت نفسه تقوم بتحصيل عوائد من الخمور؟ من هنا كانت بداية البحث الشاق عن هذا الموضوع".
وتوضح البكري في حديثها لنا عن المشقة التي واجهتها لتسجيل أطروحة الدكتوراه عن الخمور في جامعة القاهرة، وكذلك نشر الأطروحة في كتاب بعد ذلك، قائلة: "رفضت اللجنة العلمية بجامعة القاهرة الدراسة في البداية، وظللت قرابة ستة أشهر أسعى للحصول علي موافقتها، وبعد انتهاء الدراسة قوبل الكتاب برفض دور النشر لمثل هذه النوعية من الكتب، باعتبارها تمس عن قرب خصوصية المجتمع المصري، مع العلم أن الظواهر الاجتماعية على اختلاف أنواعها تخضع للدراسة والتحليل".
وتضرب الباحثة مثالاً بالدكتور عماد هلال، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة قناة السويس، موضحة أنه "قدم دراسة تاريخية مهمة عن 'البغاء'، ونشرتها دار العربي للنشر والتوزيع، وسبقنا عبد الوهاب بكر في دراسة البيوت السرية في القاهرة، وهي مواضيع شديدة الخصوصية والحساسية لكنها ليست بمنأى عن الدراسة".
يتناول الكتاب تفاصيل دقيقة عن أحوال الخمارات والبارات، والفارق بين بيع المشروبات الكحولية في دكان أو محل بقالة وبيعها في خمارة، هو أنه يمكن للمشتري أن يجلس ويحتسي الخمرَ في الخمارة، وترصد الكاتبة بالشرح الوافي إحدى خمارات القاهرة في القرن التاسع عشر بكل مكوناتها من صالة وطرقات وأبواب ومكان متسع للتخزين، والعاملين بالخمارة من صاحبها إلى العمّال، وروادها من الوجهاء والأغنياء والفقراء، وكيف كانت تتم السرقات بداخلها، وكيف تحولت خمارات إلى مقار للرهونات، ومن الطريف أن أحدهم رهن معزة في خمارة حتى يسدد الحساب.
ولا يخلو الكتاب من نصوص تراثية حول المشروبات الروحية وتأثيرها على البشر، من ذلك "مسامرات الأمير نور الدين" التي يقول في وصفها: "إنها تهضم الطعام، وتصرف الهم والغم، وتزيح الأرياح، وتروق الدم، وتصفي اللون، وتنعش البدن، وتشجع الجبان، وتقوّي همة الرجال على الجماع".
وتوضح المؤلفة أن الجانب النفسي لتعاطي الخمور رصده متخصصون كثر، فتقول: "للمفارقة أن تأثير تناول الخمور يفوق تأثير المخدر، وقد ناقش ذلك العالم الكبير مصطفى سويف"، بينما أشارت إلى أن بعض المتخصصين في علم النفس (السيكولوجي) الذين ربطوا بين الإدمان وتعاطي الخمور وبين الإبداع مثل الدكتور أيمن عامر، المتخصص في علم النفس الإبداعي بجامعة القاهرة، إلا أنها من وجهة نظر المؤلفة نماذج فردية ومحدودة.
وتتناثر في الكتاب أبيات الشعر عن الخمور، من بينها البيت الشهير لأحمد شوقي:
رمضان ولّى هاته يا ساقي/مشتاقة تسعى إلى مشتاقِ
كما أوردت أبياتاً لا تخلو من طرافة، استعادت من خلالها أبياتاً شائعة منسوبة لأبي نواس في الخمر، منها:
دع المساجد للعُبّاد تسكنها/وسِرْ إلى حانة الخمار يسقينا
ما قال ربّك ويلٌ للذين سكروا/ ولكن قال ويلٌ للمصلينا
وأيضاً: "وقيل إن من يشرب منه كأساً وينظر إلى وجه حبيبته يقع في نشوة، وينشد ألف بيت من الشعر، ويصبح خصب الخيال"، هذا ما ذكره أوليا جلبي، صاحب "سياحة نامة"، أما عن تأثير شرب "خمر البانجو" فيقول: "من شربها لم يميز رأسه من قدمه".
وتعدّ الخمر وسيلة للوصول إلى حالة مزاج معينة تجعل الإنسان مخدراً يبيت مبسوطاً لا يسأل عن الدنيا وما فيها، بحسب ما ورد في الكتاب، نقلاً عن مقالات عبد الله النديم. وعن هذا المزاج المميز الذي يفصل المرء عن الواقع يصفه ريتشارد بيرتون بأنه "الكسل المصحوب بالسرور، والسكون الحالم، وبناء القلاع في الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى إبهاج الحواس".
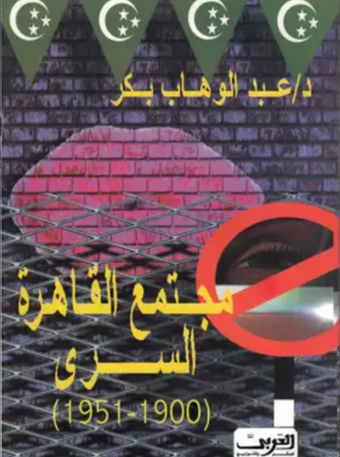
وعلى الجانب الآخر فالخمر والخمارات مادة خصبة للجريمة، حيث تنتقل المؤرخة عبر فصول الكتاب إلى جوانب متعددة ترتبط بتقنين الخمور وتراخيص الخمارات التي بدأت في 1891، والجرائم التي ترتكب لحظة النشوة والسكر.
وتقول: "وجدت ما يقرب من خمسمائة قضية ما بين قتل وسرقة وتعدي بالضرب عقب وصول المتعاطي إلى حالة السكر، وتم تداول هذه القضايا في المحاكم الشرعية والمجالس القضائية المختلفة في مصر".
فالجريمة اقترنت إلى حد كبير بشرب الخمر، لما فيه من تغييب للعقل، و"تخطت الخمارة حدودها كمكان يوفّر تناول المشروبات، لتصبح ملاذاً للمجرمين، ومن المثلة الطريفة التي توردها أن شخصاً يدعى أميديو بيلادينو من شارع البلاقسة، قدم بلاغاً عن خمارة مصطفى الحريرى الدخاخنى، بأنه "جاعلها مأوى للأشقياء واللصوص"، كما كان الجيران الساكنون بجوار "أوتيل بست"، يشتكون من "سكن الأشخاص الأشرار والمشبوهين"، والأكثر من ذلك أن شخصاً نمساويّاً بجهة السنانية كان يبيع بدكانه عتلات وآلات حديد تساعد على السرقة.
هذا المقتطف يدل على السمعة السيئة التي اكتسبتها الخمارات في القرن التاسع عشر، ربما ليس كمأوى للصوص والأشقياء فقط، بل كبيئة خصبة للجريمة. ورصدت الباحثة 428 قضية، عن التعدي والسرقة وجرائم في بيوت الهوى وجرائم القمار والاعتداء الجنسي والسكر والعربدة.
كان السكر يجلب السباب، وهناك ألفاظ شاعت للسب فى الخمارة مثل "شرموط"و"علق"، ولم تقتصر هذه الألفاظ على عامة المصريين، بل امتدت ليتم تداولها بين الأجانب. وتورد الباحثة أمثلة عدة من شكاوي الأجانب ضد بعضهما بعضاً؛ تقول: "ادعى الخواجه مجريان، صاحب ورشة الحديد، بشارع أبو العلا، على الخواجه فيكتور، حماية دولة البلجيك، أنه تطاول عليه بالشتم، قائلاً: 'تارة يشتم بالعربى بقوله يا ابن الكلب، يا معرص، يا قليل الدين...، وتارة صار يشتم بالفرنساوي'".
"وقيل إن من يشرب منه كأساً وينظر إلى وجه حبيبته يقع في نشوة، وينشد ألف بيت من الشعر، ويصبح خصب الخيال"، بحسب أوليا جلبي، في "سياحة نامة"
لا شك أن الكاتبة عانت حتى تحصل على الوثائق والسجلات والقرائن لتصنع حول الخمور قصة حية وخطاً مستقيماً يعطينا فكرة شبه متكاملة عن تداول الخمور في المجتمع المصري في القرن التاسع عشر بين شاربين وخمارين أو أصحاب بارات ومراقبين أو متسلطين؛ "بصفة عامة تناول الظواهر الاجتماعية غاية في الصعوبة لأنه يحتاج إلي الإلمام الجيد بالعلوم الإنسانية الأخرى، وتوظيف الدلالات الثقافية التى يعثر عليها الباحث، خصوصاً في الموضوعات التي تتسم بالحساسية الشديدة على المستوى الاجتماعي؛ مما يتطلب التعامل معها بما أسميه مجازاً الذكاء البحثي، لضمان تناولها برُقيّ وموضوعية من جهة، مع احترام ثقافة القارئ"، وفق تعبيرها.
وأوردت على لسان عبد الله النديم في جريدته "التبكيت والتنكيت"، أو "اللطائف"، حول الخمر وحالاتها وما يصاحبها من جرائم ومفاسد، وكذلك أقوال ومقالات أبو نضارة يعقوب صنوع، وتجربة سعد زغلول الشخصية التي حذر منها في مذكراته، في سياق الربط بين لعب القمار وشرب الخمر.
واستهلت الكاتبة الحديث عن الجرائم الناجمة عن السكر في بيوت الهوى بدعوى شرعية أقامها شخص ضد آخر في المنصورة، حول امرأة تدعى غزالة، المرأة بنت يوحنا، وهناك قضية أخرى لعمدة ظل يشرب مع امرأة من الفواحش ورفض أن يعطيها أجرتها، وكان العثمانيون قد قننوا فتح بيوت الدعارة، ولذا ليس ببعيد أن يربط توماس رسل (حكمدار القاهرة في بدايات القرن العشرين) خلال مذكراته بين المشروبات الروحية، والبغاء/ العهر، ومن منطلق أن "بيت الدعارة" كيان اجتماعى، تكتنفه علاقات اجتماعية متعددة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحصول على المتعة الجنسية، من ناحية، والتلذذ بشرب الخمور.
الكتاب إذاً هو محاولة لتأريخ المشروبات الروحية، وكيف سمحت الدولة العثمانية بتداولها من قبل الأجانب، ثم قامت بتقنينها مع الوقت، ولم تظهر تراخيص خمارات بأسماء مصريين مسلمين أو نصارى إلا في نهايات القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1897، ومع انتشار الخمارات واختلاطها بالدكاكين والبقالة، أصبحت أشبه بظاهرة راحت بعض الأصوات تقاومها وتحارب ضدها، حتى أن أحمد أفندي غلوش قام بتأسيس جمعية لمنع المسكرات، ومثلت الجمعية مصرَ في مؤتمر دولي عام 1928 بدعم من الأمير عمر طوسون، كما تناولها عبد الله النديم في جريدته "التبكيت والتنكيت" وجريدة "السكارى" وجريدة "الأستاذ".
في النهاية، يضع هذا الكتاب بين يدي القارئ ما يمكن اعتباره تاريخاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً ينطلق من تأثير وحضور الخمر كعنصر فاعل ومؤثر في جوانب متعددة في حياة المصريين في القرن التاسع عشر.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.