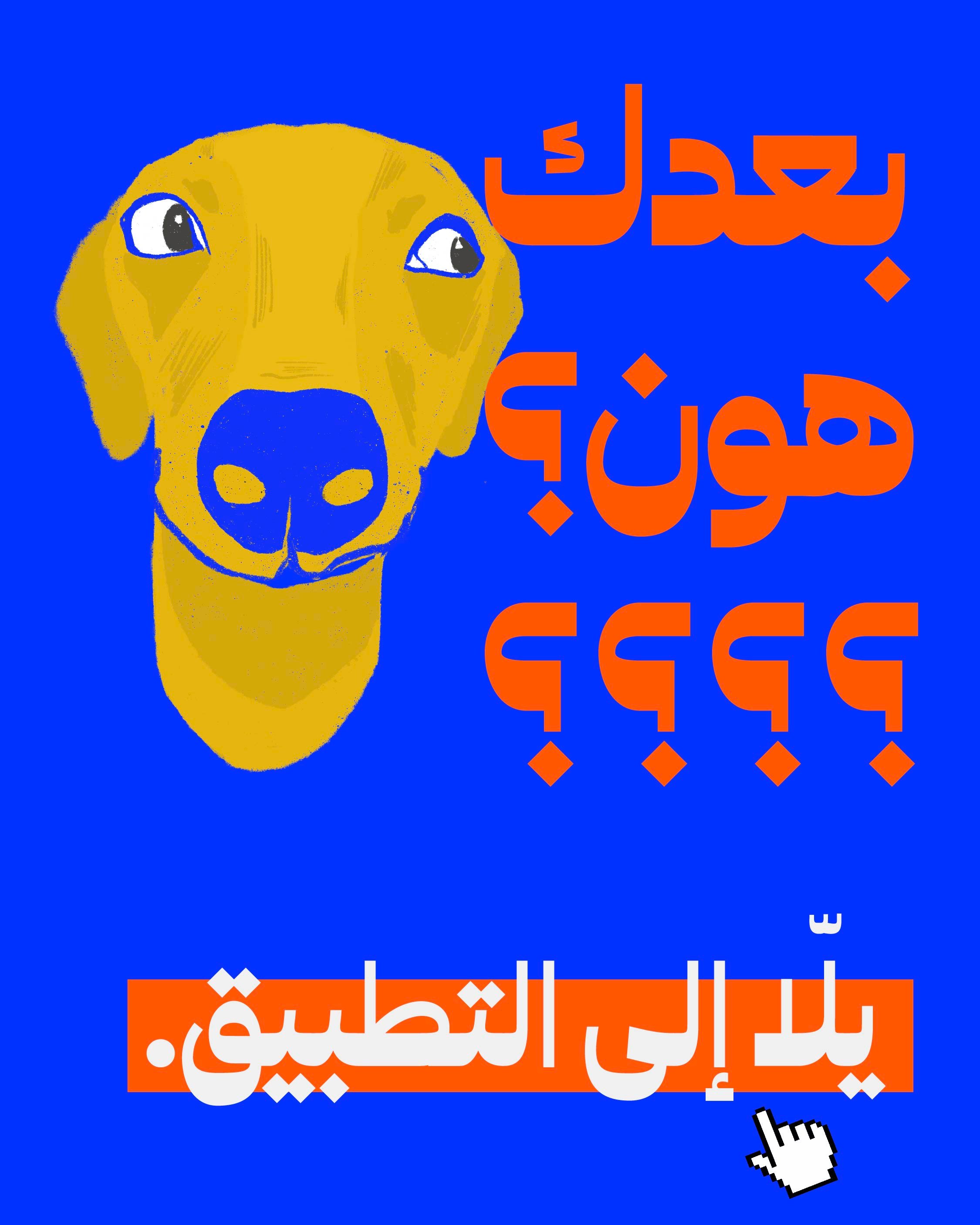هل سمعتم من قبل عن صندوق "عجايبك عجايب"؟ هو ببساطة صندوق خشبي كبير يحمله رجل، ويحتوي على فتحات زجاجية تُمكّن من ينظر عبرها من رؤية قصص تشبه إلى حد كبير السينما في الوقت الحالي، وقد اشتهر في دمشق زمن الحكم العثماني. ومن شدة انبهار الناس بهذا الاختراع، أسموه "صندوق العجائب"، أو بالعامية الدمشقية "صندوق عجايبك عجايب"، لأن ما يُشاهد خلاله كان يُعدّ أعجوبة في ذلك التوقيت.
اليوم، تبدو سوريا بأكملها وكأنها هذا الصندوق، حيث تحدث فيها يومياً أشياء عجيبة لا يقبلها العقل أحياناً، ويتابعها الناس دون فهم أسبابها أو كيفية حدوثها؛ فعلى سبيل المثال، عقب إسقاط نظام الأسد ووصول قيادات هيئة تحرير الشام ذات العقيدة الجهادية إلى الحكم، انقسم السوريون بين مؤيد لهذه السلطة الجديدة ورافض لها.
وفي حين أنه متفهّم الخلاف حول هذه السلطة الجديدة إلا أن الغريب في الأمر ما يكشف عنه تحليل سمات الأشخاص المنتمين إلى كل طرف منهما. فالفريق المؤيد أو المدافع عن السلطة الجديدة يضم يساريين وعلمانيين، وصحافيين ليبراليين، ومثقفين معروفين بعدائهم للإسلام السياسي، وأحياناً يرفض هؤلاء أي خطاب ينتقد أحمد الشرع وحكومته بحجة أهمية التلاحم وما يفرضة من ضرورة غضّ النظر عن الأخطاء حتى "بناء الوطن".
"السوريين لا يملكون اليوم المرونة الكافية للتعامل مع التغيّرات المتسارعة التي تمر بها بلادهم. فهم يعيشون في واقع لا يفهمونه. لذلك، تمثّل مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً أكثر استقراراً بالنسبة لهم… يبنون من خلاله واقعاً يشبههم"
على الجانب الآخر، نجد رجال دين يقفون ضد السلطة الحالية، رغم أن الناقد والمنتقد كليهما من خلفية دينية. كما نرى تنظيماً دينياً جهادياً ينتقد الشرع ويدعوه إلى التشاركية.
وعلى هذا الحال، يستمر المشهد اليوم في سوريا الجديدة حيث أصبح الانقسام سمةً مميزة، وهناك دائماً جمهوران، كلاهما على طرفَي نقيض؛ يذهب كل جمهور إلى حالة متطرفة في نقد الآخر، ومراجعة عيوبه، وتسليط الضوء عليها، دون الاهتمام بإظهار المشروع الذي يحمله الطرف الناقد، إذ أن الأهم هو تعرية الآخر واصطياد أخطائه.
ولا ينحصر هذا الانقسام والتخبّط في صفوف النخبة أو المهتمين بالشأن العام فقط، بل وصل إلى الطبقات الشعبية. بجولة سريعة على السوشال ميديا السورية، يمكن أن نلمس حجم الانقسام العمودي بين الأشخاص على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية والفكرية وميولهم السياسية وانتماءاتهم الدينية. وربما يشعر المتابع، من قراءة التعليقات أو المنشورات، باستحالة قدرة مكونات هذا الشعب على العيش معاً.
تظهر السوشال ميديا السورية وكأنما الجميع منغلق على نفسه، وكل طرف يدّعي المظلومية، ويتهم الآخر بالظلم أو الخيانة أو التبعية أو التطرّف، إلخ. كما يرى كل طرف أن الحل الأمثل للبلد هو القضاء على الآخر المخالف لفكره أو معتقده أو قوميته، مع السقوط المتكرّر في فخ تعميم الأخطاء وتضخيمها، بل وإسقاطها على الدين أو العرق، وكأن ما كان يجمع هؤلاء الأشخاص هو الخوف الأمني من النظام فقط، وبعد انكسار هذا الخوف ظهرت بواطن النفوس.
لكن هذا يستدعي التساؤل: هل هذا حقيقي؟ بكلمات أخرى: هل كل ما يصدر عن هذا الفضاء الافتراضي واقعي؟ أم أن السوشال ميديا لا تعكس الواقع السوري؟ وإن لم تكن سوريا الجديدة كما يبدو على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل ما يظهر مقصود؟ ومن قد تكون له مصلحة في ذلك؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا التقرير على ألسنة السوريين أنفسهم.
واقع مُرّ وفضاء للتجييش
"لا يمكن تجاهل حجم الانقسام بين السوريين اليوم. ببساطة، هناك نحو عقد ونصف من النزاع العسكري، الذي تحوّل في بعض جوانبه إلى نزاع طائفي، تبعه سقوط نظام الأسد بشكل دراماتيكي، وغياب القدرة على ضبط المشهد الأمني"، يقول الناشط المدني سومر الأحمد، من طرطوس لرصيف22.
يستخلص الأحمد مما سبق أن "حصول انفجارات دموية بين الجهات المتصارعة، راح ضحيتها الكثير من المدنيين من كل الأطراف، وفق منهجية طائفية تقتل الآخر بناءً على خلفيته الدينية"، مردفاً بأنه لأن السوشال ميديا وسيلة من وسائل "فشة الخلق"، أصبحت الملاذ الأول للتعبير عن الرأي، بغض النظر عن صلاحية هذا الرأي.
ويتابع الناشط السوري: "مع سهولة إنشاء حسابات وهمية، سواءً كانت وهمية تماماً أو بأسماء مستعارة، أصبح من السهل كتابة أي شيء يخطر ببال الناشر، دون إخضاعه لمنطق السلم الأهلي والوحدة الوطنية. مع الوضع بالاعتبار أن الدول الرافضة لاستقرار سوريا تعتبر السوشال ميديا خط جبهة متقدّم لتحقيق مصالحها، وتستفيد منها لتجييش فئات الشعب على بعضها بعضاً".
من هذا المنطلق، يقول الأحمد، إننا "نسمع أن أهل السويداء، وخصوصاً الدروز منهم، جميعهم متحالفون مع إسرائيل، وأن العرب السنّة في عموم سوريا متطرّفون، وأن الأكراد انفصاليون، وهكذا حتى آخر فرد في سوريا. وبمرور الوقت، تتغذّى هذه الخطابات لتصبح واقعاً في الوجدان الشعبي، ما يفسح المجال لقبول التعميم وتبرير أي جريمة في حق أي مكوِّن أُلصقت به تهمة ما، نتيجة قيام بعض أفراده بارتكاب خطأ ما".
كما يحذّر من أنه مع زيادة التجييش، يقتصر الحل لدى "البسطاء" على الهروب، أو المطالبة بالقضاء على الآخر صاحب السمعة السيئة، وفق ما يتم تداوله. لذلك، نرى، والحديث ما يزال للأحمد، أن ما يسيطر على السوشال ميديا السورية هو إما رفض البلاد بكليتها والدعاء بمغادرتها، أو المطالبة بالقضاء على الآخر المخالف في الرأي وإبادته، واعتبار مسألة استمراريتها في البلاد تهديداً لوحدة البلاد في حين أن "ضمان استمرار وحدة البلاد، هو استمرار كل أطيافها في عيش مشترك مصان وفق القانون".
"حقيقة أكثر من الحقيقة"
من جهته، يعبّر الناشط المدني سامر السعدي، من حلب، خلال حديثه إلى رصيف22، عن أن "السوريين لا يملكون اليوم المرونة الكافية للتعامل مع التغيّرات المتسارعة التي تمر بها بلادهم. فهم يعيشون في واقع لا يفهمونه. لذلك، تمثّل مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً أكثر استقراراً بالنسبة لهم… يبنون من خلاله واقعاً يشبههم، يختارون فيه من يشاؤون صداقته، ويقصون من لا يرتاحون لأفكاره. باختصار، يبحثون عن ذواتهم التي أضاعتها التغيّرات المستمرة التي تمر بها البلاد".
لهذا السبب، في رأي السعدي، "السوريون اليوم لا يرون الواقع الافتراضي واقعاً افتراضياً، بل صار حقيقيّاً بالنسبة لهم أكثر من واقعهم، من الحقيقة. وإذا حدث شيء ولم تغطِّهِ مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى بالنسبة لهم وكأنه لم يحدث. لذا، لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد ناقل للواقع، بل أصبحت تخلقه".
وهو يقر بأنه "ربما تعكس مواقع التواصل الاجتماعي بعضاً من الحقيقة، لكن علينا أن نسأل أنفسنا: هل توجد حقيقة في ظل هيمنة الواقع الافتراضي؟ إننا كبشر لم نطوّر ربطاً دقيقاً بين كلماتنا والواقع، لذا تجدنا نكيل الاتهامات والتهديدات دون أن نحفل بخطورتها".
وفق الصحافية عكاوي، فإن السوريين تعايشوا سابقاً بمحبة ولم يكن الخوف محرّكهم للتعايش، مستدركةً بأنه عقب عقود من التكميم على أيدي النظام الساقط، وعندما سنحت الفرصة للتعبير، بالتزامن مع الضغط والتجييش، تحوّلت الساحة العامة إلى بيئة خصبة للتراشق وبدأت الانقسامات
بينما ليس باستطاعة اثنين أن يقتلا بنفس المسدس في الوقت عينه، فإن بإمكانهما القتل بنفس الكلمة، يشرح السعدي، متابعاً: "من هنا، لم نطوّر بعد، كبشر، فهماً دقيقاً لخطورة مواقع التواصل الاجتماعي. ولكونها أعادت إنتاج الحرب. فالحرب لم تعد كما نعرفها؛ إنها تغرينا بالتجريد، وعدم ملامسة الواقع، والتعاطي مع كل شيء بوصفه إحصائيات وأرقاماً. إنه عالم لا يستند إلى الواقع، ويُقرَّر المنتصر والمنهزم وفق مجرياته".
"علامَ نلوم السوريين؟"
أما عن مدى قدرة السوريين على العيش معاً، فيقول السعدي: "لا أعتقد أن السؤال هو عن رغبة السوريين في العيش سوياً، بقدر ما هو: ماذا تبقّى من دولة الجلاء التي قامت على تحييد الانتماءات القبلية الأولية للأفراد لصالح هوية وطنية سورية جامعة؟ تلك الدولة التي قامت على أساس ليبرالي برلماني يؤمن بالتعددية السياسية والعمل الحزبي، وتقود مؤسساتها برجوازية مدنية راكمت، لسنوات، منذ العهد العثماني، ثم عهد الانتداب، ثم العهد الوطني، خبراتٍ في إدارة المؤسسات وبنائها".
ويمضي الناشط السوري قائلاً: "ماذا تبقّى من هذه الدولة بعد عقود من الحكم العسكري الذي أحلّ الولاء مكان الكفاءة، والقوة مكان الفكر؟ ثم جاءت حرب الـ14 عاماً، التي فكّكت ما تبقّى من هذه الدولة التي أنهكتها سنوات الانقلابات والمؤامرات. اليوم، إن أردنا أن نلوم السوريين، فعلينا أولاً أن نسأل أنفسنا: على ماذا نلومهم؟ على عدم تمسّكهم بالسراب؟ أليس الأجدى أن نسأل أنفسنا: هل قدّم أحد لعامة السوريين نموذجاً لإعادة بعث الدولة الوطنية ورفضوه؟".
لا يجيب السعدي عن سؤاله، بل يكتفي بالتأكيد: "إننا اليوم نتحدّث عن من يريد إعادة بعث الدولة من زاوية السيادة، في الوقت الذي يتحلّل فيه من وظائف الدولة ومسؤولياتها، وينكر عجزه عن خلق سردية سورية جامعة من جديد".
"لن يعود الأمر إلى ما كان عليه"
بدوره، يقول الصحافي والناشط سوار الصفدي، من السويداء، لرصيف22، إنه لا يعتقد أن مفهوم تقبّل الآخر في سوريا سيعود إلى ما كان عليه، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في كلٍّ من غرب وجنوب سوريا. وهو يبرّر ذلك بأنه "لم نشهد في التاريخ السوري، ولا سيما القريب، مفهومَي الجهاد والفزعة على مكوِّن آخر ضمن القطر السوري". وهو يؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي "لعبت، لا شك، دوراً هاماً في تأجيج الفتنة والتحريض الطائفي، وخاصةً الذباب الإلكتروني"، مستدركاً بأنها أيضاً "كان لها دور مهم في كشف نوايا الكثير من السوريين وخلفياتهم الطائفية، وخاصةً المثقفين أو من يدّعون ذلك".
ولا ينكر الصفدي أن ما يصفها بـ"أصوات الاعتدال في سوريا" لم تسلم أيضاً، حيث "انقضّت مواقع التواصل على جميع المكونات، بمن فيهم من كان داعماً للسلطة الانتقالية. عدا عن دور المؤثرين والمشاهير على هذه المنصّات، وتوجيههم الصريح وبكل الوسائل المتاحة لنشر خطاب الكراهية والتحريض عنوّةً. بل ولم يكتفوا بذلك، إذ شاركوا الصور والفيديوهات المضللة وساهموا في ترويج روايات زادت عمق الشرخ أكثر بين السوريين".
صك غفران للأقليات
أما عن التخوين والاتهامات، فيشدّد الصفدي على أن "المشكلة بلغت مداها بحيث يحتاج المرء في سوريا، ولا سيّما الأقليات، إلى صك غفران وبراءة بشكل دائم. حتى وإن كان الطرف الآخر قد اتخذ يوماً ما موقفاً يضعه في الخانة نفسها، إلا أن الفرق أنه ليس بحاجة ذلك الصك بحجة الأكثرية والواقع آنذاك".
أما عن اتهام طرف معين بالتطرّف، فيعتقد الصفدي أن كثيراً من المعنيين في هذا الصدد قد أثبتوا بأنفسهم الحجة المزعومة، تحديداً بعد تلبية "نداء الجهاد والفزعة". فالأمر إذاً، والحديث ما يزال للصحافي السوري، لا يقف عند رفض مكوّن لآخر أو مواطن سوري لآخر، بل إن الشرخ قد حصل، ولا يمكن إنكار ذلك أو تغطيته بعدما استُهدفت المكونات السورية واحداً تلو الأخرى، دون أي محاسبة أو ردع للمعتدين، أو استنكار من شركاء الوطن. فمن مجازر آذار/ مارس 2025 في الساحل السوري، إلى تفجير الكنيسة، إلى مجازر الجنوب، ومن بينها انتهاكات ريف حماة وريف دمشق، ولا سيما الاستفزازات المتكررة والانتهاكات اليومية قبل وقوع المشكلة الأكبر.
"وحدة الدم قبل الجغرافيا"
وعن اعتقاد البعض بأن السوريين تقبّلوا بعضهم سابقاً نتيجة الخوف من النظام الطاغية، يرد الصفدي: "الخوف والقمع كانا يستهدفان من يتكلّم في السياسة بشكل خاص، ومن أي طائفةً كانت، أي أنه كان موزّعاً على جميع السوريين دون المسّ بالمعتقدات الدينية أو تصنيف الأشخاص بحسبها".
"أما ما نشاهده اليوم، فلا أعتقد أنه بسبب الضغط والتجييش فقط، فقد هوجمت معظم المكوّنات والقوميات السورية، أي أن الجميع كان مستهدفاً، والمشكلة تكمن في الطرف المهاجم والفكر المتطرّف المنغمس فيه، والذي نشاهده اليوم"، يقول الصفدي.
وهو يشدّد: "إن أردنا المطالبة بالوحدة وعدم الانجرار وراء المشاريع الخارجية، يجب أن تكون الوحدة في الدم السوري قبل الجغرافيا، وأن يكون الجميع، من دون استثناء، مدركين لما يحصل على الساحة السورية. فالمشكلة الأغرب اليوم أن البعض ممن تسبّب في المقتلة، وجيّش وحرّض وقطع طرق الإمداد عن بعض المناطق، ينتظر المبادرة الأولى من قبل المُعتدى عليه، مستنكراً ما حصل، دون أن يطرح آلية جدّية للتعامل، بل يفاوض أي جهةٍ كانت طالما أنها ليست من الداخل، لنعود إلى سردية إرضاء الخارج على حساب الداخل".
تباين طبيعي
من جهتها، تعتبر الصحافية كلير عكاوي أنه "لا يمكن تقديم إجابة قاطعة عن سؤال إمكانية عيش جميع السوريين سوياً إذ أنه من المستحيل تعميم حكم واحد على الجميع". وتشرح: "الإنسان، في أي زمان ومكان، يتشكّل من مزيج فريد من طبيعته وظروفه وبيئته وتربيته، ما يؤثر حتماً على طريقة استجابته وتفاعله مع الآخرين. فكيف بمن عاشوا تحت وطأة الأزمات وتداعياتها العميقة؟".
وتخلص عكاوي إلى أنه "من الطبيعي أن نرى تبايناً في ردود أفعال السوريين، فبعضهم قادر على تجاوز الجراح وتقبّل الآخر، بينما سيجد آخرون صعوبة بالغة في ذلك. ولا بد من الإقرار بأن تقبّل الآخر يزداد تعقيداً في مجتمع يفتقر جزء منه، للأسف، إلى ثقافة هذا التقبّل أصلاً".
إضافة إلى ما سبق، تشير الصحافية السورية إلى تعدّد رؤى الشارع السوري لذاته، وتأثره بكيفية تفاعل الأفراد مع التغيّرات الجذرية الأخيرة. فهناك من يرى نفسه منتصراً ومفعماً بالأمل والحرية بعد سنوات الحرمان، وآخرون يرون في الواقع انهياراً وخيبة أمل، سواءً بسبب خذلان نظام قديم كانوا يعتبرونه قدوة، أو نتيجة صدمة من مسار التغيير ومآلاته، حتى لو كانوا من معارضي النظام السابق. كما يغلب على البعض الخوفُ من المجهول ورفض خلفيات ما هو قادم، على حد قولها لرصيف22.
"المشهد ليس موحداً"
مما سبق، تستنتج عكاوي أن "بعض السوريين وصلوا إلى مرحلة رفض الآخر، لكن المشهد ليس موحداً. فهناك شريحة واسعة رجّحت العقل على العاطفة، ولم ترفض الآخر رغم تعقيدات المرحلة، حيث تجلّى وعيها في التعامل بحكمة مع ما يجري، وباتت تطالب بتحقيق العدالة الانتقالية عبر تفعيل دور القانون في محاسبة الجناة من جميع الأطراف. في المقابل، تغلغل الألم في نفوس البعض الآخر، وتحكّمت به العواطف، فشعر بظلم شديد واتخذ من الثأر والانتقام الشخصي سبيلاً، ما دفعهم إلى رفض كل من يختلف معهم في الرأي".
وبنبرة تغلب عليها الحسرة، تستذكر عكاوي: "لقد تعايشنا سابقاً بمحبة، ولم يكن الخوف هو المحرّك للتعايش السوري. لكن النظام السابق منع حرية الرأي وكمّم الأفواه. وعندما سنحت الفرصة للتعبير، دون رقابة، بالتزامن مع الضغط والتجييش الهائلَين، والأخطاء الجسيمة والمجازر المتطرّفة من أطراف عدة، تحوّلت الساحة العامة إلى بيئة خصبة للتراشق بالاتهامات، ما أحدث انقساماً حاداً بين كثيرين رأوا أنفسهم ضحايا أبرياء من جميع الأطراف".
السوشال ميديا والصوت المعتدل
وعن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، تشير عكاوي إلى أنها لعبت دوراً محورياً في المشهد السوري، حيث أتاحت في البداية مساحات للتعبير، لكنها سرعان ما تحولت إلى ساحة صراع عمّقت الشرخ المجتمعي، وأجّجت الخلافات الطائفية والقومية والسياسية الكامنة في المجتمع.
وهي تشرح: "ساهم كثيرون في نشر الروايات المتحيّزة، والأخبار الكاذبة، والتحريض الممنهج، مستغلين ضعف الوعي الإعلامي لدى البعض، والرغبة في تصديق ما يؤكد قناعاتهم واتجاهاتهم، ما غذّى الكراهية وأدى إلى تآكل الثقة المتبادلة وتحجيم دور الصوت المعتدل".
كما كان للمؤثرين والمشاهير دور كبير في تشكيل الرأي العام، وفق عكاوي التي تزيد أن للبعض منهم دوراً سلبياً واضحاً في تأجيج الأمور، حين تخلّوا عن الحيادية والموضوعية، وانحازوا إلى طرف يخدم مصالحهم أو توجهاتهم الشخصية، بدلاً من تقديم محتوى متوازن. وهذا الانحياز، سواءً كان بقصد التحريض أو نتيجةً لقلةِ الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، يُعدّ سلوكًا غير مهني ويجب مساءلتهم قانونياً، خاصة عند نشر معلومات مضللة أو دعوات للكراهية والعنف.
بشأن شكل النظام القادم، يوضح الصفدي أن "طرح الفيدرالية أفضل من خيار الانفصال عن الجغرافيا الأم، لا سيما وأنه كان من الممكن تدارك ذلك عبر الحوار الجامع دون هذا النزيف كله"
ما العمل؟
وصولاً إلى الحلول الممكنة لتفادي اتساع الصدع بين السوريين، يقول سامر السعدي إن الأمر مرهون بإعادة إلباس الصراع ثوبه السياسي، ونزع الثوب الثقافي الذي أثقله عنه. ويشرح: "الصراع الثقافي هو صراع هويات ونمط حياة. وبالتالي، هو صراع صفري بينما الصراع السياسي هو صراع أفكار وبرامج، والآخر فيه هو خصم خلال فترة محددة، وهي الانتخابات. من هنا، علينا أن ندرك الخطأ الذي نكرره باستمرار وهو ألا نعطي كل لحظة ما تستحق. في حين أنه ينبغي علينا أن نفكّك لحظتنا الراهنة، ونسأل أنفسنا لماذا وصلنا إلى هنا".
وفي السياق نفسه، يتمسّك السعدي بأن "العنف ليس فقط ردّ فعل، بل ابن سياقات اجتماعية وكوامن بنيويّة جعلت العنف ممكناً. فالجماعات ليست مكونات طبيعية، إنما اصطناعية، ولا توجد وتتصلّب إلا في ظل التهديد. لذا، يجب أن ندرك أن كل عدوّ هو آخر لم نسمع قصّته بشكل جيد، وأن الشر الذي نعتقده في الآخر، غالباً، يكمن في داخلنا، وأن الآخر يستحق منا احتراماً غير مشروط بإنسانيته".
"علينا أن نعي أننا أبناء ثقافة بدوية تميل للانتقام، وترى فيه رسالة لمن ظلمنا بأننا لسنا ليّني العريكة، وترى التسامح قمة ما قد تمنحه من تنازلات للآخر. لذا، علينا أن ندرك اليوم بأن التسامح مقولة أيديولوجية، وأنه حل متعجرف. فالاختلاف ليس رحمة، بل حقيقة في عالمنا، وعلينا تقبّله كما هو. وربما الفيدرالية ليست حلاً فقط في ظرفنا الحالي، بل ضرورة لكي تؤمّن مرحلة انتقالية لا بد منها، لكي نعيد قراءة ما حدث دون استعجال للخلاصات"، يختم.
وحول سُدّة الحكم وشكل النظام القادم، يوضح الصفدي أن "طرح الفيدرالية أفضل من خيار الانفصال عن الجغرافيا الأم، لا سيما وأنه كان من الممكن تدارك ذلك عبر الحوار الجامع دون هذا النزيف كله. ما يجب فعله هو الوقوف كجسد واحد، وباسم الانتماء والجنسية، دون التطرّق إلى المعتقدات الدينية والقومية، والاعتراف بحقيقة ما حصل وبحقوق الآخر أياً كان، ومن جميع الأطراف، دون إنكار أو تسخيف للأحداث الأخيرة، وأعتقد أن الأهم لمحاولة تدارك ما حصل، ألا يستند أي مكوّن إلى السلطة والحكومة، بل يجب –وإن فات الأوان حتى– أن ينتفض الشعب السوري كاملاً، وينفض غبار الكراهية والحقد، ويصلح ما ارتكبت الحكومة من مجازر في حق الجميع".
تعزيز القانون والفدرلة
وبحسب عكاوي، "يمكن للسوريين العودة لتقبّل بعضهم بعضاً بعد وقف التجييش، وهي تعوّل في ذلك على تدخّل العقلاء ونشر الوعي المجتمعي، مع الاعتراف بأن الأمر يحتاج إلى وقت وخطوات واضحة وصريحة تعزّز الثقة بين الشعب والسلطة.
"في الحقيقة، أنا لست مع التقسيم، لكن الفدرلة مقبولة بالنسبة لي بشرط بقاء أجزاء سوريا تحت مظلة الدولة المركزية وحكومتها، بهدف حقن الدماء والوصول إلى حلول مشتركة تؤدي إلى ولادة وطن آمن يضمن حقوق الفرد"، تصر عكاوي.
"يجب أن ندرك أن كل عدوّ هو آخر لم نسمع قصّته بشكل جيد، وأن الشر الذي نعتقده في الآخر، غالباً، يكمن في داخلنا، وأن الآخر يستحق منا احتراماً غير مشروط بإنسانيته".
أما "الأهم"، بالنسبة للصحافية السورية، فـ"هو تعزيز سيادة القانون لتفعيل العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات من جميع الأطراف بشكل علني، مع ضرورة بسط الأمن والاستقرار، والسعي لتحقيق نهضة اقتصادية تسهم في هذا الاستقرار وتوفّر فرصَ عمل وسبلَ عيشٍ كريم للمواطنين، بالتوازي مع التوعية المجتمعية بالحقوق والواجبات والمفاهيم الأساسية كالمواطنة والعيش المشترك، وكل ما يؤدي إلى بناء وطن موحد لكل السوريين".
شركاء يتقاسمون الخراب
ختاماً، الحالة الشعبية السورية اليوم أكثر تعقيداً من تلك التي تشهدها النخب السياسية أو الثقافية، وهو تعقيد غير مسبوق. فعلى مدار سنوات، اعتدنا رؤية الانقسام بين السياسيين خدمةً لمصالحهم، بينما كان المواطنون دوماً وقود هذا التناحر. أما اليوم، فالوضع مختلف تماماً، ويستدعي حلاً عاجلاً يحفظ البلاد، بغض النظر عن شكل نظام الحكم، سواء كان مركزياً أو فدرالياً.
ولعل ما حافظ على سوريا في الماضي هو تعاضد أبنائها في مواجهة الأزمات، منذ ما قبل الاستقلال وحتى يومنا هذا. لكن الصدمة المجتمعية الراهنة أفرزت مناخاً يشعر فيه الفرد بأن الحليف السياسي الخارجي لفئة ما أقرب إليه من جاره في المدينة المجاورة.
وهنا، يتحول الشعب السوري من شعب يسعى إلى تقرير مصيره السياسي إلى شركاء في تقاسم الخراب، وهو ما يُعد أخطر من اندلاع حرب أهلية أو طائفية، أو حتى الخضوع لاحتلال. فكل حرب لها نهاية، وكل احتلال سينجلي عاجلًا أم آجلًا، أما اتساع هوة التباعد بيننا، فسيترك أثراً عميقاً لا على الجغرافيا فحسب، بل على استمرارية سوريا التي امتدت لآلاف السنين. وفي هذا السياق، لن يكون أي نظام، سابقاً كان أو حالياً أو لاحقاً، قادراً على حماية البلاد من هذا التآكل الداخلي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.