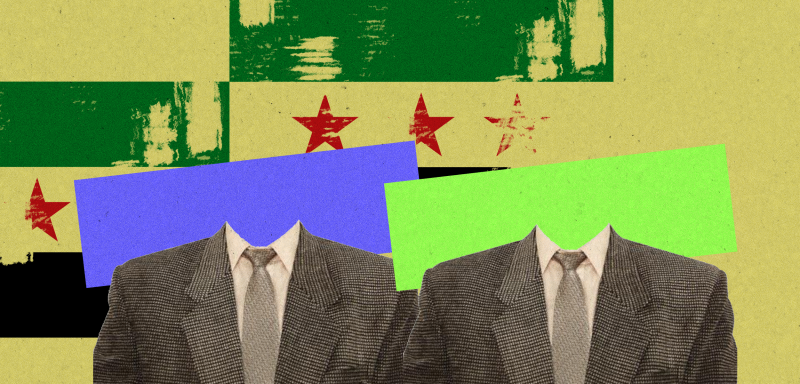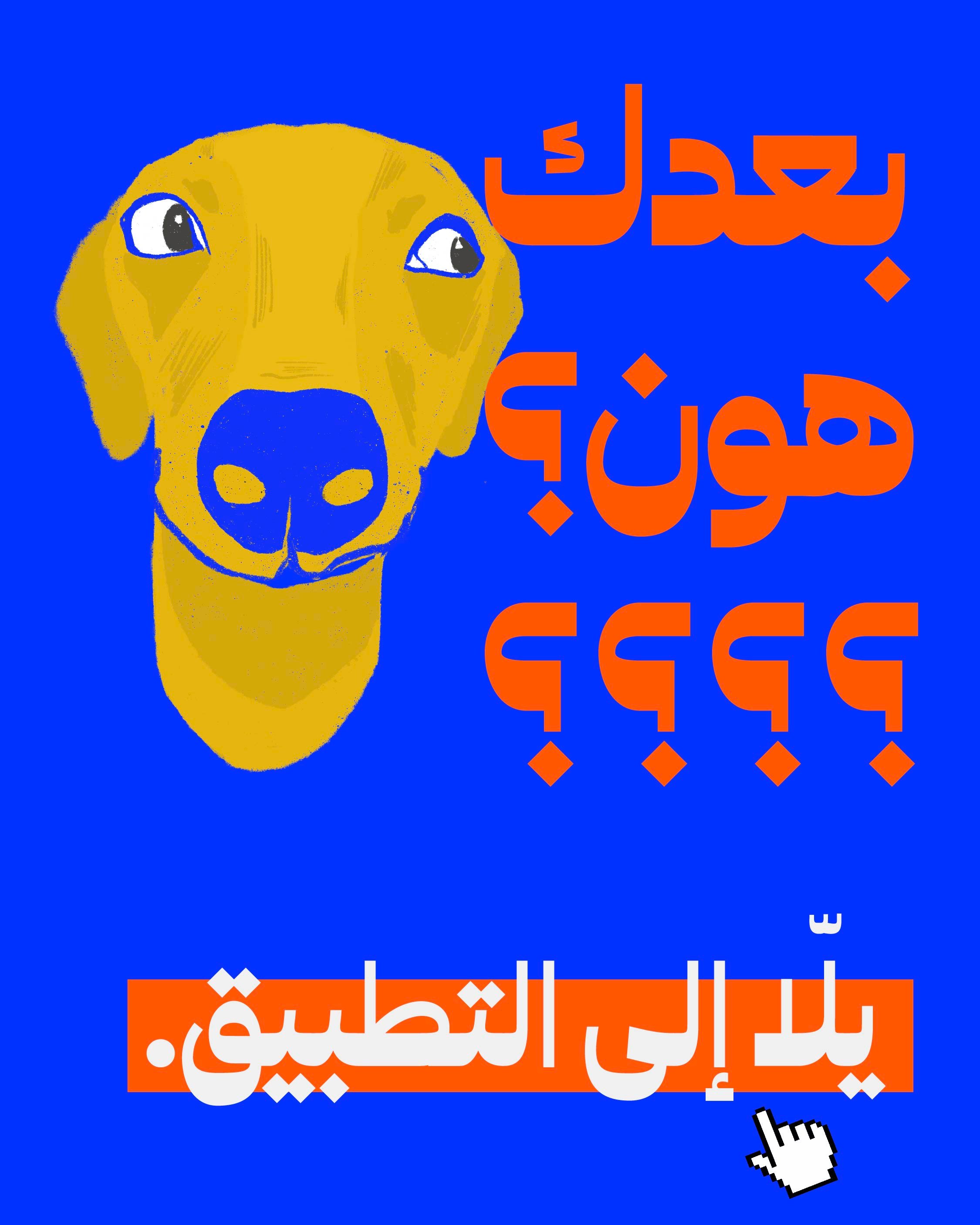في مرحلة تُوصف بأنها انتقالية بكل ما تحمله الكلمة من هشاشة وإمكانيات، تبدو التعيينات في مؤسسات الدولة السورية واحدةً من أكثر المؤشرات تعبيراً عن كفاءة إدارتها، إذ لم تعد المسألة مرتبطةً بمن يشغل المنصب فحسب، بل بما تعنيه هذه التعيينات من رسائل أو تساؤلات رمزية حول معايير المرحلة المقبلة: هل هي مرحلة ولاءات جديدة؟ أو بداية لسياسة إدارية مختلفة قوامها الكفاءة والإصلاح؟ وما أثر هذه السياسات على الاقتصاد السوري، خاصةً في ظل الحديث عن بيئة استثمارية ومالية جديدة ورفع تدريجي للعقوبات؟
بين مؤشرات السوق، ومخاوف التكرار، وأزمات الكفاءة، يبرز سؤال جوهري: كيف تعيد الدولة إنتاج نفسها في مرحلة ما بعد البعث والأسد؟
التعيينات… كمؤشر أوّلي ضخم
مع تغييب الكفاءات، وتآكل الثقة بالمؤسسات من منظور الإدارة والشرعية الاجتماعية، يقرأ بعض الباحثين التعيينات من زاوية تأثيرها على علاقة الدولة بمواطنيها. هنا يقول الدكتور طلال عبد المعطي، الباحث في "المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة"، إنّ تغييب شرائح مهنية واسعة عن مؤسسات الدولة لا يُعدّ فقط خطأ إدارياً، بل خطوة لها تبعات عميقة على العلاقة بين الدولة والمجتمع.
تبدو سوريا في مرحلة ما بعد البعث والأسد وكأنها تقف على مفترق طرق: التعيينات الإدارية لم تعد مجرد وظائف، بل رسائل سياسية مشحونة بالرموز. فهل نحن أمام ولادات جديدة لشبكات الولاء أم أن هناك رغبة حقيقية في إدخال الكفاءة كمعيار؟ هذا السؤال وحده كفيل بكشف ملامح الدولة المقبلة
يقول عبد المعطي، لرصيف22: "هذا التغييب يُنتج فجوةً متناميةً بين الدولة ومجتمعها المهني، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص، ما ينعكس سلباً على الأداء العام، ويكرّس شعوراً عاماً بالغبن واللامساواة".
ويضيف أنّ الدولة، حين تُقصي الكفاءات لصالح المحسوبيات، تخلق بيئةً تشعر فيها فئات واسعة بعدم الانتماء، وتنتج تمثيلاً زائفاً للواقع السوري المتنوّع.
ويحذّر عبد المعطي من أنّ "التعيينات المنحازة تعمّق الانقسام داخل الدولة نفسها، وتخلق حالة تنافس غير عادلة، فبدلاً من أن تكون الدولة مساحةً مشتركةً للجميع، تصبح أداةً بيد فئة ضيّقة، ما يُضعف التماسك الاجتماعي ويهدد وحدة النسيج الوطني".
من يحرّر يقرّر… في الاقتصاد كما في السياسة
ماذا عن التعيينات كمؤشر اقتصادي أو معيق للاستثمار داخل بنية القرار الاقتصادي؟ هنا يظهر سؤال الخبرة كمعضلة متجددة، وفي هذا الشأن يرى الصحافي والخبير الاقتصادي معمر عوّاد، أنّ واحدةً من أكبر أخطاء السلطة في المرحلة الانتقالية كانت إقحام أشخاص بلا خبرة في مواقع القرار تحت شعار "من يحرّر يقرّر".
يقول لرصيف22: "هذه التعيينات من خارج الخبرة كانت عبئاً على الإدارة، وسبّبت بطئاً في وتيرة الإنتاج، وأضعفت ثقة رجال الأعمال المحليين والدوليين، خاصةً في ظل غياب من يشرح القوانين ويفسّرها".
ويحذّر عواد من أنّ استمرار هذا النهج، في وقت تستعد فيه سوريا لانفتاح اقتصادي بدعم إقليمي ودولي، يعني تضييق فرص جذب رؤوس الأموال، وإعادة إنتاج أزمات الإدارة والبيروقراطية التي عرفها السوريون لعقود.
استثناء الكفاءات لا يفرّغ مؤسسات الدولة من خبراتها فقط، بل يخلق فجوة ثقة مع المجتمع ويكرّس الشعور باللامساواة، وكأن الدولة تتحول إلى ناد مغلق لفئة ضيقة، مما يهدد فكرة الانتماء الوطني ذاتها.
ويجد أنّ مرحلة ما بعد الحرب كانت فرصةً لمراجعة السياسات الإدارية، لكن ما حدث فعلياً هو استمرار النمط القديم من التعيينات، والذي تَمثّل في إقحام شخصيات لا تملك الخبرة اللازمة في مواقع القرار، واصفاً هذه المرحلة بأنها "فرصة أُهدرت جزئياً"، بسبب تغييب الكفاءات الوطنية عن صياغة السياسات الجديدة.
وبحسب عواد، فإنّ تغلغل المحسوبية في التعيينات ساهم في تعقيد الإجراءات البيروقراطية، وفي إضعاف قدرة مؤسسات الدولة على جذب الاستثمارات، وبرغم صدور قوانين جديدة، مثل قانون إعادة الإعمار، إلا أنّ البيئة الإدارية، برأيه، بقيت غير قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.
ويتابع: "رؤوس الأموال -المحلية والخارجية- ما زالت مترددةً، لأنّ الإدارة الاقتصادية لا توفّر حتى الآن الشفافية أو التفسير الواضح للقوانين".
فمن وجهة نظر الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال، النوايا ليست ذات وزن، بل الإشارات الرمزية المتراكمة. لذلك يرى الكاتب والصحافي مالك داغستاني، أنّ الاستثمار في "سوريا ما بعد الأسد" ليس فعلاً اقتصادياً فحسب، بل هو تصويت غير معلن على نصّ سياسي جديد.
ويشرح لرصيف22: "حين تبدأ الأموال بالتدفق نحو سوريا، فإنها لا تعني فقط فرص عمل ومشاريع تنموية، بل تعني إعلاناً عن بداية سردية مختلفة، من الفوضى إلى إمكانية الحياة". ويضيف أنّ المستثمرين لا يتحرّكون بدافع وطني أو أخلاقي، بل لأنهم يملكون حاسةً خاصةً لقراءة المستقبل، وقد رصدوا علامات على تحوّل قادم لم نقرأه جيداً كسوريين بعد.
لكن هذا "التصويت" الاقتصادي ليس مضموناً. وفق داغستاني، فإنّ تراكم البيروقراطية، وغياب الكفاءات في مراكز القرار، قد يشكّلان عائقاً كبيراً أمام استدامة هذا الزخم الاستثماري المحتمل.
إصلاح بلا أدوات؟ الاقتصاد الزراعي والمالي
وفي حين يُركّز الخطاب الرسمي على فرص الإعمار والتدفقات المالية المنتظرة، يغيب أحياناً الحديث عن البنية الاقتصادية العميقة القادرة على استيعاب هذا الإعمار وتحويله إلى واقع منتج. فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى قاعدة زراعية وصناعية متينة، ونظام مالي قادر على مواكبة المرحلة.
من هنا، يطرح الدكتور سمير العيطة، رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، تساؤلات جوهريةً حول طبيعة الاقتصاد الذي يمكن أن ينهض بسوريا، محذّراً من اختزال الإصلاح في الشعارات أو المناسبات دون أدوات حقيقية للتنفيذ.
كما يتساءل حول شكل الاقتصاد الذي يمكن أن تنهض به سوريا، مشبّهاً الوضع الحالي بما شهدته الولايات المتحدة بعد أزمة 1929. لكنه يرى أنّ أيّ "نهوض" لا يمكن أن يتم من دون إستراتيجية واضحة لإعادة إحياء القطاعَين الزراعي والصناعي، ووقف النزيف المالي.
ويقول إنّ كثيراً من السدود الزراعية مهدد بالانهيار، بسبب غياب الصيانة، وإن القحط يهدد الأمن الغذائي السوري في ظل موسم زراعي هو الأسوأ منذ سنوات. ويرى أنّ السياسات الحالية، التي تعتمد على الإعلانات والمهرجانات بدل إصلاح الهياكل، غير قادرة على خلق ثقة أو بيئة إنتاج حقيقيتين.
السؤال الأشد خطورة اليوم: هل تستطيع سوريا بناء اقتصاد حقيقي بلا أدوات إنتاج حقيقية وبلا خبرات مؤسساتية؟ فالزراعة مهددة، والصناعة مترنحة، والقطاع المالي يعيش في فوضى نقدية... ودون إصلاح جذري لهذه البنى، سيبقى كل حديث عن الإعمار مجرد ديكور سياسي ينهار عند أول اختبار برأي كثير من الاقتصاديين السوريين
وعلى الصعيد المالي، يثير الدكتور العيطة ملف تطبيق "شام كاش"، المرتبط ببنك مقره خارج مناطق سيطرة النظام سابقاً، عادّاً أنّ ربط الرواتب به يخلق ما يشبه "أداةً موازيةً تهدد وحدة القرار النقدي"، ويقوض سيادة البنك المركزي السوري. ويضيف: "لا يمكن الحديث عن اقتصاد حقيقي في ظل كبح السيولة وحرمان السوريين من تحويلات المغتربين، وتحويل البلاد إلى اقتصاد كاش".
من الجدير بالذكر أنّ تطبيق "شام كاش" يُعدّ ذراعاً رقميةً لبنك الشام، ويقدّم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، ولا يخضع لإشراف مباشر من مصرف سوريا المركزي، ويُستخدم كواجهة مالية جديدة للسلطة الحالية لتعزيز السيطرة على الحركة النقدية الرقمية في المناطق التابعة لها.
ويدعو عواد إلى ضرورة العمل على تثبيت سعر الصرف، وطرح أدوات دين محلية من خلال البنوك، وأن تقوم هذه البنوك بأدوار أكبر من دورها التقليدي في عملية الإيداع والإقراض، وطرح أدوات استثمارية جديدة، لذلك يحتاج الأمر إلى إدارة واعية في مركز الإشراف على أدوات السياسة النقدية، وكذلك في التعامل مع وزارة المالية، ويعتقد أنّ هذا القطاع يحمل كثيراً من الفرص، لكن أيضاً أمامه تحديات كبيرة، خاصةً أنّ العالم دخل مرحلة التكنولوجيا المالية والفنتك (Financial Tech) والتحويلات الرقمية، لكنه يرى أنّ هذا القطاع ما زال متخلّفاً، وأمامه الكثير من الفرص على مستوى التأهيل والتدريب لكوادره الحالية.
البنوك السورية… صورة أكثر تعقيداً
من جانبه، يلفت الخبير الاقتصادي أنس الفيومي، إلى مفارقة لافتة: عشرات القوانين تُسنّ كل عام، لكنها لا تُترجم إلى تحسن ملموس في حياة السوريين. ويقول إنّ الواقع المصرفي لا يزال يفتقر إلى الثقة.
يقول: "هناك تصريح قديم لأحد رؤساء مجلس الوزراء تباهى فيه بأنّ سوريا وخلال عام واحد أصدرت أكثر من 120 قانوناً ومرسوماً. يومها في تعليق لي على هذا التصريح قلت: إذا كان حجم التشريعات التي صدرت لم يصنع ابتسامةً أو فرحةً على وجه المواطن البسيط فجميع هذه التشريعات ليس لها أي تواجد على أرض الواقع. وهذا ينسحب على مجمل الأخبار التي وردت في الآونة الأخيرة حول رفع العقوبات عن سوريا، فإلى الآن لم يلمس المواطن العادي أثراً إيجابياً لهذا الرفع حتى وصل إلى مرحلة الشك في أنّ هناك رفعاً حقيقياً".
برغم الضجيج الإعلامي حول رفع العقوبات عن سوريا، لكن لم يلمس الناس أيّ أثر حقيقي لذلك في حياتهم اليومية بعد. فالأسعار بقيت مرتفعة، وفرص العمل نادرة، والبنية التحتية الاقتصادية على حالها من التدهور.
والمناخ العام حتى الآن -بحسب فيومي- لا يشجع على الاستثمار، خاصةً مع غياب البنية التقنية، وتردد البنوك الدولية في تنفيذ التحويلات، برغم إعلان الانضمام إلى نظام "SWIFT".
ويضيف: "القاعدة التقنية للمصارف ضعيفة، والتشريعات وحدها لا تكفي ما لم تقترن بكفاءات بشرية مدرّبة وقادرة على العمل مع النظام المالي العالمي وفق معايير الشفافية والمكافحة".
ويؤكد أنّ دعم مرحلة الانفتاح يحتاج إلى أربعة أعمدة: نظام SWIFT فعّال، قوانين استثمار ضامنة، قاعدة برمجية متينة، وكفاءات مدرّبة. وكلها، حتى الآن، إما غير مكتملة أو غير مفعّلة.
من يجيب عن الأسئلة المركزية؟
بين الخوف من التكرار وأمل التغيير ربما يكون أكبر تحدٍّ يواجه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد ليس في إعادة الإعمار المادي، بل في إعادة بناء مفاهيم الدولة نفسها: ما هي الدولة؟ من يُمثّلها؟ ولمن تعمل؟ هذه الأسئلة لم تعد ترفاً فكرياً، بل أصبحت مركزيةً لأيّ تصوّر مستقبلي مستدام.
التعيينات ليست مجرد قرارات إدارية، بل مؤشرات على العقل السياسي الذي يدير المرحلة، وإن بقيت تحكمها الولاءات أو الحسابات الأمنية أو الإقصاء المبطن، فإنّ النتيجة ستكون إعادة تدوير الماضي بثياب جديدة، لا قطيعة معه.
أما الاقتصاد، فإنه يظل مرآةً دقيقةً لما يجري في العمق، فإن لم تُرافق السياسات الاقتصادية خطوات حقيقية نحو الشفافية، والكفاءة، وتمكين الناس من فرص متكافئة، فلن يُقنع أيّ مؤتمر استثماري أو أي وعود إعمار، أحداً بأن شيئاً تغيّر حقاً.
هكذا، تظل لحظة التحوّل السورية رهينة معادلة صعبة: دولة تُولد من رحم الصراع، لكنها لا تزال مترددةً في اختيار ملامحها، وإن كان التاريخ لا يُعيد نفسه، فإنه كثيراً ما يُقلّد ذاته بإخلاصٍ مؤلم، إن لم يُدرك الفاعلون لحظة القرار الحقيقي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.