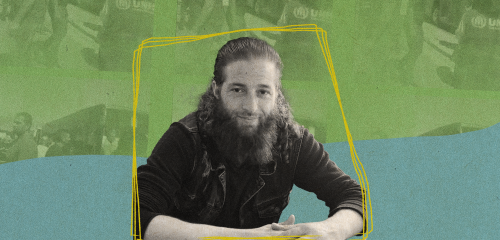شكّل عام 2025 لحظةً فاصلةً في القيادة السياسية في كل من سوريا ولبنان. ففي سوريا، أدى انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى إنهاء أكثر من خمسة عقود من الحكم الاستبدادي البعثي. ووضعت الحكومة الموقتة التي انبثقت - بقيادة أحمد الشرع من هيئة تحرير الشام - نفسها في موقع الطليعة لسوريا الجديدة، وتعهّدت بتحقيق العدالة وسيادة القانون والحكم التشاركي بعد سنواتٍ من الحرب والقمع والإفلات من العقاب.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، انتهى "الجمود السياسي" الذي طال أمده في لبنان في كانون الثاني/ يناير 2025، بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام رئيساً للوزراء. ووعدت القيادة الجديدة في بيروت أيضاً بالابتعاد عن الطائفية المتجذّرة في المجتمع اللبناني وإنهاء الجمود في مؤسسات الدولة، داعيةً إلى أجندة إصلاحية شاملة لاستعادة سيادة الدولة على كل أراضيها واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد.
ترافقت هذه التحوّلات السياسية في كلا البلدين مع تحوّل ملحوظ في الخطاب العام. فأصبحت لغة "الإدماج" و"العدالة" و"التنوع" و"الديمقراطية" محورية في كيفية صياغة النخب لبرامجها والتفاعل مع الجمهور الوطني والمجتمع الدولي. ودعا القادة في بيروت ودمشق إلى المساواة والتعايش والمساءلة - واضعين أنفسهم في مصافّ الإصلاحيين الذين يسترشدون بدروس النزاع وضرورات التعافي الوطني. في سوريا، كان التركيز على الحوار والسلم الأهلي، وفي لبنان، على إحياء المؤسسات والوحدة الوطنية. ويمثل هذا التحوّل الخطابي ابتعاداً كبيراً عن السرديات الاستبدادية والطائفية والزبائنية التي طالما ميّزت النظامين. لكنه يثير أيضاً سؤالاً نقدياً: من هو المقصود بالضبط بهذا الخطاب؟
يستكشف هذا المقال ما إذا كان هذا الخطاب الإصلاحي المعتَمد حديثاً، في كل من سوريا ولبنان، يشمل حقاً الفئات السكانية الأكثر ضعفاً من الناحية السياسية، أي اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، والنازحين داخلياً والعائدين في سوريا. يمثل هذا التحوّل الخطابي ابتعاداً كبيراً عن السرديات الاستبدادية والطائفية والزبائنية التي طالما ميّزت النظام في البلدين. لكنه يثير أيضاً سؤالاً نقدياً: من هو المقصود بالضبط بهذا الخطاب؟
يستكشف هذا المقال ما إذا كان هذا الخطاب الإصلاحي المعتَمد حديثاً، في كل من سوريا ولبنان، يشمل حقاً الفئات السكانية الأكثر ضعفاً من الناحية السياسية، أي اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، والنازحين داخلياً والعائدين في سوريا. وفي حين أن لغة الحقوق وإدماج هذه الفئات تظهر الآن بشكلٍ جليّ في الخطابات والبرامج الحكومية والتصريحات عن المرحلة الانتقالية، إلا أن قضية النازحين تبقى غالباً هامشيّة في خطابات المسؤولين، فيُدرجون بشكل ضيق في خانة المخاطر الأمنية أو الأعباء الديموغرافية أو التحديات اللوجستية. وبدلاً من إشراكهم كفاعلين سياسيين أو أصحاب حقوق كاملة، يُغيَّبون غالباً من المخيلة الإصلاحية.
يوفر النزوح عدسة قوية يمكن عبرها تقييم مدى صدق التحوّل السياسي وجوهره. فالطريقة التي تعالج بها الحكومة حقوق واحتياجات ومستقبل من اقتُلعوا قسراً من ديارهم - خصوصاً عندما يكون النزوح نتيجة لعنف الدولة أو انهيار المؤسسات أو الصراع الذي طال أمده - تقدم نظرة ثاقبة على ما إذا كانت وعود العدالة والإدماج آلية للتنفيذ أم تبقى مجرد شعارات للاستهلاك. وبينما تدخل سوريا ولبنان فصلاً سياسياً جديداً، ستكون معاملة النازحين مؤشراً واضحاً على إمكانية أن يمثل الخطاب الإصلاحي بدايةً لسياسة أكثر شمولاً، أو مجرد إعادة صياغة للإقصاء تحت مصطلحات أكثر مقبولية.
ففي لبنان، ومنذ بداية 2025، تبنّى الخطاب السياسي لغة إصلاحية علنية، مع التشديد على الوحدة الوطنية وإحياء المؤسسات واستعادة سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. لكن في هذا الخطاب، بقي اللاجئون السوريون والفلسطينيون مهمشين بشكلٍ واضح - ليس من خلال العداء الصريح، بل من خلال الإدماج الانتقائي الذي يعزز تغييبهم السياسي. وفي حين تذرّعت القيادة الجديدة بمصطلحات "العدالة" و"المساواة" و"المواطنة" كركائز للتجديد، اقتصرت هذه المصطلحات في الغالب على المواطنين اللبنانيين. في المقابل، يجري تصوير اللاجئين باستمرار على أنهم عبء ديموغرافي أو تهديد اقتصادي أو أمني - وليسوا أفراداً لهم حقوق، أو هم أصحاب مصلحة في مستقبل البلاد السياسي أو الاقتصادي
أما في سوريا ما بعد الأسد، فقد تحوّل النزوح من أحد أعراض عنف الدولة إلى رمز للمصالحة الوطنية والتجديد. ورددت الحكومة التي يقودها أحمد الشرع مراراً وتكراراً أن النازحين واللاجئين العائدين مساهمون أساسيون في إعادة إعمار سوريا. وتطرقت الخطابات التي ألقيت في الحوارات الوطنية والتجمعات الانتقالية إلى العودة باعتبارها واجباً وطنياً ومقياساً لتعافي البلاد. وجرى تصوير العائدين على أنهم أبطال في نهضة وطنية جماعية، ويُحتفى بعودتهم إلى الوطن كدليل على أن البلاد طوت صفحةً من صفحات الماضي.
على الرغم من أن لغة العدالة والإدماج والإصلاح تهيمن الآن على الخطاب السياسي لما بعد العام 2025 في سوريا ولبنان، إلا أن تطبيقها لا يزال محدوداً. وتُنفذ هذه المصطلحات بشكل انتقائي - إلى حد كبير على المواطنين والمجموعات المعترف بها سياسياً - بهدف تعزيز الشرعية والإشارة إلى التوافق مع المعايير الدولية. وفي الوقت نفسه، يبقى النازحون خارج هذه الرؤى الإصلاحية، مستبعدين من المجتمع السياسي الذي يُفترض بهم إعادة بنائه.
من أجل أن يتجاوز الإصلاح في سوريا ولبنان الأداء، يجب أن يتصدى للإقصاء الإستراتيجي الذي كشف عنه النزوح ومكّنه في آنٍ واحد. فلا يمكن تحقيق الوعود بالعدالة والتنوع والتجديد الوطني في الوقت الذي يبقى فيه ملايين النازحين - اللاجئون السوريون والفلسطينيون في لبنان، والنازحون والعائدون في سوريا - خارج حدود الاعتراف السياسي والإصلاح
لا يُستخدم التهجير كمؤشر على فشل الدولة في الماضي فحسب، بل كمؤشر على النوايا السياسية الحالية. وفي أعقاب التحولات في القيادة في سوريا ولبنان، فإن كيفية التعامل مع السكان النازحين لا تقدم نظرة ثاقبة على الأولويات الإنسانية فحسب، بل على إعادة تقويم - أو إعادة تقليم - شرعية الدولة. يتذرع الخطاب الإصلاحي في كلا البلدين بالإدماج والعدالة، إلا أن النزوح يشكل تحدياً لا يمكن حله من خلال الخطاب وحده. فهو يتطلب إعادة توزيع الحقوق، إعادة تعريف الانتماء، وإعادة هيكلة السلطة، وهو بالضبط ما تتجنبه أجندات الإصلاح في مرحلة ما بعد العام 2025.
إلى ذلك، فإن التعامل مع التهجير كاختبار حقيقي يعني طرح أسئلة أصعب على الإصلاح نفسه. هل الإصلاح هو إعادة هندسة المؤسسات أم توسيع العضوية السياسية؟ هل يمكن للدولة أن تدعي التحول إذا كانت تعيد تأكيد التسلسل الهرمي القديم للانتماء؟ حين يُنظر إلى النازحين على أنهم مجرد إحصاءات يجب إدارتها، أو رموز ينبغي استعراضها، فإن وعود الإدماج تبدو جوفاء.
من أجل أن يتجاوز الإصلاح في سوريا ولبنان الأداء، يجب أن يتصدى للإقصاء الإستراتيجي الذي كشف عنه النزوح ومكّنه في آنٍ واحد. فلا يمكن تحقيق الوعود بالعدالة والتنوع والتجديد الوطني في الوقت الذي يبقى فيه ملايين النازحين - اللاجئون السوريون والفلسطينيون في لبنان، والنازحون والعائدون في سوريا - خارج حدود الاعتراف السياسي والإصلاح. فهذه المجتمعات ليست مجرد حالات إنسانية أو اعتبارات لوجستية، بل هي جهات سياسية فاعلة يعكس نزوحها ملامح سلطة الدولة ويعيد تشكيلها في آن واحد.
*أعدّت جاسمين ليليان دياب، هذه المقال التحليلي، وهي مديرة معهد دراسات الهجرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ويمكن الاطّلاع على النص الكامل عبر مبادرة الإصلاح العربي (ARI).
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.