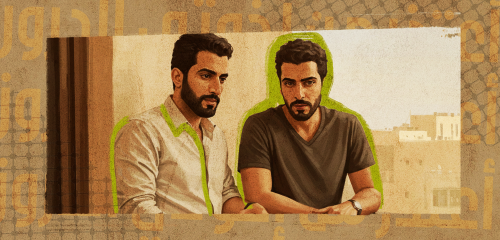من يحكم البادية حين تنسحب الدولة؟ ومن يملأ الفراغ حين تتداخل المفاهيم بين ولاء الدم والمواطنة؟ وهل العشائر السورية مجرّد بقايا نظام قديم استثمرها ثم همّشها أو أنها كيان حيّ يعيد تشكيل ذاته في قلب الفوضى بأدوات قديمة لكن فعّالة؟
من دير الزور إلى السويداء، ومن بادية حمص إلى سهول الرقة، قد لا تتشابه العشائر السورية تماماً في أنماط عيشها، لكنها تتفق في إدراكها ثقلها السياسي والاجتماعي في أوقات فراغ السلطة، أو على الأقل عدم تمكّن السلطة الجديدة من زمام الأمور، والأهم في قدرتها على قلب الطاولة أو تثبيتها.
المثال الأوضح على إدراك العشائر السورية ثقلها، ظهر في تموز/ يوليو 2025. وبينما كانت القوات الحكومية بصدد "إعطاء فرصة للتهدئة" في السويداء، كما ورد في بيان وزارة الداخلية، كانت مشاهد الدراجات النارية والبيارق القبلية تنقل إلى السوريين والعالم صورةً مغايرةً عن التهدئة: آلاف المقاتلين من عشائر البدو يتّجهون جنوباً، وبيانات "النفير العام" تتوالى، وبعض العائلات تُقتل أو تُهجّر، فيما البيانات الرسمية لا تزال تكرر عبارة "مجموعات خارجة عن القانون".
لكن من هم هؤلاء؟ ما الذي نعرفه عنهم باستثناء وضعهم تحت عنوان عريض واحد "العشائر السورية"؟ وما الذي تغيّر بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل السلطة الجديدة؟ في هذا التقرير نحاول تفكيك هذا العنوان العريض.
أهم العشائر السورية وخريطة توزّعها
في تقرير تحليلي نشره مركز "جسور" للدراسات، بعنوان "خارطة أهم القبائل والعشائر العربية في سوريا"، وُزّعت العشائر السورية على ثلاث فئات: العشائر البدوية، العشائر الريفية والزراعية، والعشائر الكردية والتركمانية والديرية، حسب مناطق توزّعها في الشرق والشمال.
يُعدّ ريف الحسكة موطناً لأكبر التجمعات العشائرية في سوريا، وتتصدّرها قبيلة شمّر بفروعها عبده، الأسلم، وزوبع، المرتبطة بعشائر العراق، كما تقطن في القامشلي عشائر العساف، الحريث، الجوالة، بني سبعة، الحرب، البوعاصي، بالإضافة إلى الجبور الزبيدية التي تمتد زراعياً ورعوياً حتى شمال العراق وغربه.
وتُعدّ عشيرة العكيدات (العقيدات)، أكبر تجمع عشائري في دير الزور بفروعها البوسرايا، البوحسن، البورحمة، القرعان وغيرها، وهي من العشائر التي حافظت على طابعها البدوي. كما تنتشر قبيلة البقارة وعشيرة البوصليبي، ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة وتربية المواشي.
لا يمكن الحديث عن العشائر السورية بمعزل عن دورها السياسي المتزايد بعد سقوط النظام، فالبداوة في سوريا لم تعد مجرد أسلوب حياة، بل تحوّلت إلى هوية سياسية تسعى للنجاة وسط واقع متحرك. بيانات "النفير العام"، والاستعراضات العسكرية، وتوظيف الرموز التقليدية مثل سكب القهوة ورفع الرايات، كلها تعبّر عن تحوّل اجتماعي عميق يجعل من القبيلة بديلاً عن مؤسسات الدولة الغائبة
غير بعيد عنها، تضمُّ الرقة عشائر بارزةً عدة، أهمّها شمّر، البقارة (بفروع مثل البوحسن والبومعيش)، وبنو خالد ذات الجذور القحطانية، التي لها تاريخ في تأمين طرق القوافل الصحراوية. أما البادية الممتدة من حمص إلى دير الزور فتضم عشائر عنزة وفرع "السبعة" الرحل، بالإضافة إلى عشيرة الفواعرة في البادية الشرقية وفروع بني خالد على أطراف المحافظة، وتتمركز قبيلة الحديديين (عدنانية الأصل)، في بادية حماة وريف حلب الشرقي، وأبناؤها مشهورون بتربية الخيول والفروسية.
أما السويداء جنوباً، مركز الطائفة الدرزية، فتضم عشائر عربيةً بدويةً من قبيلة عنزة مثل السرحان، السلوط، الزويد والحرافشة، ومعظمهم استقروا في القرى الشرقية كملح وخربة عواد، كما يتواجدون في حي المقوس داخل المدينة.
دولة داخل الدولة
في المنطقة العربية، لا تُفهم السلطة عبر مؤسسات الدولة فقط، بل عبر تلك البنى الاجتماعية الممتدة في التاريخ، حيث تأخذ "الأنساب" أهميةً كبرى في تحريك المجتمعات وتثبيت عاداتها، في الصحراء كما في المدن، فكما تعرف حلب عائلاتها، وكذلك دمشق، تعرف كل عشيرة سورية أبناءها، لكنها ليست مجرد رابطة دم أو نسب مشترك، بل نظام اجتماعي متكامل، فيه القيادة والسلطة والاقتصاد وحتى القضاء وأدوات العدالة.
بحسب تقرير موسّع نشره موقع "الجزيرة" بتاريخ 21 تموز/ يوليو 2025، فإن البنية القبلية في سوريا تعود إلى قرون طويلة، حين هاجرت قبائل عربية من الجزيرة العربية واليمن إلى بادية الشام بحثاً عن الماء والكلأ، واستقر بعضها في القرى، بينما حافظ آخرون على حياة الترحال.
هؤلاء، أي بدو سوريا، لعبوا أدواراً بارزةً في التاريخ الحديث، إذ شاركوا في مقاومة العثمانيين، ووقف بعضهم في وجه الاستعمار الفرنسي، بل كان لبعض شيوخهم نفوذ مؤثر في صياغة التحالفات الاقتصادية والسياسية المحلية. واليوم، تنقسم هذه العشائر إلى ثلاث فئات رئيسية:
عشائر متحضّرة: وهي التي استقرت منذ أجيال في القرى والمدن، وتخلّت جزئياً عن الترحال، لكنها حافظت على تسميتها وهويتها القبلية.
عشائر شبه متحضّرة: تعيش بين القرية والبادية، وتزاوج بين الزراعة وتربية المواشي، وتنتقل موسمياً.
عشائر بدوية بالكامل: لا تزال ترتبط بأسلوب الترحال والرعي وتربية الإبل، وتُعدّ الأكثر محافظةً على أعراف البدو التقليدية، برغم اضطرار كثر من أبنائها إلى الاستقرار بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة بعد عام 2011.
بعد سقوط النظام، تحوّل "مجلس القبائل والعشائر السورية" إلى كيان سياسي وعسكري موحّد. فرض نفسه كطرف قادر على استدعاء مقاتليه من كل سوريا، ويحتاج تدخلات دولية لردعه، فيما أسماه البعض "دولة داخل الدولة".
بيد أنّ هذا التعدّد في مستويات العيش والاندماج لم يمنع من تمسّك العشائر -بفئاتها كلها- بمرجعياتها التقليدية، إذ ظلت كلمة الشيخ نافذةً، وظلّ الانتماء إلى العشيرة متقدماً على الانتماء إلى الدولة، خصوصاً في مناطق التهميش التنموي والأطراف.
فإذا عدنا إلى العلاقة بين العشائر والدولة في سوريا، نجد مساراً متقلّباً بدأ مع العثمانيين الذين وظّفوا العشائر لحماية الطرق الصحراوية مقابل امتيازات مادية ومعنوية، ومع دخول الفرنسيين، حاولت سلطة الانتداب تأمين ولاء شيوخ العشائر بمنحهم الأراضي والامتيازات، في خطوة أدّت إلى تصنيفات داخلية بين عشائر "مسلَّحة"، وأخرى خُصّصت لتكون بلا سلاح.
بعد الاستقلال، ألغى البرلمان "قانون العشائر" الفرنسي، وأصدر "مرسوماً لعشائر البدو" بهدف دمجهم في المجتمع المستقر. وفي أثناء الوحدة مع مصر عام 1958، أصدر جمال عبد الناصر قانون الإصلاح الزراعي، ما أدى إلى تراجع نفوذ شيوخ العشائر اقتصادياً واجتماعياً. غير أنّ حافظ الأسد غيّر المسار ليستعيد دور العشائر من خلال دمج شيوخها في البرلمان وتكليفهم بأدوار أمنية، وتم توطين بعضهم في مناطق ذات أغلبية كردية.
في عهد بشار الأسد، استمر استثمار النظام للعشائر عبر دمج أبناء القبائل في الأجهزة الأمنية واستخدام ولاءاتهم في قمع احتجاجات الأكراد عام 2004، لكن جفاف الجزيرة بين 2007 و2008، وفشل المشاريع الزراعية، أضعفا دورها في مناطق مثل الحسكة والرقة ودير الزور، التي أُدرجت ضمن الأفقر في البلاد عام 2010.
كل شيء حدث في السويداء
منذ أن بدأت أحداث السويداء الأخيرة، والتساؤلات حول حجم وقوة العشائر في المحافظة تزداد، وكذلك قوتها وقدرتها على حمل السلاح وتجنيد نفسها، ولا سيما بعد إعلان البدو "النفير العام" وسكب القهوة أرضاً، ومطالبتهم الحكومة السورية بعدم التدخل بينهم وبين "ميليشيا الهجري الإرهابية" كما أسموها في البيان، الذي صرّحوا فيه أيضاً بوجود 50 ألف مقاتل من البدو للـ"فزعة".
لا توجد أرقام رسمية محدثة لتعداد البدو في محافظة السويداء، لكن بحسب تقرير نشرته "مونت كارلو الدولية" بتاريخ 18 تموز/ يوليو 2025، يبلغ عدد أبناء العشائر البدوية في محافظة السويداء وحدها نحو 250،000 نسمة، يتمركزون في مناطق مثل المقوس والشهبا وعرى والمزرعة، ويشكلون امتداداً لموجات استقرار قديمة حافظت على رموز الحياة البدوية من لباس ولهجة وممارسات.
يدعم هذا الرقم تقرير آخر نقلته "العربي الجديد" عن الباحث العشائري أحمد أبو نجد، الذي قال إنّ أبناء العشائر عربية الهوية يشكّلون نحو ثلث سكان المحافظة (250،000 من إجمالي نحو 750،000 نسمة)، وهم منتسبون إلى قبائل مثل زبيد وعنزة وبني خالد والفواعرة، ومستقرون في مناطق مثل المقوس وحي المقوس وجبل العرب منذ مئات السنين.
العشيرة كـ"كتلة سياسية"
يعرف من عايش الثورة السورية أنّ العشائر لم تجتمع على كلمة واحدة منذ البداية، ففي الوقت الذي انضم فيه عشائر إلى الثورة، انضمت عشائر أخرى إلى قوى النظام وحاربت في صفّه، وظهرت بعض العشائر كقوة ثالثة لا تنتمي إلا إلى نفسها. فإن كان لأحد القدرة على السيطرة على العمق الإستراتيجي الفارغ من السكّان والبني التحتية والممتد على طول الحدود، فالبدو هم الأقدر على هذا الأمر.
في هذا السياق، يشير الباحث في التاريخ الاجتماعي السياسي محمد الكاطع، في مقابلة له على موقع "عنب بلدي"، إلى أنّ غياب السلطة في بعض المحافظات السورية دفع الأهالي إلى الاحتماء بالعشائر بحثاً عن الطمأنينة والدفاع عن مصالحهم، ما عزز الدور الاجتماعي والسياسي للعشيرة، وإن بشكل متفاوت.
فعلى الرغم من قلّة عدد أفرادها في الحسكة، برزت قبيلة "شمر" بدور محوري بعد الثورة، بتحالفها مع "الإدارة الذاتية" واستفادتها من الدعم الأمريكي لـ"قسد"، ما وفّر لزعمائها مكاسب ماديةً وحصانةً نسبيةً من التجاوزات. في المقابل، وقفت قبيلة "طيء" إلى جانب النظام وأسهمت في تشكيل "الدفاع الوطني" في القامشلي، لكنها خضعت لاحقاً لضغط النظام الذي أجبرها على تسليم مقارها لـ"قسد". أما قبيلة "العقيدات" في دير الزور، فكان لها دور بارز في الثورة، حيث نظّمت جماعات مسلحة وطردت النظام من المحافظة، لكنها انقسمت لاحقًا بسبب الفوضى، فاستُخدم بعض أبنائها في معارك النظام، وآخرون في صفوف "قسد"، بحسب الكاطع.
استغل نظام البعث لعقود التوتر التاريخي بين البدو والدروز في السويداء، فحرّض، ثم تدخّل كوسيط، ليضمن بقاء الجميع تحت سطوته. ولعل المثال الأكبر حدث في العام 2000، فيما عرف لاحقاً بـ "أحداث البدو"، فما بدأ بحادثة صغيرة في مقبرة، تحول إلى اقتتال عنيف استدعى تدخل النظام لفضّه، ثم إلى سياسة ممنهجة عزّزت الانقسام، وجعلت من العشيرة أداة ضبط أمني
حسب تقرير لـ"مونت كارلو الدولية" بتاريخ 18 تموز/ يوليو 2025، فإنّ العشائر السورية أصبحت في السنوات الأخيرة تُدار ككتل سياسية -أكثر من كونها مكوّناً اجتماعياً- في إطار صراعات النفوذ بين النظام، الأكراد، والقوى الإقليمية، وأحياناً بين أمراء الحرب المحليين.
كل ذلك أدى إلى تآكل "العرف العشائري" لحساب "منطق التحالف والسلاح"، وجعل من العشيرة حلبةً لصراع داخلي، بدل أن تكون كما كانت في الماضي: حاضنة حماية اجتماعية. لكن السؤال الذي يُطرح الآن: ما الذي تبقّى من ذلك النظام القَبَلي؟ وهل يمكن إصلاحه أو إعادة دمجه في مشهد سياسي جديد؟
لعلّ الإجابة تبدأ من السويداء.
عودة إلى الثأر القديم… 25 عاماً إلى الوراء
مع تولّي بشار الأسد الحكم في عام 2000، اندلع واحد من أبرز الصدامات بين الدروز والبدو، في ما عُرف لاحقاً بـ"أحداث البدو"، وهو توصيف رَوّج له النظام نفسه. وتشير شهادات السكان المحليين ودراسات متعددة إلى أنّ شرارة الخلاف انطلقت حين عُثر على حمار نافق داخل إحدى مقابر السويداء، بالتزامن مع تعرّض بعض الأهالي لمضايقات من ضباط وعناصر منتمين إلى البدو العاملين في أجهزة النظام. سرعان ما تصاعد التوتر وتحوّل إلى اشتباكات مسلّحة، خاصةً أنّ البدو كانوا حينها يتمتعون بتفوّق في امتلاك السلاح.
وجد أبناء السويداء أنفسهم أمام خطر حقيقي، ما دفعهم إلى التماس الحماية من الدولة بعد أحداث عنف ذهب ضحيتها 20 شخصاً وجرح أكثر من 200 معظمهم من الدروز، في المقابل، استغل النظام هذه الفرصة لتعزيز وجوده الأمني والعسكري داخل المدينة، مستخدماً ذريعة "حماية السويداء من البدو" كوسيلة لإحكام قبضته وضمان ولاء الأهالي. كما لعبت الأجهزة الأمنية دوراً خفيّاً في إذكاء نار الخلاف، إذ كانت تستعين بضباط من الطرفين لتأجيج الصراع وتنظيم عمليات خطف متبادلة، قبل أن تتدخل لاحقاً عبر وسطاء محسوبين عليها لاحتواء الأزمات، بما يضمن بقاء حالة التوتر قائمةً بين الطرفين.
وعلى مدار السنوات الممتدة من عام 2000 وحتى اندلاع الثورة السورية في 2011، استمرت العلاقات بين البدو والدروز في التذبذب، حيث شهدت المنطقة سلسلةً من التوترات والمواجهات الطفيفة التي كان يتم احتواؤها من خلال وساطات محلية وأدوار مرسومة بعناية من أجهزة الأمن. ومع انفجار الثورة وبدء المواجهة المسلحة بين النظام وقوى المعارضة، اتجهت معظم الأطراف إلى التسلّح، وكان للدروز والبدو نصيب وافر من هذا السباق.
عسكرة البدو
بعد سقوط النظام في نهاية العام 2024، اتجهت معظم المجتمعات المحلية والأقليات الطائفية والعرقية، إلى اتخاذ موقع المدافع عن نفسها، وكما تمّت تصفية خلافات شخصية في استغلال فترة فراغ السلطة، تمت تصفية خلافات جماعية، أو على الأقل استدعاؤها من الماضي.
وفي منتصف تموز/ يوليو 2025، اندلعت في محافظة السويداء المواجهات الدموية بين فصائل درزية مسلحة ومجموعات عشائرية بدوية، وعرفت باسم "مقتلة السويداء" وراح ضحيتها 1،311 شخصاً بين مدنيين ومقاتلين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يعفِ في توثيقاته أياً من الأطراف الثلاث من أعمال العنف: البدو، الدروز، وقوات الأمن السوري.
الأحداث أعادت ملف العشائر إلى الواجهة. لكن هذه المرة، ليس كقوة اجتماعية أو كمخزون انتخابي أو حتى كواجهة أمنية، بل ككيان سياسي عسكري قادر على الهجوم والدفاع والتحدث ككتلة عسكرية.
تسارع الأحداث في السويداء كان وحده منبعاً للرعب، إذ أكدت جهوزية العشائر للتحرك الفوري والتجنيد السريع، حين دعا الشيخ عبد المنعم الناصيف، رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية، للنفير العام لـ"نجدة أهالي البدو في السويداء"، ضد ما وصفه بـ"جرائم إبادة وتهجير قسري"، نُسبت إلى فصائل محلية درزية بعد انسحاب قوات الأمن التابعة للدولة.
في مشهد غير مسبوق أظهرت مقاطع فيديو توجّه آلاف المقاتلين من 41 عشيرة سورية نحو السويداء، فيما صرّح مجلس العشائر بأن عدد المشاركين من طرفه بأكثر من 50 ألف مقاتل.
في مشهد غير مسبوق منذ بدء الثورة السورية، أظهرت مقاطع فيديو توجه آلاف المقاتلين من 41 عشيرةً وقبيلةً باتجاه السويداء، وسط أخبار عن احتجاز مدنيين من البدو . وقدّرت تقارير عدد المشاركين في المواجهات من طرف العشائر بما يفوق 50 ألف مقاتل، وهو ما يؤكده تصريح مجلس العشائر.
في المقابل، ناشد الشيخ حكمت الهجري، أحد زعماء طائفة الموحدين الدروز العالم، طالباً بتدخل دولي عاجل لحماية السكان في السويداء، متحدثاً عن "حرب إبادة شاملة" تقودها الحكومة السورية وحلفاؤها. وقال الهجري في بيان مصوّر إنهم يواجهون "حملةً بربريةً" تُشنّ ضدهم "بكل الوسائل الممكنة"، مطالباً بالحماية من "جميع دول العالم".
وفي الوقت نفسه، برزت مواقف درزية مناقضة؛ إذ أصدر عدد من زعماء الطائفة بياناً آخر رحّبوا فيه بتدخل الحكومة السورية، داعين إلى بسط سلطة الدولة في السويداء، وتسليم السلاح من قبل الجماعات المسلحة، وبدء حوار مباشر مع دمشق. هذا الانقسام العلني في مواقف الزعامة الدرزية يسلّط الضوء على تعقيدات المشهد في السويداء، وسط تصاعد المواجهات وتباين الرؤى حول مستقبل العلاقة مع النظام السوري.
ومع هذا الانفلات، تدخّل الجيش الإسرائيلي أيضاً بضربات جوية في 15 و16 تموز/ يوليو 2025، وبدا كأنّ الأحداث في طريقها إلى التصعيد لا التهدئة، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم الإتفاق على وقف إطلاق النار في 16 من الشهر نفسه، وينسحب الجيش السوري.
أدى انسحاب الجيش إلى عودة الاقتتال الدامي في 17 تموز/ يوليو، وأصدرت الرئاسة السورية بياناً، حمّلت فيه "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون" مسؤولية العنف في السويداء، مؤكدةً أنّ انسحاب الجيش جاء لـ"منح فرصة للحوار"، لكن غيابه استُغلّ في ارتكاب ما وصفته الرئاسة بأنه "جرائم موثقة ضد المدنيين من النساء والأطفال والبدو"، مع التأكيد على ضرورة استعادة الدولة سيادتها على الأرض.
ثم مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرةً أخرى، تم إعلان وقف إطلاق النار، وبرغم نفي وزارة الداخلية السورية نيتها دخول المدينة بعد انسحابها، إلا أنها أكّدت في بيان رسمي بتاريخ 19 تموز/ يوليو الجاري أنّ قواتها "في حالة جاهزية طبيعية ولم يصدر أي أمر باقتحام السويداء". ولاحقاً، صدر عن عشائر تجمّع الجنوب، بياناً أعلنت فيه التزامها الكامل بقرار الرئيس المؤقت أحمد الشرع وقف إطلاق النار، وعبّرت عن رفضها "منطق الفتنة"، مؤكدةً أنها لم تكن يوماً "داعية قتال، ولكن حين يُفرض القتال، يصبح دفاعاً عن النفس والكرامة"، على حد تعبير البيان.
وفي ظل هذا التصعيد، برزت الأسئلة الأهم: هل ما زالت العشائر قادرةً على الاندماج ضمن مشروع وطني جامع؟ أو أنّ ما حدث في السويداء كشف حدود الدولة الجديدة أمام الموروث القبلي المسلّح؟ وهل نحن اليوم بصدد تصاعد قبلي يشبه سيناريو العراق بعد سقوط البعث؟
بحسب تحليلات، حاولت الحكومة الجديدة بعد 2024، اعتماد سياسة أكثر واقعيةً تجاه العشائر، فعيّنت ممثلين عنهم في مؤسسات رسمية، وأطلقت برامج لإعادة الإعمار في مناطقهم، مقابل تعهّد واضح من الشيوخ بعدم تشكيل أي ميليشيات خارج سلطة الدولة. كما سعت إلى إعادة المجالس العشائرية التقليدية ضمن إطار قانوني، وأبدت انفتاحاً على مطلب بعض العشائر في الجزيرة بالحصول على تمثيل أفضل في توزيع الثروات والحكم المحلي.
لكن هذه المقاربة لا تزال تصطدم بمعوقات حقيقية، منها استمرار النفوذ الخارجي (إيراني، تركي، وأمريكي)، والانقسامات داخل العشيرة الواحدة، بالإضافة إلى إرث عقود من التوظيف الأمني والسياسي. ولعلّ ما تسعى إليه الحكومة السورية اليوم هو "اتّقاء شرّ" العشائر أكثر من محاولة دمجها.
مقارنة لا بدّ منها… عشائر العراق وسوريا ما بعد الـ"بعثَين"
من ينظر إلى الخريطة القَبَلية في المشرق العربي، يلحظ بوضوح أنّ العشائر لا تعترف بالحدود الحديثة، بل تمتد من الأنبار إلى البوكمال، ومن الجزيرة الفراتية إلى نينوى، مروراً بالحسكة والرقة. لكن على الرغم من هذه الامتدادات العائلية واللغوية، اتخذت العشائر في سوريا والعراق مسارين مختلفين منذ 2003، حين سقط نظام صدام حسين، ثم لاحقاً مع اندلاع الثورة السورية في 2011.
في العراق، تحوّلت العشائر بسرعة إلى فاعل سياسي مباشر بعد انهيار الدولة المركزية. فمنذ المرحلة الأولى للاحتلال الأمريكي، اعتمدت واشنطن على زعامات عشائرية في ضبط الأمن وتأسيس مجالس الصحوة، خصوصاً في الأنبار وصلاح الدين.
ومع غياب مؤسسات الدولة، برزت العشيرة كبديل للدولة في التحكيم، والحماية، والتوظيف. وقد تجلّى ذلك في ازدياد نفوذها النيابي والسياسي مع مرور السنوات، إذ أصبح للزعامات العشائرية حضور دائم في البرلمان والحكومة، وتمّ دمج منطق "التحاصص العشائري" في البنية السياسية الطائفية الجديدة.
أما في سوريا، فقد ظلت العشائر لعقود تحت عباءة الدولة البعثية التي جرّدتها من أدوات التأثير الحقيقي، وأبقتها مجرد أداة لضبط المناطق الريفية، لا شريكاً في القرار. وعندما اندلعت الثورة، لم تكن العشائر جاهزةً للعب دور موحد، بل دخلت الصراع بانقسامات داخلية شديدة، بعضها اصطف مع النظام، وبعضها الآخر مع المعارضة، وآخرون اختاروا الحياد أو العمل تحت رايات محلية. وحتى بعد سقوط الأسد في 2024، لم تظهر بعد بنية عشائرية سورية قادرة على ملء الفراغ السياسي، كما حصل في العراق.
ومن ناحية الدمج المؤسسي، نجح العراق في إدخال العشائر ضمن جهاز الدولة ولو شكلياً، عبر المناصب والموازنات، بينما بقيت العشائر السورية في معظمها خارج هذه الدائرة، باستثناء بعض التعيينات الرمزية أو العسكرية. كذلك، غالباً ما تشكّل العشيرة العراقية عنصر حماية اجتماعية بوجه الطائفية السياسية، بينما في سوريا لا تزال تعاني من استقطابات طائفية ومناطقية تعمّق انقساماتها، خصوصاً بعد الصراع في السويداء.
لكن تبقى النقطة الأخطر هي أنّ التحول العشائري نحو التسلّح في كلا البلدين جعل من بعض العشائر قوةً عسكريةً، لا مجتمعية فحسب. والفرق هنا أنّ العراق يملك (نظرياً على الأقل)، دولةً متماسكةً نسبياً، تحاول إعادة ضبط هذا التسلّح، بينما في سوريا، لا تزال الدولة الجديدة تُختبر في قدرتها على فرض هذا الضبط، بعد عقد من التصدّع الكامل.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.