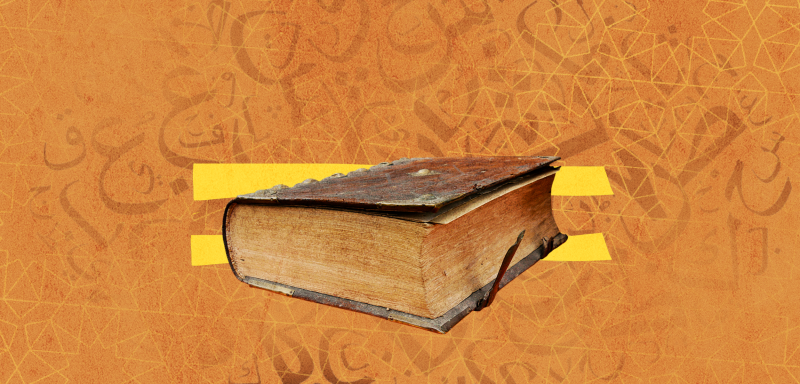في سنة 663هـ، اتخذ السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، قراراً بتعيين أربعة فقهاء في مناصب القضاء بمصر. مثّل كلُّ فقيه أحد المذاهب السنية الأكثر تأثيراً وانتشاراً في البلاد الإسلامية، وهي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي. مع مرور السنوات، ثبتت تلك المذاهب الأربعة في الوجدان الإسلامي الجمعي، ونسي الناس أن هناك العشرات من المذاهب الفقهية الأخرى التي لم يُكتب لها الانتشار، فاندثرت جميعاً ولم يبق منها إلا بعض الآراء والأفكار التي ينادي بها البعض على فترات متباعدة. ما هي أشهر المذاهب الفقهية السنية التي اندثرت؟ ولماذا لم تبق تلك المذاهب؟ وما هي أهم الأفكار التي يمكن أن نقتبسها اليوم من تلك المذاهب؟
أهم المذاهب المندثرة
بطبيعة الحال، لا يمكن حصر جميع المذاهب الفقهية التي انتشرت في البلاد الإسلامية في القرون الأولى من الهجرة. رغم ذلك، بوسعنا أن نلقي الضوء على بعض من أهم المذاهب التي ظهرت في أماكن متفرقة، والتي تمكنت من فرض نفسها داخل دائرة الثقافة الإسلامية لفترات متباينة، قبل أن تنزوي شيئاً فشيئاً لتترك مكانها للمذاهب السنية الأربعة الأكثر شيوعاً وتأثيراً.
من تلك المذاهب، مذهب الأوزاعي المنسوب للفقيه الشامي عبد الرحمن الأوزاعي. ولد الأوزاعي في بعلبك في سنة 88هـ، وتلقى العلم الديني في صغره على يد علماء العراق والحجاز. ثم عاد أدراجه إلى الشام وتنقل بين مدن سوريا ولبنان. وبعد فترة من الترحال، استقر في بيروت، وتولى القضاء لفترة قصيرة في أواخر العهد الأموي. قبل أن يتوفى في سنة 157هـ.
توجد العديد من الأسباب المُفسرة لاندثار المذاهب الفقهية. بشكل عام، تتنوع تلك الأسباب بين العوامل الفردية، والظروف السياسية. كما ارتبط انقراض بعض المذاهب بظروف وسياقات المنافسة مع باقي المذاهب الفقهية الأكثر انتشاراً
في كتابه "سيَر أعلام النبلاء"، سلط شمس الدين الذهبي الضوء على سيرة الأوزاعي العلمية، وعلى دوره في تشكيل أحد المذاهب الفقهية المتميزة في القرن الثاني الهجري، فقال: "كان له -يقصد الأوزاعي- مذهب مستقل مشهور، عمل به فقهاء الشام مدة، وفقهاء الأندلس، ثم فنِيَ".
من تلك المذاهب أيضاً، مذهب الليث بن سعد المتوفى سنة 175هـ في مصر. بحسب المصادر التاريخية، ولد الليث في أواخر القرن الأول الهجري في مصر لأسرة من أصول فارسية، ورحل في طلب العلم في شبابه، ثم عاد واستقر في الفسطاط، وتولى قضاء مصر لفترة في أواخر زمن بني أمية. واشتهر بنبوغه العلمي في المسائل الشرعية والفقهية حتى قيل إن: "علم التابعين في مصر تناهى إلى الليث بن سعد"، وذلك بحسب ما يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه "الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية".
كذلك، اشتهر المذهب الفقهي الذي أسسه الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى 310هـ. ذاع صيت الطبري باعتباره مؤرخاً عظيماً واسع المعرفة والاطلاع. كما كان في الوقت ذاته من كبار العلماء المشتغلين بالفقه وتفسير القران والسنة النبوية. ويُذكر أنه كان صاحب رأي خاص في الفقه، كما أنه دخل في خصومات عديدة مع بعض الفرق الإسلامية مثل الحنابلة والخوارج والشيعة الإمامية.
أيضاً، عُرف المذهب الظاهري كأحد المذاهب الفقهية المتميزة التي أثبتت حضورها في القرون الأولى من عمر الحضارة الإسلامية. يُنسب هذا المذهب لداود بن علي الأصفهاني المتوفى سنة 270هـ. وكان أحد كبار الأئمة الذين عاشوا في العاصمة العباسية بغداد في القرن الثالث الهجري. وقد عُرف عنه الميل لرفض القياس، والعمل على تطبيق الفهم الظاهري للنصوص القرآنية والحديثية. رغم أفول نجم المذهب الظاهري في المشرق، فقد أُعيد إحياؤه مرة أخرى في بلاد الأندلس في القرن الخامس الهجري على يد العالم الكبير أبي محمد علي بن حزم (المتوفى 456هـ).
لماذا اندثرت؟
في الواقع، توجد العديد من الأسباب المُفسرة لاندثار المذاهب الفقهية التي تحدثنا عنها. بشكل عام، تتنوع تلك الأسباب بين العوامل الفردية، والظروف السياسية. كما ارتبط انقراض بعض المذاهب بظروف وسياقات المنافسة مع باقي المذاهب الفقهية الأكثر انتشاراً.
على سبيل المثال، يرى الكثيرون أن اندثار مذهب الليث بن سعد بمصر قد وقع بسبب تقاعس أتباع وتلاميذ الليث عن نشر مذهبه. يظهر ذلك في المقولة المشهورة المنسوبة للإمام محمد بن إدريس الشافعي: "الليث أَفقه من مالك، إلا أنّ أصحابه لم يقوموا بِه". كذلك، تسببت بعض الكوارث الطبيعية في الحد من انتشار أفكار بعض المذاهب، من ذلك أن أغلب كتب الإمام الأوزاعي قد تلفَت بعد وقوع أحد الزلازل المدمرة في بيروت، وتسبب غياب تلك الكتب في ضياع الكثير من علوم الفقيه الشامي.
على الرغم من اندثار مذهبه، أسهم رأي الطبري بشكل فعال في تغيير المدونات القانونية في العديد من البلاد العربية في العصر الحديث.
من جهة أخرى، أدت المنافسة المحتدمة مع المذاهب الأخرى في تهميش أفكار بعض الفقهاء العظماء. يُحكى أن الطبري قد هوجم على نطاق واسع من قِبل حنابلة بغداد، بسبب رفضه اعتبار الإمام أحمد بن حنبل كأحد الفقهاء في كتابه "اختلاف الفقهاء". أدى هذا الهجوم لتضييق الخناق على أفكار الطبري، مما صعب من وصولها للعامة.
في سياق أخر، اضطلعت السلطة السياسية بأدوار مهمة في زيادة أو نقصان شعبية المذاهب الفقهية؛ على سبيل المثال، تحدث القاضي عياض عن الظروف التي تسببت في إضعاف مذهب الأوزاعي في المغرب وشبه الجزيرة الأيبيرية، فقال في كتابه "ترتيب المدارك وتقريب المسالك": "أخذ أمير الأندلس إذ ذاك، هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، الناسَ جميعاً بالتزامهم مذهب مالك وصير القضاء والفتيا عليه... وقد لحق به من أصحاب مالك عدة، فالتزم الناس بهذا المذهب وحموا بالسيف عن غيره جملة".
كذلك، تم تحجيم نفوذ الظاهرية في الأندلس بعدما دخل الفقيه الظاهري ابن حزم في صدام مع المعتضد على الله بن عباد حاكم أشبيلية. على إثر ذلك الخلاف، أمر المعتضد بإحراق جميع كتب ابن حزم، فانزوى الفقيه الأندلسي وحيداً بائساً مكتئباً حتى رحل عن الدنيا، ولم تقم للمذهب الظاهري قائمةً من بعده.
في المشرق أيضاً، تأثر انتشار المذاهب الفقهية بالسياسية؛ تذكر المصادر التاريخية أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور أراد أن يجبر الناس على العمل بالمذهب المالكي. في حين تعصب هارون الرشيد للمذهب الحنفي، وكان يرفض تعيّن أي قاض أو مفتٍ إلا بعد الرجوع لرأي الفقيه الحنفي الشهير أبي يوسف. من هنا -وبناءً على تلك الأخبار- بوسعنا أن نصدق المقولة الشهيرة المنسوبة لابن حزم: "مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة في المشرق، ومذهب مالك في المغرب".
ما الذي يمكننا اقتباسه من تلك المذاهب؟
على الرغم من انقراضها، تركت المذاهب الفقهية المندثرة العديد من الشذرات الفكرية التي يُمكن الأخذ بها في واقعنا المعاصر. على سبيل المثال، قدمت آراء الأوزاعي بخصوص التعامل مع المسيحيين الشاميين إرهاصاً لمشروع فكري متسامح مع الآخر الديني. يذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الأموال" أن المسيحيين في لبنان قد قاموا بثورة ضد الحكم العباسي، ولمّا فشلت الثورة وأراد العباسيون أن ينتقموا من مسيحيي الشام، فإن الأوزاعي قد عارض ذلك، وأرسل إلى الخليفة أبي جعفر المنصور طالباً منه العفو عن أهل الذمة، فاستجاب له الخليفة وأمر بحقن دمائهم.
على الرغم من انقراضها، تركت المذاهب الفقهية المندثرة العديد من الشذرات الفكرية التي يُمكن الأخذ بها في واقعنا المعاصر. على سبيل المثال، قدمت آراء الأوزاعي بخصوص التعامل مع المسيحيين الشاميين إرهاصاً لمشروع فكري متسامح مع الآخر الديني
من هنا، لم يكن من الغريب أن يذكر ابن عساكر في كتابه "تاريخ دمشق" أن جنازة الأوزاعي قد "شيعها أهل أربعة أديان، المسلمون واليهود والنصارى والقبط". ظهرت النزعة المتسامحة نفسها في بعض مواقف وآراء الليث بن سعد؛ بحسب ما يذكر المؤرخ تقي الدين المقريزي في كتابه "الخطط والآثار" فإن بعض ولاة مصر قد قاموا بهدم الكنائس والأديرة، فعارضهم الليث في ذلك، وقال إن بناء الكنائس من عمارة البلاد، واحتج بأن الكنائس التي بمصر لم تُبنَ إلاّ في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين.
في سياق آخر، عُرف عن الليث معارضته لمذهب الإمام مالك بن أنس، فيما يخص قصر الإجماع على عمل أهل المدينة دون باقي الأمصار الإسلامية. إذ وسع الليث من دائرة حجية الصحابة لتشمل جميع الصحابة الذين انتشروا في مصر والشام والعراق والحجاز وغير ذلك من الأمصار الإسلامية؛ الأمر الذي سمح بقبول العديد من الآراء، وتوسيع هامش الاجتهاد والتجديد.
وبالنسبة للمذهب الظاهري، فقد قدم بعض الآراء المُنصفة للمرأة وللفنون. في كتابه "الفصل في الأهواء والملل والنحل"، صرح ابن حزم بجواز نبوة النساء، وضرب على ذلك بعض الأمثلة من القرآن الكريم، ومنها كلّ من مريم بنت عمران، وسارة زوجة إبراهيم، وأم موسى. وفي الوقت نفسه، أجاز ابن حزم ولاية المرأة للقضاء، واستدل على ذلك بأنه لما كانت الزوجة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كما جاء في الحديث الصحيح، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن تلي بعض الأمور الأخرى ذات المسؤولية الأعلى.
أما في كتابه "المُحلى"، فقد شكك ابن حزم، في جميع الأحاديث النبوية التي ذكرت تحريم الغناء والموسيقى، وقال: "لا يصحّ في هذا الباب -يقصد باب تحريم الموسيقى والغناء- شيء أبداً، وكل ما فيه موضوع، ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله لما ترددنا في الأخذ به".
في السياق نفسه، قدم ابن جرير الطبري عدداً من الأفكار المُنصفة للنساء، ومنها إجازته لتولية المرأة لمنصب القضاء الشرعي. كما كان الطبري من الفقهاء الذين قالوا بالوصية الواجبة. وهي وصية مالية ثابتة للأحفاد في تركة جدهم من جهة الأب، أو في تركة جدتهم من الأب إذا ماتت أمهم أو مات أبوهم في حياة أبيه أو أمه.
على الرغم من اندثار مذهبه، أسهم رأي الطبري في تلك المسألة بشكل فعال في تغيير المدونات القانونية في العديد من البلاد العربية في العصر الحديث، بعدما تم تعديل أحكام الإرث بما يضمن وصول جزء من تركة الجد المتوفى لأحفاده الذين مات أبوهم في حياة والده.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.