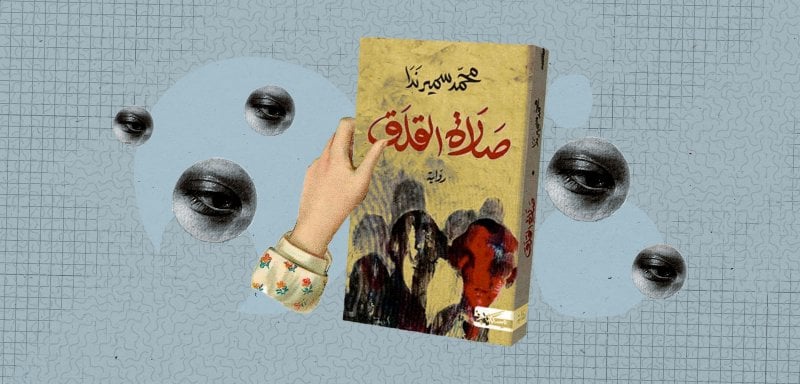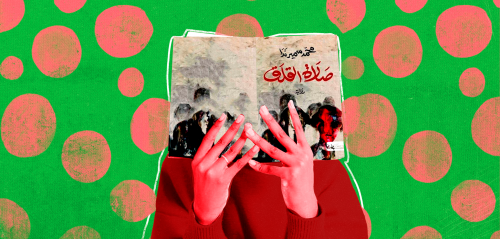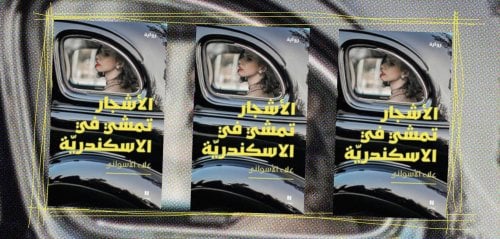بمجرد الإعلان عن فوز رواية "صلاة القلق"، للروائي المصري محمد سمير ندا، بجائزة البوكر للرواية العربية، تسرب جدل غامض على صفحات السوشال ميديا المصرية، من أصوات ترفض ما وصفه البعض بـ"فوز مصر بالجائزة" بعد غياب نحو 16 عاماً، حين حصد بهاء طاهر، الجائزةَ في دورتها الأولى عن روايته "واحة الغروب" عام 2008، فيما حصل عليها المصري يوسف زيدان، في دورتها الثالثة عام 2009، عن روايته "عزازيل".
احتجّت الأصوات الرافضة بأنّ الرواية ليست مطبوعةً في مصر، بل في دار نشر تونسية مالكها يقيم في الإمارات (موطن الجائزة)، وانبرت أصوات أخرى تدافع عن الكاتب، وتؤكد أنه اضطر إلى نشرها بعيداً عن مصر لما فيها من محظورات يمكن أن يتم رفضها مثل الحديث عن "صنم عبد الناصر"، أو "انتصار اليهود في حرب 73"، أو غيرهما من الأسباب، ويؤكدون أنّ الجائزة مصرية مئة في المئة، لأنّ كاتب الرواية مصري والموضوع مصري بامتياز، بل يشكل جزءاً مهماً ومثيراً للجدل في تاريخ مصر، منذ نكسة حزيران/يونيو 1967، وحتى عام 1977 بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر، بنحو 4 سنوات.
ربما لم تكفِ تهنئة وزير الثقافة المصرية في بيان رسمي للكاتب محمد سمير ندا، للتأكيد على حصول كاتب مصري على الجائزة، بقدر ما استطاعت التعليقات التهكمية الساخرة للبعض أن تشي بهذه "المصرية"، ومنها من طالب بعدم القول بـ"حصول مصر على الجائزة"، حتى لا يتم أخذ ضرائب من الكاتب. في حين حرص أدباء مصريون كبار على تهنئة ندا، واستعادوا صداقتهم مع والده الكاتب سمير ندا، وأثنوا على الرواية التي استغرقت منه نحو ستّ سنوات من الكتابة، بحسب التواريخ التي يذيّل بها شكره لمن ساندوه في إنجاز هذا العمل.
بعيداً عن هذا الجدل الذي يصفه البعض بـ"العقيم"، ويعدّه آخرون تساؤلات مشروعةً، وإن كانت تتضمن تحاملاً ومزايدةً على الإبداع، دعونا نلقي نظرةً على متن الرواية.
يتتابع جلّ السرد الروائي في خطّين، زماني ومكاني، واضحين ومباشرين تماماً، فالمكان هو النجع الموبوء المحاصر بشريط ألغام، وهو على تخوم محافظة سوهاج، وفق التحقيقات الرسمية المنشورة في آخر العمل
على نهج كافكا، في براعة استهلال رواية "المسخ"، حيث يصحو غريغور سامسا، ليجد نفسه قد تحول إلى صرصار هائل، فقد "استيقظ الشيخ أيوب المنسي صباح اليوم، فلم يجد رأسه بين كتفيه".
بهذه الصورة الغرائبية تبدأ رواية "صلاة القلق" للكاتب المصري محمد سمير ندا، الحائزة على جائزة البوكر العربية 2025، والمنشورة في دار ميسكلياني في تونس، وفي دار صفصافة في مصر، لتعلن عن نص يحمل الكثير من الاستعارات والرموز والنقد التاريخي للحقبة الناصرية، في إطار يمزج الواقع بالخيال، فيما يمكن نسبته إلى الواقعية السحرية.
عبر لغة حافلة بالتصوير المجازي، تنساب الحكايات حول نجع المناسي، ذلك النجع المنسيّ فعلاً لا مجازاً، بحسب ما يعلن شيخ المسجد في لحظة غضب، متعجباً من اللعنة التي حلّت على أهل النجع، فسقطت شعورهم وحواجبهم، وأصبحوا أشبه بالمنطقة الموبوءة، حتى إنّ أخباراً تحدثت عن النجع بوصفه "مستعمرةً للجذام".

يتتابع جلّ السرد الروائي في خطّين، زماني ومكاني، واضحين ومباشرين تماماً، فالمكان هو النجع الموبوء المحاصر بشريط ألغام، وهو على تخوم محافظة سوهاج، وفق التحقيقات الرسمية المنشورة في آخر العمل، ولا يُسمح لأحد بالخروج منه أو الدخول إليه ما عدا سيارة الجنود التي تزوّد خليل الخوجة، الحاكم العرفي للنجع، بكل ما يحتاجه الأهالي من مؤونة يدفعون مقابلها من زرعهم أو تجارتهم أو صناعتهم، مع حسم ربع مستحقاتهم لصالح المجهود الحربي.
الزمان إذاً بعد نكسة 5 حزيران/يونيو 1967، ويمتد لعشر سنوات، حتى يحدث التمرد وإحراق بيت الخوجة في أحداث 1977. هذه السنوات العشر تشهد الحدث الأكبر الذي أصاب النجع. الضوء الساطع في السماء الذي سقط قرب النجع ولا يعرفون إن كان صاروخاً من الأعداء أم سلاحاً جديداً يتم تجريبه أو قمراً صناعياً. وبرغم محاولات خليل الخوجة الذي يتحكم في كل شيء تقريباً، إقناع الأهالي بأنّ ما رأوه هو شهاب أو نيزك، إلا أنهم يرفضون تصديقه.
يحمل نص الرواية الكثير من الاستعارات والرموز والنقد التاريخي للحقبة الناصرية، في إطار يمزج الواقع بالخيال، فيما يمكن نسبته إلى الواقعية السحرية.
وتتضارب القصص حول صنعة الخوجة الحقيقية: هل هو طبيب أو بقّال أو عامل طباعة أو مخبر سرّي يكتسب سلطته من القيادات التي ترسل له السيارات دورياً بالمؤونة التي يحتاجها النجع؟ ومن ثم فهو تقريباً الوحيد الذي له علاقة بالعالم الخارجي، خصوصاً بعد عودة إحدى شخصيات الرواية "نوح النحال"، من عمله في القاهرة بعد تجربة عصيبة تعرض خلالها للاستجواب والتنكيل والتعذيب ليعترف على أحد زملائه بأنه ينتمي إلى الإخوان. وبرغم محاولته التأكيد على أن زميله شيوعي، يزداد التعذيب واتهامه بالتلاعب بهم، فيعود نوح بعد إخلاء سبيله إلى النجع ويعلن الخصومة مع العالم الخارجي، إلى أن يُفجع بأخذ ابنه مراد إلى الجيش، وانقطاع أخباره تماماً.
خليل مسعد الخوجة، كما ورد اسمه في تحقيقات النيابة المنشورة نهاية الرواية، يستمدّ سلطته من مكان آخر أكثر عمقاً. من حبه للزعيم الملهم جمال عبد الناصر. فقد نصب تمثالاً بحجم ضخم للزعيم في باحة منزله، بالقرب من دكانه، إلا أنّ الخوجة صحا ذات يوم فوجد رأس التمثال مقطوعاً، وظل جسده المنتصب في الباحة محطّاً للطيور المتعبة. وشاع بين الناس أن التمثال يتحرك في الليل ويتجول ليتفقد أحوال الرعية، وشاع أيضاً أنه يهاجم الأطفال الأشقياء الذين يتأخرون ليلاً خارج منازلهم، وأنه يضاجع الفلّاحات اللواتي يتأخرن في الحقول، بقضيبه الحجري الصلب.
تنقسم الرواية إلى جلسات. في كل جلسة تحكي شخصية من أبطال العمل حكايتها. ويختار الكاتب في مفتتح كل جلسة أو كل فصلٍ مقطعاً من إحدى أغاني عبد الحليم حافظ. معظمها أغانٍ وطنية، مثل "عدّى النهار" و"أدهم الشرقاوي" و"إحنا الشعب"، والقليل منها عاطفي، وبعضها ديني مثل الأدعية الأخيرة التي كتبها الشاعر عبد الفتاح مصطفى، لحليم، وتبدو هذه الأغاني قادمةً من الجهاز الذي يمتلكه حكيم الأخرس، ابن خليل الخوجة.
رجل يعاشر صغيرته المعوقة، آخر استبدل بامرأته دوابّه، ثالث يفقد الأمل في عودة أبنائه من الحرب ويحرض الأهالي ضد "الخوجة/السلطة"، وسيدة حامل من سفاح، وقابلة تقتل الأطفال المشوهين؛ لعنات مستمرة تنهال على سكان النجع، وأسرار لا يعرفها أحد تدمغ جدران المنازل.
تأتي هذه اللعنات أو التهديدات أو الأسرار تحت اسم الكتابة السوداء على حيطان المنازل. لا يعرفون من الذي يكتبها. ولم يخلُ منزل من الكتابة على جدرانه حتى المسجد. في حين تظهر محاولات يائسة للهروب والخروج من هذا المكان. فأحدهم، "محجوب النجار"، الذي يصنع القوارب في منطقة لا تعرف البحر، يقرر حفر نفق يخرجه بعيداً عن حزام الألغام الذي يحاصر النجع، بعد أن أوشكت امرأته أن تضع المولود الذي ينتظرونه منذ سنوات طويلة. وتحوم الشكوك حول حملها في سنّ متقدمة، إلا أن الزوج يحاول أن يقنعها بأن حملها معجزة.
التفسيرات التي يطلقها البعض حول اللعنة التي أحاطت بالنجع، أخذت في بعض الأحيان منحى غيبياً. فسّرت ودادُ القابلة، الضوءَ الساطع بقوة الذي بدأ تلك اللعنة، بأنه يشبه الفلاش الذي يشغّله المصور لالتقاط الصور، فربما قوى عليا أرادت التقاط صور للنجع بهذه الطريقة. فيما ينقم شيخ المسجد أيوب على الأمر برمته، ويحاول تفسير ما حدث للنجار بأنّ الضوء الساطع والصوت المدوي بعده ليسا سوى سهم الله في عدو الدين.

يعدّ الشيخ أيوب، نفسه، صاحب حظ بوصفه إمام المسجد، وكان يكره خليل الخوجة، ويتعجب من استئثاره بالسلطة، برغم أنه غريب عن النجع ولا يعرفون له أصلاً من فصل. في حين أن "أيوب"، ابن الولي جعفر، صاحب الكرامات العائد من الموت، وآخر نسل المنايسة، كان يتمنى أن يقذف بخليل الخوجة، خارج النجع، لكنه كان يخاف من السلطة الغامضة التي يمتلكها، ومعرفته برجال السلطة الذين يزورونه كل فترة، ولا يجد له ميزةً سوى أنه خرج في مظاهرات الشعب ضد التنحي بعد الهزيمة، التي لم يتم ذكرها كهزيمة، بل عدّها الخوجة، انتصاراً وحاول إيهام الجميع بهذا الأمر، وبأنّ ما تبقّى مجرد مناوشات من العدو، بمساعدة الشيطان الأكبر أمريكا ومعداتها الحديثة. وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل داخل العمل: هل تعرضت مصر للهزيمة في 1973، بعد الثغرة التي فتحها الأمريكان؟ يمكن للخوجة إشاعة ونشر أي شيء، فهو صاحب الجريدة الوحيدة التي تصل إلى الناس، "صوت الحرب".
ولمنافسة الخوجة على دوره، كان الشيخ أيوب، يعين الناس على تحمّل مشقّات الحرب، محاولاً إقناعهم بأنها حرب مقدسة على وشك الانتهاء، ووصل به الأمر في موالاة السلطة أن انتحل كلاماً نسبه إلى القرآن يمجّد في الزعيم ناصر. وحين حاول نوح النحال، المتعلم الذي عاش في القاهرة فترةً، إقناع البعض بأنّ هذا الكلام ليس من القرآن وإنما منحول، عدّوه مخطئاً، لتظل سمة القداسة مرتبطةً بالزعيم، فهو أشبه بالمهدي المنتظر.
الشيخ أيوب نفسه هو أيضاً من قرر أن يخترع "صلاة القلق"، حتى تزول الغمّة ويبتعد الوباء عن النجع، ووضع لها طقوساً من عنده، وقرر أن تكون كلها جهراً، ورتّب الأدعية التي يقولها خلال الصلاة، الأمر الذي لقي ترحيباً من أهالي النجع الذي يضم 70 منزلاً، إلى أن جاء نوح النحال، ودعا الناس للبحث عن مخرج من هذا المكان. وكان نوح قد اعتاد السُّكْر بعد رحيل ابنه الوحيد إلى الحرب، ووفاة زوجته التي قرر أن يدفنها في المنزل ليناجيها طوال الوقت ويأنس بها.
تنقسم الرواية إلى جلسات. في كل جلسة تحكي شخصية من أبطال العمل حكايتها. ويختار الكاتب في مفتتح كل جلسة أو كل فصل مقطعاً من إحدى أغاني عبد الحليم حافظ. معظمها أغانٍ وطنية، مثل "عدّى النهار" و"أدهم الشرقاوي" و"إحنا الشعب"
النجع المعزول وسط الصحراء أو الروابي والمحاصر بحزام من الألغام، أو هكذا يتوهّم الأهالي، يشبه إلى حد كبير قرية ماركيز ("ماكوندو") في "مائة عام من العزلة"، مع مقاربة مكانية مختلفة مرتبطة بخصوصية المكان وشخوصه والظرف السياسي أو التعبئة للحرب التي تُعدّ مركزيةً في رواية "صلاة القلق".
من الشخصيات البارزة في الرواية أيضاً "شواهي"، الغجرية الحرّة التي تعيش حياتها كما تشاء؛ فهي تمتلك حانةً ومرقصاً على مشارف النجع في مكان استقروا عليه بعد مشورة شيخ المسجد الذي كان يتسلل إليها ليلاً في السرّ برغم أنه متزوج من ثلاث سيدات، إلا أن المواصفات الشبقية القياسية التي تمتلكها شواهي، جعلتها مطمعاً لكل رجال القرية.
ينكشف سرّ الراوي الحقيقي لأحداث الرواية، وأنها عبارة عن 170 صفحةً فولسكاب تركها حكيم الأخرس أو عبد الحكيم ابن خليل مسعد الخوجة، هذا الولد الذي كان يمثّل لغزاً لأبناء النجع، لأنه الوحيد الذي لم تصبه اللعنة ولم يسقط شعره أو حاجباه. وكان يتحرك في أماكن كثيرة، إلى درجة أن البعض يخيّل إليه أن هناك نسخاً منه. ربما بفعل السحر أو مصادقته للقطط، بعض القطط تتمثل هيئته في أماكن معينة. ويصبح البوح والكتابة التي يقوم بها هي علاجه الأثير في مستشفى الصحة النفسية للعباسية، في عام 1988، بعد أكثر من 10 سنوات على الثورة التي اندلعت ضد أبيه في النجع، وأدت إلى حرق منزله.
وتأتي هذه القطعة لتختتم الرواية، وهي ضمن توصيات الطبيب المعالج لحكيم: "من الحتمي أن يواصل المريض الكتابة، لا بد من تشجيعه وتحفيزه على تفريغ كل ما يختزنه من صور ومشاعر وكلمات حبيسة، الأوراق والأقلام هي صلته الوحيدة بالعالم، فإن انقطعت هذه الصلة سقط في عوالمه البديلة. الحبر هو ما يغذي طاقته ويروي خياله ليبقيه حيّاً، فإن جفّ الحبر ذبل الجسد، واستعدّت الروح للرحيل".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.