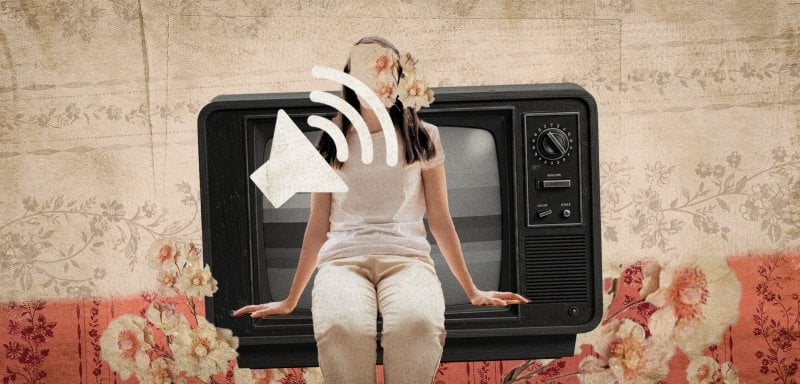في تتر مسلسل "لعبة نيوتن"، تتمايل كرات بندول نيوتن، واحدةً تلو الأخرى. سلسلة من الارتطامات الميكانيكية، لكنها في يد المخرج والمؤلف تامر محسن، تتحول إلى استعارة مشحونة: حركة تبدأها امرأة، فتتتابع صدماتها في جسد النظام الاجتماعي، كأنّ السكون ذاته لم يعد ممكناً. تلك هي "هنا"، بطلة الحكاية، التي ما إن تغادر القاهرة إلى الولايات المتحدة، حتى تبدأ رحلة تصدّع بطيء في البنية الأبوية التي أحاطت بها.
بهذه اللمسة الرمزية الدقيقة، يتسلل محسن، إلى قلب العلاقات الجندرية، لا بوقائع صريحة أو شعارات جاهزة، بل بحركة كامنة بين الشخصيات، وباهتزاز في ميزان القوة، وبتصدع لا يُعلن عن نفسه إلا حين يقع. فمن "لعبة نيوتن" إلى "هذا المساء"، وصولاً إلى "قلبي ومفتاحه"، ثمة خيط واضح: نساء لم يعد بإمكانهنّ تقبّل الأدوار المرسومة لهنّ، ورجال يتعثرون أمام تلك التغيرات، فيتجلى الصراع الجندري كحقيقة سردية لا يمكن نفيها.
ما يميز رؤية محسن ليست جرأته في طرح المسكوت عنه فحسب، بل دقة تشريحه لعلاقات القوى الاجتماعية، خاصةً تلك التي تمرّ عبر أجساد النساء وأصواتهنّ الصامتة. إنه لا يضع المرأة كرمز أو ضحية فحسب، بل يتعامل معها بوصفها كائناً سردياً يمتلك وكالته الخاصة، وهو ما يشكل صلب التحليل الجندري في النظرية النسوية.
تستند هذه القراءة إلى مقاربات النقد النسوي، الذي لا يكتفي برصد وجود المرأة في النص، بل يطرح أسئلةً جذريةً حول من يروي الحكاية، ومن يمتلك سلطة تمثيل الذات، ومن يُسمح له بالكلام أو يُفرض عليه الصمت. فالجندر هنا ليس مجرد سمة ثقافية تضاف إلى الشخصيات، بل هو مسرح كامل من علاقات الهيمنة والمقاومة.

وفي هذا السياق، يصبح بندول نيوتن أكثر من مجرد استعارة بصرية. إنه حركة الوعي النسوي ذاتها، حين تدرك النساء أنّ خضوعهنّ ليس قدراً طبيعياً، بل نتاج تراكم اجتماعي يمكن مساءلته وتحريكه، حتى لو بثمنٍ عالٍ. حركة تبدأ من شخصية واحدة -"هنا"- لكنها لا تلبث أن ترتطم بشخصيات أخرى، من الزوج المرتبك، إلى الشيخ الغامض، إلى النسوة العالقات بين الرغبة والتقاليد. كلهم يتلقون الضربة، بطريقة أو بأخرى.
الهيمنة تُروى… كيف تفكك "لعبة نيوتن" آليات السيطرة الأبوية
منذ الحلقات الأولى، يتكشّف لنا زواج "هنا" و"حازم"، كعلاقة لا تقوم على الحب أو التفاهم، بل على وهم الحماية. حازم لا يصرّح بأنه يريد السيطرة، لكنه يفعلها باسم الخوف عليها. يرسم ملامح رجل يحكم قبضته لا بالسوط، بل بالقلق، بالإقناع العاطفي، وبالتشكيك الهادئ في قدرات زوجته. إنه ما يسمّيه النقد النسوي بـ"الإسقاط النفسي"، حين ينقل الرجل مخاوفه ومشكلاته إلى المرأة، ثم يعاقبها عليها.
يتسلل محسن، إلى قلب العلاقات الجندرية، لا بوقائع صريحة أو شعارات جاهزة، بل بحركة كامنة بين الشخصيات، وباهتزاز في ميزان القوة، وبتصدع لا يُعلن عن نفسه إلا حين يقع
"أنتِ ضعيفة… ستفشلين إذا ابتعدتِ عني"؛ ليست هذه جملة قالها حازم نصّاً، لكنها الرسالة التي تكرّست داخل "هنا"، شيئاً فشيئاً. يتحول الخوف من العالم الخارجي إلى قيد داخلي، ينمو في ذهنها كقناعة، لا كفرض. هذه الآلية الدقيقة، التي يسردها المسلسل دون وعظ أو إدانة صريحة، تفضح الوجه الخفي للسلطة الذكورية: كيف تصنع امرأةً تعتمد على من يسلبها استقلالها، وتظن أنها اختارت ذلك بنفسها.
لكن اللعبة، كما يوحي اسم المسلسل، لا تنتهي عند هذا الحد. حين نتتبّع جذور سلوك حازم، نكتشف أن هشاشته المتخفية تحت قناع القوة ليست إلا صدى لتاريخ عائلي من المقارنات القاسية. شقيقه الأفضل، صورته المهزوزة عن نفسه، كلها تُعاد إنتاجها في زواجه، في محاولته الفاشلة لإثبات ذاته عبر تقييد "هنا". هنا يتقاطع السرد مع النظرية النسوية: الهوية الجندرية ليست معطى طبيعياً، بل نتيجة لتكوين اجتماعي طويل يعيد إنتاج نفسه، جيلاً بعد جيل، عبر الآليات القمعية نفسها.
لكن المسلسل لا يكتفي بتشريح العلاقة الذكورية على مستوى السيكولوجيا فقط، بل ينتقل إلى ما هو أعمق: الجسد.
في "لعبة نيوتن"، لا يُروى جسد المرأة فقط، بل يُتنازع عليه. يتحول جسد "هنا"، إلى ساحة صراع بين رجلين، حازم ومؤنس، لا باعتبارها كائناً حُرّاً، بل كملكية، كرمز لسلطة يُنتزع أو يُحمى. حين تتزوج "هنا"، من مؤنس، بعد طلاقها من حازم، لا ينتهي الصراع، بل يأخذ شكلاً أكثر عنفاً ووقاحة. امتناعها عن العلاقة الحميمة مع مؤنس يُفسَّر كنوع من التحدّي الذكوري، ما يدفعه لمحاولة اغتصابها تحت ستار "الحق"، وكأنّ الجسد الأنثوي لا يُعرّف إلا من خلال رغبة الرجل فيه، لا عبر إرادتها هي.
هنا، يكشف تامر محسن، عن آلية شديدة التوحش في النظام الأبوي: الجسد الأنثوي لا يُرى كحقّ للمرأة، بل كامتياز للرجل، وكل رفض لأن يُمتلَك يُقابَل بالعقاب. وهذا بالضبط ما تسعى النظرية النسوية إلى تفكيكه: أن تكون المرأة ذاتاً، لا موضوعاً. أن تُروى من داخلها، لا أن تكون ميداناً لسرد خارجي يكتب عليها لا عنها.
بهذا، لا يقدّم المسلسل مجرد حكاية زواج متعثر، بل نموذجاً سردياً دقيقاً لتكاثر السيطرة في العلاقات الجندرية، وللكيفية التي يتحول بها الحب، أو ما يشبهه، إلى أداة قمع ناعمة، تُمارس باسم الحماية، وتبرَّر بالخوف.
حين تتكلم الدراما… الاغتصاب الزوجي والطلاق الشفهي كجروح مفتوحة
لم تكن مفردات "الاغتصاب الزوجي" و"الطلاق الشفوي" مألوفةً في الخطاب الدرامي المصري. في العادة، تتوارى مثل هذه المفاهيم خلف عبارات مخففة، أو تُختزل في خلافات زوجية لا تُمسّ. لكن "لعبة نيوتن" شقّ هذا الصمت. في مشهد فارق، يضعنا تامر محسن، أمام ما لا يمكن تأويله: رجل يُجبر زوجته عن ممارسة الجنس، وهي ترفض بوضوح، فيتمادى، مدفوعاً ليس فقط بالرغبة، بل بفكرة الحق، وكأن جسدها مُلكٌ مشروع.
لا يترك المسلسل مساحةً للتبرير. الكلمة تُقال بوضوح: "اغتصاب". ليس "إكراهاً"، وليس "خلافاً"، بل اعتداء صريح يُقدَّم كما هو، بما يحمله من عنف وانتهاك. إنها لحظة فاصلة لا في مصير الشخصية فحسب، بل في خطاب الدراما المصرية نفسها، التي كثيراً ما غلّفت هذه الأفعال بستار من الأعذار أو الصمت.
وبالحِدّة نفسها يتعامل المسلسل مع قضية أخرى لا تقلّ حساسيةً: الطلاق الشفوي. بكلمة مسجّلة على تطبيق واتساب، يُنهي حازم زواجه من "هنا"، ثم يحاول إرجاعها، أيضاً بصوت لا يبلغها في حينه. هذه البساطة المخيفة في هدم علاقة إنسانية، تسلّط الضوء على اختلال قانوني واجتماعي مزمن، حيث يملك الرجل وحده سلطة الفسخ، بينما تُترك المرأة رهينةً لما لم يُبلّغ إليها.
اللافت أنّ هذه المشاهد لم تمرّ بهدوء. وسما #الطلاق_الشفوي و#الاغتصاب_الزوجي، تصدّرا منصات التواصل الاجتماعي في مصر فور عرض الحلقات. لم يكن ذلك ضجيجاً لحظياً، بل انعكاساً لدور الدراما حين تخرج من دور التسلية، لتصبح جزءاً من النقاش العام، وتعيد طرح الأسئلة المؤجلة.
وراء هذه القضايا، يتحرك شيء آخر أكثر رهافةً: تطور الشخصيات النسائية نفسها. "هنا"، التي عرفناها كزوجة تابعة، خائفة، تنظر دائماً إلى زوجها لتستمدّ يقينها، تبدأ –ببطء- رحلةً إلى الداخل. ليست رحلة صعود درامي مباشر، بل مسار متعرج، فيه السقوط بقدر ما فيه الاكتشاف. إنها لا تتحول إلى "امرأة قوية" بالصورة الكليشيهية، بل تصبح ببساطة ذاتاً تحاول أن تكتب روايتها بيدها.
وهي ليست وحدها. يارا، شقيقة هنا، ومنة، وشقيقة مؤنس، شخصيات نسائية تتصارع مع محيط يحاول قولبة حياتهنّ، واحتواء قراراتهنّ. كل واحدة منهن تمثّل مقاومةً صامتةً، خيطاً صغيراً في نسيج أكبر من التغيير. ليست الثورة دائماً بصوت عالٍ. أحياناً، تكون في اختيار واحد صغير، في لحظة انسحاب، في رفض أن يكون الجسد أو المصير قراراً يُتخذ من قِبل آخرين.
في النهاية، لا يمنح "لعبة نيوتن" إجابات جاهزةً، لكنه ينجح في زحزحة ما كان يبدو مستقراً. يجعل من قضايا كانت محظورةً جزءاً من المشهد العام. ويجعل من النساء -لأول مرة منذ زمن- شخصيات تملك صوتها، لا صدى لسلطة ذكورية تتكلم عبرها.
في حضرة العين الخفية... "هذا المساء" وتقاطعات الفضول والجندر في عصر المراقبة
لم يعد التجسس يتطلب خلسةً من وراء الجدران. في عالم هذا المساء، يكفي أن تمسك بالهاتف، أن تمرر إصبعك على الشاشة، أن تضغط تسجيلاً دون أن تُرى. هكذا تتفتح الأبواب، تلك التي قال تامر محسن، إنها أغوت خياله، لأنها مغلقة، لأنها تخفي ما لا يُقال.
لكن ما يجعل هذا المسلسل أكثر من مجرد حكاية عن تطفّل عصري، هي تلك الجرأة في طرح سؤال مزعج: هل الفضول بريء؟ وهل هو متساوٍ عند الجميع؟ أم أنه -مثل كل شيء في عالم غير عادل- يخضع لمنطق الجندر والسلطة؟
في أحد خطوطه الدرامية، نتابع "أكرم"، الرجل الذي ينتمي إلى طبقة اجتماعية أعلى، يدفعه فضوله لاجتياز الحدود الطبقية والنزول إلى عالم أقل منه اجتماعياً، لا بدافع التضامن، بل بدافع التلصص. بينما "سمير"، العامل البسيط، يوجّه فضوله نحو زوجة رئيسه، لا ليعرفها، بل ليمتلك نظرةً لا يُفترض به امتلاكها. أما "سوني"، فيبحث عن لحظة تسلية خارج روتين زواجه، كأنّ الفضاء الرقمي صار مرآةً لرغبات مكبوتة، لرجلٍ لم يُعلّمه العالم كيف يعبّر، فقرر أن يراقب بدلاً من أن يتكلم.
هذا التفاوت في "فضول الذكور"، لا يُطرح باعتباره خصلةً إنسانيةً فقط، بل كأداة من أدوات القوة. فحين يراقب الرجال، فإنهم يتحكمون في الصورة، يملكون زمام القصة. بينما النساء، غالباً، يُرصدن، ويُنتجن كمواضيع للمشاهدة لا كذوات فاعلة. من هنا يصبح الفضول، في قراءة جندرية، امتداداً لعلاقات السيطرة التي تتخذ في العصر الرقمي شكلاً أكثر نُعومةً، وأشدّ توغلاً.
الشخصيات في هذا العمل لا تصرخ، لا تعترف، لكنها تنكشف. يقول تامر محسن، إن الأصعب في هذا المسلسل هو أن شخصياته "مالهاش عنوان". إنها لا تنتمي إلى قوالب جاهزة، بل تتشكل بين التردد والإنكار والبحث عن معنى لما تشعر به ولا تستطيع تسميته. وهذا تحديداً ما يجعل الشخصيات النسائية في هذا المساء بعيدةً عن النمطية المعتادة. لا "ضحية مثالية"، ولا "امرأة شريرة"، ولا حتى "بطلة قوية" بالمعنى التقليدي. بل نساء يَظهرن ككائنات معقّدة، مترددة، تعيش تناقضاتها دون أن يُطلب منها تقديم تبرير كامل.
لكن وسط هذه التعقيدات، يبقى انتهاك الخصوصية الجنسية هو لحظة الانكشاف الأكبر. في إحدى أكثر لحظات المسلسل قسوةً، تُبتزّ "تُقى" من قبل شخصية تُدعى "فياض"، بعد حصوله على مقطع جنسي يخصّها. لا يكتفي بابتزازها، بل يستثمر في هشاشتها، مستغلاً الهلع المجتمعي من سمعة المرأة، والخوف من الفضيحة. إنها لحظة تُظهر كيف يتحول الجسد الأنثوي إلى عبء رقمي، وكيف تصبح أدوات التكنولوجيا امتداداً للسلطة الذكورية التي اعتادت أن تراقب وتُدين وتُخضع.
في عالم هذا المساء، لا تُطرح الخصوصية باعتبارها حقاً قانونياً فقط، بل كجبهة جديدة في معركة الجندر. ومن خلف كل شاشة، تقبع عين تتفرّج، تُراقب، تُعيد تشكيل الحكاية. ومن خلف كل امرأة، شبح فضيحة جاهزة، حتى لو كانت الضحية.
"قلبي ومفتاحه"... حين يتحول الزواج إلى معاملة مشروطة
في "قلبي ومفتاحه"، يعود تامر محسن ليطرح سؤالاً أكثر جذريةً مما يبدو: ماذا لو كانت القوانين التي تنظم علاقاتنا الأكثر حميميةً، الزواج، الطلاق، الحضانة، قائمةً من الأساس على بنية اختلال في القوة، لا على عدالة إنسانية؟ لا يدور العمل حول الحب أو الخيانة أو الفقد، بل حول النساء كأجساد عالقة بين النصوص والتفسيرات، بين ما يُقال إنه "شرع الله" وما تمارسه السلطة الذكورية باسم هذا الشرع.
بطلتها "ميار" (مي عز الدين)، تطلّقت ثلاث مرات من زوجها "أسعد"، وتجد نفسها مطالبةً -لتعود إليه- بالزواج من رجل آخر، يُعرف اصطلاحاً بـ"المحلل الشرعي". لكن المفارقة أنّ هذا "المحلل" لن يكون شخصيةً دينيةً تقليديةً أو رجلاً مسنّاً في حكاية رمزية، بل شاب عادي يعمل سائق "أوبر"، "محمد عزت" (آسر ياسين)، لم يتزوج قط لأنّ والدته ترفض كل امرأة يختارها.
في هذا التوازي السردي، يكشف المسلسل عن جبهتين متقاطعتين من السلطة: الأولى قانونية/ دينية، تطلب من المرأة أن تتزوج جسدياً لا رمزياً لتعود إلى بيتها الأول. والثانية عائلية/ نفسية، تجعل من الأمّ نموذجاً للمراقبة والتقييد، لا للحنان والرعاية.

ليست الأم هنا شخصيةً هامشيةً. إنها القاعدة الصامتة التي يستند إليها النظام. في النموذج الذي يقدّمه المسلسل، تتجلى "الأم الحارسة للنظام الأبوي" بأوضح صورها. تتحكم الأمّ في خيارات ابنها العاطفية، ترفض كل مرشحة للزواج، لا بدافع الغيرة أو الخوف، بل لأنها أصبحت جزءاً لا يُفكك من آلية السيطرة. بهذا، تصبح السلطة الأبوية أكثر تعقيداً: لا تأتي فقط من الرجال، بل أحياناً تُمارس باسم الحب، من امرأة ضد امرأة.
ما يميّز "قلبي ومفتاحه" هو أنه لا يبتذل هذه العلاقات. لا يصوّرها كصراع بين شرّ وخير، بل كنظام ثقافي معقد، حيث تداور السلطة بين الأفراد، أحياناً دون وعي، وأحياناً بدافع النجاة.
وسط هذا النسيج السردي، تبرز "ميار"، كشخصية تمثل مأزقاً يتكرر في حياة آلاف النساء في مصر. لا تخشى فقط فقدان كرامتها أو استقلالها، بل تخشى شيئاً أكثر فداحةً: أن تُحرَم من ابنها. وهنا، لا يعود الطلاق مجرد نهاية علاقة، بل بداية سلسلة من التهديدات: في الحضانة، في السمع، وفي السمعة.
عبر هذه الشخصية، يسلّط المسلسل الضوء على القوانين غير المتكافئة التي تجعل من حضانة الأطفال سلاحاً في يد الرجل، وعلى منظومة اجتماعية ترى أنّ المطلقة يجب أن تُعاقب، ولو باسم "الصالح العام". حين تسعى ميار، إلى الزواج من "محلل" تختاره بنفسها، فهي لا تبحث عن رجل، بل عن وسيلة لحماية ابنها، لنيل حقّها في البقاء أمّاً، حتى لو عبر زواج مشروط لا رغبة فيه.
حين تُجبر المرأة على التفاوض على جسدها من أجل أمومتها، فثمة خلل لا يتعلق فقط بالدين أو القانون، بل بالتصورات العميقة لما يعنيه أن تكوني امرأةً في مجتمع يحاسبك على ما تفعلينه... وعلى ما لا تفعلينه.
من التلصص إلى التفكيك... تطوّر الرؤية النسوية في أعمال تامر محسن
لم يكن تامر محسن، في بداياته يُقدِّم نفسه كصوت نسوي بالمعنى المباشر. في هذا المساء (2017)، كان الفضول هو مركز الثقل، مدفوعاً بالدهشة إزاء العالم الرقمي الجديد. بدا اهتمامه بما وراء الأبواب أكثر منه بما خلف الأجساد. لكن ما بدأ كتأمّل في "أفضل نقيصة بشرية"، كما وصفها، تطوّر تدريجياً إلى مشروع درامي متماسك، تُشكّل فيه قضايا النساء وبُنى العلاقات الجندرية عموداً فقرياً لا يمكن تجاهله.
بين "هذا المساء" و"لعبة نيوتن" (2021)، تتبدل اللغة. لم يعد الحديث عن العلاقات بالرمز والغمز، بل صار في مواجهة مباشرة مع النظام الأبوي. يغدو "الاغتصاب الزوجي" حدثاً درامياً يُسمّى باسمه، ويصبح "الطلاق الشفهي" فعلاً فجّاً يُمارس بوسائل رقمية، تكشف عري القانون والمجتمع معًا. وفي "قلبي ومفتاحه" (2025)، ينتقل الخطاب من سطح القضايا إلى عمق البنية: الزواج لم يعد مؤسسةً للحب، بل آلية تفاوض معقدة تُخضع المرأة لسلطة التشريع، والأمومة نفسها تُعاد قراءتها كسياج اجتماعي يضبط الرغبة والاستقلال.

هذا التحوّل من الطرح إلى التفكيك، من الحكاية إلى البنية، يعكس نضجاً واضحاً في رؤية محسن النسوية. لم يعد يكتفي بإثارة الجدل أو تقديم شخصية "قوية"، بل صار معنياً بسؤال الجذر: من يملك القرار؟ من يكتب القواعد؟ من يُحاسب؟ ومن يُعفى؟
من "لعبة نيوتن" إلى "هذا المساء"، وصولاً إلى "قلبي ومفتاحه"، ثمة خيط واضح: نساء لم يعد بإمكانهنّ تقبّل الأدوار المرسومة لهنّ، ورجال يتعثرون أمام تلك التغيرات، فيتجلى الصراع الجندري كحقيقة سردية لا يمكن نفيها
واحدة من أهم مميزات مشروع محسن، أنه لم يقع في فخ التنميط المعاكس. لم يُقدّم نساء مثاليات ولا رجالاً كاريكاتوريين. شخصياته، كما يقول، "مالهاش عنوان". إنها تتحرك داخل تعقيداتها، تتلعثم، تنكر، تخطئ، وتكافح. ومن هذا التعقيد تحديداً، تولد المسافة التي تسمح للمشاهد بالتفكير، لا بالاستهلاك.
في "لعبة نيوتن"، تصبح استعارة بندول نيوتن أداةً دراميةً لتجسيد الشرخ داخل المنظومة: حركة تبدأها امرأة واحدة، فترتطم بالقيم، بالرجال، بالشرع، وبالعائلة. في "هذا المساء"، تتحول الهواتف المحمولة إلى شاشات عرض صغيرة تُعرض عليها الحياة الخاصة، وتُكشَف فيها هشاشة الجميع، خاصةً النساء. وفي "قلبي ومفتاحه"، تتجسد السلطة لا في صورة رجلٍ عنيف، بل في أمّ ترفض زواج ابنها، وفي تشريع يُجبر المطلقة على إعادة المرور بجسد رجل آخر، لتستحق العودة إلى بيتها.
خلف الكاميرا... الصوت النسائي حاضر أيضاً
ليس من قبيل المصادفة أنّ هذه الرؤية النسوية جاءت متزامنةً مع حضور نسائي قوي في طاقم العمل. في "لعبة نيوتن"، كانت مها الوزير التي تشرف على الكتابة، وسمر عبد الناصر حاضرتين في مفاصل المشروع. هذه الشراكة لا تُقرأ فقط كدلالة رمزية، بل كمفتاح عملي لفهم الحساسية العالية التي تُكتب بها الشخصيات النسائية في أعمال محسن. فالمرأة ليست هنا مرآةً لرؤية المخرج، بل شريكة في صناعتها.
هذا ما تدعو إليه النظرية النسوية في عمقها: ليس فقط تمثيل النساء على الشاشة، بل تمكينهنّ من مواقع القرار خلف الكاميرا أيضاً. وهنا يبدو تامر محسن، ملتزماً بهذه القاعدة، لا بوصفها "كوتا" فنيةً، بل كعنصر ضروري لتحقيق الواقعية وتعقيد التجربة النسائية في الدراما.
لا يمكن إنكار أنّ هناك حدوداً لما يمكن طرحه في الدراما المصرية. الرقابة، حساسيات الجمهور، ومعايير السوق كلها عوامل تشكل الإطار. لكن داخل هذا الإطار، نجح محسن، في المراوغة الذكية: لم يصرخ، ولم يعظ، لكنه روى. وحين تُروى القصة بطريقة إنسانية، دون تنميط أو ادعاء، يصير لها وقع حقيقي.
وبرغم أنّ معظم أعماله تدور في فضاء الطبقة الوسطى أو العليا، إلا أنّ البنية التي ينتقدها النظام الأبوي تتغلغل في كل الطبقات، وهو ما يُعطي أعماله بعداً أوسع من حدود الشريحة الاجتماعية المصوّرة.
أعمال تامر محسن، لا تقدّم أجوبةً، لكنها تطرح الأسئلة؛ عن الجسد، عن الصوت، عن القانون، عن الحب حين يُمارَس كقيد، وعن الزواج حين يصير عقداً يُفسَّر ضد النساء دائماً. ومن خلال هذا الطرح، قدّم نموذجاً لدراما مصرية معاصرة قادرة على إحداث تحوّل في وعي الجمهور، لا عبر الوعظ، بل عبر الحكاية المتقنة، والإنصات العميق لما لم يُقَل.
في زمنٍ يتكلم فيه الجميع، تبرز أهمية أن نستمع إلى من يصوغ فنّه بوصفه فعل تفكير. وتامر محسن، في أعماله الأخيرة، لم يعد فقط صانع دراما، بل مفكر سردي يعيد رسم خرائط السلطة، ويسائل الذكورة... بصوت خفيض، لكنه لا يُنسى.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.