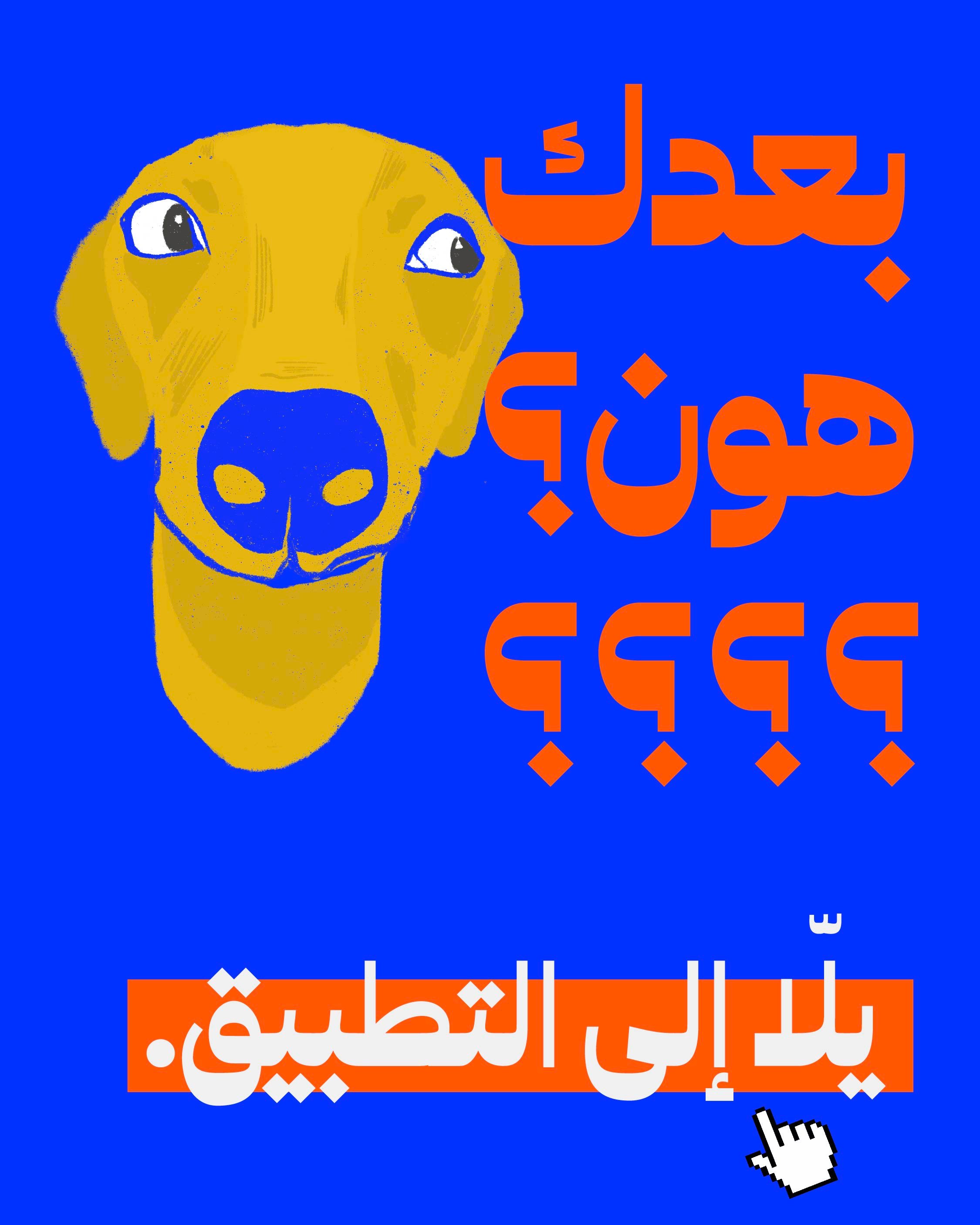منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، دخل المجتمع السوري في دوامة تغييرات ديناميكية عميقة، أفرزتها أحداث الثورة، وما تبعها من صراعات سياسية وعسكرية.
لم تقتصر هذه التحولات على بنية الدولة ومفهوم الحقوق والواجبات والمواطنة، بل طالت سلوكيات الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، وحتى لغتهم المشتركة، وأعادت رسم المشهد الطائفي والعرقي في البلاد على أسس جديدة، قوامها التشرذم والخوف المتبادل والتوجس من الآخر.
هويات فرعية
لطالما كان المجتمع السوري متنوعاً طائفياً وعرقياً، لكن السياسات القمعية التي انتهجها نظام الأسد، خصوصاً تجاه الجماعات السنّية التي شكّلت العمود الفقري للثورة، عمّقت الاستقطاب، وحوّلت الهوية الوطنية المشتركة إلى هويات فرعية ترتكز على الطائفة والانتماء الجماعي الضيّق.
بعد وصول حافظ الأسد، اختلطت الأغلبية والأقليات في المدن. كما في دمشق، التي تسكنها الأغلبية السنّية وجماعات أخرى من العلويين والمسيحيين في أحياء محددة، حيث تفرض هذه الأقليات بدورها على تلك المناطق سمة الأغلبية، وكما في حمص، حيث من الشائع أن نجد حارة العلويين ملاصقةً لحارة السنّة، أو حيّاً كبيراً يضمّ مختلف الطوائف
ولم يعد الانقسام بين مكوّنات المجتمع مجرد اختلاف في الآراء أو الولاءات، بل أمسى شرخاً عميقاً جعل كل طرف ينظر إلى الآخر بعين الريبة والعداء، فقد ترسخت قناعات بأنّ على كل جماعة أن تحمي نفسها ومصالحها، ما جعل التفاهم والتواصل بين المكونات أكثر صعوبةً، وعزز مشاعر الخوف وعدم الثقة. ومع تصاعد الصراع في البلاد، زادت حالة الاستقطاب، ووجدت الطائفة العلوية نفسها في قلب الاتهامات، باعتبارها الحاضنة الرئيسية للنظام الذي ينتمي إليها، ما رسّخ الانقسام، وأذكى مشاعر العداء بين المكوّنات.
التنوّع وقود لصراعات دموية
توزّع الجماعات الطائفية في سوريا، كان حاضراً قبل نشوء الدولة الحديثة سنة 1946، حيث عمل الانتداب الفرنسي على تقسيم سوريا إلى مناطق إدارية تشمل طوائف ومجموعات إثنيةً مختلفةً، مثل العلويين في الساحل السوري، والدروز في السويداء، والمسيحيين في مناطق متفرقة، والسنّة في دمشق وحلب.
بعد وصول حافظ الأسد، إلى السلطة، عام 1970، قام بتعزيز سيطرة بعض أبناء الطائفة العلوية على العديد من المناصب العسكرية والأمنية، ما أدى إلى تشكيل شبكة من الولاءات الطائفية في مختلف أنحاء البلاد.
ونتيجةً لهذا كله، اختلطت في المدن الأغلبية والأقليات، مثل دمشق التي تسكنها الأغلبية السنّية وجماعات أخرى مثل العلويين والمسيحيين في مناطق محددة ضمن العاصمة، وتفرض هذه الأقليات بدورها على تلك المناطق سمة الأغلبية، وفي حمص أيضاً، حيث من الشائع أن تجد حارة العلويين ملاصقةً لحارة السنّة، أو حيّاً كبيراً يضمّ مختلف الطوائف.
إلا أنّ هذا الاختلاط والتنوع الذي كان يتفاعل ضمن إطار وطني واحد، إلى حدّ ما، قبل الحرب، أصبح وقوداً لصراعات دموية وعنف في السنوات التي تلت الحرب، كما حدث في مدن مثل حمص وجبلة وبانياس، خلال ذروة الأحداث فيها، حيث تحول الجوار الطائفي إلى مواجهات عنيفة ومجازر متبادلة، وزاد من تفكّك النسيج المجتمعي.
بجانب ذلك، جاءت موجات النزوح الداخلي والخارجي لتغيّر ملامح المجتمع السوري ديمغرافياً وسلوكياً، فقد أفرزت هذه التحولات أنماطاً جديدةً من العلاقات بين الأفراد، قائمةً على الحذر والتوجس، وزادت من انتشار الوصم والتمييز على أساس المعتقد واللهجة واللباس، ما عزّز الانقسامات المجتمعية.
طور جديد من التغييرات الديناميكية
ومع سقوط نظام الأسد ووصول جماعات ذات خلفية إسلامية متشددة إلى الحكم، ووجود تاريخ لبعضهم مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"؛ دخلت سوريا طوراً جديداً من التغييرات الديناميكية، حيث تصاعدت مخاوف الأقليات -وعلى رأسهم العلويون- من انتقام جماعي على خلفية انتماء عائلة الأسد إلى الطائفة.
تشير تقارير إلى تسجيل انتهاكات ضد العلويين، في الأشهر التالية لسقوط النظام، وأخرى أقلّ حدّةً تجاه باقي الجماعات الأقلية، ومن جانب آخر، تصاعدت مخاوف قطاعات واسعة في المجتمع من أن تتحول مؤسسات الدولة والموارد إلى أداة لترسيخ سلطة طائفية جديدة، ما يعيد إنتاج الإقصاء والاستبداد بصيغة مختلفة، ولا سيّما أنّ رئيس البلاد أكد في حوار سابق، ضرورة أن تتمّ التعيينات من لون واحد خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى العديد من القرارات التي اتّخذتها الحكومة الجديدة، مثل تسريح الموظّفين، أو إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً إدارياً.
محاولات لرأب الصدع… ولكن!
في ظلّ هذا المشهد المتشظّي، تصاعدت دعوات الانقسام الجغرافي على أساس الطائفة والجماعة، برغم بعض المحاولات لرأب الصدع، كما في اتفاق الإدارة الجديدة مع "قسد". إلا أنّ استمرار بعض الجماعات، مثل الدروز، في الاحتفاظ بسلاحها تحت مظلّة حماية الذات، برغم رفضها الرسمي للانفصال، يعكس هشاشة الواقع الجديد، ويطرح تساؤلات حول مدى إمكانية إعادة بناء دولة موحدة.
تشير تقارير إلى تسجيل انتهاكات ضد العلويين، في الأشهر التالية لسقوط النظام، وأخرى أقلّ حدّةً تجاه باقي الجماعات الأقلية.
وفي خضمّ هذه الديناميكيات المضطربة، جاءت مجزرة الساحل السوري أو ما عُرف بـ"فتنة الساحل"، التي راح ضحيتها أكثر من 1،300 شخص، وفق تقديرات غير نهائية، لتعزز فتيل العداء الطائفي المشتعل أساساً، خصوصاً بعد أن أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، وغيره من المنصات، إلى أنّ عمليات القتل جرت على أساس طائفي على يد جماعات أمنية غير منضبطة.
هذه الأحداث تعكس كيف أصبح العنف الطائفي جزءاً من المشهد السوري، وكيف تتجدد الديناميكيات المتغيّرة بوتيرة متسارعة، دون أن تلوح في الأفق بوادر حلول مستدامة.
الانتصار من حقّ طرف واحد!
فقدت الصحافية، حلا منصور (30 عاماً)، جزءاً من عائلتها في مدينة بانياس الساحلية، في أثناء المجزرة. تقول لرصيف22، عن مشاهداتها: "لم أتوقع أن نصل إلى هذا الوضع. كنت أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهم في الساحل لحلّ الأمر وتسليم الإرهابيين الذين استهدفوا دورية الأمن العام".
وتضيف: "ما حدث كان إبادةً جماعيةً وقتلاً عشوائياً استهدف المدنيين الأبرياء في بيوتهم، دون أن تكون لهم أيّ علاقة بالنظام أو بفلوله". وتحدثت عن مظاهرة في وسط مدينة حمص -حيث تعيش- تزامنت مع المجازر في الساحل، ودعت إلى قتل أبناء الطائفة العلوية، مشيرةً إلى أنّ أكثر ما لفت نظرها كان وجود طفل يحمل سكيناً بيده، ويهتف بشعارات المظاهرة الطائفية بينما كان والده يحمله على كتفيه.
غليان حمص بعد السقوط
لم تكن هذه الفاجعة هي أولى تجارب منصور، مع الغليان الطائفي ضد العلويين، إذ تتحدث عن أوضاع مدينة حمص بعد سقوط النظام، قائلةً: "عاش الناس في حمص فترةً من الودّ المزيّف حينها، فقد شهدت المدينة منذ بداية الثورة انقساماً حادّاً بسبب التنوع الطائفي واختلاف المواقف السياسية بين مؤيّدي الثورة وأنصار النظام، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية طائفية أحدثت شرخاً واضحاً بين أبناء المدينة".
وتضيف: "تركة النظام ثقيلة في المدينة، حيث لجأ إلى تدمير أحياء المعارضة ذات الغالبية السنّية بشكل كامل أو جزئي، ولذلك بدأ خطاب الكراهية يزداد حدّةً بعد سقوط النظام، وظهرت تصرفات استعلائية تُصرّ على أنّ الانتصار من حقّ طرف واحد فقط، وأنّ التسامح مع الطرف الآخر أو السماح له بالعيش، نوع من الكرم".
وتوضح أنّ الخوف أصبح شعوراً ملازماً لها ولعائلتها وأقاربها، خاصةً مع وضوح الممارسات الطائفية في حمص. وتتحدّث عن مشاهداتها خلال الأشهر السابقة، قائلةً: "وجود سلطة من لون واحد متشددة دينياً، دفع النساء غير المحجبات إلى ارتداء الحجاب لتجنب المضايقات، وكانت الحواجز الأمنية تسأل الناس عن طائفتهم وتتعامل معهم بناءً على ذلك، بالإضافة إلى الانتهاكات التي رافقت حملات التفتيش من قبل بعض فصائل الأمن العام".
ما حدث ليس شرخاً!
أما الصحافي علاء الخطيب (32 عاماً)، الذي عاش في دمشق لأكثر من 14 عاماً قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في طرطوس بعد سقوط النظام، فقد مرّ بتجربة صعبة للغاية خلال مجازر الساحل. يصف تلك الأيام قائلاً: "كنا ننتظر دورنا"، مضيفاً: "المشكلة أنّ صور شهداء هذه المجازر انتشرت في باريس ولندن ورفعت في شوارعها، بينما كان الناس هنا يحتفلون باتفاق قسد فوق مأساة المجازر!".
ويؤكد علاء، لرصيف22، أنّ ما حدث لا يمكن أن يُسمّى "شرخاً"، مشيراً إلى أنه "كان مقتلةً لم تشهدها المنطقة منذ زمن طويل، وإذا كان هذا شرخاً، فلن يتم إصلاحه".
لو نظرنا من كثب، لوجدنا أنّ الفلاح السنّي من إدلب، بأسلوب حياته اليومي وعاداته وهمومه، أقرب إلى الفلاح العلوي في الساحل من رجل الأعمال السنّي الإدلبي، وحتى وجوه الأمّهات اللواتي فقدن أولادهنّ جرّاء المجازر في الساحل، سواء من إدلب أو من الساحل نفسه، تتشابه في تقاسيمها، كما أنهنّ يتشاركن اللباس البسيط نفسه الذي يعكس المعاناة المشتركة بينهنّ
وعن توقعاته لما سيحدث، يقول علاء، إنّه كان يتوقع حدوث شيء خطير منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، ويضيف: "كان الناس يقولون لي إنني أبالغ في خوفي وتكهّناتي، لكنني كنت أؤكد لهم أنّ هناك تحريضاً وإشارات على ارتكاب هذه المجازر ضد العلويين، خاصةً بعد أن سلّموا كل ما لديهم من أسلحة ولم تعد لديهم القدرة على حماية أنفسهم".
"لم يفقد المجتمع السوري تجانسه!"
يرى علي (30 عاماً)، وهو مهندس مدني ينتمي إلى الطائفة العلوية، أنّ ما حدث بعد سقوط النظام هو "احتقان" اجتماعي، موضحاً: "لا أعتقد أنّ المجتمع السوري فقد تجانسه بعد، أو أنّ المشكلة تكمن في رفض الآخر على أساس طائفته أو اختلافه في عاداته ومعتقداته وأسلوب حياته، لأننا لو نظرنا من كثب، لوجدنا أنّ الفلاح السنّي من إدلب، بأسلوب حياته اليومي وعاداته وهمومه، أقرب إلى الفلاح العلوي في الساحل من رجل الأعمال السنّي الإدلبي!
وحتى وجوه الأمّهات اللواتي فقدن أولادهنّ جرّاء المجازر في الساحل، سواء من إدلب أو من الساحل نفسه، تتشابه في تقاسيمها، إذ تحمل علامات الفقر والمشقّة، كما أنهنّ يتشاركن اللباس البسيط نفسه الذي يعكس المعاناة المشتركة بينهنّ".
ويضيف، لرصيف22: "إدلب وقرى الساحل تتشاركان في زراعة الزيتون، وكلتاهما تنتميان إلى مجتمعات ريفية فقيرة، إذ تحدد الزراعة ونوع المحصول شكل الحياة اليومية وتوجهات المجتمع فيهما. لكن السؤال هو: كيف وصلنا إلى هذه الحالة برغم وجود كل هذه المشتركات، حتى أنّ المجتمعَين يتحدثان بالقاف؟ الجواب بسيط، إنها تركة النظام".
"نتيجة طبيعية لحرب أهلية طويلة"
من جهته، يتحدث سامر (56 عاماً)، ويعمل سائق مركبة في شركة خاصة، وهو علويّ يقيم في حي الورود في دمشق ذي الغالبية العلوية، عن خوفه منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، موضحاً لرصيف22: "ليس لأنّ النظام كان يحمينا، بل لأنّ الطائفة العلوية تُتّهم بأنها شريكة هذا النظام المجرم"، ويتابع: "منذ أعوام وأنا أحاول تدبير طريقة للسفر خارج البلاد، لكن الأوضاع المادية كانت تمنعني، وعائلتي تعتمد كلياً على عملي هنا. البلاد أصبحت مكاناً غير صالح للعيش في عهد بشار، ولكن الآن أصبحت غير صالحة للعيش للعلويين بالذات".
في المقابل، فؤاد (40 عاماً)، علويّ يعمل حارساً في منشأة في حلب منذ أكثر من عقدين، يرى أنّ ما حصل هو نتيجة طبيعية في بلاد خرجت لتوّها من حرب أهلية طويلة، وأنّ الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت بعد سقوط النظام "هيّنة وبتمرّ"، ولكن "ما لا يمرّ، هي هذه المجازر التي وصل عدد ضحاياها إلى الآلاف".
ومع ذلك، يجد فؤاد، أنه بالإمكان معاودة بناء دولة ذات هوية وطنية مشتركة، حيث يتساوى الجميع في الحقوق والحريات والواجبات، قائلاً لرصيف22: "عشت في حلب لأكثر من عشرين عاماً بحكم عملي، ومعظم أصدقائي هم من السنّة، وجميعنا نريد الحلّ، ولا نؤيد التقسيم أو الانفصال على أساس الطائفة والجماعة، ولا استمرار هذه الخلافات".
أما جان (45 عاماً)، وهو مدير لفرع مؤسسة في حلب، ومن مسيحيي المدينة، فيوضح لرصيف22، أنه لم يلاحظ أي تغييرات في بنية المجتمع الحلبي بعد سقوط النظام، أو علاقاته، ويضيف: "القتل والانتهاكات التي حدثت في هذه الفترة كانت تتمّ بين العشائر في حلب، وليس بين الطوائف، أو بدافع الحصول على المال".
تخوّف من تزايد هجرة المسيحيين
ويروي عدد من الأشخاص، لرصيف22، رفضوا الكشف عن أسمائهم، بعض المواقف التي تعرّضوا لها في دمشق، طرطوس، وحلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية. منهم فرح، التي تقول إنها كانت في السيارة مع صديقها في طريقها إلى منزلها، حيث اضطرا إلى التوقف قليلاً على جانب الطريق بالقرب من شارع عام. مرّت سيارة للأمن العام، ونزل منها بعض العناصر وسألوه عن علاقته بها. فاضطر صديقها إلى الكذب وقال إنها خطيبته، برغم أنها مسيحية، ثم طلبوا منه هويته. وتعتقد فرح، أنهما كانا سيتعرّضان لموقف محرج لو كانت هويته تشير إلى غير الطائفة السنّية.
الطائفية ليست متأصلةً في الطبيعة المجتمعية، بل هي نتاج تضارب المصالح بين الجماعات، وليس العكس. فإذا كانت الفرص متساويةً وعادلةً بين الجميع، فإنّ الطائفية ستنحسر.
وفي حادثة أخرى، يروي عمار، أنه اضطر إلى ترك منزله في حي تقطنه غالبية علويّة في دمشق، وانتقل إلى حيّ آخر "لا تغلبه التهمة العلوية". ويضيف: "ثمة أقاويل تتردد مفادها أنهم سيقومون بطرد العلويين من تجمعاتهم في العاصمة، وأنّ الأمر مسألة وقت"، وهذه الأخيرة شائعة جرى تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات السابقة، ولا سيّما في ما يخصّ منطقة الـ"86 خزّان"، في المزّة.
كما يعرب عدد من المسيحيين الذين تحدث إليهم رصيف22، عن تفكيرهم في مغادرة البلاد في أقرب فرصة، خوفاً من تهميشهم وتقويض حرياتهم، مع العلم أنّ هجرة المسيحيين من سوريا تصاعدت بشكل كبير خلال سنوات الحرب، وانخفض عدد المسيحيين في سوريا من 10% من السكان قبل الحرب إلى نحو 2% حالياً، بحسب تقرير وكالة "فرانس برس". وإذا استمرّت رغبة هؤلاء في الهجرة خارج سوريا، وغيرهم من الجماعات الأقلية الأخرى، فإنّ ذلك سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في ديناميكية المجتمع السوري وبنيته الاجتماعية، حيث تهدد هذه التحولات بتغيير التوازن الطائفي، وتعزيز الانقسامات الداخلية، لتزيد من حالة الاستقطاب وتؤثر سلباً على استقرار المجتمع.
تأثير الطائفية على بنية المجتمع سيكولوجياً
استطلع رصيف22، تأثير التحولات المجتمعية في سوريا خلال سنوات الحرب وبعد سقوط النظام، مركّزاً على تأثير الطائفية على بنية المجتمع السوري من الناحية السيكولوجية بعيداً عن التحليلات السياسية.
في هذا الإطار، تقول وردة بوضاهر، الاختصاصية النفسية والناشطة الاجتماعية: "عندما نتحدث عن أيّ مجموعة، سواء كانت سياسيةً أو طائفيةً أو حتى مجموعةً تشجع فريق كرة قدم، نجد أنّ هذه المجموعات تتكاتف لأنّ الأفراد يشعرون بقوة أكبر عندما يكونون معاً.
وعندما يواجهون تهديداً أو محاولةً من مجموعة أخرى لإلغاء وجودهم أو هزيمتهم، فإنهم يسعون إلى الدفاع عن أنفسهم للحفاظ على قوّتهم وعدم السماح لأيّ طرف بالهيمنة عليهم. هذا التكاتف يمكن أن يكون إيجابياً إذا كانت الوسائل التي تُستخدم للدفاع عن المجموعة سليمةً وصحيةً. لكن الأمر قد يتحول إلى سلبي عندما تنقلب هذه الدفاعات إلى سلوكيات عنيفة، كما نرى في بعض الأحزاب السياسية والطوائف".
وتضيف في حديثها إلى رصيف22: "يشعر الأفراد في المجموعات الطائفية أو السياسية بأنهم ملزمون بالدفاع عن هويتهم وأفكارهم، ما قد يدفعهم للقيام بأيّ شيء للوصول إلى هدفهم. هذه السلوكيات قد تصل إلى حدّ العنف، مثل القتل أو الأذى أو تعميم الأفكار السلبية على أفراد طائفة معيّنة، كوسيلة لتحقيق الهدف".
وتشير بوضاهر، إلى أنّ أيّ طرف قد يستغلّ حالة الشرخ الطائفي لتحقيق مصالحه، كما حدث في لبنان، حيث قامت إسرائيل باستخدام الطائفية لصالحها خلال صراعاتها في لبنان، وتأجيج الطائفية بين اللبنانيين. هذا النوع من الاستغلال يجعل من السهل على الأطراف الخارجية التأثير في الصراعات الداخلية من خلال ضرب نقاط الضعف بين أفراد المجتمع. مضيفةً: "يتكرر الأمر ذاته في سوريا، ولو لم تكن هناك أرضية خصبة لهذه التوترات الطائفية، لما كان لهذه المحاولات أن تحقق أيّ تأثير".
وعن سؤال حول إمكانية أن يكون الشخص الذي يرتكب جريمةً أو مجزرةً، طبيعياً مع عائلته، تجيب وردة أبو ضاهر: "للأسف نعم، قد يكون كذلك، فالشخص قد يكون مثالياً في علاقاته العائلية، لكنه في الوقت نفسه قد يرتكب جريمةً إذا كان يعتقد أنه يحمي عائلته أو مصالح جماعته. وبرغم ذلك، تظلّ الجريمة جريمةً وتجب محاسبة مرتكبيها".
التأثير على المرأة
وتظهر التحوّلات في ديناميكيات المجتمع السوري، بعد سنوات من الحرب، التأثيرات الطائفية بشكل واضح على المرأة، وقد انعكست هذه التغيرات على صورتها ودورها الاجتماعي. وبهذا الخصوص، تقول اختصاصية علم الاجتماع، ولاء ناصر، لرصيف22: "لقد أثّرت الحرب على المرأة السورية بشكل عميق اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، ومع انقسام المجتمع على أساس طائفي وديني، أصبحنا نرى تغيّرات في مظهر المرأة الخارجي وطريقة لباسها على سبيل المثال، فقد عانت العديد من النساء من ضغوط اجتماعية، خاصةً في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإسلامية، حيث اضطرت كثيرات منهنّ إلى ارتداء النقاب أو الحجاب خوفاً من المضايقات، سواء لأنفسهنّ أو لعائلاتهنّ".
وتضيف ناصر: "على الجانب الآخر، بعض النساء اللواتي نزحن إلى مناطق جديدة شعرن بضرورة تعديل ملابسهنّ، حيث خلعن العباءة وأصبحن يرتدين الحجاب فقط، أو تخلّين عنه، إما خوفاً من المضايقات أو تكيّفاً مع المجتمع الجديد". وتتابع: "لكن بعض النساء لم يغيّرن ملابسهنّ بسبب الخوف الطائفي أو الأمني، بل لأنهنّ شعَرْن بمزيد من الاستقلالية بعد النزوح، ما سمح لهنّ باختيار ما يناسبهنّ".
وتقول ناصر، إنّ هذه التغيرات في المظهر لا تعني بالضرورة أنها اختيارات طوعية، بل هي استجابة لضغوط اجتماعية وحاجة إلى حماية الذات أو التعبير عن الهوية في ظلّ الوضع السياسي والطائفي السائد. وتتابع: "أثّرت هذه التغيّرات على هوية النساء، حيث فقدت كثيرات منهنّ الشعور بالانتماء الثابت، وأصبحن يعانين من اضطرابات نفسية بسبب القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة".
وتضيف: "من جهة أخرى، يلاحظ أنه مع سقوط النظام، بدأ النظام الجديد يفرض تحديات جديدةً على المرأة السورية. لا يزال تأثير هذا النظام غير واضح بالكامل، ولكن ما نراه على الأرض الآن يشير إلى تزايد الفصل بين النساء والرجال في وسائل النقل وأماكن العمل، بالإضافة إلى الدعوات لارتداء ملابس محتشمة، وهو ما يمكن في حال استمراره أن يؤثر بشكل كبير على حرية المرأة في اتخاذ قراراتها الشخصية، بما في ذلك اختيار نوع عملها ودراستها، وتالياً على دورها في المجتمع وشكل المجتمع عموماً بعد ذلك".
"تضارب المصالح يولّد الطائفية"
من جهته، يقول إبراهيم الريس، مسؤول برامج مجتمعية في إحدى المنظمات غير الحكومية في سوريا، ويمتلك خبرةً تمتد لأكثر من عشرين عاماً في العمل المجتمعي والتنموي، إنّ سوريا لا يمكن وصفها كمجتمع واحد، بل هي مكوّنة من جماعات ومجموعات متعددة. ويضيف: "هناك جماعات مختلفة في سوريا، مثل جماعة التجار، جماعة الشيوخ، وجماعة الكنائس، وكل واحدة منها تتحدث باللهجة ذاتها وتتمتع بالعادات والتقاليد نفسها".
ويتابع الريّس: "لوحظ أنّ المجتمعات -إنّ صحّ قول مجتمعات- التي تأثرت بالعمليات العسكرية خلال الحرب كانت أكثر تماسكاً وتعاوناً، ويرجع ذلك إلى الحاجة التي دفعت الناس للعمل معاً في غياب مؤسسات الدولة. هذه المجتمعات لم تكن تجد أمامها سوى التعاون المحلي لتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل تأمين الغذاء، ما ساعد في تعزيز تجانسها. في المقابل، كانت المجتمعات التي لم تشهد عمليات عسكريةً أكثر تفككاً، حيث اعتمد سكانها بشكل أكبر على مؤسسات الدولة لحلّ مشكلاتهم، ما ساهم في تعزيز التفرقة بينهم. فالاعتماد على مؤسسات الدولة، التي كانت أصلاً معزولةً عن المواطنين، جعلهم يفتقرون إلى المصالح المشتركة التي قد تجمعهم، ما أدى إلى زيادة انقسامهم".
ويشير الريّس، إلى أنّ "الطائفية ليست متأصلةً في الطبيعة المجتمعية، بل هي نتاج تضارب المصالح بين الجماعات، وليس العكس. بمعنى آخر، عندما تتضارب المصالح بين جماعة وأخرى، يكون ذلك هو العامل الذي يثير الطائفية ويعززها". ويضيف: "إذا كانت الفرص متساويةً وعادلةً بين الجميع، فإنّ الطائفية ستنحسر". ويردف: "الطائفية كانت تستخدم كغطاء تحرّكه السياسة حسب المصلحة، ولا يمكن القول إنّ هناك مجتمعاً واحداً أو موحّداً في سوريا".
ويؤكد الريّس، أنّ "المجتمعات التي قد تبدو منغلقةً ليست في الواقع مغلقةً بالكامل، ولا يوجد مجتمع في سوريا يمكن تصنيفه على أنه منغلق تماماً". ويختم بالقول: "لا يتأثر العمل التنموي بالطائفية ولا تصبح الأخيرة عائقاً أمامه، إذا تم التواصل بشكل صحيح مع الناس وتلبية احتياجاتهم، لأنّ أهم شيء هو التركيز على التعاون لتحسين الظروف المعيشية والمساواة والتوزيع العادل للموارد بين جميع المجموعات".
إعادة بناء الثقة أو إنتاج الصراعات
بالرغم من تعقيد الواقع، يبقى الحلّ الأول والأخير في إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري، والتركيز على القيم الإنسانية المشتركة بعيداً عن الهويات الفرعية التي تعمّق الانقسام. ومع ذلك، لا بدّ من الانتباه إلى أمر بالغ الأهمية: الجيل الجديد الذي نشأ خلال الحرب. هذا الجيل يحتاج إلى بيئة آمنة وصحية تتّسم بالتسامح والتقبل بدلاً من بيئة مملوءة بالصراعات والتمييز. إذا لم تتم معالجة هذه التوترات بشكل فعّال الآن، فإننا سنجد أنفسنا أمام إعادة إنتاج الصراعات نفسها، ما يولّد دائرةً مفرغةً من العنف والتمييز، والسؤال المطروح هنا: هل سيختار السوريون الحلّ والمصالحة أو الاستمرار في الدوران في دوائر مفرغة؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.