وفقاً للعقيدة العلوية النصيرية، العالم المادي الذي نحيا فيه دنس، ومليء بالشرّ. فالدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. هذه النظرة التشاؤمية متوافقة مع تاريخ الشيعة السياسي عموماً؛ فبعد وفاة الرسول، لم يسُد العالم الإسلامي أيّ من أئمة أهل البيت سوى علي بن أبي طالب، ولفترة محدودة سادت فيها الحروب الداخلية والاضطرابات، ثم توالت سلسلة من الهزائم العسكرية لجميع العلويين من أحفاد عليّ المطالبين بملك أجدادهم.
ولا يمكن تناسي مبدأ "القعود"، أي الخط السياسي للإمام الصادق، الذي كان يقوم على أساس مقاطعة الحكم الجائر، وهي مقاطعة هادفة إلى التغيير الجذري للحكومة القائمة. إلا أنه لم يكن يرى أن الظهور بالسيف، والانتصار المسلّح الآني يكفيان لإقامة حكم الإسلام الذي آمن به أغلب الشيعة الإمامية؛ أي انتظار مجيء المخلّص في آخر الزمان. وطبعاً، ازداد الأمر تعقيداً بعد وفاة الإمام الحادي عشر الحسن الأخير العسكري، وغيبة الإمام الثاني عشر، محمد بن الحسن (المهدي المنتظر). وعملياً باب الجهاد بالمعنى الواسع أُغلق، وتأكدت سيطرة الأشرار والمفسدين.
وفقاً للعقيدة العلوية النصيرية، العالم المادي الذي نحيا فيه دنس، ومليء بالشرّ. فالدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. هذه النظرة التشاؤمية متوافقة مع تاريخ الشيعة السياسي عموماً.
وغالباً، ما ذُكر سابقاً هو السبب الرئيس وراء ندرة أو شبه انتفاء حالات الخروج على السلطة، أو التمرد على سلطان جائر، أو ما قد ندعوه اليوم ثورةً. فخلال ما يقرب من ألف عام، بالكاد وُجد ما قد يشبه الثورات أو الانتفاضات لطائفة أو أقلية رائدة، كما يدعوها المستشرق يارون فريدمان، في كتابه "العلويون النصيريون الهوية والمعتقدات".
مع الأمير المكزون السنجاري
أولى تلك الحالات، كانت مع الأمير الحسن بن يوسف المكزون السنجاري، الذي يبدو من لقبه أنه عكس القادة المؤسسين الأوائل كابن نصير والخصيبي، من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة المتفقهة في الدين، فهو سليل أسرة من الأمراء حكمت سنجار.
لا تزال قصته كقائد عسكري ناجح وسياسي محنك يشوبها الكثير من الغموض، لكن بحسب المرويات العلوية وعلى رأسها كتاب "المكزون السنجاري"، للشيخ يونس حسن رمضان، والمؤلَّف عام 1913، والذي اعتمده الدكتور أسعد علي، كمرجع في كتابه "معرفة الله والمكزون السنجاري"، ووجد فيه المستشرق يارون فريدمان (ص 80)، المرجع الأكثر ثقةً لاحتوائه على نسخ مخطوطات قديمة من القرنين السابع والثامن عشر.
يمكن عطف شعور الهزيمة والمظلومية الشيعي الإمامي العام القديم والمستمر، على شعور جديد خاص هو المرارة من رفض عموم الجماعة الأم، أي الاثني عشرية، لأفكار المؤسسين الأوائل للفكر النصيري، ووصفهم بالغلو في الدين وحتى الهرطقة
 ثورات العلويين "النصيريين" خلال ألف عام
ثورات العلويين "النصيريين" خلال ألف عام
وغالباً، ما ذُكر سابقاً هو السبب الرئيس وراء ندرة أو شبه انتفاء حالات الخروج على السلطة، أو التمرد على سلطان جائر، أو ما قد ندعوه اليوم ثورةً. فخلال ما يقرب من ألف عام، بالكاد وُجد ما قد يشبه الثورات أو الانتفاضات لطائفة أو أقلية رائدة، كما يدعوها المستشرق يارون فريدمان، في كتابه "العلويون النصيريون الهوية والمعتقدات".
في كتاب ستيفان وينتر "تاريخ العلويين"، يضع تصوراً مختلفاً لا يناقض ما سبق بل يكمله، فقد كانت علاقة العلويين بالمماليك تتراوح بين اللامبالاة والودّ أحياناً... واللامبالاة حتماً هي الغالبة، فبعد يأس المماليك من تسنين العلويين، انتقلوا إلى أساليب أكثر برغماتيةً وأقل حدّيةً، طالما أن العلويين لم يكونوا مزعجين سياسياً للدولة
مع الأمير المكزون السنجاري
أولى تلك الحالات، كانت مع الأمير الحسن بن يوسف المكزون السنجاري، الذي يبدو من لقبه أنه عكس القادة المؤسسين الأوائل كابن نصير والخصيبي، من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة المتفقهة في الدين، فهو سليل أسرة من الأمراء حكمت سنجار.
لا تزال قصته كقائد عسكري ناجح وسياسي محنك يشوبها الكثير من الغموض، لكن بحسب المرويات العلوية وعلى رأسها كتاب "المكزون السنجاري"، للشيخ يونس حسن رمضان، والمؤلَّف عام 1913، والذي اعتمده الدكتور أسعد علي، كمرجع في كتابه "معرفة الله والمكزون السنجاري"، ووجد فيه المستشرق يارون فريدمان (ص 80)، المرجع الأكثر ثقةً لاحتوائه على نسخ مخطوطات قديمة من القرنين السابع والثامن عشر.
عام 1218، أرسل إليه علويو بانياس واللاذقية رسالةً يستنجدون به فيها من الكرد الذين جاؤوا مع الأيوبيين والإسماعيليين، غالباً النزاريين، وذلك إثر مجازر تعرّض لها العلويون عامي 1214 و1215، وبالفعل قَدِم الأمير السنجاري على رأس جيش من 25،000 مقاتل، ويبدو أنه هُزم في أول معاركه فعاد إلى مسقط رأسه ليشكل جيشاً من خمسين ألف مقاتل عام 1222، وفعلاً استطاع جيشه السيطرة على قلاع "أبو قبيس" والمرقب والعليقة، واستمرت معاركه حتى عام 1223، حيث استطاع إخراج الكرد والاسماعيليين من منطقة الجبل.
السيرة الملحمية للمكزون السنجاري كشخصية فذّة، وخليط بين الزعيم السياسي ورجل الدين الفقيه والشاعر الصوفي، خلّدت ذكراه في الذاكرة الجمعية العلوية. مع العلم بأنه لم يقُد ثورةً أو ما قد يشبه الثورة، بل قاد ما قد يوصف بـ"موجة عسكر مهاجرين"، والتسمية للمستشرق ستيفان وينتر (تاريخ العلويين)، مكّنت العلويين من الصمود في وجه التحديات، وإن أنتجت تقسيم العلويين إلى عشائر، مستندةً إلى تقسيمات السكان الأصليين والمهاجرين الجدد، وليسوا من سنجار وحدها.
المهدي العلوي
قد تكون "ثورة" المهدي العلوي عام 1318، هي أكثر خروج على السلطة يقترب من تعريفات الثورة بالمعنى المعاصر، لكن من الواضح أنها منسية تماماً في الذاكرة الشعبية. فالذاكرات الشعبية تستند دوماً إلى قصص مجيدة؛ سواء انتهت بنصر جليّ حال المكزون السنجاري، أو بانتصار الدم على السيف كما في كربلاء.
ولهذا أسباب عدة: أولاً نتائجها الكارثية المباشرة، وثانياً أنها لم تكن مدعومةً أساساً من عموم زعامات الطائفة لا سيما رجال الدين، بل كانت مرذولةً.
بمحاولة العودة إلى أسبابها غير المباشرة بعيد نصر المماليك في عين جالوت عام 1260، وسيطرتهم بعد ذلك على كامل البرّ، ثم كامل الساحل الشامي، من الصليبيين أواخر القرن نفسه، مسحوا الأراضي الزراعية وقسموها كإقطاعات لقادة الجند، كذلك قاموا بمحاولات حثيثة لإدخال العلويين في المذهب السنّي الحاكم، كبناء جامع في كل قرية، وأجبروا الناس على الذهاب إلى الجوامع لأداء الصلوات بالطريقة السنّية، ومنعوا العلويين من أداء طقوسهم الدينية، كذلك فرضوا ضرائب باهظةً على ملّاك أراضيهم المقتطعة حديثاً، أي الملّاك الجدد!
وعلينا أن نفترض أن الضغوط الاجتماعية والدينية والاقتصادية هي وراء هذا التمرد المهدوي الشكل.
في كتاب ستيفان وينتر، ثمة سبب مباشر للأمر، هو إصدار السلطان المملوكي الناصر محمد، مرسوماً مؤذياً بحق الطائفة العلوية، اندلعت الانتفاضة بعد إصداره بأسابيع قليلة، وينص على التالي: "بالأطراف القصية من هذه المملكة قرى سكانها يعرفون بالنصيرية لم يلج الإسلام لهم قلباً، ولا خالط لهم لباً، ولا أظهروا له بينهم شعاراً، ولا أقاموا له مناراً، بل يخالفون أحكامه، ويجهلون حلاله وحرامه". ثم يتعهد المرسوم بالتالي: "كل ذلك مما يجب ردعهم عنه شرعاً، ورجوعهم فيه إلى سواء السبيل أصلاً وفرعاً" (ص 107)، ويستشهد هنا بالمقريزي والنويري والقلقشندي...
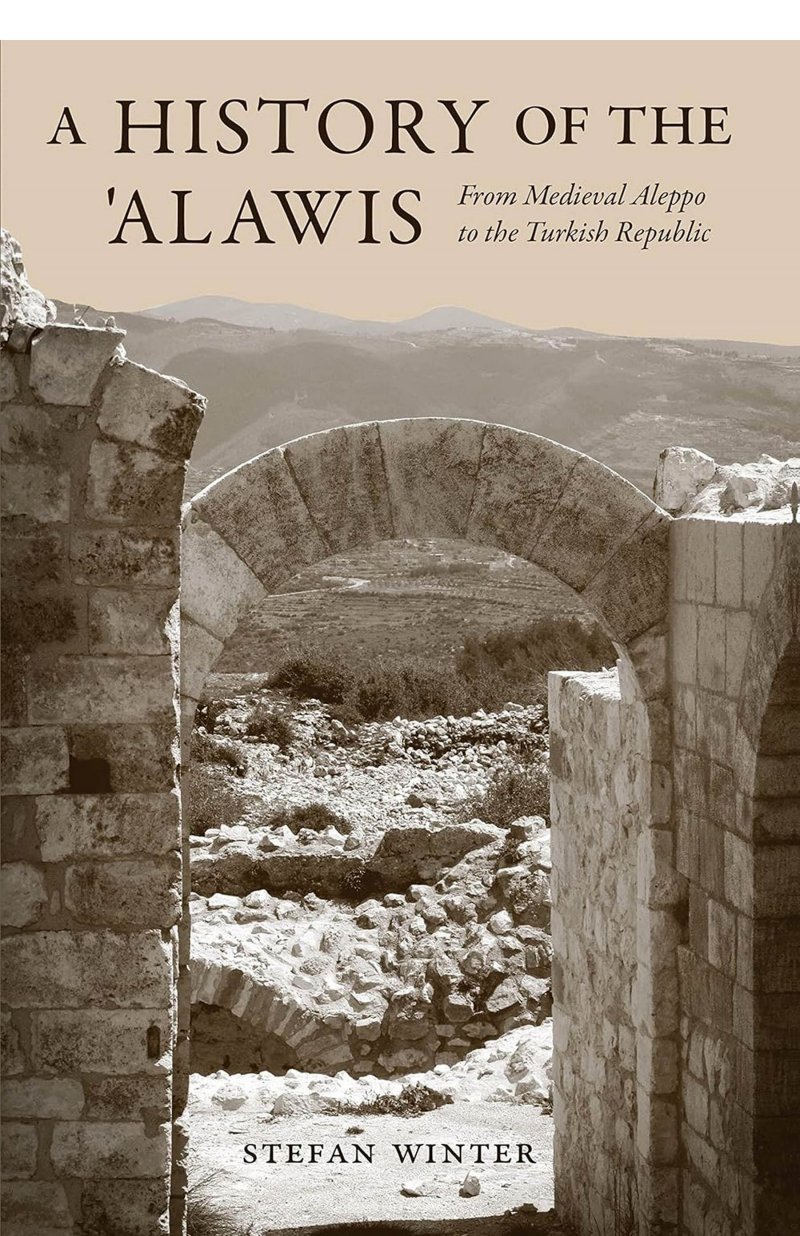 ثورات العلويين "النصيريين" خلال ألف عام
ثورات العلويين "النصيريين" خلال ألف عام
تفاصيل المعركة
وفعلاً بعد التمثيل بجثة المهدي، ورفع رأسه على الرماح، "شنّ الأمير المملوكي لولاية طرابلس هجوماً انتقامياً، حيث قتل ما يزيد عن عشرين ألف نصيري، وهرب آخرون إلى عمق الجبل"، حسب ابن بطوطة "تحفة النظار" (ص 292). يلاحَظ من صغر حجم الجيش الذي سحق التمرد ألف فارس فقط! أن التمرد كان صغيراً، ولم يحظَ بالشعبية، خاصةً بالمقارنة مع الأمير المكزون السنجاري الذي استطاع جمع جيش يُقدَّر بخمسين ألف فارس قبل ذلك بقرن كامل. وكما ذكرنا، لم تكن الانتفاضة مقبولةً من عموم أفراد الطائفة. وقد حاول زعماء الطائفة، لا سيما المشايخ، إطفاء الحرائق الارتدادية، فقد أصدر السلطان قراراً بالقضاء عليهم وسحقهم، وطبعاً هذا القرار منسجم أساساً مع المرسوم السلطاني الصادر قبيل انتفاضة المهدي، ومحاولة تسنين العلويين. ومن تلك القرارات الصعبة كتجرّع السم، طلب معاملتهم كأهل الكتاب! باعتبارهم طائفةً موحدةً يتوجب عليهم دفع الجزية.
العلاقة مع المماليك
مع بداية الحكم المملوكي للشام، كان المماليك في غاية القسوة مع الطوائف الإسلامية غير السنّية. قد يكون الأمر متوقعاً لدولة حديثة الإنشاء تحارب على جبهتين معاً الصليبيين والمغول، لا سيما مع العلويين كونهم أكبر الطوائف الإسلامية "البدعية"، والأقدر على تشكيل خطر.
أما حالات الودّ فكانت فرديةً ونادرةً؛ إذ تروي قصة من كتاب "خير الصنيعة" (ص 597، 599)، للشيخ العلوي حسين ميهوب حرفوش، أن الأمير أيبك الموصلي، الذي أضحى والياً لطرابلس نحو عام 1277، دعا إلى مجلسه بعضاً من مشايخ العلويين، وقد أفزعهم خبر أن أحد الكارهين همس في أذنه أنهم مهرطقون لا يقرؤون القرآن... لكن أحدهم وهو الشيخ مسلم بن عبد الله، من قرية البيضاء من نواحي حماة، كان شجاعاً، وذهب إلى مجلس الوالي "مضحّياً بنفسه من أجل إخوانه ومدافعاً عن دينه ومعتقده"، وبعد سجال شرعي طويل مع القاضي بصورة رئيسة حول جواز إقامة صلاة شعائرية على الميت أم لا، تبيّن للوالي صواب رأي الشيخ العلوي، وأنهم مسلمون غير مهرطقين، وأغدق له العطاء، حسب ستيفن وينتر (ص 93).
ومن الجدير بالذكر أن الذاكرة الشعبية للعلويين تفيض بظلم الفرنجة، وسجنهم لأكابر الطائفة، وهذا ينفي المزاعم حول مساندة علوية للصليبيين. وتجدر الإشارة هنا إلى الاستخدام الشعبي القديم للفظة الفرنجة أو الإفرنج، في إشارة واضحة إلى فهم العلويين أن هؤلاء غرباء وليسوا مسيحيين.
متلازمة ابن تيمية
من غير المنطقي سرد الأحداث السابقة، ونسيان رجل دين كان معاصراً ومؤثراً في تلك الأحداث كابن تيمية. وللأمانة يبدو ابن تيمية، عنواناً في الذاكرة الشعبية العلوية للاضطهاد، ما جعل فعلاً من ذكره متلازمة التعبير لوينتر. لكن هل كانت فتواه الشهيرة منهج عمل سار عليه أمراء المماليك؟ سأستعير تفسير ابن تيمية نفسه لبقاء العلويين بعد ثورة المهدي: "وراسلوا ملك الأمراء (أمير طرابلس) والتزموا أن يعطوه ديناراً عن كل رأس إن هو حاول إبقاءهم... وكان الخبر (أي ثورة المهدي في جبلة) قد وصل به الحمام إلى الملك الناصر (السلطان المملوكي توفي سنة 1341). وصدر جوابه أن يحمل عليهم السيف، فراجعه ملك الأمراء، وقال إنهم عمّال المسلمين (أي يعملون لدى المسلمين في حراثة الأرض)، وإنهم إن قُتلوا سيضعف المسلمون لذاك، فأمر (السلطان) بالإبقاء عليهم"، حسب ابن بطوطة، "تحفة النظار" (ص 292)، وحسب فريدمان (ص 99).
قد تكون "ثورة" المهدي العلوي عام 1318، هي أكثر خروج على السلطة يقترب من تعريفات الثورة بالمعنى المعاصر، لكن من الواضح أنها منسية تماماً في الذاكرة الشعبية. فالذاكرات الشعبية تستند دوماً إلى قصص مجيدة؛ سواء انتهت بنصر جليّ حال المكزون السنجاري، أو بانتصار الدم على السيف كما في كربلاء
هذه الأسطر القليلة لابن تيمية كافية وحدها لجلاء الأمر.
من الواضح أن المماليك، كأي امبراطورية كبيرة، طلبوا من العلويين الولاء أولاً، ثم دفع الضرائب وإمداد المدن السورية بالغذاء كونهم فلاحين مهرةً. إذ يشير وينتر إلى أن قيادات سنّيةً بارزةً تعاطفت مع العلويين، وأن قصص الاضطهاد الطائفي الممنهج والمنظم اجتاحت الذاكرة الشعبية في حقبة متأخرة، كما سيتضح معنا في الجزء الثاني لهذا المقال، خاصةً في العهد العثماني.
بنظرة معمّقة بعيدة عن التفكير الذي يستند إلى المظلوميات أو التكفير الأعمى أو الأحادية، نجد التاريخ لا يسير أبداً يتلك الأدوات، بل أدواته الفعلية هي المصالح والاقتصاد والولاء... العلويون استفادوا من لحظة انعدام وزن سياسي في المنطقة في زمن المكزون السنجاري، ودقّوا أوتادهم في الجبال ولم ولن يتركوها، ولم يحاولوا إنشاء إمارة مستقلة (مبدأ القعود)، وحتماً لم يبشّروا بدين جديد، بل طلبوا الأمان فقط. حالات الخروج على السلطة حتماً كانت موجودةً، لكنها كانت دوماً محدودةً، ونتيجة ضغط من موتورين في السلطة أصحاب محاكم التفتيش. ما يثير الدهشة أيضاً ليس فقط اهتمام المستشرقين بأدق التفاصيل، بل أننا نجد، برغم تحيّز بعضهم لطرف ما، كل الشهادات موجودةً، شرط أن تملك حدّاً أدنى من الواقعية والمنطق، فهم لا يتعاملون مع التاريخ كسند لطرف فيه، بل كجرّاح ماهر لا يخشى رؤية الدم؛ يشرحون الحقائق ولا يخافون رأي الجمهور.
كم نحن بحاجة إلى هكذا أبحاث، لكننا بحاجة أيضاً إلى جمهور غير قلق، يعامل التاريخ أولاً كتاريخ مضى، فنستفيد منه في فهم صيرورة الأحداث، لكن دون أن نجد أنفسنا أحفاداً دائنين أو مدينيين لأحد. نحن أبناء اليوم وعيننا فقط ترنو إلى المستقبل ولن تنكس إلى الماضي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





