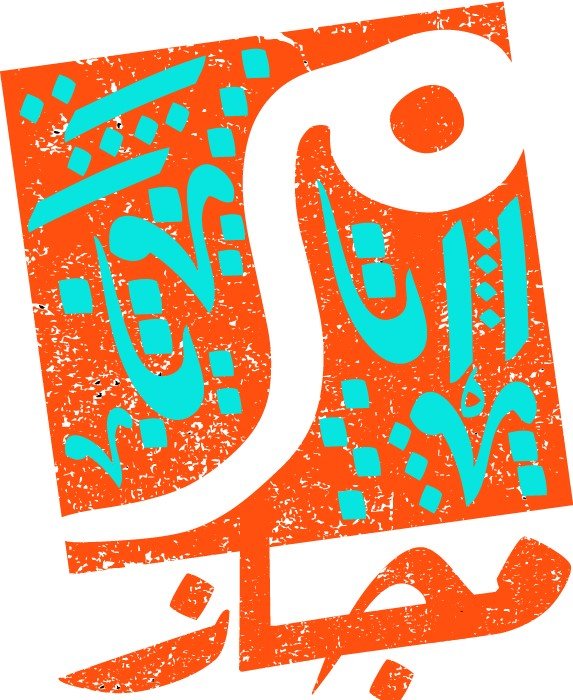 تصميم حروفي لكلمة مجاز
تصميم حروفي لكلمة مجاز
عندما كنت أبيت أحياناً في منزل جدتي لأمي، وفي آخر الليل أو بعد الفجر، حينما كنت أستيقظ عرضياً وأفتح عيني في سريرها الذي أنام عليه، كنت أراها مستيقظة جالسة، تذرف دمعات صامتة، فأسألها بصوت ناعس: "ما الأمر؟"، فتنتبه لي وتكذب وتقول: "لا شيء"، وفي سذاجة خليقة بسنواتي الست، كنت أصدّقها وأكمل نومي، فأنا أيضا اعتدت أن أبكي لمجرّد شعوري بالحزن العارض لا لشيء آخر.
في العصاري، أيام الجمع، اعتاد خالي بعد الغداء بقليل أن يصنع لنا جميعاً "دور شاي"، الشاي المغلي له، والمظبوط لجدتي، والشاي المحلّى مع اللبن لي. يأخذ خالي كوبه ليشربه على السلم أمام باب الشقة مع الصمت والسيجارة كعادته الأزلية، فأبقى أنا وجدتي مع كوبي الشاي والراديو المشغّل على أقل درجة صوت ممكنة، وجدتي ترتشف الشاي وتكتفي بالتحديق في الفراغ، فأذهب للجلوس تارة مع خالي وهو يعقب كل رشفة بنفس من سيجارته.
أراقب سحب الدخان وهى ترتفع وتتراقص في الهواء بسلاسة ونعومة، ثم تتلاشى ببطء منسجمة مع خيوط ضوء الشمس القادم من فتحات شرفة السلم، والذي بدأت حدته تنكسر تدريجياً في هذا الوقت من اليوم. لا يمضي الوقت حتى أتململ سريعاً، فأرجع إلى الصالة أنظر من النافذة ضجرة، باحثة عن أطفال يلعبون لأستأذن جدتي بالنزول واللعب معهم، ولكنني أعلم أن بحثي هذا بلا جدوى، فالأطفال إما يتناولون غداءهم أو فرغوا مثلنا من الغداء للتو، فحبستهم أمهاتهم عن الشارع حتى المغرب، حيث ينزلون جميعاً إلى الشارع، الأمهات والجدات والجارات يتسامرن ويحتسين الشاي والقهوة، والأطفال يلعبون ويتشاجرون بحذر، مستغنين مؤقتاً عن الشتائم واللكمات خوفاً من وعيد الأمهات.
كنت أستسلم للواقع وأستكين في مكاني مع جدتي وكوب الشاي. أتأمل جدتي وهى ترشف الشاي بدون صوت، فلا يبين هل شربت شيئاً منه أو لا، وهل ما شربته قد بلعته فعلاً أم لا؟ كنت أراقبها بينما أشرب شايي بالشاليموه أو بالملعقة مثل الشوربة، ومذهبي في ذلك هو أني بهذه الطريقة أتلذذ بطعم السكر فيه لوقت أطول.
وفي سبيل تمضية الوقت، كنت أمرّر أصابعي على العروق والوشوم والثنيات في يدها، فدائماً ما كنت أراها أكثر إثارة من يدي، فيداها شفافتان، تظهر العروق داخلها بوضوح، وتزخر بشقوق من أثر الزمن، ثابتة صامدة، ووشوم كانت في وقت ما خضراء، بهت بعضها مع الزمن وبقى بعضها طازجاً كأنه دُقّ أمس. كانت تلك الوشوم تملأ كفيها وساعديها، اعتدت أن أسالها أسئلة كثيرة عن هذه الرسومات المنمنمة العجيبة التي تملأ كفيها وتمتد إلى ذقنها، فكانت كثيراً جداً ما تكتفي بإجابات مقتضبة، ولكن، في أحايين نادرة، كانت تخرج عن طور صمتها وتسترسل في إجابات لا ترد على سؤالي، بأحاديث سرعان ما أندمج فيها، عن الصعيد الذي ظننته وقتها بلد حكايات خرافية، عن إخوتها وأولادهم وكيف تفرّع أغلبهم في محيط الدلتا والقاهرة مع عائلاتهم، كل إلى بلد، وكيف استمسك أقلهم بالصعيد، أو تعدّد أبناءها الذين ماتوا صغاراً، وعن رحلاتها اليومية القصيرة إلى الترعة لملء الجرار مع خالتي الكبرى والتي ماتت، كأغلب أخوالي، طفلة، أو تحكى لي عن تبركهم بحفيدة رسول الله في تسميتها بـ "أم هاشم" كي تخالف أمي النمط وتعيش، فاسألها سؤالي الساذج المعتاد الذي يترك في الفراغ دائماً: "يعنى ماما ليس لها ابن اسمه هاشم؟".
اعتدت أن أسالها أسئلة كثيرة عن هذه الرسومات المنمنمة العجيبة التي تملأ كفيها وتمتد إلى ذقنها، فكانت كثيراً جداً ما تكتفي بإجابات مقتضبة، ولكن، في أحايين نادرة، كانت تخرج عن طور صمتها وتسترسل في إجابات لا ترد على سؤالي... مجاز
*****
في يوم ما بعد ذلك بسنوات، كانت أمي تعانى صداعاً، فلم تقدر على إعداد الشاي لنفسها كعادتها في العصاري، فطلبت مني، وعمري وقتها حوالي التاسعة، إعداد كوب شاي لها، ووصفت لي طريقة إعداده، من غلي الماء واستخدام البرّاد المناسب ومستوى شعلة النار وعدد الملاعق التي يجب أن أضعها من السكر والشاي، ولكنها سهت عن شيء مهم، وهو التأكيد على ضرورة استخدامي للمعلقة الصغيرة في معايرة الشاي والسكر، ولذلك لم أفعل، بل ولسعادتي بأول مرة تطلب منى أمي عمل كوب شاي على الإطلاق، ناهيك عن أنه لها، استخدمت معلقتي المفضلة في تناول الطعام لأعاير بها، وعندما قدمت لها الشاي سألتني بعدما ذاقته عن كيف صنعته، فأجبتها أنني قد فعلت تماماً مثلما وجهتني، وأضفت بفخر: "وعايرت لك بمعلقتي"، فأخبرتني باسمة بأن "دي أطعم كوباية شاي دقتها في حياتي"، واذكر أنني جلست بجانبها في رضا، أراقبها وهى تتجرّع الكوب حتى آخره.
والحقيقة أنني لم أتبين قط فداحة ما صنعت إلا عندما عادتني الذكرى التي كنت قد نسيتها، بعدها بسنوات عديدة، ولكن أمي ظلت على وفائها لعهدها لكوب الشاي ساعة العصاري، وأكثر من مرة حين كنت أقتحم مجلسها، كنت ألمحها تمسح دموعاً، ولأنني كنت قد كبرت وتوسعت معرفتي بأسباب تجعل الإنسان يبكي، فكنت أخاف أن أسأل، وأتظاهر بأنني لم أر شيئاً، وأتناول معها أطراف الحديث في أمور سخيفة بغرض إخراجي من حالة الارتباك التي أُقحمت فيها، وكعادتها كانت تتجاوب معي _وكم كنت ممتنة لذلك_ رغم معرفتي بأنها لا تحب إفساد عزلتها اليومية القصيرة بالكلام، والتي كثيراً ما كنت أقطعها باندفاعي، والسبب الذي كان يدفعها لكسر عزلتها مرغمة والتجاوب مع أحاديثي السخيفة باسمة هو إشفاقها علي من ارتباكي، وفي مرة من هذه المرات فاجأتها بسؤال عبثي من على سطح أفكاري لأغطى به ارتباكي المفضوح: "إيه سبب العلامة التي في راس خالي؟"، وخالي لديه فوق حاجبه ندبة صغيرة جداً، غائرة كأنها من أثر جرح، فأجابت بابتسامة: "أنا اللي عملتها له!"، ثم أردفت، وأظن أني رأيت عينيها تلمعان بحماس وظفر طفولي كأنها قد انتقلت بالزمن إلى وقت الحادث، أنهما كانا صغيرين، وكانا يلعبان في الشارع، فاختلفا وتشاجرا فصعدت هي إلى شرفة شقتهم في الدور الثاني ونادت عليه، وعندما رفع رأسه باغتته بقطعة حجر مكسورة من أحجار البناء، أخطأت عينه بمسافة سنتيمترات قليلة، وعند إبدائي اعتراضي المدهوش، قالت بنفس ابتسامتها: "كنا عيال بقى"، فبقيت لحظة أعالج تلك المعلومات التي تعرّضت لها للتو، والتي بكل تأكيد لا تتسق مع كم الحب والمودة التي أراها دائما بين أمي وخالي، ولا الإكبار الذي يكنه خالي تجاه أمي والعطف الذي تلقى به أمي خالي، كأنه ابنها وليس أخيها الذي لا يفصل بينها وبينه سوى عامين.
عالجت تلك المعطيات في رأسي، وحاولت تنسيقها معاً ولم أهتد إلى شيء، فأجبت بلهجة تسليم: "هزار صعايدة"، وضحكنا معاً، ثم وقفت وهممت بتناول كوب الشاي من يد أمي والذي بدا لعيني أنه لم يبق فيه إلا الذبالة، فاستمسكت به قائلة: "لسه باقي شفطة"، فأمعنت النظر وأنا نصف منحنية لأرى ما الذي ستشربه من كوب لم يبق فيه إلا الذبالة، فوجدتها تشرب في رشفة واحدة سريعة سائل الشاي الذي يكاد يغطى سطح الثفل من دون أن يدخل في فمها عرضياً شيء من الثفل، ثم سلمتني الكوب فمططت شفتي بإعجاب ممزوج بدهشة، وأرجعت ذلك وأنا في طريقي للمطبخ إلى جذورها الصعيدية التي لابد أن تكون التفسير الوحيد لكل تصرفاتها التي لا أجد لها تفسيراً، حيث هناك في الصعيد يفطمون الرضيع على الشاي، ويصنعون للأطفال "تصبيرة" من الخبز الناشف المسقى بالشاي، وأوقات الكبار يكون الشاي فيها هو القطعة التي تكمل الصورة، في أوقات الراحة مع البقسماط، بعد الغداء ليمنع الأكل من أن يقف في الحلق، أوقات السمر يترك ليغلي في البراد حتى يخال المرء أنه سيظل يغلي إلى ما لا نهاية، إلى أن يعاجله أحد ما برفعه من على الموقد قبل أن يستحيل لونه إلى السواد المطبق، إلى آخر تلك التفاصيل عن الشاي والدنيا التي تكمن في الصعيد الذي يمكن أن يغادره المرء ولكن الصعيد لا يغادره.
لن أعرف أبداً سبب دموع جدتي في الفجر، ولا دموع أمي في العصاري، فانا لم أسأل قط، ولكنني وجدت عيني تتلألآن بدمعة وحيدة عندما غمرتني كل تلك الذكريات، فصنعت لنفسي كوب شاي وجلست لأكتب دموعي... مجاز
*****
جدتي وأمي وخالي وأنا، يثقل علينا الكلام. أعنى أننا نمارسه إذا أجبرنا عليه، ولكن إذا لاح خيار الصمت فإننا نلوذ به دوماً؛ ولذلك، لا أذكر الكثير عن أحاديث بيني وبين جدتي، أو أذكر أحاديث ليست جديرة بعشرين عاماً قضتها أمي معي قبل أن تفضل على عالمنا عالماً آخر، ولكنى لا أستطيع إحصاء عدد المرات التي تركتني جدتي ألقي رأسي على قدمها بينما تربّت بيدها الناعمة على شعري، أو كيف اعتاد خالي أن يصنع لي خاتماً من الغلالة الذهبية التي يفكها عن كل علبة سجائر جديدة يفتحها، ولا عن عدد المرّات التي تلاقت عينا أمي مع عيني وهى ساهمة تحتسي الشاي، فيشرق وجهها بابتسامة صافية وترسل لي في الهواء قبلة.
لن أعرف أبداً سبب دموع جدتي في الفجر، ولا دموع أمي في العصاري، فانا لم أسأل قط، ولكنني وجدت عيني تتلألآن بدمعة وحيدة عندما غمرتني كل تلك الذكريات، فصنعت لنفسي كوب شاي وجلست لأكتب دموعي.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


