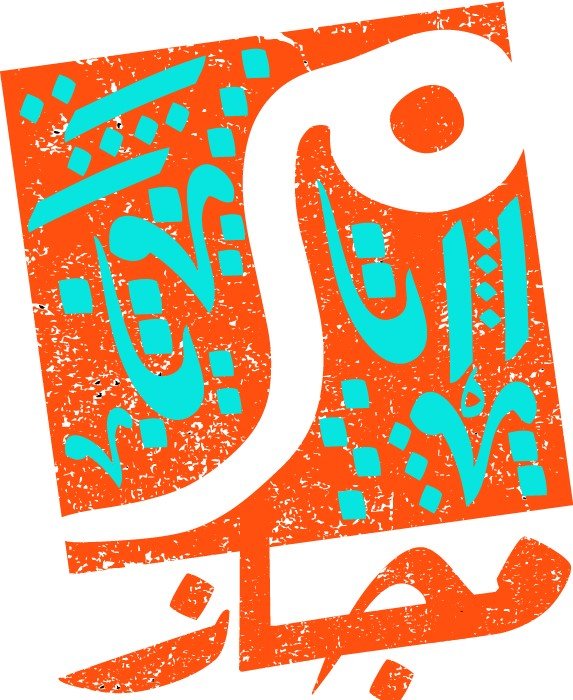 تصميم حروفي لكلمة مجاز
تصميم حروفي لكلمة مجاز
على شاطئ ما في الإسكندرية، تركني أبي، أنا طفله الذي لم يبلغ العاشرة، وغادر.
ولدتُ في مدينة صغيرة تتوسّط الطريق الزراعي بين القاهرة والإسكندرية، وفي تلك الأخيرة، خلال شهر يوليو أو أغسطس، اعتادت أسرتي قضاء أسبوع المصيف السنوي، الذي نتشاركه كل عام مع عائلة أبي، عمتي وزوجها وابنيها، وجدي، والد أبي.
كنا نحمل معنا شمسية البحر الكبيرة، والتي لا نراها أنا وأخي الأصغر سوى في هذا الوقت من العام، كاسيت كبير الحجم مع مجموعة من الشرائط الملونة، وجهاز فيديو، كان، بالإضافة لشرائط الكرتون الخاصة بنا، أنا وأخي، وعدد من المسرحيات والأفلام، أثمن ما نحمله معنا، حيث يضمن لنا سهرة يومية عظيمة بعد موعد انقطاع البث التلفزيوني الرسمي. وفوق كل ذلك، عدداً من الكراسي الخشبية التي تُطوى وتُفرد، وأشياء أخرى أقل أهمية، لأننا لا نستخدمها، لكنها رغم ذلك أساسية في كل السفرات.
وتصرّ عمتي في كل عام على إحضار الخضروات واللحوم وأكياس الأرز والمعكرونة، لإعداد الطعام لنا في المصيف، ولم نفهم أنا وأخي ضيق أمي المستمر بذلك. ربما لأن تلك العادة تُجبرها أحياناً على الاستيقاظ المُبكر لإعداد الفطور، ثم المكوث طوال النهار في المطبخ لإعداد الغداء. وكانت إذا خرجت معنا إلى الشاطئ، الذي لا يبعد كثيراً عن الشقة التي تستأجرها العائلة لقضاء المصيف، لا تُمضي أكثر من ساعتين معنا وتعود، ولم نفهم ذلك.
وأسألها من وقت لآخر: "ماما انتي مش بتحبي تقعدي معانا في البحر ليه؟"
كنتُ أعتقد أن أمي كبيرة ولا تبكي، اعتادت أن تنهرني بسبب كثرة بكائي، وتقول: "متعيطش. مفيش حد كبير يعيط"... مجاز
ولا تُرضيني الإجابات المُبهمة التي يعتادها الأطفال في مثل سني، ورغم ذلك لا أُلحُّ في التساؤل مخافة إثارة غضبها، وأذهب معهم إلى الشاطئ، حيث أنسى كل تساؤلاتي السابقة، وأنغمس في اللعب في المياه المالحة، متفاخراً بقدرتي على السباحة في سن مبكر، أو أنهمك في مغامرة محاولة اصطياد قنديل البحر قبل أن يلسعني، وأتتبع مسار الطحالب الخضراء العائمة، والأسماك الصغيرة التي تستسلم لتيار الموج الذي يجرفها بالقرب من الشاطئ، ثم أرفع رأسي من وقتٍ لآخر لأنظر تجاه الشاطئ، باحثاً عن ألوان الشمسية الخاصة بالعائلة، فأجدها ولا أجد أمي، التي تأتي معنا وتمكث فترة قصيرة، تعود بعدها إلى شقة المصيف، مصطحبة معها أخي الأصغر الذي يخاف من البحر الواسع، ولم تعتد براءته الطفولية صوت تلاطم الأمواج بعد.
يتشبّث خلال المشي بيد أمي التي تظلله بجسدها، وتضع قبعة شمسية فوق رأسه لتضمن بقاء بشرته الفاتحة آمنة من الاحتراق. فلا تُضطر لدهن وجهه الملتهب بالكريم المضاد للحروق، وهو ما لم تُجده أمي أبداً، بسبب تأثرها بتأوهات أخي المتتابعة عندما تمسّ يدها الجلد المحترق.
لم تنس أمي أبداً وضع الكريم في حقيبتها الخاصة قبل السفر، إلى جانب أدوية أخرى لا أعرفها؛ شامبو، صابون، والكثير من علب المناديل الورقية، لا أعرف سبب احتياجها إليها.
وفي يوم من تلك الأيام التي غطستُ فيها وانتظرتُ مرور الأمواج من فوق رأسي لتغسلها. رفعتُ رأسي، وجلتُ بناظريَ تجاه الشاطئ المكتظ بالناس، وكالعادة لم أجد أمي تحت الشمسية الملونة، لكن الجديد هذه المرة أني لم أجد أبي أيضاً، لم أجد حتى عمتي، أو أياً من ولديها اللذين يكبرانني سناً، رغم رؤيتي لأحدهما قبل قليل بصحبة أبي.
على شاطئ ما في الإسكندرية، تركني أبي، أنا طفله الذي لم يبلغ العاشرة، وغادر
خرجتُ من الشاطئ باحثاً عن أبي أو عن أي من آثاره، وبعد دقائق من التيه بين الشمسيات التي تُخفي تحتها عدداً مهولاً من الأسر، استسلمتُ لحقيقة أنه تركني وعاد للشقة.
خرجتُ من الشاطئ حافي القدمين، عاري الصدر، وخلال سيري لم أبكِ، لم يُقلقني شيء، ولم أخف.
فلم تكن تلك هي المرة الأولى التي ينساني فيها أبي. تهتُ عنه مرة قبل ذلك، في طنطا، في السوق. اختطفت أضواء الليل عينيَ وشردتُ، ولم أجد أياً من أبي أو أخي الأصغر معي. لكن تلك كانت ذكرى أشد سوءاً. وقفتُ أبكي بحرارة في الشارع طالباً المساعدة. أخذني صاحب أحد المحلات وسألني عن بيتي، وأخبرته من بين دموعي أني لا أعرف، ثم طلب مني وصفاً لوالدي وأخي. غرقتُ في البكاء، والتمَ الناس من حولي، وفجأة ظهر أخي الأصغر واحتضنني، ومن خلفه يمشي أبي.
ساعدتني تلك التجربة على عدم الخوف، حتى وإن اختلف المكان، اختلفت الظروف، وكنتُ عارياً من ملابسي، وبلا يدٍ من المفترض أن تُمسك بيدي الصغيرة وأنا أعبر إلى الجهة الأخرى من الكورنيش الواسع، الذي تحايلتُ على سياراته المسرعة بالتظاهر بأني فرد من عائلة أخرى تعبر الطريق في الوقت نفسه، وافترقتُ بخطواتي عنهم فور وصولي للجهة الأخرى.
كنتُ أحفظ المتبقي من الطريق جيداً، تلك المسافة التي أمشيها يومياً بينما أراقب الطائرات الشراعية المُلونة، وذيولها الطويلة المراوغة لهواء البحر، وصولاً إلى الشارع الذي تقع فيه الشقة التي نستأجرها، وأعرف ناصيته بإعلان آيس كريم "كيمو كونو" المُلوّن، وعلامة الدب الأزرق الذي أحبه كل الأطفال في ذلك الوقت، ولكن شردتُ.
ها أنا وحدي، ولو كنتُ أملكُ بعض المال لاشتريتُ الكثير من الآيس كريم، أو لتغيبتُ عنهم لبعض الزقت وعشتُ باحثاً عن بيت الدب الأزرق، الذي سيُشفق عليّ، وعلى سيري حافياً خلال القيظ، وسيبقيني في ثلاجة مليئة بالآيس كريم.
سأتغيب عنهم لوقت أطول، سأنسى الشارع الذي تقع فيه الشقة. وسأجد جماعة من الصيادين، فأكرّر البكاء الحار الذي بكيته في طنطا، ومن ثم يعملون على تهدئتي، وأقنعهم بأن أعيش معهم في البحر، مُعدّداً لهم مزاياي المتمثلة في قدرتي على السباحة والغطس.
وقلتُ لنفسي: "سأعيش حياة رائعة أفضل من تلك التي أراها في كرتون سبيس تون. حياة أتعرف خلالها على أصدقاء رائعين، يُنسونني مأساة ضياعي من أهلي".
أوقفت الآلام المتكرّرة في أسفل قدميَ الحافيتين تفكيري في المغامرات التي تتفوق على الكرتون. تتفوق على "عدنان ولينا"، و"سنو وايت"، "عهد الأصدقاء"، و"جزيرة الكنز"، و"ماوكلي فتى الأدغال".
أمسكتُ بقدمي اليُمنى، ورفعتها قليلاً لأتفقّد الاحمرار الشديد في أسفلها وبقايا الرمال العالقة بها. كدتُ أفقد توازني وأسقط بعد لحظات من حملي إياها، لولا أن سندتني ذراع أمي التي أمسكت بي فجأة، ودموعها منسابة على وجهها بشكل بدا غريباً عليّ، فعندما حكيتُ لها من قبل عن المرة الأولى التي تُهتُ فيها من أبي، لم تبكِ، فقط عانقتني لفترة طويلة، وطفقت تُربّتُ على رأسي، بينما جسدي يرتعد بين يديها، وتطالبني بعينين ذاهلتين ألا أخاف من شيء.
كنتُ أعتقد أن أمي كبيرة ولا تبكي، اعتادت أن تنهرني بسبب كثرة بكائي، وتقول: "متعيطش. مفيش حد كبير يعيط"
وفي مرة من المرات، لمحتها تبكي عند مشاهدتها لفيلم على التلفاز، لكنها سرعان ما أخفت دموعها بالمناديل الورقية. حينها ضحكتُ على منظرها دامعة العينين، أما هذه المرة، فانهمرت دموعها بلا توقف، وهي تضمّني إليها بقوة، ولا تحاول أن تتوقف عن البكاء أمام الكبار.
ومن خلفها جاء أبي من بعيد ممسكاً بأخي الأصغر في يده، والقبعة على رأسه الصغيرة، ولمحتُ أخي الأصغر يضحك في إعلان عن النهاية السعيدة لمغامرة البحث عني، عندها نظرتُ مجدّداً تجاه أمي، واكتشفت أنها نسيت تغطية رأسها بالإيشارب الملون.
لا أذكر أني رأيتُ أمي حزينة على الانفصال، بدا لي شيئاً سعت إليه كخسارة عادية ستعفينا من خسائر أخرى باهظة، وربما كانت حزينة، لكن حزنها من نوع آخر دفينٍ... مجاز
مضت الإجازة الصيفية وعدت للدراسة، وأصدقائي جميعاً يحكون قصصهم المتشابهة حول ذكريات مصيف الطفولة في سعادة، وبينما فضّلتُ البقاء صامتاً كالمعتاد، فقد باتت تلك الذكرى تنتمي لفئة الذكريات التي لا أرغب في معاودة زيارتها أبداً. قلت لهم مرة محاولاً المزاح على طاولة الغداء في المنزل: "أصدقائي جميعاً قضوا الصيف في الإسكندرية مثلنا، لكن لم يته أحد من والديه"
قال أبي إنه أراد مني أن أتعلّم الاعتماد على نفسي مبكراً، وقالت له أمي إنه لا يُعتمد عليه في شيء. تشاجرا، وكانت تلك هي المرة الوحيدة التي آتي بها على هذه السيرة.
بعد تلك الحادثة بسنوات قليلة، انفصل أبواي. غادرنا أبي، ونسي مرة أخرى أن يأخذنا معه. لم أتساءل حقاً حول الأسباب، بدا لي كل شيء حينها منطقياً. كنتُ أشعر أننا ندور في دائرة تشبه حياة الآخرين لا أكثر، لدينا عائلة، ولدينا بيت، ونسافر كل عام، لكن في ثنايا كل ذلك هنالك شيء لا يشبه حياة الآخرين، تماماً مثلما لا يشبه مصيفنا مصايف أصدقائي في المدرسة. لا ينفصل كل البشر الذين تزوجوا، لكن في حالة كحالة أبي وأمي كان لا بد من الانفصال.
لا أذكر أني رأيتُ أمي حزينة على الانفصال، بدا لي شيئاً سعت إليه كخسارة عادية ستعفينا من خسائر أخرى باهظة، وربما كانت حزينة، لكن حزنها من نوع آخر دفينٍ، يحترم رغبتها في التماسك أمام ابنيها، حزن غير ذلك الذي رأيته عندما وجدتني في الشارع. ظللنا سنوات لا نتحدّث أنا وأمي حول حادثة تيهي، لم أعرف إلامَّ يرجع ذلك؟! ربما لأنها لا تحب تذكيري بأني مررتُ بها، أو لأنها ضمتها إلى سلسلة من الذكريات التي لا تحب تذكرها أبداً، كما حاولتُ أنا أيضاً ذلك فيما بعد، لكني فشلت.
وصار المصيف بعد ذلك مقتصراً عليَّ وعلى أخي الأصغر، بصحبة أمي، التي تحاول جاهدة صنع ذكريات مغايرة جديرة بالحكي والتذكر، ذكريات مليئة باللعب على رمل الشاطئ في الصباح، وأكل المطاعم الشهي في المساء، بعدما هجرت بلا رجعة، عادة الطبخ خلال المصيف.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


