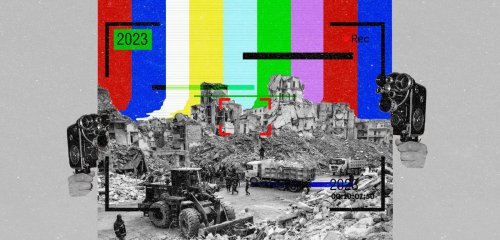في صباي شجعت نادي الزمالك. يكاد تشجيع الأندية يكون عقيدة، يدعمها المتعصبون بقراءة تاريخ النادي في مجلته الأسبوعية، وحفظ أمجاده، وأخبار لاعبيه، ومشاهدة البرامج الرياضية، والإشادة بالأداء والنتائج، والنيل من الأندية المنافسة، والتشاجر مع زملاء وأصدقاء للخلاف على استحقاق ضربة جزاء لم تُحتسب، واتهام الحكم بالرشوة ومعلق المباراة بالانحياز، حتى يسيطر النادي على المشجّعين. وأوشكت أعصابي أن تتلف. وبقوة لا أعرف، الآن، تفسيرها أنقذت أعصابي ووقتي، نجوْتُ من المرض بالزمالك، تعزّيتُ بأنني أشجع منتخب مصر، ثم تولى الإنجليزي مايك سميث تدريب المنتخب، وفي افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، في آذار/مارس 1986، خسرنا أمام منتخب السنغال بهدف نظيف، لكننا فزنا بتلك البطولة.
في عام 2007 أصبحت عضواً في النادي الأهلي، وإلى الآن يتهمني أولادي، ذوو العقيدة الأهلاوية، بالانتماء الروحي إلى الزمالك، ولا يقتنعون بأنني لا أعرف لاعبي الزمالك عدا شيكابالا، وأبدي إعجابي بأهدافه الممتعة في الأهلي.
يكاد تشجيع الأندية يكون عقيدة، يدعمها المتعصبون بقراءة تاريخ النادي في مجلته الأسبوعية، وحفظ أمجاده، وأخبار لاعبيه، ومشاهدة البرامج الرياضية، والإشادة بالأداء والنتائج
ولا أنوي سرد حكايتي مع الزمالك ومنتخب مصر في تلك البطولة، ولا في غيرها، التزاما بوعد قطعته في المقال السابق أن أبتعد عن الصداع، أن أصون أعصابي مؤقتاً؛ فلا شيء يتغير إلا إلى الأسوأ، ولم ينضج الشرط التاريخي للثورة، وفي المدى المنظور لن تستعاد حالة "جمعة الغضب". وفي استراحة قد تطول، آمل أن تجود سلّة الحروف بما يستحق القراءة. ومباراة مصر والسنغال ذكّرتني بثنائية الهمس والصراخ.
 منتخب مصر بطل كأس إفريقيا 1986
منتخب مصر بطل كأس إفريقيا 1986
الصياح والصراخ ظاهرة مصرية، وأخشى أن تكون عربية، ويرتبط الصراخ بالاستغاثة، أو النداء على بعيد لكي يسمع، ولا يزال أغلبية خطباء الجمعة يصرخون في المصلين، ولا يجرّبون الابتعاد عن هذا اللون من الأداء المنفّر، ويلينون قليلاً؛ فلا ينفض عنهم الناس.
كما اقترن الصياح بأداء أدعية موجّهة إلى رنّات الهواتف وأسطوانات ورثت أشرطة الكاسيت، في سباق على التظاهر بالتذلّل، وإبداء التقوى، بميكروفونات مزعجة مخالفة لأمر القرآن أن يكون الدعاء "تضرعاً وخفية". الأداء الآلي للأدعية يخالف آيتي "ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية"، "واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول". ينتهي الأداء التمثيلي، الممزوج بالتباكي بصوت مستعار، فيستعيد الداعي صوته الطبيعي.
الإنسان الطبيعي، المتحقق الواثق، لا يتكلف التمثيل، ولا يستعير صوتاً آخر، ولا يلجأ إلى الصياح. أما غضبنا فانفعالات صاخبة، مثل نار القش تعلو ولا تترك جمراً، مجرد رماد تذروه الريح.
وفي الغضب من هزيمة مصر، بهدف للسنغال في مرمى الحارس ثابت البطل، في افتتاح البطولة الإفريقية بالقاهرة، قذف مشجع مصري صلعة المدرب مايك سميث بالزبادي، فاستدعى الرجل تراث البرود الإنجليزي، وتذوق الزبادي بطرف إصبعه، وقال بهدوء: "Good milk". وللإنجليز في هذا الأداء الهادئ مدرسة أرجو أن يتفرغ لتأصيلها ودراستها مؤرخون، ونقاد سينمائيون لا يكتفون بأبرز النجوم الذي تهلْودوا، ونالوا جائزة الأوسكار في التمثيل، وفي مقدمتهم أنطوني هوبكنز ودانييل داي لويس.
في فيلم "لورانس العرب" جذب انتباهي الممثل أليك جينيس أكثر من غيره، كان المخرج ديفيد لين يفضّله، واختاره لدور الأمير فيصل. مشاهده قليلة، منحها قوة بذكائه ورسوخه، وانفعالاته المحسوبة. في مشهد مؤثر يحاور ضابط الاستخبارات البريطاني لورانس، ولأنه أمير ذو كبرياء، ولا يملك سلاحاً لمواجهة الاحتلال التركي، فإنه يواجه لورانس بالسؤال: "هل تعتقد أننا شيء يمكنك اللعب به، لأننا شعب صغير؟"، لا يعلو صوته، هكذا هو الأمير الذي سيكون ملكاً على العراق. وفي عام إنتاج "لورانس العرب"، 1962، أخرج حلمي رفلة فيلم "ألمظ وعبده الحامولي". بدا الخديو إسماعيل داعراً جاهلاً فظاً غليظاً، لعله الدور الأسوأ في تاريخ الممثل حسين رياض.
الإنسان الطبيعي، المتحقق الواثق، لا يتكلف التمثيل، ولا يستعير صوتاً آخر، ولا يلجأ إلى الصياح.
من يملك ويحكم لا يضطر إلى الغضب الهستيري، تكفيه إشارة بإصبع، رمز بالعين، إيماءة ذكية يفهمها المقربون. فماذا لو فقد هذا كله؟ عزلا أو تنازلا باختياره؟ الإجابة يقدمها الممثل الإنجليزي أليكس چينينجز الذي أدى دور الملك إدوارد الثامن في مسلسل "التاج". في نهاية 1936 ضحّى الملك بالعرش، فقدَ لقب الملك والإمبراطور، لكي يتزوج الأمريكية واليس سيمبسون، (يصرّون على وصفها بالمطلقة مرتين).
لعل قصة الحب واجهة لصراع خفيّ، في مؤسسات الحكم، القصر والبرلمان؛ خوفاً من الشخصية القوية لملك يستند إلى حب الشعب في تجاهُل الأعراف والقيود الدستورية. قيل إن عزل الملك سببه علاقته بالنازي. قد يكون ذلك زعماً، لإحكام تمثيلية الانقلاب.
خلع إدوارد لقبه الملكي. عاد أميراً. قبض الممثل أليكس جينينجز على هذه الروح المترددة في هذا السديم، وقدم أداء مقنعاً، في خطاب التخلي عن العرش. شعور مركّب بالعظمة والإيثار، وهو يقدم للشعب أخاه الملك جورج السادس المتمتع بأسرة مستقرة مع زوجته وطفلتيه إليزابيث ومارجريت. وأنهى الخطاب: "فليحفظ الله الملك".
ويموت الملك، ويشعر الأخ الأمير، المقيم في المنفى، بالإساءة والإهانة؛ لحرمانه من اصطحاب زوجته إلى جنازة أخيه، وبمرارة يشكو إلى أمه أنهم يضيقون عليه في مستحقاته المالية. القويّ بحقه لا يفقد أعصابه، ولا يعلو صوته. يذكّرها بأنه كان الملك، وصار فرداً ثانوياً في العائلة. تنازل عن الملك، ولا يتنازل عن الأنفة.
العم إدوارد، في لقائه بالملكة الشابة التي كان يسخر منها ويسميها "شيري تيمبل"، يمنحها الاحترام اللائق بملكة. تسأله ألا يشتاق إلى بلده وأهله؟ فيرد بهدوء وثقة واعتداد بالنفس أنه كان ليشتاق، لو تقبلوا المرأة التي يحبها، "لكنهم لم يتقبلوها، لذا لا أشتاق إليهم". أسى شفيف، عتاب، ترفّعٌ غير مصحوب بكلام إنشائي، لفظاً أو صخباً. ويرجع الأمير إلى باريس، ويتابع مع أصدقائه البثّ المباشر لحفل تنصيب الملكة، وينهض ويتخذ هيئة المايسترو؛ لشرح المشهد، ويشير بالقلم إلى التلفزيون، ويردد النشيد المذاع، ويشرح طبيعة الطقوس المقدسة، وأهمية الشعائر "لتكون ملكة مكرّسة على العالمين"، ودلالة شبكة الطلاسم في وضع "غشاوة على الكثير من الأعين".
الصياح والصراخ ظاهرة مصرية، وأخشى أن تكون عربية، ويرتبط الصراخ بالاستغاثة، أو النداء على بعيد لكي يسمع، ولا يزال أغلبية خطباء الجمعة يصرخون في المصلين، ولا يجرّبون الابتعاد عن هذا اللون من الأداء المنفّر
في الحوار الذكي، الذي كتبه بيتر مورغان، يؤكد المالك السابق أن هذه الطقوس والرموز الغامضة لا تمكن "أي كاهن أو مؤرخ أو محام أن يفك طلاسمها"، فيقول أحد الضيوف إن هذا الجنون، وبواقعية ومعرفة سابقة يرد الملك السابق بكلام مهموس: "بالعكس، هذا عين العقل. من يريد الشفافية عندما يكون لديه السحر؟ من يرغب بالنثر عندما يكون لديه الشعر؟ أزل الحجاب فما الذي سيبقى؟ مجرد امرأة شابة لا تتمتع بقدرات كبيرة أو خيال واسع". وفي اللقطة التالية يتم تتويج الملكة، تحيطها عظمة "إلهة"، أما العم المسكين فينعكس وجهه كشبح مائل، صامت وساخر، على شاشة التلفزيون الذي يذيع هتاف: "فليحفظ الله الملكة".
 مباراة مصر والسنغال في كأس إفريقيا 1986
مباراة مصر والسنغال في كأس إفريقيا 1986
إتقان الأداء جسده الممثل البريطاني مارك رايلانس، في فيلم "The Outfit" للمخرج الأمريكي غراهام مور. ومسرح الأحداث دكان صغير في شيكاجو، يملكه الخياط ليوناردو القادم من لندن، بسبب مأساة عائلية. الخياط الغريب يتجنب مشكلات تخصّ زبائنه من رجال العصابات، ثم يتورط من غير قصد، حين يشهد المحل جريمة قتل. يواجه الموت؛ فيسفر عن وجهه الآخر، وعن حكايته الحقيقية في لندن. ممثل كبير يحافظ على الإيقاع الصوتي، من دون أي انفعال زائد. رايلانس ممثل ومؤلف مسرحي يفرق بين كاميرا السينما والأداء المسرحي المباشر الموجه إلى جمهور، لم ينقل المسرح إلى الشاشة، يعي أن جوهر الشعر أعمق من صخب الأوزان وحدود البحور.
هنا، في مصر، يظن الكثير من الفنانين أن المهارة تقاس بالقدرة على الصخب، وإبكاء الجمهور. مساكين تعوزهم الثقافة والوعي بإزالة الشحوم الصوتية، لا يقرأون الشعر، ويعيشون عصر المسرح قبل اختراع مكبرات الصوت. لا يدركون أن الصياح يجيده أصحاب الحناجر الفتية الخالية من الذكاء والإحساس. الذكاء والإحساس يلزمهما تدريب شاقّ، إذا وجدت الموهبة.
لهذا السبب، ولغيره، لا تتقدم السينما. ومن البؤس أن تنظم مصر مهرجاناً دولياً، ولا يجدون فيلما يمثل البلد المضيف. الأزمة أكبر من مساخر الرقابة في زمن يستخف بالمحظورات، وينسف حدود الجغرافيا. لو شاهد مايك سميث عينة من أفلامنا لغضب غضباص لا يبدده ميراث البرود الإنجليزي، وقال: "Bad acting".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.