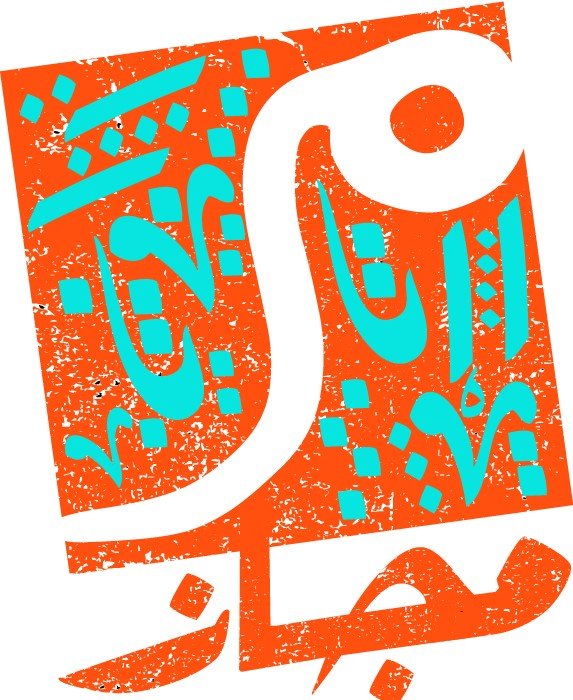 تصميم حروفي لكلمة مجازالضفّة، قطار إلى الجهة الأخرى
تصميم حروفي لكلمة مجازالضفّة، قطار إلى الجهة الأخرى
أذكر حين كنت طفلة تتهيّأ لدخول المدرسة، وفي أوج مراهقة بناتٍ أكبر مني سنّاً، كنّ يذهبن إلى الحدود السورية التركية القريبة من قريتنا الصغيرة المرمية شمالاً، ويركضن خلف ثغاء الأغنام، وغبارها وحزنها، حتى يصلن هناك.
الأغنام ترعى ما تيسر لها، وهن ينتظرن عبور القطار التركي الذي كان يتباطأ حين يلمح شيئاً قريباً من سكّته الحديدية، لأن قبل عملية بناء الجدار على طول الحدود السورية التركية، كان يمكن أن تتراشق مع المغيب بحجارة السكة، وعادة القطار في عبوره كان يطل من نوافذه العالية شبّان يغمزون ويغنون، ويرمون قوارير الماء وأكياس الخبز والسكاكر التي تتطاير قبل أن تصل إلى أصابعهن الصغيرة.
ذات مرة، رمى أحدهم ورقة معطّرة عليها كتابة غريبة، فيما بعد سمعنا أنها كانت رسالة من شاب يعمل في مقهى القطار، وقد كتب فيها بلغته عن شؤون القلب والغياب، عن الحنين والعناق. قال ذلك أحد العجائز الذين كانوا يتقنون لغة جيران الوطن، بعد تلك الحادثة أصبحت الحدود مرعبة لي، بعد أن وبّخت الأمهات أحلام بناتهنّ بلغتهن، عرفنا حينها معنى الخجل ومعنى أن تكون حائراً في التعبير عن شيء يؤلمك ويُبكيك.
بعدها تركت المكان وأتيت مع العائلة إلى بلدة قريبة، ولا أعرف لماذا تلك الحادثة بقيت في ذاكرتي وعلّمتني أن أبحث في اللغة كيفما كانت روحها وشكلها، ربما لأني توهّمت بأن من يعرف أكثر من لغة يملك أكثر من وطن، بحيث يمحو حدود الجغرافيا من ذاكرته ليحلق بروحه كما يشاء، ووحده يميز كيف يكون لك روح بألوانها وغزارتها وأحلامها وآلامها، وبطرق وأساليب مختلفة تماماً، ولأن بلدي الجميل سوريا متنوع اللغات، كان علينا أن نحمل أكثر من هوية معنا.
أجدت الكردية جيداً مثل العربية تماماً. أصبحت الآن حائرة الحنين بين اللغتين، أشعر بروحي تغني في سماء هذه البلاد حين أترجم لنزار قباني وجكر خوين، وأطلق أسماء قصائدهما على الغيوم والأزهار... مجاز
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد، وأنا التي أتقنها جيداً -كما كل أقراني- بحكم الدراسة في المدارس والجامعات، وأتقن الإنجليزية أيضاً، أصبحت لغتي الرسمية أيضاً، وبقيت لغتي الكردية الأم ثانوية نوعاً ما بالنسبة لي، حتى بدايات عام 2013، حيث أصبحت مناطق شمال وشرق سوريا ذات خصوصية كردية، إن جاز التعبير (وتلك المناطق تسمى بعبارة أخرى أو بلغة ثانية: مناطق خارج السيطرة بالنسبة للشركاء الذين يزينون نسيج البلاد)، ولكي أجد عملاً جديداً في المؤسسات الجديدة، بطوابعها ومراسلاتها وأرشيفها العام، يجب أن أتقن اللغة الكردية جيداً، نعم أعرفها نطقاً ونوعاً ما كتابة، لكن ليست بتلك الطلاقة التي أتحدّث وأكتب وأقرأ فيها بالعربية.
الكردية خلقت معي في إحدى البلدات الشمالية الصغيرة، تلك التي بنيت من الطين والأخشاب، ومن خلال اللغة الكردية عرفت كيف أبكي وأضحك، وكيف أغني كما أشاء عن ذاتي والأشياء التي أحبها. لغة أمي التي كانت تتحدّث بها لجراحنا فتشفى، لعيوننا التي فيها رمد فنبصر من جديد، وتشتمنا أيضاً بها كما لو أننا لصوص دجاجاتها الصغيرة.
بدايات العربية بالنسبة لي كانت مع جيراننا المسيحيين الذين كان بيننا سور قصير بُني على عجالة، بحيث تعطي أو تأخذ أي شيء من فوقه. كلمة من هنا وأخرى من هناك، كنا نفهم ما المقصود ونبتسم، وحتى بناء الجملة في ألعابنا الصغيرة كانت ليست لها قواعد محددة: بعض المفردات من هذه اللغة وأخرى من تلك، حتى تتداخل أرواح اللغات مع بعضها ممزوجة بالحب والثقة، لنعرف من عليه أن يذهب إلى البيت ويجلب الماء والخبز للجميع دون استثناء.
على أية حال ودون استئذان من أحد، ودون لغة أو حتى إيماءة أو إيحاء، دخلت الحرب بلدنا، وبطرفة عين سادت لغة السواد والدم والبكاء في كل الجهات. نسي الكثيرون لغة الماء والخبز، ليصبح الخوف والدموع والقلق لغتنا دون التقيّد بالمفردات والقواعد، وأحياناً لا لغة في العالم كله بمقدورها أن تساعدني على التعبير عن مواقف حدثت وتحدث الآن في هذا البلد، لأن هنا كل شيء متوقع.
أصبحت الحدود مرعبة لي، بعد أن وبّخت الأمهات أحلام بناتهنّ بلغتهن، عرفنا حينها معنى الخجل ومعنى أن تكون حائراً في التعبير عن شيء يؤلمك ويُبكيك... مجاز
في بداياتي التي كنت مضطرّة أن أجيد الكردية. كانت هناك أصوات جديدة لها رنين خاص في القلب. دخلت الجامعة بلغتي الأم، لغة حمامات بيتنا الطيني وأشجار اللوز والتين والزيتون والعنب، عرفت حينها أن الكلس الذي كان يتساقط من جدران الغرف، لم يكن غير رسائل ألم، وأن النهر المقابل لبيتنا انتحر من الحزن حين استبدلنا أسوار الشجر والنباتات بالحديد والإسمنت. تخرجت متفوقة وبدرجات عالية جداً، وحينها عرفت لماذا كنت أذهب إلى جارتنا المسيحية، وأطلب منها الماء والخبز على أنها أمي وأم الذين ينتظرون.
فلكل شيء لغته الخاصة به، يتحدّث بها، يعبّر بها عن روحه ويخفي بها أيضاً مشاعره خوفاً على تلك اللغة، غير الحب الذي هرب بعيداً، فهو ليس بحاجة إلى لغة وكلمات. أعتقد لو كنا نعرف لغة الحب جيداً لما وجدنا دموعاً غزيرة وخياماً احتضنتنا في البراري الموحشة والقاسية بدل المنازل.
هذه البلاد الجميلة بشرقها وغربها، شمالها وجنوبها، تشبه الحب بلا لغة وبنفس الوقت بلغات كثيرات. نحن بحاجة إلى بعض الوقت من السنين – إن بقينا أحياء- لنحمل هوية واحدة، ملونة كسوريا أو بيضاء تماماً مثل الكلس القديم، وتصلح للحواجز الكثيرة بين القلوب والعيون والمدن، أتمنى أن تعود هذه البلاد إلى ما قبل حريق الدم.
أجدت الكردية جيداً مثل العربية تماماً. أصبحت الآن حائرة الحنين بين اللغتين، أشعر بروحي تغني في سماء هذه البلاد حين أترجم لنزار قباني وجكر خوين، وأطلق أسماء قصائدهما على الغيوم والأزهار، وعلى تلك العيون التي غابت مع شمس البلاد، غابت وأخذت معها الكثير من الكلمات التي لم نستطع النطق بها يوماً ما.
أفكّر الآن بتلك الرسالة القديمة التي ألقيت من نافذة قطار متباطئ، مكتوبة بلغة أجهلها، لكن بمشاعر أرغب في قضمها كتفاحة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


