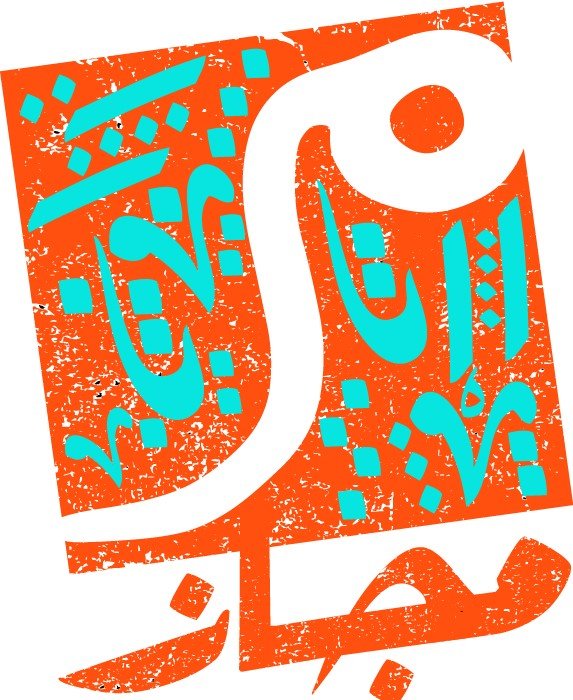
النرد: مكعب مرقم، ألقيه عشوائياً، في رقعة خشبية تشبه خريطة الكون، إذا أردت تحريك الأقراص العاجية بارتجال، بغية استخراجها من اللوح بالتدريج. هنا لا مساحة لمهارات فردية، ترجح كافة عن أخرى. أنا وأنت متساويان في الحظ، بوصلة النرد فحسب هي من تحدّد موقعنا من الحدث. يُعكّر المزاج هذا النرد، لم ألقِ يوماً إلا وخرجت من الحدث مهزوماً، ثمة حركة تدفع الحظ نحو هؤلاء، ربما الإيمان ذاته أن الحظ مخلوق غير مرئي، يشبه الملاك والشيطان، ولديه القدرة والسطوة معاً، ولا يصاحب غير صوفي هائم أو مخطئ آثم، أما من يتأرجحون بين ميزان العقل والعاطفة، ويسبحون في الكون، ويتقلبون بين الليل والنهار، لتدبر ما وراء افتعال اللحظة، لا يعيشون الحدث، بقدر ما ينتظرون نهايته.
*****
يرثي القهوجي الكهول كآبتي بعد الهزيمة بنظرات تطفلية، أقرأ في عينيه تساؤلات عن سرّ اعتيادي المجيء يومياً، والجلوس منفرداً في الزاوية الخلفية للمقهى غير المضاء بالمصابيح. تشتعل نار المعرفة بعقله عن سبب عدم تناولي سوى القهوة السادة، ورفض احتسائها في كوب زجاج. تلاعبه الشكوك، حينما يهمس لأحد الزبائن عن اسم الكتاب الذي أداوم على مصاحبته، أثناء خلوة الليل، فيخبره بهمهمة خفية أنه لشاعر ومصوّر صيني، مات منتحراً، يدعى رين هانغ.
ولأن النار إن لم تهدأ تحرق، يأتي القهوجي ويحاول قطع المسافات بيننا، بكذبة يغلفها مُراد المعرفة، بأنه يهوى الشعر منذ الصبي. أفهم دون مزيد من العلل، أنه يود القرب من رين هانغ، فأتلو عليه ما كنت أقرأ من الأبيات: "أحدق في السقف فيزدادُ بعداً. أجلس على الأريكة فتزدادُ سِعة. أسلكُ الطريق فيزدادُ عرضاً. لم أعد أفهم، هل الكون يتمدد أو أنا من يتقلص".
الأم لا تبكي أو تنوح أو "تُعدّد" بالعامية المصرية، بل تشرح أن الارتباط بينها وبين طفلها المكفّن تشكل بـ "580 حقنة هيبارين"، لذلك لن يكون انفصاله عنها كسائر نهاية العلاقات... مجاز
لم يكترث المعلم لكآبة يغلفها العمق، ونهض دون تعليق، وغادر في سكون نحو ضوضاء المقهى. وبين خطواته المتعثرة، كنت قد تركت هانغ وأبدلته بمجموعة من الأوراق، جلبتها لأفراغ في سطورها لقاء لم أفهم مغزاه القدري، بدأ منذ 5 أشهر، وانتهى اليوم.
تناولت القلم وافتتحت كعادتي الكتابة، بتدوين التاريخ في الجانب الأعلى من الورقة الأولى، ثاني أيام عيد الفطر 2024. وفي أيسر السطر ذكرت المكان، "مقهى المعاشات"، إكراماً لصديقي الذي لقبها بهذا الاسم لأنه لا يجلس بين جنباتها سوى كبار السن، باستثناء شاب وحيد.
*****
8 ديسمبر 2023، تاريخ ثانٍ تلا الأول، أرفقته بسهم كما تعلمت في دروس مادة التاريخ بالثانوية، ليرتبط بالحدث، فيظل عالقاً في ذهني ولا أنسى. في مساء ذلك اليوم، حيث كنت أجلس بمكتب العمل في القاهرة، أتابع عن كثب آخر مستجدات الحرب على غزة. وقع في عالمي الافتراضي مقطع فيديو لأم منفطرة، تحتضن طفلها المُكفّن بقطعة من ثوب أبيض ملطخ بالدماء، في إحدى زوايا المستشفى الكويتي في رفح. لا تبكي أو تنوح أو "تُعدّد" بالعامية المصرية، بل تشرح أن الارتباط بينهما تشكل بـ "580 حقنة هيبارين"، لذلك لن يكون انفصاله عنها كسائر نهاية العلاقات.
صعقتني الجملة، وأثارني فضول عملي بالصحافة معرفة حكاية جملتها المستجدة على قواميس رثاء لغتنا العربية. وفي خلال اليومين، أعددت قصة بعد أن تواصلت معها، فصلت وسردت ما وراء الكواليس. ومرّت الأيام وتوالت الحكايات الفلسطينية الأخرى، ولهتني أمواج الأيام عن "لانا فرحات". حتى أتتني مكالمة من زوجها قبل عيد الفطر بأيام، أخبرني خلالها عبر الهاتف، أن الأسرة حضرت إلى مصر. تسامرنا بنهم عن تفاصيل عدة، انتهت بترتيب مقابلة ودية، تصادف موعدها نهار اليوم.
نحو الثالثة والنصف عصراً، كنت قد انتهيت من العمل، وتوجّهت صوب مكان المقابلة، حيث اتفقنا على أن يكون حديقة الطفل، مدينة نصر، لعل مساحة الاسترخاء والألعاب الترفيهية توفر لطفليهما، ديما وصلاح، اللذين حضرا دقائق استشهاد شقيقهما، وقتاً هادئاً يمحو من ذاكرتهما لحظة القصف وموقف الخوف.
مع حلول الرابعة والنصف كنت قد وصلت على بوابة الحديقة، حيث وجدت الأب صالح والأم والطفلين. تصافحنا ومررنا من بوابة عبور التذاكر، وقصدنا مقعداً يحيطه مساحة خضراء وعائلات تضج مجالسهم بلهو الأطفال. لم تنطق لانا حرفاً واكتفت باستكشاف الحياة القاهرية في شرود، كون هذه هي المرة الأولى التي تخرج من المنزل منذ أن جاءت إلى أرض الجوار، بينما أخذني صالح من يدي وسافرنا إلى غزة، وصار يحكي كالقنابل الموقوتة حينما تنفجر، مشاهد الموت، الجوع، الحياة غير الآدمية.
لم يمكث آل صالح في نزهتهم إلا دقائق وعادوا، بينما وقف الطفل صلاح يحملق في أعلى أفق سماء القاهرة بترقب: "هاي طائرة مدنية ياصلاح. أصل في سمانا ما في إلا طائرات حربية"... مجاز
"أنا من الناس اللي أتأذت في الحرب، ابني استشهد وبيتنا راح. وأهلي وجيراني لسة في غزة، بكون نايم وبخاف يجيلي اتصال يقولوا قصفوا بيت أهلك واستشهدوا. بحكي معاك وبدي أعيط عليهم، كنت هناك وعارف إيش عم يصير. لما كنت بشوف الأطفال نشفوا من الجوع، كنت أبكي، كان نفسي أساعدهم. ما حدا شاف الصاروخ لما كان ينزل ويتفرق منه عدة صواريخ. إن ولادي لسة عايشين أشبه بالمعجزة. لما البيت انقصف، ووصلت أول الشارع وشوفت المنظر قولت كلهم استشهدوا. كان الفرق بينهم وبين أخوهم خطوة، لأنهم كانوا راجعين مع خالهم ومحمد راح يجري عليهم وفي لحظتها انقصف البيت".
لم يتوقّف صالح عن الحكي حتى أمهلته هدنة لاصطحاب طفليه وزوجته لبرهة من التنزه. وبمجرّد أن بدأ يبتعد عن عيني، شعرت أنني أدخل في نوبة من الهلع مما قال. ضممت يدي إلي، ورحت أتمعّن في لهو الأطفال وزِحام الزوار في صمت وخشوع. لم أسهُ عنه إلا حينما سمعت صوت وردة، يخرج من بين أسرة جلست في أحد أركان الحديقة. حيئنذ، تساءلت متى أحببت وردة؟ علّي أشتت الذهن المتكدّس بالذعر بشيء من الرقة.
*****
وجدتىي أعود بالزمن للوراء 5 أعوام، حيث كانت الليلة الأولى التي أقضي العيد خارج أسوار القاهرة، بعد أن التحقت بالخدمة العسكرية بأحد جبال السويس النائية. لم يكن هناك أي مظهر للاحتفال، أنا وثلاثة آخرون نجلس بغرفة يحيطها الجبل والصحراء والليل الدامس، وبينما انغمس هؤلاء في أكل الكعك والبسكوت، غاب ذهني بالتفكر في هوامش اللحظة، وفي هذه الأثناء، لاحظ أحدهم متاهات الأفكار على انقسامات وجهي، فنبهني بزجرة أعلى كتفي متعجباً: "قال أيه بيسألوني!".
أجبته لحظة العودة من الشرود مستفهماً: "نعم؟"، فأطلق ضحكة بلهاء وعرض علي استعارة هاتفه، ربما أجد في موسيقاه ما يونس وحدتي. لم أتردّد واصطحبت الهاتف خارج الغرفة وتجوّلت في الظلام بحذر، وقمت باستشكاف الموسيقى بشكل عشوائي، وإذ بـ وردة تصادفني كأولى المؤنسات في تلك الليلة، وبمجرّد أن ضغطت على زر التشغيل أكملت هي "... عنك يانور عيوني".
*****
لم يمكث آل صالح في نزهتهم إلا دقائق وعادوا، بينما وقف الطفل صلاح يحملق في أعلى أفق سماء القاهرة بترقب، حيث كانت تمر طائرة غير واضحة الملامح، صاحبها صوت والده كالأفلام التسجيلية التي تولد من رحم مآسي البشر: "هاي طائرة مدنية ياصلاح. أصل في سمانا ما في إلا طائرات حربية".
أخذت في المشهد سوى دور المستمع، ومحاولة مداعبة وجه صلاح، الذي أبى التعرّف على غريب مثلي، وحاول اللهو مع شقيقته، إلا أنه بين الحين والأخرى كان يتذمر وينفث عن غضبه بطريقة انفعالية، حللها والده بـ "صلاح كان طفل هادي. بس من بعد موقف استشهاد أخوه قدامه، صار عنيف، تغيرت شخصيته".
يسود السكون، يتلاعب بنا أزيز الطائرات، بينما تخلق أصوات ضحكات العائلات المتشابكة حالة من الونس، دفعتُ لانا والأطفال لركوب القطار الملون، لربما يتخلخل حزنها من الوجوم إلى درجة أقل، وتركت صالح ينوب عنها في سرد يومياتها: "كانت متعلقة كتير بمحمد لأنه كان تعبان. كان طول الوقت معاها. هي ما بتقدر تنجب إلا بحقن الهيبارين، لأنها مريضة غدة درقية نشيطة وعندها نسبة تجلطات بالدم. ولو يوم وقفت الهيبارين، الجنين بيموت. لما انولد الطفل طلع عيان وقعد 8 أيام بالحضانة والعناية الخاصة، ولما خرج كانت تخاف عليه من الهوا، لكن ربنا أراد يستشهد".
"في الظهيرة، استيقظت على زقزقة العصافير، لو كنت أملك بندقية لأطلقتُ النار عليها جميعاً. لأن الكون لا يحتمل هذه الروعة"... مجاز
"لما عرفنا بعد استشهاده بمدة أنها حامل، قرّرنا الخروج عبر شركة هلا، العرجاني، بتعرفه؟ بتاخد على الفرد 5000 دولار والأطفال 2500 دولار. وساعدنا في تجميع الأموال شقيقها عايش هنا. كنا بنخرج نروح لحد المعبر والقصف حوالينا. لحد ماجينا. الحمدلله ربنا عوضها وعادت مرة أخرى تأخذ يومياً حقنتين هيبارين عشان الطفل الجديد، لكنها بتحتاج رعاية طبية خاصة، وكمان لسة بنفكر نرتب أوضاع التعليم لصلاح وديما، لأنه راح عليها سنة أولى بسبب الحرب".
طاف القطار جولته في أرجاء الحديقة، حتى عاد وتوقف في محطتنا، وهنا هممتُ بالمغادرة، فتذكر صالح أن يقدمني لـ لانا، التي رحّبت برحيلي بهمهمات وابتسامة متكلّفة. قابلتها بالاسترسال في حديث مقتضب انتهى بكلمات وداعية على أمل لقاء ثانِ. واستدرت ووليت قبلتي صوب باب الخروج من الخيالات إلى المقعد الخلفي في مقهى المعاشات.
*****
لاحظ المعلم وهو يدخّن الشيشة عن بُعد، أن الزبون صاحب الأطوار الغريبة تكالبت عليه عواصف الأيام، فجاء بعاطفة الأبوّة، يصاحبه صوت فيروز وهي تدندن من أثير الراديو: "خلي بالك م الحبايب دول أنصار القضية"، ورائحة المعسّل في ثيابه تفوح في الأرجاء، مطالباً بالحساب وبيتاً من كلمات رين هانغ.
لمستني دعابته، فبادلني بابتسامة وتناول كتاب الشعر الغامض دون استئذان، وبأنامله المتسخة ببقايا المعسّل تصفّح أوراقه، حتى وقف عند صفحة اختارها بمحض الصدفة، وأخذ يقترب بعينه منها وصار يقرأ بتلعثم من يتحسّس القراءة لأول مرة: "في الظهيرة، استيقظت على زقزقة العصافير، لو كنت أملك بندقية لأطلقتُ النار عليها جميعاً. لأن الكون لا يحتمل هذه الروعة".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


