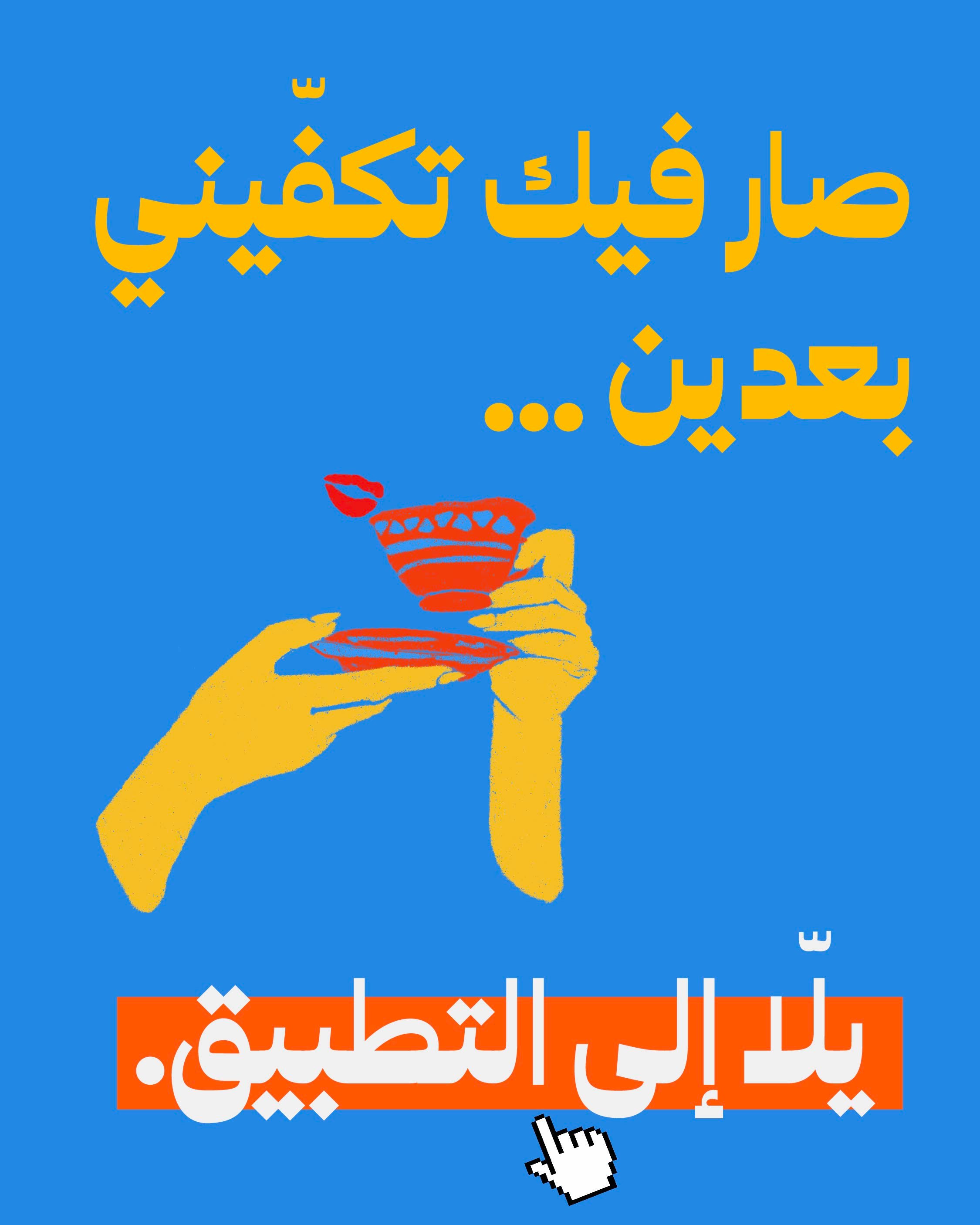في زمنٍ كانت فيه الحرب الأهلية تقتسم الجغرافيا والهوية، ظهر "كوكو" على الشاشة الصغيرة: تلفزيون لبنان، أواخر السبعينيات. ظهر لا كبطلٍ مغوار ولا كمقاتلٍ يحمل مشروعاً، بل كشخصية غريبة، مضحكة، ومختلفة.
في قلب مسلسل "الدنيا هيك"، أطلّ "كوكو" كشخصية هزلية، ولكن أيضاً كشخصية غير نمطية. رجل بصوتٍ ناعم، وحركات مبالغ فيها، ولباس غير مألوف… رجلٌ لا يندرج تحت سلّم "الذكورة" اللبنانية المعتادة، خصوصاً خلال الحرب.
لكن "كوكو" لم يكن يُدعى "كويرياً"، ولا "مثليّاً" في سياق واضح. لم تكن هنالك من لغة تُحيط به. لم يكن هنالك اسم. كان فقط "كوكو". ومع ذلك، كان حضوره علامةً على شيء لم نكن نعرف كيف نسمّيه، ولكننا نعرف في طيّاتنا بأنّه مختلف. وهذا المختلف، لم يكن يهددنا.
هل يمكن اعتبار "كوكو" أوّل أرشيف بصري للكويرية في التلفزيون اللبناني أو مجرّد كاريكاتور تم توظيفه للضحك والتفريغ وسط دمار حقيقي؟
نوستالجيا مؤلمة
ما زلت أشاهد مسلسل "الدنيا هيك". نوستالجيا مؤلمة، لكنها غير مؤذية. أشاهده لأنني أشتاق الى "كوكو" وتلك العلاقة الشائكة البائسة حدّ الهزل، وإلى صديقه "علّوش".
كل من عايش الحرب الأهلية، طفلاً كان أو شابّاً، يتذكر المسلسل ويتذكر "كوكو"، وكأنّ تلك الشخصية أتت بلسماً لطيفاً لحرب هوجاء، لم نعٍ حتى اللحظة كيف انتهت.
هل يمكن اعتبار "كوكو" أوّل أرشيف بصري للكويرية في التلفزيون اللبناني أو مجرّد كاريكاتور تم توظيفه للضحك والتفريغ وسط دمار حقيقي؟
أذكر جدّي لأمّي، الذي كان يحب "كوكو"، ولعلّني أحببته أيضاً، لأنّ جدّي أحبّه.
أذكر جدّي، الذي كان ينتظر "الدنيا هيك" كمن ينتظر ماءً في صحراء، صحراء حرب فهم بعضاً منها، وتاه عنه بعضها الآخر.
أذكره يناديني :" يا جدّو، وينك؟ رح يبلّش". وأنا أحاول أن أتأكد من أنّ أبي يغطّ في نوم عميق، لئلا يحاول أن يحثّني على النوم باكراً.
أهرع صوب صوت جدّي. أحياناً أسقط أرضاً لأنّ أمّي نسيت حذاءها في الممر بين غرفة النوم وغرفة الجلوس. في الحرب، ننسى أشياء كثيرةً مبعثرةً هنا وهناك.
أركض صوب ضحكة "كوكو"، الذي ينهال بالشتائم على زوج أمّه. الطفل يعرف ما يفرحه. وأنا كنت أعرف أنّ لحظات كوكو معنا، هي لحظات عائلية، نسرقها من هول الحرب، لعلّنا نبقي على بعض أمل في صباح مختلف.
أجلس ملتصقةً بالشاشة، لكي أكون أقرب إليه. أردت أن أسأل جدّي إن كان بالإمكان أن يأخذنا لنزور "كوكو".
مات جدّي ولم أسأله. وحافظت على "كوكو" في ذاكرتي، كمن يحافظ على رائحة المألوف جداً، والمحبوب كثيراً.
كمن يحافظ على ضحكة جدّه، وحذاء أمّه، ونوم أبيه.
كمن ربط هذا الغريب المضحك المختلف، بما يجعل العائلات ممكنة.
"كوكو" كان خارج النمط، ولكن داخل بيوتنا.
أسترجع نفسي في زمن الحرب وعرض المسلسل، وكأنني ببراءتي تلك، أفهم "كوكو" أكثر، أو كأنني تركته هناك، وحين أعود إليه اليوم، أترك أعوامي وتعبي، وكل نظرية قضيت السنوات الثمانية الأخيرة وأنا أدرسها، وأتجه صوبه، عاريةً تماماً من المصطلح، الهوية، التنميط، وإدخال الجنس في دائرة القضايا الاجتماعية والسياسية.
أحاول جاهدةً أحياناً ألا أعود إليه مثقلةً بكل ما أعرفه اليوم عن الهويات، عن التصنيفات، وعن الصناديق التي صنعناها لننقذ أنفسنا من الإنكار، فوجدنا أنفسنا نُعرّف أكثر مما نعيش.
تسميات
"كويري"، "مثلي"، "عابر/ ة"، و"غير ثنائي"... تسمياتٌ جاءت متأخرةً عن زمن "كوكو"، ولكنها أيضاً لم تكن تتّسع له، لأنّ "كوكو"، ببساطة، لم يسعَ لأن يُفهَم، بل دخل إلى الشاشة بخفّة الظلّ، فدخلنا نحن معه، في اختلافه.
ما زالت الطفلة التي في داخلي، تضحك اليوم كلما شاهدت "الدنيا هيك". ولكنّها في مكانٍ ما، كانت تشعر بشيء من التوتر اللذيذ، لأنّ اختلاف "كوكو" كان يضع في رأسها لوناً مختلفاً، حقيقةً مختلفةً، من دون أن يكون لهذه الحقيقة أي اسم. حقيقة لم تجد لغتها بعد.
لم أستطع أن أحافظ على هذا التوتر…
اليوم، ومع كل ما نعرفه، نحاول أن نُسمّي. أن نضع التصنيف المناسب. لكن، هل تستحق كل العلاقات أن تُفكَّك بلغة الهويّات؟ ماذا لو كانت اللغة ذاتها قيداً؟
لا أكتب هذا انحيازاً ضد من وجد في اللغة هويةً تحميه، بل أكتبه انحيازاً إلى ما لا تقوله اللغة، إلى ما تتركه على الحافة، إلى ما تخونه دائماً.
كتب رولان بارت، أنّ "اللغة هي جلدنا"، وأنا صدّقته، لكنني أيضاً اختبرتها كسجن، كثقلٍ على من لا يجد جسده داخل الجملة. "كوكو" لم يكن جملةً. لم يكن بياناً. لم يكن هويةً جنسيةً تُحمَل كدرع. لم يكن يحتاج إلى درع، لأننا استقبلناه بيننا، في بيوتنا التي من دون نوافذ، استقبلناه خارج اللغة.
"كوكو" سبق الكويرية كسياسة مناهضة لسياسات الهوية، وكنظرية وجدت ذروتها في تسعينيات القرن الماضي.
الوجود يسبق التعريف.
"كويري"، "مثلي"، "عابر/ ة"، و"غير ثنائي"... تسمياتٌ جاءت متأخرةً عن زمن "كوكو"، ولكنها أيضاً لم تكن تتّسع له، لأنّ "كوكو"، ببساطة، لم يسعَ لأن يُفهَم، بل دخل إلى الشاشة بخفّة الظلّ، فدخلنا نحن معه، في اختلافه
وفي زمن أصبحنا فيه أكثر توحشاً مع الاختلاف، أترك سؤال اللغة معلّقاً: هل كنا أكثر تقبّلاً لأنّ الاختلاف كان خارج اللغة؟ هل اللغة وضعت التهديد، وجعلت من المختلف الذي يحمل اسماً، عدوّاً لدوداً لتقبّلنا؟
"كوكو" لم يكن وجهاً على شاشة فحسب. كان ممرّاً، فاحتمالاً، فعلامة استفهام لم تُغلق. "كوكو" كان أيضاً، جيل الحرب، يضع اختلافه بين صوت قذيفة، وساعات هدنة، ويقبل ويضحك ويجهل التصنيف… ويجمعنا حوله.
لكلّ هذا أكتب عن "كوكو"، وعنّا جميعاً، في زمن "كوكو". لا لأفهم أو أصنّف، بل لأبقى معلّقةً في الاحتمالات التي وُجدت، وفي المساحة التي لم تُقفل بعد.
ولربما أيضاً، لأحاول أن أضع شخصياتنا الكويرية التي لنا، قبل زمن الكويرية وثورات العالم الجنسية، في سياقاتنا الخاصة جداً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.