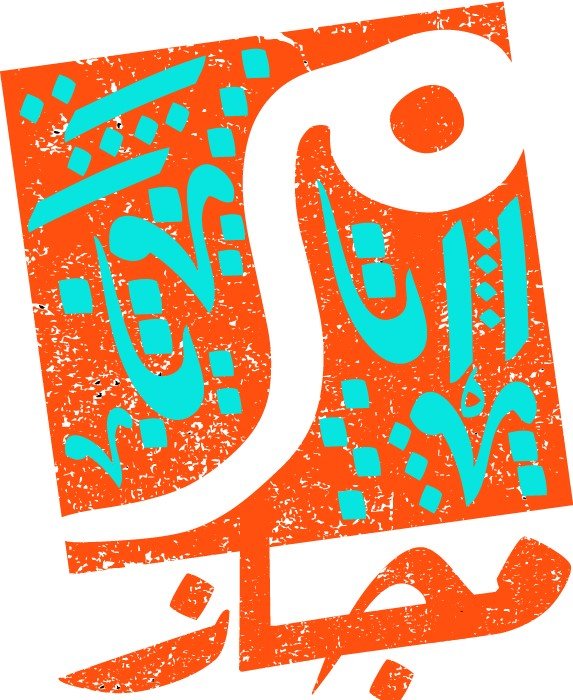
سأخبركم الآن عن أوليفيا.
شقراء، شعرها ناعم كشعر طفلةٍ، متوسّطة الطول كمراهقةٍ لم يمتدّ عظمها إلى حدّه الأخير بعد، عيناها ملوّنتان بلون البحيرة، وكلّ ما فيها أبيض.
دقّت أوليفيا باب بيتي ذات صباح.
فتحتُ الباب.
- نعم؟
- أتودّين أن أجرف لكِ الثلج عن مدخل البيت هذا الصباح؟
صُدِمت لثانية، أنا التي تركتُ الثلج يتراكم أمام مدخل بيتي مع علمي بأن القانون في كندا يحتّم على الجميع الجرف. اجرفوا يا سكّان كندا، وسنبني بلداً أبيض آخر من فتات الثلج فقط.
تكاسلتُ، ذلك أنني لا أريد بناء أيّ بلدان أخرى وفتات الآخرين لا يعنيني، كما لا يهمني في هذه الآونة سوى أن أعيش بسلام. لكن القانون لا يهمه هذه الترّهات ويلزمنا بالجرف اليومي. المهم، تجمّع الثلج في مدخل البيت بسبب إهمالي الشخصي الذي أتحمّل كامل مسؤوليته، فجذب هذه الصبية إلى احتمال جني بعض الدولارات من الثلج. يبيع البشر الثلج أينما كان، وهنا، يبيعون جرفه أيضاً.
ما الذي تفعله هذه المراهقة في الخارج في هذا الوقت المبكر ولماذا ليست في المدرسة؟ مازالت تنظر إليّ، والمجرفة الطويلة في يدها، تتحيّن نظراتي كما تتحيّن فرص العمل بما فيها الجرف، وأنا واقفة على باب البيت، يتملّكني شعورٌ بأنني تكاسلت حتى بات الثلج يغطّيني كلّي وبأنني أغرق، أغرق، أغرق.
قبل سنواتٍ، كانت حياتي مختلفة تماماً. كلّ تفصيلٍ فيها اختلف، بما في ذلك لونها. هل تعلمون أن لكلّ حياة لوناً، كما لكلّ مدينةٍ لون؟... مجاز
أردتُ أن أقول لها أن تجرفني قبل أن أختنق، فرددتُ فجأةً وبصوتٍ خفيض: نعم، نعم طبعاً. ثم أغلقتُ الباب على عجل وعدتُ إلى طاولتي وكرسيّ وتناسيت الصبية البيضاء حتى تهيّأ إليّ أنني نسيتها فعلاً، وغصتُ كلياً في صومعتي التي أحتمي فيها من الثلج ومن كلّ البشر، بغضّ النظر عن ألوانهم، هنا في حياتي الجديدة التي ما زلت لم آلفها كلياً بعد.
قبل سنواتٍ، كانت حياتي مختلفة تماماً. كلّ تفصيلٍ فيها اختلف، بما في ذلك لونها. هل تعلمون أن لكلّ حياة لوناً، كما لكلّ مدينةٍ لون؟ أما لون حياتي، فكان يراوح بين الأحمر والليلكي والأزرق والرمادي، وكانت تتناثر فوق اللوحة ألوان أخرى هنا وهناك، تعجق المشهد حيناً وتتنافر مع الرمادي الذي يغلب حيناً آخر.
*****
لم تكن ألوان حياتي واضحة، لكن لون البحر فيها كان واضحاً. أما اليوم، فلا بحر هنا. تقول مهاجرةٌ لبنانية إن الحديث عن البحر تافهٌ بوجود بحيرة أونتاريو. لا أوافقها ولا يهمّني أن يبدو عالمها مثالياً لا يغبّر عليه أحد حتى غياب البحر. فالبحر أمي، وأبي، وأختي، والبحر تحديداً حماني من انفجار مرفأ بيروت. هنا لا انفجارات، تقول عينا أوليفيا الزرقاوان بلون البحيرة لكنني أتجاهلهما تماماً، أنا الجالسة في الدفء فيما أوليفيا الشابة تجرف في البرد. ينتابني شعورٌ شديدٌ بالذنب.
أما اليوم، فلوحة حياتي بيضاء. ليس الثلج سبباً وحيداً، ولا دخل للون البشرة. أن نبدأ من جديد في مكانٍ آخر أي أن نفتح صفحةً جديدة، والصفحات الجديدة لا يليق بها الذنب. لا الذنب تجاه العائلة، ولا الذنب تجاه البلد، ولا الذنب تجاه أوليفيا طبعاً. بعد قليل، ستحصد أوليفيا ثمار تعبها بالدولار الكندي، ولا ضير في ذلك، "فعلى المرء أن يؤمّن دولاراته"، بحسب الفتاة ذات المعطف الأسود الذي تفوح منه رائحة الرطوبة والعطن. يا إلهي كم مدخلاً جرفَت حتى الآن؟
نريد ضمنياً أن نخلص إلى أن بلادنا أفضل وأن احتمال العودة قريب، وإن علمنا يقيناً أن هذا غير صحيح
في صفحات حياتي الأولى، لم يكن المراهقون العاديون يجرفون الثلج ولا يدقّون على الأبواب سوى للتسلية ربما. أعمال كهذه غالباً ما كانت حكراً على الشبان والرجال، في فقرا وعيون السيمان، أو في الباروك، أو في جرود الهرمل، أو في أيّ من الأماكن القليلة التي تتساقط فيها الثلوج وتعلو في بلادي، في النوادر هذه الأيام بسبب التغيّر المناخي. لبنان على خريطة العالم، لذا فالاحترار أصابه أيضاً، لكن مصائب البلد أكبر بكثير من تراجع الثلوج المتزايد كلّ يوم.
في صفحات حياتي الأولى، ليس عادياً أن يدقّ مراهق باب بيتك لأنه رأى فرصة للاستفادة والإفادة، مع ما تتضمّنه هذه الفرصة من تعبٍ جسديّ وتحمّلٍ لظروفٍ مناخيةٍ صعبة. آخر مرة جرفتُ الثلج هنا أحسست بعضلاتٍ جديدةٍ في ظهري كنت قد نسيت وجودها حتى، وظلّ جسمي يؤلمني ليومين على الأقلّ. من المؤكّد أنه ليس أمراً عادياً أن تدقّ بابك مراهقة شقراء بعينين زرقاوين، ذلك أن مراهقات بلادي يعرفن الخطر الشديد الذي قد يتأتى عن ذلك. الغريب مصدر خوفٍ، لأن القانون غائب أيضاً، ونحن البنات نتعرّض للكثير لذا فالحذر واجب، أقلّه ألا نذهب مراهقاتٍ إلى بيت الغريب بقدمينا وندقّ بابه.
الفرق بين الشرق والغرب. الفرق بين لبنان وكندا. التربية على أهمية المظاهر مقابل التربية على أهمية الإنتاج. ضغط الرأسمالية على المراهقين بشكلين مختلفين تماماً، وإن ارتبطا بالمال. أولويات المجتمع، والعوامل الثقافية والحرية الاقتصادية منذ الصغر. ماذا ستفعل أوليفيا بالمال الذي جمعته في هذا النهار الثلجي؟
قبل فترةٍ قصيرة، أراد ابني الذي يبلغ من العمر خمس سنوات أن يبيع العصير. رأى أطفالاً كثيرين يبيعون العصير هنا خلف ستاندٍ صغيرٍ مع أهلهم. أعجبه المشهد فطلب مني أن نقيم ستانداً لنا. لم يكن لديّ ما يكفي لعصره، فاقترحت عليه أن نقدّم الشوكولاته الساخنة، وهكذا كان.
حين خرج أوّل جارٍ من منزله ندهنا له وأعطيناه كوب الشوكولاته الساخنة. قال: كم سعره؟ أجبته: ببلاش. اعترض الجار موجّهاً حديثه إليّ: لكنه هكذا لن يتعلّم جني المال، ومدّ يده إلى جيبه ليعلّم ابني أولويات الحياة في كندا. لم أعترض، ابتسمت له، وتركت ابني يفرح بأول مالٍ ينتجه عبر العطاء. أعطِ يا ابني وسيعطيك ربّك. الحياة تحبّ من يعطي، وإن قست عليه أحياناً.
من المؤكّد أنه ليس أمراً عادياً أن تدقّ بابك مراهقة شقراء بعينين زرقاوين، ذلك أن مراهقات بلادي يعرفن الخطر الشديد الذي قد يتأتى عن ذلك... مجاز
*****
رنّ جرس الباب مجدداً. نظر القطّ البرتقالي إليّ وماءَ لينبّهني ثم سارع نحو الباب. لحقتُ به.
- لم أستطع أن أجرِف كلّ شيء، فالثلج حال جليداً قاسياً.
لا مرادف إنكليزياً لِـ "يعطيك العافية"، فأجبتها "نو بروبلم" (لا مشكلة). شكرتها لأنها أخرجتني من صومعتي لتزيح غيوم الثلج من رأسي قبل أن تزيحها كلياً من مدخل البيت. دفعت لها، وأخذت رقم هاتفها واسمها وسجّلت على هاتفي: أوليفيا لجرف الثلوج.
رحلتِ الفتاة وتركتني أفكّر في احتمال أن تكون أوليفيا لصةً مثلاً، تراقبني منذ فترة، وتريد أن يعتاد الجيران وجودها حول المنزل كي تقتحمه في الوقت المناسب دون جلبة. ليتني سألتها عن عنوانها بدقّة! أن أتأقلم أي ألا تعصف بي الأفكار هكذا فأكتب مقالاً كاملاً عن أوليفيا والثلج. ثم من الواضح أن إزاحة بعض السيناريوهات من رأسي ستتطلّب وقتاً، وبعدها سيأتي التأقلم.
رحلت أوليفيا وتركتني أيضاً مع سؤالٍ ملحّ: لماذا لا يتوقّف المهاجرون عن المقارنة؟ ومع جوابٍ لاح لي من النافذة وأنا أراقب الثلج المتراكم في كلّ مكان: لأننا نريد ضمنياً أن نخلص إلى أن بلادنا أفضل وأن احتمال العودة قريب، وإن علمنا يقيناً أن هذا غير صحيح.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


