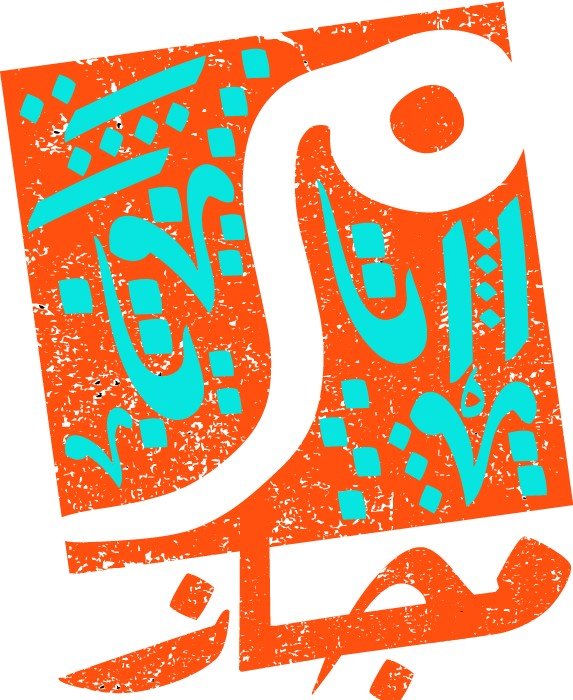
في حديث في إحدى ليالي شتاء القاهرة، كانت الكهرباء مقطوعة، وعلي الاعتراف أن أكثر لحظاتي الحميمة والقريبة من أصدقائي القاهريين كانت في أوقات انقطاع النور. سألني يومها صديقي: "لماذا تركتِ أوروبا واخترت القاهرة؟ أليست أوروبا أكثر أماناً لامرأة وحيدة؟".
امرأة وحيدة
أواجه صعوبة في تقبل أنني الآن امرأة. لم أعد أحمل لقب "فتاة"، فقد تخطيت الخامسة والثلاثين. بصراحة أنا لا أستطيع تمييز الفرق بين الكلمتين، لكن هذا الفرق يترك أثراً ثقيلاً في نفسي، وبالطبع لا أريد الخوض مطلقاً في "وحيدة" هذه، فالموضوع صعب.
فتاة أو امرأة، ما الذي دفعني للتخلي عن مساحة مريحة من الحرية بين برلين ومرسيليا، مقابل العيش في القاهرة؟
كامرأة، لم أضطر في أوروبا إلى تفكير طويل قبل ارتداء ثياب تناسب الحرّ والمجتمع، لم أقلق أثناء عودتي إلى المنزل في وقت متأخر، ولم أتوقع الأسوأ وأنا أمشي وحيدة في الشوارع الفارغة ليلاً. لا أحد يسألني أين كنت ومن يزورني. تعودت خلال 12 عاماً في أوروبا أن أعيش بفردانية واستقلال، بحرية بالدرجة الأولى.
كانت لي قوقعتي: مجموعة صغيرة من الأصدقاء، بيتي، قطتي، ولابتوبي الذي أصبح قطعة مني، يشاركني السرير والطعام والحمام، ويزور معي أصدقائي. وتشكيلتي من الأوراق الثبوتية. يعني، الحاجات الضرورية في حياة لاجئة/فري لانسر تعيش في أوروبا.
اعتدت الانفصال عن المحيط، سماعة الأذن تعزلني عن اللغات التي لا أزال لا أفهم ما بين سطورها، جدار سميك يبعدني عن جارتي العجوز النازية، أصوات عصافير حديقة البناء تشغلني عن سماع صوت أفكاري وهي تسألني عن موعد تجديد الإقامة، وكم المبلغ الذي ستسحبه مصلحة الضرائب هذا الشهر، وحساب ما سيتبقى في رصيدي بعد دفع الإيجار. أسئلة تقليدية يومية لا قيمة لها أمام زقزقة عصفور في حديقة فارغة.
كامرأة، خارج أي سياق، سأفضّل الحياة في برلين، عندي بعض الامتيازات التي تساعدني على النجاة في هذا الكوكب، فلم لا؟
أواجه صعوبة في تقبل أنني الآن امرأة. لم أعد أحمل لقب "فتاة"، فقد تخطيت الخامسة والثلاثين. بصراحة أنا لا أستطيع تمييز الفرق بين الكلمتين، لكن هذا الفرق يترك أثراً ثقيلاً في نفسي، وبالطبع لا أريد الخوض مطلقاً في "وحيدة" هذه، فالموضوع صعب... مجاز
لكن السياق أساسي
انا امرأة، لاجئة، سورية رغم أنني لا أحمل من الأوراق ما يثبت سوريتي إلا وثيقة سفر فرنسية توضح أنني لاجئة سورية مقيمة في فرنسا. حين ستتحوّل هذه الوثيقة إلى جنسية فرنسية أصيلة، ستتسهل حركتي وتتناقص المواقف العنصرية التي أواجهها. سأصبح واحدة أخرى، نفس الاسم والجسم والشكل والحياة والشخصية، لكن بورقة مختلفة، ستفتح لي أبواباً كانت موصدة خلف المطارات، وتستقبلني الآن القاهرة دون أن أدفع مبلغاً وقدره (كذا) كلما دخلت البلاد.
فري لانسر أعاني من القلق والأرق، أنتظر التعوّد على روتين ما ينظم حياتي اليومية، حيث لا تتداخل مواعيد النوم ومواعيد الطعام ومواعيد العمل ومواعيد الملل. وقوة خفية ما تنظم حياتي المالية بما يكفي الإيجار والضرائب والتأمين الصحي والنصف الثاني من الشهر.
في الخامسة والثلاثين، أحاول التعوّد على مستحضرات التجميل والكريمات التي تخفّف الهالات السوداء، أغضّ النظر عن قطعة الجلد المتهدّل أسفل ذقني، يحاول جسمي تذكيري كل يوم بأنني لم أعد في العشرينات. تقلصت حركتي اليومية إلى المسافة بين السرير والكنبة وطاولة العمل، في غرفة في منزل مشترك مع صديقتي، بذلنا جهداً لتحويله إلى بيت أليف يشبه بيوت جداتنا.
وحيدة ومعتزة باستقلاليتي، لأنها العذر الشرعي الوحيد الذي يبرر هذه الوحدة، ومنذ 12 عاماً تعيش أمي في قارة أخرى، وحيدة ومعتزة هي أيضاً. وعلى عكس السائد، تحاول إقناعي بعدم جدوى إنجاب أطفال إلى هذا العالم. بالمناسبة شكراً ماما!
منذ 2011 لم أزر منزل عائلتي إلا في نومي. لطالما كان مسرحاً لكل الأحداث العبثية التي تجري في أحلامي. كنت من المحظوظات القلائل اللواتي تمكنّ من رؤية أفراد عائلتهن كل سنتين أو ثلاث، في كل مرة أكتشف توسع الشرخ بيننا في اختلاف الثقافات والمسافات والأجيال. لطالما قالت لي أمي: "أنت تتغيرين، تصبحين أكثر قسوة وبروداً وتوتراً!". ليس تماماً، بل أعتقد أني أصبح أكثر تعوداً على الفقدان منذ فقدت منزلي.
الإنكليزية هي لغتي الثانية، الفرنسية هي لغتي الثالثة، لكنني لا أزال أحلم بلغتي وأفكر بها، فالصوت في رأسي يستخدم اللغة العربية لتذكيري بأنني يجب أن أتوتر قبل مقابلة موظفة الجنسية يوم الأربعاء القادم، بلكنة سورية بيضاء مشوبة ببعض الكلمات اليومية بلغات أخرى: "انتي مو لازم تكوني حاسة بشوية stress قبل ال entretien الزفت؟ أو خلص تمسحتي؟"
أقول لأمي: "مصر هي المكان الوحيد الذي تشعرين فيه بالسعادة لأنك سورية"
القاهرة 2023
حر شديد، انقطاع الكهرباء في شارع التحرير لم يؤثر على ضجيج الموتوسيكلات والكلاكسات، عربة لقطر السيارات المتوقفة على جانبي الطريق بشكل مخالف، صوت حاد يخترق هذا الضجيج: "بيكيا بيكيا". مهرجان يصدح من عربة خيل، تلاوة خليجية للقرآن قادمة من مضخّمات صوت في افتتاح محل بيع كاميرات مراقبة، حجم المضخمات ضروري كي يميز الزبائن المحتملون المحل الجديد، بين عشرات محلات بيع كاميرات المراقبة في الشارع.
أشتاق لفساتيني الخفيفة التي تمكنت من ارتدائها دون وشاح يغطي كل ما تكشفه، أشتاق للمساحة التي تمنحها لي برلين للتعامل مع جسدي بحرية، وأنا أعرف أن الآخرين لا ينتبهون لفردتي الخفّ المختلفتين اللتين ارتدي. صوتي الداخلي انمحى في أصوات القاهرة، أفهم تمتمة البواب وهو يحسبن على جارتنا النزقة. أسمع عبارة "حمدلله عالسلامة" كل مرة أدخل شارعي بعد مشوار نصف ساعة أو ساعة.
أستيقظ في بعض الليالي بعد حلم سريالي، أرى فيه أمي تصحو من عملية القلب المفتوح وتقف على باب منزلي في برلين، بمحاليلها وصدرها النازف، غاضبة لأني شغلت تلاوة قرآن خليجية في جنازتها في مضخّمات صوت عملاقة. أصحو مذعورة قبل أن أتذكر أن أمي تسكن في نفس البناء الآن، جارتي، هي في الطابق الرابع وأنا في الطابق السابع، كما في أغنية "بحذرك" لصباح خوري. فلا داع للقلق، لن تموت أمي وحيدة في قارة أخرى.
أجتاز غرفة كاملة تفصل بين سريري وطاولة عملي، كل قطعة في غرفة الآن: الكنبة في غرفة، السرير في غرفة ثانية وطاولة العمل في غرفة ثالثة، عدد أكبر من الغرف وعدد أكبر من الأبواب التي سأغلقها على نفسي.
لطالما قالت لي أمي: "أنت تتغيرين، تصبحين أكثر قسوة وبروداً وتوتراً!". ليس تماماً، بل أعتقد أني أصبح أكثر تعوداً على الفقدان منذ فقدت منزلي... مجاز
ضجة شارع التحرير تشعرني بأمان غريب، الساعة الثانية فجراً، الزحام لا يتناقص، بائع متجول يحمل عيون حورس ملونة، ينادي على عيونه: "تعالى اشتري عين حورس، عين الحظ، عين الرزق..". أمرّ بقربه فينادي: "عين السخنة!". تضحكني هذه المعاكسة الذكية التي استخدمت اسم منطقة عين السخنة على ساحل البحر الأحمر.
هنا أنا ما زلت فتاة، أعيش قرب أمي، يسألني البائع عن سني قبل أن يبيعني بيرة ستيلا ليتأكد أني +18، ورغم تأكدي أنه لاحظ خصلة الشعر البيضاء أعلى جبيني، لكنني أستمتع بهذا الإطراء.
لا يأبه الكثيرون لمعرفة من أين أتيت، أقول لأمي: "مصر هي المكان الوحيد الذي تشعرين فيه بالسعادة لأنك سورية". تنزل عن أكتافك هذه اللعنة التي تؤدي في أحسن الأحوال إلى تعاطف يساري متعال مع اللاجئة المسكينة التي احتضناها لأننا نحب الإنسانية. هي كذلك فعلاً، لا أعتقد أني سأكون سعيدة بسوريتي في سوريا كما أنا في مصر.
أعيش في القاهرة لأني أعتقد أن الحياة وظروفها، والأماكن والأشخاص، كلها تجارب نخوضها بكليتّها، متحصنات بتفاصيل صغيرة تحقق لنا بعض التوازن أمام البشاعة. بأننا كلنا ناجون وناجيات، نبحث عن سبل نجاتنا بشكل أو بآخر، في لغاتنا وفي فساتيننا الخفيفة، وزجاجات البيرة المحلية، وبيوتنا المؤقتة، وفي ذاكرتنا وأحبائنا وقواقعنا الضيقة، في أحاديثنا الحميمة التي تفتح الباب أمام أسئلتنا عن ذاتنا. في خطوطنا الحمراء أو في حدودنا المرنة، في عزلتنا أو تأقلمنا. في شخصياتنا التي تتنقل بين المدن والبيوت.
نحن نبحث عن نجاتنا في ألفة الشوارع، وألفة الوجوه، وألفة الكلمات البسيطة التي نفهم ونعيد، في ألفة مشهد بائعة مناديل عجوز تحنو على قطة مشردة.
نحن دائماً نبحث عن نجاتنا. وأنا، إن كنت أنجو، فلأني أجد نجاتي في ألفتي. وللألفة، كما يبدو، وجوه كثيرة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





