قدرُ فلسطين أن تتشكل مسيرة تاريخها التراجيدي من لحظات فارقة، مروية بالدماء، ومصنوعة بمعاناة شعبها. وما أكثر هذه اللحظات المفصلية في تاريخ هذا البلد، الذي أصبح - منذ زمنٍ بعيد- بؤرة صراع، مُفجراً وفاضحاً للعنصرية التي تُمارس ضده، عبر عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية من جانب إسرائيل.
وقد احتل التاريخ السياسي لفلسطين موقع الصدارة في خطابات وكتابات النخبة، وفي السردية الفلسطينية بشكلٍ عام، فيما اندثر واختفى إلى حدٍ بعيد التاريخ الاجتماعي، ولم يأتِ إلينا منه سوى القليل، الذي بالكاد يمنحنا صورة واضحة عن أنماط الحياة في البلد الذي يُقاوم ويُناضل منذ سنوات طويلة ضد الاحتلال وسياساته العنصرية.
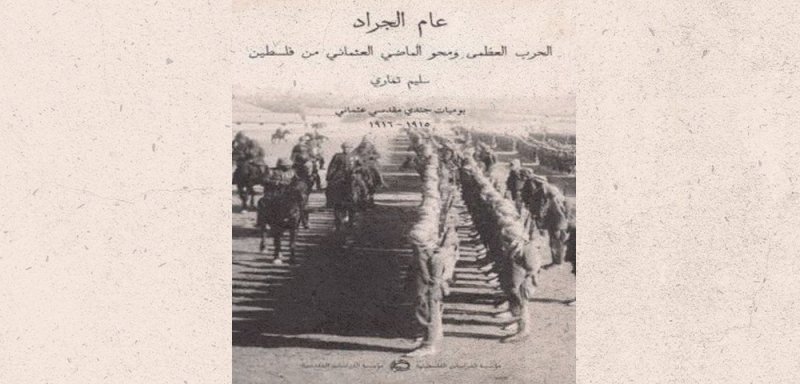 كتاب "عام الجراد... الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين"
كتاب "عام الجراد... الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين"
وقبل الاحتلال الإسرائيلي، كان هناك الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1917، بعد أربعة قرون من الوقوع تحت الحكم العثماني، الذي لم يكن رحيماً هو الآخر، خاصة في فترة الحرب العظمى (1914- 1918)، بل كان وحشياً وقمعياً، بحسب ما كشفته مذكرات المُجند المقدسي إحسان الترجمان، التي دونها لمدة عام في الفترة من عام 1915- 1916، قبل أن يلقى مصرعه على يد أحد الضباط الألبان في عام 1917، عن 25 عاماً، بعد حياة مضطربة ورتيبة في آن.
تأتي أهمية هذه المذكرات التي دونها إحسان في منزله ليلاً على ضوء شمعة بعد انقضاء دوامه اليومي، من أنها تعكس حياة جندي عادي ومواطن مقدسي في إحدى أهم لحظات التحول التاريخي في فلسطين، وهي نهاية أربعة قرون من الحكم العثماني
فبعد إعلان الحكومة العثمانية النفير العام للمشاركة في الحرب العظمى بجوار دول المحور ألمانيا والنمسا عام 1914، جُند إحسان في الجيش العثماني، وذهب إلى جبهات القتال في نابلس والخليل، ثم التحق بالمنزل العسكري في القدس، وعمل مساعد كاتب، وكان هذا العمل بالنسبة للشاب الصغير رتيباً ومملاً، والأمر الآخر، أن التجنيد أجهض أحلامه في التحاقه بالجامعة الأمريكية ببيروت كما كان يطمح، وكذلك دراسة اللغة الفرنسية، وهو ما فجر بداخله الصراعات النفسية، والأسئلة الوجودية حول الجدوى من هذه الحرب التي أخذته من حياته، حتى أنه فكر عدة مرات في الانتحار، خاصة بعد تكالب المصائب على مدينته القدس من انتشار الأوبئة والفقر وهجمات الجراد، والسياسات التعسفية القمعية للحكومة العثمانية.
ومن ناحية أخرى المطاردة العنيفة التي تعرض لها من جانب أحد الضباط المثليين جنسياً، الذي مثل تهديداً مباشراً لحياته، حتى قتله هذا الأخير بعد أن رفضه إحسان، بشكل قاطع، هو الذي كان يتعذب من حبه لجارته ثريا، ومن فشله في الزواج منها، لأنه مجرد عسكري، يقضي وقته "يلعب في شواربه"، بحسب تعبيره.
وفقاً للدراسة التي أعدها المؤرخ الفلسطيني سليم تماري في كتابه "عام الجراد... الحرب العظمى ومحو الماضي العثماني من فلسطين"، وُلد إحسان حسن الصالح الترجمان ونشأ في باحة الحرم المقدسي الشريف سنة 1893، وتجند في الجيش النظامي العثماني في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1914، حيث كانت بداية خدمته في قضاء الخليل ثم نابلس، قبل أن ينتقل إلى أركان القيادة العسكرية في القدس، ويعمل تحت قيادة روشن بك بمنصب مساعد كاتب.
وكانت وظيفته مقصورة على مراجعة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية وتنظيم الملفات داخل بيروقراطية الجيش، وقد سمح له عمله بأن يكون على علم بما يدور من نقاشات وجدل سياسي بين الضباط الموجودين في فلسطين من أتراك وألبان وبلغار وسوريين، وممثلي دول المحور من الضباط الألمان والنمساويين.
كما كان شاهد عيان على المعنويات المنخفضة للجنود بسبب الهزائم المتراكمة بعد سنة 1915، ومن ناحية أخرى كان إحسان متابعاً لإيقاع الحياة الاجتماعية في مدينته القدس، راصداً للتحولات والتغيرات التي تشهدها إثر الحرب التي تخوضها الحكومة العثمانية على عدة جبهات في الأناضول والعراق والسويس. وينتمي الترجمان إلى عائلة مقدسية معروفة، وفرت عدة أجيال من المترجمين من التركية إلى العربية للمحاكم الشرعية وسلك موظفي الدولة، ونتيجة لهذا التخصص عُرفت عائلته "آل الصالح" بدار التُرجمان.
تأتي أهمية هذه المذكرات التي دونها إحسان في منزله ليلاً على ضوء شمعة بعد انقضاء دوامه اليومي، من أنها تعكس حياة جندي عادي ومواطن مقدسي في إحدى أهم لحظات التحول التاريخي في فلسطين، وهي نهاية أربعة قرون من الحكم العثماني، وبداية حقبة جديدة كانت مجهولة آنذاك، عندما أوشك الجيش البريطاني الزاحف من غزة وبئر السبع أن يصل إلى القدس، في الوقت الذي كان الأسطول الإنجليزي يقصف يافا وحيفا من البحر.
بالإضافة إلى ما تكشفه هذه اليوميات من الخراب الذي غطى مدينة القدس في فترة الحرب، فإنها تُمثل إضاءة لنسيج الحياة الاجتماعية وأحوال المرأة على وجه التحديد.
ورغم تعدد سير ومذكرات السياسيين والمفكرين التي وثقت لهذه الحقبة الفاصلة، إلا أن "يوميات الترجمان"، تتميز بتفردها وخصوصيتها، وذلك بسبب الحرية التي تمتع بها صاحبها، من قيود الانتماءات السياسية والأيديولوجية، مما منحه الفرصة ليكون أميناً في رصده وتدوينه لمشاهدات الحياة اليومية، ومن ثم يمكن اعتبار هذه اليوميات -بحسب ما ذكره سليم تماري- بأنها "وحيدة زمانها فهي مشاهدات عسكري بسيط ورؤيته الحميمية لمدينته المحاصرة دونها بأمانة ومتوخياً ألا يراها أحد. وبهذا تُصبح هذه اليوميات سجلاً نادراً للأصوات الشعبية المهمشة- أصوات التابع- التي وصلتنا من الحقبة العثمانية".
والسبب الآخر في تفرد مذكرات إحسان هو أنها عصارة تنقلاته بين عالمين؛ أحدهما عالم خاص بالدوائر السياسية والعسكرية الذي كان على مقربة منها لظروف عمله، والعالم الآخر يكمن في قدرته على رصد المشاهدات اليومية وإيقاع الحياة في مدينته القدس حيث كان يعمل ويُقيم، مما ساعده على اندماجه في الأحداث والمصائب التي حلت على أهل البلدة القديمة، من استشراء الفقر والجوع، بسبب مصادرة الحكومة للمحاصيل الزراعية، وهجمات الجراد التي غزت المدينة في عام 1915، وما أدت إليه من تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والتيفوس، والجدري، والملاريا وغيرها، والتي حصدت مئات الأرواح. أما الجوع والفقر فقد شكلا صورة أخرى لمدينة القدس كما رصد إحسان في مذكراته حيث يقول:" أصبحت القدس مدينة التسول. المتسولون ينتشرون في جميع الأنحاء، يمدون أياديهم للمارة. والجوع يصل بأنيابه إلى الأسر المستورة، فبيتنا ظل خالياً من الخبز لعدة أيام".
ونتيجة للفقر الذي استشرى في مدينة القدس، يذكر إحسان أن النساء مارست البغاء، فكن يقفن في الطرقات ليبعن أنفسهن للرجال مقابل ما يسد رمقهن، وكانت هذه السلوكيات، مصدراً للألم النفسي العميق لدى الكاتب، الذي يُشير إلى أن السلطة العسكرية قد توسعت في إنشاء دور البغاء منذ اندلاع الحرب العظمى، لإدخال البهجة على الجنود والضباط الذين يعيشون بعيداً عن بيوتهم. هذا بالإضافة إلى أعمال السخرة من حفر الطرق، وجمع القمامة من الشوارع، وأعمال البناء الشاقة، التي خصت بها السلطات العثمانية "اليهود والمسيحيين" على وجه التحديد.
كل ذلك كان يتم تحت رقابة السلطة العثمانية القمعية التي لم تتوان في إعدام المعارضين لسياستها في ساحات القدس، وقد رأى إحسان بنفسه إثنين من الجنود العرب، الذين تم إعدامهم في الشارع، بذريعة أنهما جاسوسان لدى الإنجليز. هذه المآسي التي تجسدت بضراوة في القدس، جعلت الكاتب شديد النقمة على السياسات العثمانية، تفيض يومياته بمعاداته الشرسة للقادة الأتراك، حتى أنه يصف أحدهم وهو (جمال باشا)، قائد الجيش الرابع في سوريا، بـ "أحقر إنسان على وجه الأرض، يكفي أنه تزوج من مومس يهودية".
 إحسان الترجمان
إحسان الترجمان
كما كان الترجمان يسعد بهزائم الجيش العثماني ويتمنى سحقه، بالأحرى يتمنى أن ينتهي هذا الكابوس العثماني الجاثم على نفوس العرب. وفي هذه الفترة كان النقاش محتدماً في أوساط النخبة الثقافية والسياسية العربية حول مصير فلسطين بعد انتهاء الحرب؛ فهناك من أيد الاتحاد الفلسطيني المصري، وآخرون رأوا أن الأفضل هو تواصل الامتداد الفلسطيني مع بلاد الشام (سوريا)، وعلى جانب آخر، كان هناك ارتباك في موقف الكثيرين من الاستقلال الفلسطيني عن الدولة العثمانية، غير أن الانتداب البريطاني قد وضع حداً لهذا الجدل في عام 1917.
وكما كان إحسان الترجمان يصب لعناته على العثمانيين، كان كذلك إزاء العرب، فعلى مدار يومياته، يصفهم "بالعبيد الأذلاء، الذين يرضخون لهذه السلطة القمعية ولا يتفوهون بكلمة"، ولذا كان مؤيداً للثورة العربية في الحجاز بقيادة الشريف حسين، آملاً في التخلص من العثمانيين.
ولم يكن هذا الموقف المؤيد للثورة العربية من جانب الكاتب، نابعاً من حس قومي عروبي، بقدر ما كان معبراً عن كرهه للسلطة العثمانية، فإحسان، كان علمانياً، نقرأ له في إحدى يومياته:"أنا لست مواطناً عثمانياً إلا بالاسم فقط، فوطني هو العالم. أنا فرد من أفراد هذه الإنسانية"، وهذا الاتجاه العلماني، ترسخ لديه عبر تأثره الكبير بأفكار صديقه وأستاذه الكاتب خليل السكاكيني، الذي كتب ذلك نصاً في أحد مؤلفاته، وهي العبارات التي تسللت إلى مذكرات الشاب الصغير.
وبالإضافة لتأثيرات السكاكيني، فإن الكاتب - بحسب سليم تماري- " درس في مدارس علمانية في القدس. فرغم نشأته في أسرة متحفظة، إلا أنها منحته فرصة للانعتاق، والتحرر و(الفردية)، التي نمت في فترة الحرب العظمى، كأحد إفرازات الحداثة".
تتميز "يوميات الترجمان"، بتفردها وخصوصيتها، وذلك بسبب الحرية التي تمتع بها صاحبها، من قيود الانتماءات السياسية والأيديولوجية، مما منحه الفرصة ليكون أميناً في رصده وتدوينه لمشاهدات الحياة اليومية
بالإضافة إلى ما تكشفه هذه اليوميات من الخراب الذي غطى مدينة القدس في فترة الحرب، فإنها تُمثل إضاءة لنسيج الحياة الاجتماعية وأحوال المرأة على وجه التحديد، حيث خرجت عدد كبير من نساء الطبقة المتوسطة للعمل، وقمن بخلع الحجاب، وكان الكاتب دائم التفكير في قضايا المرأة ومن أشد المؤيدين لكتابات قاسم أمين التي دعت وحرضت على حصول المرأة على حريتها: "تكلمتُ مع حلمي أفندي الحسيني عن المرأة المسلمة وعن إصلاحها وقلت له يجب الآن تعليمها وتربيتها ثم تركها لتعتني بنفسها وقد قلتُ أيضاً بأن الحجاب هو المانع لترقيتها".
وبالعودة إلى دراسة سليم تماري المهمة، نجد أنه يُعالج تأثير الحرب العظمى من خلال مستويين؛ مستوى بلورة الهوية الوطنية القومية، ومستوى استبطان تجربة الحداثة في أحاسيس الناس. وفي حين ذكر الباحث أن مظاهر الحداثة قد عبرت عن وجودها بشكل واضح وقوي، إلا أنه رأى أن "التعبير عن الهوية الوطنية كانتماء متعد على الارتباطات المحلية، كان هلامياً ومجرداً".
وفي هذا السياق رأى تماري أن "عصر البراءة"، السابق للحرب، هيمن على طيف الأفكار المثالية التي حملها الترجمان من مواقفه الناقدة للقومية، والمساندة للنساء، والمتضامنة مع الفقراء، مشيراً إلى أن هذه الأفكار تشع بإنسانية هلامية مبتورة عن أي التزام أيديولوجي تجاه الأفكار الاشتراكية أو القومية أو الدينية التي كانت منتشرة في زمنه "كان إحسان متحرراً من إطار فكري ضابط. ربما بسبب طبيعة تربيته الانتقائية، أو في الغالب نتيجة انتصار إيمانه بمفاهيم إنسانية مجردة تشوبها البراءة الساذجة، كما كان الحال مع اثنين من مفكري جيله: خليل السكاكيني وميخائيل نعيمة، فيلسوف الفريكة، وهو تيار فكري لم يكتب له أن يعيش طويلاً".
في الثامن عشر من آب/أغسطس عام 1916، توقفت يوميات إحسان الترجمان، وكان آخر ما دونه يدور حول مطاردات وتهديد الضابط له بالقتل، بسبب رفضه له. ويذكر سليم تماري أن أحد أفراد أسرة الترجمان، قد أخبره أن إحسان قد قُتل على يد ضابط قبيل انسحاب الجيش العثماني من القدس ودخول قوات الاحتلال بقيادة اللنبي في التاسع من كانون الأول/ديسمبر عام 1917.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


