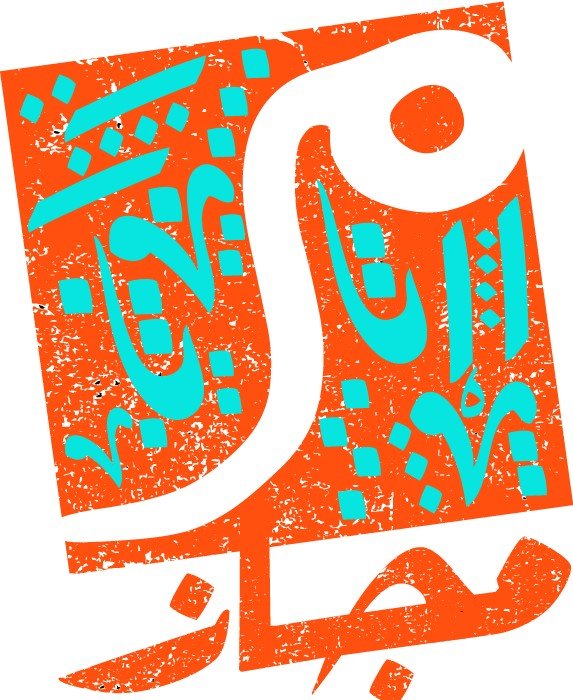
يجب أن أصحو! فتحتُ عيني، أغلقتهما، فتحتهما، وهكذا. أخذت أكرّر الأمر لعلني أقاوم الضعف الذي يعتريني، لكن ذلك النور الساطع في الغرفة يثير جنوني! فأغلقتهما مجدداً.
هل يريحني الظلام أكثر؟ لاأدري. أعتقد أنني في وضع لا يسمح لي بالبحث عن أجوبة، فالأصوات لا ترحمني، تحيطني الأجهزة من كل جانب، صوت إنذار متقطع يشبه دقات القلب، ثم أنين وحركة سريعة، بالطو أبيض يقترب، يتأكد أنني أقاوم غفلتي، فأفتح عيني تماماً: "سيدة علياء، هل تسمعينني؟".
أهز رأسي بإرهاق، فيغلق الطبيب باب الغرفة ويجلس أمامي: "أتى بك الجيران إلى هنا، هل تذكرين ما حدث؟". حملقت بوجهه صامتة، فأنا أسأل ذات السؤال! يتنهد ثم يقول باستغراب: "لماذا فعلت ذلك؟ هل جربتي فعلها من قبل ولم تفلح؟ أعني أنه غريب. امرأة في مثل عمرك تحاول الانتحار!".
سأعترف له بكل شيء، لكن على الورق. لا يمكنني إرسال تلك الرسالة، أشعر أنني مقيدة بداخل جسد مانيكان، صلب، متماسك، لا يمكنه الانحناء حتى لا ينكسر، ولهذا أفضّل الادعاء، رغم أنني فارغة من الداخل، فارغة تماماً... مجاز
امرأة في مثل عمري! نعم، تذكرت الآن.. فأنا تلك المرأة التي أكملت التاسعة والخمسين منذ يومين، وتبدلت حياتها منذ ثلاث سنوات، انفصل عنها زوجها فجأة، تاركاً علبة شيكولاتة ورسالة أخيرة فوق السرير، ذلك السرير الذي جمعني معه لثلاثين عاماً. كفى. الأرقام تتعارك في رأسي، ترغمني على تذكّر كل ما تركته خلفي، مُدعية بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وها أنا، المحلول معلق بجانبي، تتسارع نقاطه لتداخل في جسدي، جسدي الراقد فوق سرير مستشفى.
يباغتني سؤاله فجأة: "أيمكنني التحدث مع أحدهم؟ أي شخص قريب. أنا قلق أن تُقدمي على الانتحار ثانية".
‑ "لم أفعل"
‑ "حقاً! أتعني أنك نسيت ثلاث شعلات من البوتاجاز مفتوحة دون قصد؟!".
أصمت طويلاً ثم أقولها بشفاه مرتعشة: "لقد أخطأت". يهز رأسه بسخرية، ثم يطلب مني أن أبقى معهم الليلة ليطمئنوا على حالتي.. لكني لم أستطع، وفور خروجه، تحرّرت من كل شيء، هرولت من طرقة إلى أخرى، لم يشعر بي أحد، فالهروب هو نقطة قوتي كما اعتاد أن يخبرني. الفرار من كل موقف، لحظة، فعل. الفرار من الحياة ذاتها. هواية أمارسها منذ وقت طويل، حتى أصل إلى بيتي، ملجأي، مربع الوحدة الذي يحتويني، أو ربما دائرة، أدور وألف فيها حول نفسي حتى يُغشى عليّ.
لم تعد تعجبني اللعبة، فأنهض مسرعة إلى مرآتي الوحيدة. لقد كسرتها بالأمس، وقرّرت اليوم أن أجمع شظاياها لأتأكد أنني لم أجنّ بعد. صحيح أن التجاعيد زحفت على وجهي ورقبتي، لكني مازلت مثالية. مهلاً... ربما هنا بالتحديد تكمن المشكلة.
اليوم فهمت كل شيء.
حينها لم أفهم، لأنه قرّر الانفصال دون إخباري حتى. أذكر وقتها أننا كنا نأخذ فطارنا كالمعتاد، ثم اقترح أن نلعب لعبة، وقال: "انتي تشبهين الدوم كثيراً ،كيف لم ألاحظ ذلك كل تلك الأعوام؟!" فنظرت له وتأملت قميصه المنقط، ثم قلت سريعاً: "وأنت تشبه السلحفاة". ضحكت بسخرية وأطبق علينا صمت طويل، حتى قطعه بسؤاله: "ماذا تعنين بأنني سلحفاة؟"
‑ "لا شيء. فقط قميص"
وقاطعني مسرعاً: "أتعني أنني بطئ وممل، وأختبئ في صدفتي كلما حانت لي الفرصة!"
‑ "ماذا!؟ لا.. لم أعن ذلك!"
‑ "إذن أخبريني ما قصدك ببساطة"
‑ "لا شيء! كنا نلعب فقط. أنت أخبرتني بأنني دوم ولم أتصرف كالأطفال مثلك!"
‑ "لأنك تحبين الدوم، لو كنت جرحتك فأنا أعتذر"
‑ "جيد"
‑ "اعتذري إذن!"
رمقته بسخرية وتركت له الغرفة كلها، وفي اليوم التالي لملم أشياءه ورحل. قرأت رسالته مراراً، وطُبعت حروفها في عقلي ،لكني لم أدركها إلا الآن.
"... ما العيب في أن يعترف أحدهم بأنه أخطأ؟ عشتُ مع هذا الحِمل، حتى وهنت أكتافي وكان لابد أن أتخلص منه. حتى وإن كان الثمن أن أعيش في نهاية حياتي كرجل عجوز وحيد تماماً، ولا تصدقي أن الدوم والسلحفاة هما السبب، فأنا لست طفلاً كما قلت، بل كانت حيلة أخيرة مني حتى أجعلك تفهمين بأنني أستحق اعتذاراً، لكنك لم تفعليها أبداً، بل أنا الذي عاش ثلاثين عاماً يُهدّئ الوضع، يمرّر الأمور، يتلفت حوله، يصمت طويلاً، حتى أدركتُ في النهاية أنني كنت أمرّر الحياة، وها هي قد فاتت.
تزوجت ابنتنا وسافر ابننا، ولم يعد أحد في هذا المنزل يحتاجني. أنا وأنت تفصلنا مسافة طويلة، على أحد منا أن يقطعها في أي اتجاه، وأنا اخترت الاتجاه المعاكس. أنا حر يا علياء.
ملحوظة: الشيكولاتة تعني بأنني لم أكرهك أبداً، لكن لم يعد بإمكاني أن أبقى بجوارك أكثر من ذلك. سأنقذ ما تبقى مني"
هكذا ببساطة أنقذ نفسه مني. عشت حياتي كلها وأنا مجرّد فخ! وكنت أول من وقع فيه، فلم تكن ملامحي الجامدة صدفة! لكنها كانت روحي، عذبتها معي، ولم أتهاون أبداً ، فهو من يقترب، يحب، يعتذر، يهتم، يطيب الجرح، يجبر الكسر، حتى اعتدت الأمر. كأننا حبلان، أحدهما مرخي والآخر مشدود، لكنه قرر أن يرتخي تماماً حتى انقطع.
أنا تلك المرأة التي أكملت التاسعة والخمسين منذ يومين، وتبدلت حياتها منذ ثلاث سنوات، انفصل عنها زوجها فجأة، تاركاً علبة شيكولاتة ورسالة أخيرة فوق السرير، ذلك السرير الذي جمعني معه لثلاثين عاماً... مجاز
كيف لم أر كل ذلك؟ أهذا يعني أن الظلام يريحني أكثر بالفعل؟ أريد الخروج. ولو كان أمامي لكنت أخبرته كل شيء دون هروب. بماذا أخبره؟ لا! لن أخبره شيئاً، سيظن أنني أحتاجه، ولما لا؟ دعيه يظن ذلك. قولي مثلاً: "أتدري؟ لقد رأيت وجهك اليوم.
أتذكر حينما كنت تقول: يجب أن نكتب لك ورقة على البوتاجاز حتى تغلقي الشعلة! ستخنقينا جميعاً ذات يوم. لكنني كنت أغرق دوماً في نسياني وإهمالي، حتى كدت أقتل نفسي هذا الصباح، ولم يصدق الطبيب بأنني نسيت، وحالتي مشكوك فيها.
أعني امرأة على مشارف الستين، وحيدة تماماً في منزل واسع يذكرها بالفراغ الذي يحيطها. بالطبع ستُقدم على الانتحار حتى ينتهي أمرها، لكني حقاً لم أفعل يا توفيق، وقلتها، تردّدت قليلاً لكني اعترفت بأنني أخطأت، ولهذا تذكرتك.
السنوات الفائتة جعلتني أعي وجودك. لقد كنت تملأ زوايا المنزل، ومنذ رحيلك وأنا أبحث جاهدة. لكنك تعرفني: أتجنّب الاعتراف، ولهذا فضّلت أن ألعب لعبتي المعتادة: الإلهاء. أُلهي نفسي بالعمل، ونظافة المنزل، ومحادثة ابننا، وزيارة ابنتنا، وحينما تأتي سيرتك، أسألها: ما أخبار والدك؟ بخير؟ اطمئني عليه دوماً. أتظاهر بأنني لا أهتم، وكل شيء على ما يرام، فأضاعف من ساعات العمل، أعدو في الطرقات، أهرول، أدخن، أتبع حمية غذائية، أقفز في حمام السباحة غير مبالية، أحتضن المياه وتجذبني إلى الأسفل، لا أقاومها. أرتخي وأصل إلى العمق. أتحرّر تماماً، وحينها تصرخ إحداهن: امرأة عجوز تغرق... لكني أطفو على السطح، وأتذكرك.
بعدما أحرقت بعض صورك، ندمت، فخبأت البعض الآخرفي درج قديم ومهمل، ثم أغلقت عليهم بالمفتاح، لكني احتفظت بالمفتاح تحت وسادتي. حاولت محوك من ذاكرتي، لكنك أبيت أن تتزحزح.
هل مازلت تذكرني يا توفيق؟
كل ما هنالك أنني اكتشفت بأنك كنت على حق. لقد تركت الشعلة مفتوحة لسنوات طوال، تسرب الغاز وأحاط المنزل وكاد أن يخنقكم، لكنكم نجوتم، تحررتم الواحد تلو الآخر، ومازلت أنا قابعه هنا، فقررت أن أفتح النوافذ، ولهذا أدين لك باعتذار.
سامحني لأنني لم أفهمك، لم أقدرك، لم أحبك كما تستحق لأنك في الحقيقة تستحق يا توفيق".
هكذا سأعترف له بكل شيء، لكن على الورق. لا يمكنني إرسال تلك الرسالة، أشعر أنني مقيدة بداخل جسد مانيكان، صلب، متماسك، لا يمكنه الانحناء حتى لا ينكسر، ولهذا أفضّل الادعاء، رغم أنني فارغة من الداخل، فارغة تماماً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


