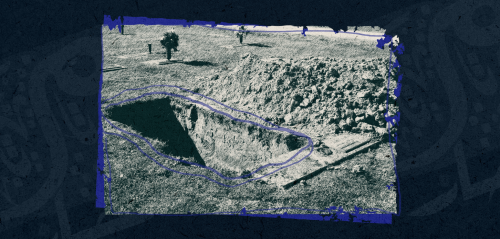نحن، كشعوب بسيطة تؤمن بأنّ التفوّه ببعض الكلمات قادر على جذبها وتحقيقها، لطالما كان شبح كلمة "الموت" مثيراً لقلقنا، فتجنّبنا باستمرار لفظها بلا مناسبة وتعوّذنا من الموت مردّدين "بعيد الشرّ/بعيد من هون" إن اضطررنا على الإتيان على ذكره. لست أقصد الاستهانة بالموت أو فقدان الأحبة، لكنني تعلمت مع الزمن أننا بتكتّمنا وتحاشينا حديث الموت منحناه سلطةً أكبر مما يحتمله، إذا ما قارناه مع آلامنا الوجودية التي نقاسيها وموت آمالنا بينما نضطر على مواصلة الادّعاء بأننا على قيد الحياة. ثم إننا مهما تفادينا حديث الموت، إلا أن الكل قد ابتلي، مرةً على الأقل، وفقد عزيزاً، وهكذا جمّعنا تجاربنا المختلفة التي شكّلت موقفنا منه ومن مراسيمه.
في اللّغة الألمانية تسمّى المقبرة، لو أردنا ترجمتها، حرفيّاً بـ"فناء السلام". تسمية تحوي قدْراً عظيماً من التّصالح مع فكرة الموت وتقبلها، يدركه على الأخصّ أولئك الذين لم يعرفوا غير "المقبرة" اسماً للمكان الذي يوارى فيه أحبّاؤهم بعد مفارقتهم الحياة.
لا يغيب عن ذاكرتي وصول خبر وفاة جارنا في دمشق وأنا ابنة السادسة. في مشهد مفزع جاؤوا حينها بأخته إلى بيتنا منهارةً لسماعها النبأ المفاجئ. على مرأى من الكبير والصغير، كانت تلْطم نفسها وهي ترثيه، ثمّ غرزت أظافرها في وجهها فنفر الدّم على شكل خطوط من خدّيها. صحيح أن والدتي نهرتنا أنا وإخوتي عن المكان وأوصتنا بملازمة غرفتنا، بيد أنّ نحيب تلك المرأة المذعور اخترق الجدران والأبواب، ليصير إحدى أشد ذكرياتي اضطراباً فيما بعد.
لا أستغرب غياب حزن الرجال عن ذاكرتي، فغالباً ما كان الكرْب في بلادنا من نصيب النساء وحدهنّ، لأن الرجال كانوا معصومين أو منهيّين عنه
عرفت المقبرة في صغري مكاناً مهيباً، مسكوناً بمخلوقات كالجنّ والعفاريت في اللّيل، كما صوّرتها أفلام الرعب قديماً، جوّها بارد والقبور فيها باهتة مغبرّة وتكسيها الأشواك. قضيت كلّ عام في ليالي الصيف الحلوة العليلة في قريتي مع أبناء وبنات عمومتي، خلال سهراتنا على الأسرة الحديدية الشاهقة، المضاءة بضحكاتنا والنجوم، كنت أنصت بإمعان لهم وهم يحكون ما سمعوه من قصص عن الموتى وكيفية موتهم، في سرديات ميتافيزيقية غير قابلة للتفسير.
كنا نحب أن نعزز مخيّلتنا عبر المشاهدة الحيّة للقبور، فنجتاز مقبرة القرية أحياناً قبل غروب الشمس، وقت كان يسمح لنا بالخروج للّعب، متناسين خوف الليالي وقصصها المرعبة. ماض يشبه حلماً، جرى في أزمنة كان الموت عندها ظاهرةً نادرة، ما جعلها مثيرةً أكثر لاهتمامنا.
لم أكنْ أتجاوز الحادية عشر من عمري حين توفّي جدّي، لتكون أول مواجهة حقيقية مع وقوع حدث الموت في حياتي. سافرنا ليلاً من دمشق نحو القامشلي مع الأقارب في باص بولمان بالكاد اتّسع للجميع، وأوضح ما أذكره هو صوت النحيب المتزامن مع شريط لتلاوة القرآن لم يتوقف عن الدوران لدقيقة واحدة. دُفن جدي في مقبرة قرية "حلوة الشيخ" التي كانتْ ثاني مقبرة أزورها في حياتي. تم أخذنا إليها، نحن الأطفال، برفقة النساء، في اليوم الرّابع بعد وفاته لزيارته. بدا لي المكان أشبه بساحة سريالية، تيّار الأحداث فيها يجرفني ولا يمهلني وقتاً حتى أستوعب ما يجري، إذ جرّتني جدّتي معها إلى مزار شيخ حلوة، حيث طافتْ حول قبره مقبّلةً شاهدته عدة مرات. قامتْ ابنة عمي بالحركات ذاتها، لألحق بهما في شيء من التقليد الأعمى.
سير الوقائع على هذه السّجيّة جعل الموت وذكره يرتبطان لديّ بمشاهد وسلوكيّات هستيرية تصل فيها النساء إلى لطم أنفسهنّ حزناً. اليوم، لا أستغرب غياب حزن الرجال عن ذاكرتي، فغالباً ما كان الكرْب في بلادنا من نصيب النساء وحدهنّ، لأن الرجال كانوا معصومين أو منهيّين عنه. لم تتسع البيوت الطينية الصغيرة لأفواج المعزّين، فكانت العادة أن يقام العزاء في خيم كبيرة. كانت الخيمة المخصّصة للرجال هادئة نسبياً، بينما كان نحيب النسوة يصلنا نحن الأطفال، مجتازاً خيمة العزاء وأبواب البيت المغلقة، إذ بدأتْ كلّ منهنّ حفلة الهذيان في اللحظة التي تقترب فيها السّيارة التي تركبها من حدود القرية.
امتنعتْ جدّتي عن الغلوّ في التعبير عن حزنها بالنواح واللطم، التزاماً منها بتعليمات أبنائها، لأنه كان فعلاً مكروهاً بالنسبة لهم، لكنّي أذكر بوضوح عدة نساء عرفن آنذاك بهذا السّلوك، وما إن كانت تقبل إحداهنّ على العزاء حتى ردّد الموجودون اسمها معلنين جميعاً إدراكهم لوصولها.
من مظاهر المبالغة في الحداد، هو أنّنا إذا حزنّا على ميت احتجنا أن نبرهن على أسفنا بالسّواد الذي نتلحّفه شهوراً، والامتناع عن سماع الموسيقا أو مشاهدة التلفاز أو حضور أي مناسبة أو التعبير بأي شكل كان عن عودة الحياة لطبيعتها. الشيء الوحيد المباح لنا كان صوت تلاوة القرآن الصّادر من المسجلة بالتحديد، وكأنّ مصائبنا احتاجت تأكيداً ما!
لم أستمع في حياتي لهذا القدر من القرآن كما عند حدوث وفاة جدّي، آيات عن الموت والآخرة والجزاء... إلخ، آيات يفترض بها أن تصبّر على الموت، تحوّلتْ وقتها بالنسبة لي، نتيجة لما شهدته، إلى نذير للموت نفسه
لم أستمع في حياتي لهذا القدر من القرآن كما عند حدوث وفاة جدّي، آيات عن الموت والآخرة والجزاء... إلخ، آيات يفترض بها أن تصبّر على الموت، تحوّلتْ وقتها بالنسبة لي، نتيجة لما شهدته، إلى نذير للموت نفسه.
كلّ هذا كان في زمن أمكن فيه إقامة العزاءات المطوّلة، والأهم من هذا: الحصول على قبر، فبعد قيام الثورة السورية صار وصول جثمان أحدهم للمقبرة بمثابة نجاة، حظ جيد، وربّما امتياز. أذكر جيداً جارةً لنا في الشام وهي تسرّ إلينا بما رأته من نافذتها فجر أحد الأيام بعد اندلاع الحرب، حين أفرغتْ شاحنة حمولتها من الجثث على حافة الطريق السريع المجاور لبيتنا، لتضرم النار فيها وتتركها تتفحّم.
توضح الأمر لنا، إنها رائحة الأجساد المحترقة التي اجتاحتْ رئة حيّنا، بل أحياء المدينة أجمع. تلك الرائحة في أنف المرء، تلك الصورة في رأسه، ذكرى، شبح يسكن داخل الأضلع لا يقوى حتى على الصّراخ، من بعدها تستعصي الحياة على المرء، ويرقب الأشياء كلّها بعين معتلّة، عين مهزومة.
إثر التّهجير والنّزوح واللّجوء الذي طال الفئة الأكبر من السوريين، ما عاد بوسع معظمنا زيارة قبور الذين أحببناهم، هذا إن وجدتْ. تبعثرنا أحياء وموتى في شتّى بحور وبقاع الأرض، طامحين للاجتماع ولو مرةً بمن يعنينا وجودهم وحالمين بلقاء أخير ربّما.
قبل عام، كانت نزهتي الأولى مع عائلة بدأت العمل في رعاية أطفالها إلى المقبرة، بالأحرى "فناء السلام". سألتْ الأمّ بناتها إن كنّ يردن اللعب هناك بجانب قبر جدّهنّ، فأجبن بحماس بالغ بالإيجاب. في الحقيقة ابتسمت في داخلي، نظراً للمفارقة بين موقفهنّ وموقفي كطفلة من المقابر. يذكّرني بهاء مقابرهم بمتنزّهاتنا الوطنيّة، فقد كانت زيارة المقبرة مجدّداً أشبه منها بزيارة إلى حديقة. شعرت بأنّي دخلت حديقة تشرين في دمشق منذ إدراكي مدخل الفناء، ولازمني هذا الإحساس طوال بقائنا هناك، وأنا أمسح بعينيّ القبور المتمايزة بتصميماتها والمزينة بورود وتماثيل غالباً في أشكال ملائكة مصغّرة. رأيت الصغيرة تقترب من بركة تتوسّط الفناء، تنحني لتلمس سطح الماء، فركضت إليها خوفاً من أن تفقد توازنها.
إنّ التّصالح مع فكرة "الموت كوصول" ومع المقابر كمحطّة حياتيّة لا بدّ منها، أخذ مني وقتاً لا بأس به، استمرّ سنيناً في الحقيقة. لم يحدثْ ذلك إلا بعد وصولي إلى ألمانيا، وزياراتي المتكرّرة لقبر زوج امرأة سكنت في منزلها. مرّة شهرياً كانت تزوره بكامل أناقتها برفقة زوجها الثاني، والذي كان يحمل بدوره العدّة اللازمة لتشذيب الشجيرات التي تغطي قبر الأول.
لا أصدق أن الحزن على فقد يصل إلى نهاية، فغياب أحبائنا المادي لا يعني غيابهم عن قلوبنا أو أن أثرهم فينا توقف عن الامتداد، لنا حرية أن نواصل ذكرهم كلما احتجنا أن نعاود الرثاء، ولنا أن نستعيد ذكرياتنا الأليمة والسعيدة معهم
من كثرة ما حدّثتني عنه عبر الأيام، بدا لي إنساناً مألوفاً وكأنني عرفته بنفسي. كانتْ خلال الزيارة تستذكر بالطبع إحدى القصص الوفيرة عنه، ويكتسب صوتها نبرة تحتوي محبةً وحنيناً وطمأنينةً أيضاً، فأشعر به كأنما هو بيننا، ولا أخاف. المقبرة كانت مسوّرة بالأشجار، بعيدة عن صخب المباني السّكنية في قاع المدينة، لا ازدحام ولا ما يبعث على الضّيق فيها، إذ للكلّ مساحته التي تكفيه حتى يزْفر ما شهقه من هواء الحياة الملوث بالعبث.
إن الغرض من وجود المقابر هو الطمأنة أولاً ومن ثم المواساة، فأن نعلم بمكان رقود أحبائنا وإمكانية زيارتهم والحديث إليهم وقتما نشاء، هو لجزء مهم وداعم في مرحلة الحزن ـ التي لا تقاس بزمن أو بسلوكيات معينة. نعمة حُرمنا منها نحن السوريين وكل الشعوب التي تجرّعت أسن التغريب والمسافات، لكن على الرغم من كلّ ما أصابنا، لا يمكن لشيء سلبنا حقّنا في أن نحزن على خسارة أحد بالشكل الذي نشاء، من دون أن نتّهم بمغالاة أو تقصير، ومهما استغرق حزننا من أمد.
إنني بطبيعة الحال لا أصدق أن الحزن على فقد يصل إلى نهاية، فغياب أحبائنا المادي لا يعني غيابهم عن قلوبنا أو أن أثرهم فينا توقف عن الامتداد، ثمّ إن تذكرهم لا يجب أن يقتصر مثلاً على سنوية وفاتهم فقط. لنا حرية أن نواصل ذكرهم كلما احتجنا أن نعاود الرثاء، ولنا أن نستعيد ذكرياتنا الأليمة والسعيدة معهم، وحتى الاحتفال بأعيادهم، كما تفعل صديقتي مع عائلتها كلما أتى عيد ميلاد أبيها المتوفى منذ أكثر من تسعة عشر عاماً، وأخيها الشاب الذي وقع ضحيةً للحرب أول اندلاعها.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.