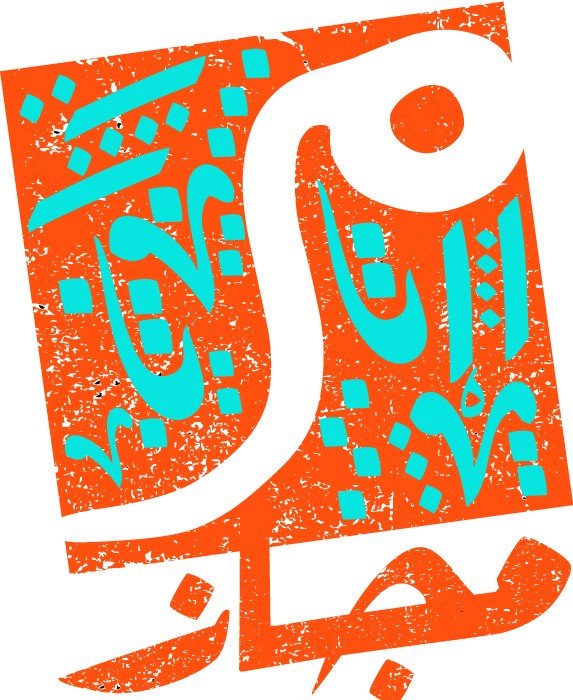في روايتي اليتيمة "نجم وسارة"، يصنع بطل القصة اليتيم "ديب" فيلم بورنو من مجموعة مقاطع يجدها على كمبيوتر ابن عمه، ليكتشف بعد سنوات أن ذلك الشريط جاب نصف بيوت القرية، وأنه أوّل عمل يفعله في حياته يجد صدى جيداً.
لن أتوقف طويلاً حول تلك القصة، التي هي بالتأكيد قد حصلت كثيراً، وبطرائق مختلفة وأماكن شتّى، ولا أنكر حدوث أشياء تُشبهها معي، وإلا من أين أتت تلك الفكرة؟
ما أريد التوقف عنده أمر آخر، حقيقي جداً، وبسيط جداً: كنتُ في منزلي وحيداً، أتصفّح الإنترنت مساءً، في بداية سنوات الحرب السورية، عندما قُرع جرس الباب، ووجدت أمامي اثنين من أصدقاء قريب لي، وقد أخبر أحدهما الآخر أنه يستطيع الحصول على مقاطع جنسية من عندي.
في تلك الأيام، كانت الكهرباء نادرة، والإنترنت مرتفع الثمن، حتى أنك تضطر للانتظار وقتاً طويلاً لتحصل على أفلام عادية، أي هوليود وبوليود أو حتى هاني رمزي، وطبعاً لم يكن يكترث بالأفلام أحد، فقد كانت الحرب جديدة، وهي الفيلم الرائج، لكن أفلام البورنو ليست أفلاماً عادية؛ إنها خبرات أجيال تُسلِّمها لغيرها.
في روايتي اليتيمة "نجم وسارة"، يصنع بطل القصة اليتيم "ديب" فيلم بورنو من مجموعة مقاطع يجدها على كمبيوتر ابن عمه، ليكتشف بعد سنوات أن ذلك الشريط جاب نصف بيوت القرية، وأنه أوّل عمل يفعله في حياته يجد صدى جيداً... مجاز
هواة يجمعون مجموعات ويعطونها لغيرهم، ودائماً تجد من يحافظ عليها كثيراً، ويحميها من الضياع لسنوات... لذا، منذ انتشار الكمبيوترات، الأفلام متوفرة كثيراً. وفي الوقت نفسه، إنها نادرة جداً ومطلوبة؛ مثل قط شرودنغر، الفيلم موجود وغير موجود دوماً.
أمام هذه الحتميات النسبية، لم يتردّد الشاب الثاني بتصديق الأول، وجاء معه مباشرةً ليسألاني عن هذا الأمر. وطبعاً أنكرتُ مباشرةً، وعندما ألحَّ الأول بالسؤال، وكان الثاني خجولاً متردداً، أكّدتُ بالرفض.
كنتُ وقتها أمام كارثة، فلو أعطيتُه الفيلم لأصبحت قضية امتلاكي له معروفة، على نطاق واسع. ولا أعرف من قد يطرق بابي في أي وقت للحصول عليه. وطبعاً، ليس هذا ما يخيف فقط، فأن يأتي أحد ما ليطلبه بعد فترة – كما يحدث الآن – ليس بالأمر الجلل، وأستطيع التصرف وقتها كما أشاء، حتى إن كان من يريد الفيلم متأكداً من امتلاكي له، سأقول ببساطة: "حذفته".
نعم، ليس هذا سبب الرفض. الأمر الذي جعلني أرفض مباشرةً وقتها، دون حتى أن أفكِّر بالأمر، أو أحس بشعور الشاب الثاني الذي اختار في ذلك اليوم أن يقصدني شخصياً، هو الخوف على سمعتي التافهة، فطبعاً لا أريد أن تعرف البلدة كلها أنني أملك أفلام بورنو.
كانت القصة ستمر بسلام وتُنسى، لو لم يُقتل الشاب الثاني في اليوم التالي. ولن أتحدث عن سبب مقتله، ومع من كان أو ضد من، فهذا أمر غير مهم، بالنسبة لي على الأقل، وإذا كان مهماً له أو لكم، فهذا شأنكم. ولكن المشكلة أنني أصبحتُ وقتها، في هذا الحلم الطويل المشترك الذي نسميه "حياتنا"، أو "الواقع" بطبقاته التي لا تنتهي، في موقف من رفض آخر أمنية لشخص ما في آخر مرة يراه فيها.
في تلك اللحظة، كان من المستحيل معرفة أن ذلك الشاب سيموت في اليوم التالي. نعم، كان من الممكن أن أرى أنني أناني، آثرتُ سلامتي الشخصية وسمعتي السخيفة، على مساعدة شخص وثق بي وجاء يطلب المساعدة، وإن كان التفكير بكل هذا صعباً جداً في لحظة واحدة، هي لحظة الجواب، فقط كان من السهل جداً أن أرى أنني أحرمه من الحصول على شيء يتمناه منذ زمن، وكان ذلك واضحاً لي حتى في تلك اللحظة القصيرة، بل إن تعابير وجهه التي تحمل التوسّل والخجل واللهفة ما تزال مرتسمة أمامي.
أخبرني صديقي يوماً ما أن الشاب العربي قد يموت وهو يتحسّر على رؤية عضو الأنثى، فقلت له إنني رأيتُ من يموت وهو يتحسّر على فيلم بورنو... مجاز
ذلك الشاب ليس بطل القصة، بل صديق عراقي كان يسألني أحياناً: "أنت سني أم شيعي؟"، فأجيبه: "أنا ليبرالي أكثر من أوباما". ما زلت أرفض الدخول في نقاش حول تلك الأمور، وطبعاً قد لا يكون إغماض أعيننا عن عالم مليء بالتعصّب حلاً، ولكنه موقف من يرفض إضاعة الوقت بتلك الخزعبلات، كما ترفض القصيدة أحياناً "حياتنا" أو الواقع بطبقاته، وتبحث عن حياة في مكان آخر، وما أريد قوله هنا إن التجاوز جزء أساسي من جميع خبراتنا وما يحدث معنا.
تخليتُ عن البحث عن أبطال لقصصي منذ زمن. إنهم يأتون بأنفسهم ويتحدثون، ومنهم بطل هذه القصة الذي يذكّرني بالشاب الثرثار الذي كنتُه قبل سنوات. ورغم اختفاء الكثيرين من حولي، بقي بعضهم يستمع إليّ، ولكن: هل أستطيع أن أقوم أنا بدور المستمع؟ بالتأكيد لا.
عدد الأشخاص الذين نتكلم معهم بصدق قليلٌ جداً، حتى أننا نستهلكم بسرعة، أقول لنفسي. لأول مرة استهلكني شخص ما، وعرفتُ ما كنتُ أفعله بالبشر. لقد أدى دوره. أتمنى له التوفيق. «السوريات غير جميلات»، وقصته عن زيارته الأولى لسوريا، وكيف عرضت إحدى السوريات عليه أن يمارس الجنس معها مقابل عشرة دولارات. ماذا أستطيع الرد على أشياء كهذه.
في النهاية، اختلفت مع ذلك الصديق لسبب تافه لا أذكره، لكن قبل ذلك، أخبرني يوماً ما أن الشاب العربي قد يموت وهو يتحسّر على رؤية عضو الأنثى، فقلت له إنني رأيتُ من يموت وهو يتحسّر على فيلم بورنو.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.