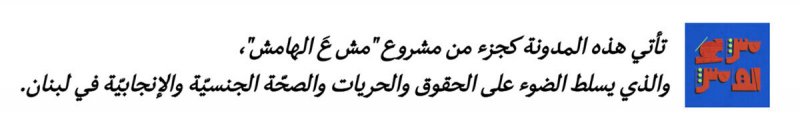
لست أدري كم من رفاقي في المدرسة أخبروني أنهم فاجأوا آباءهم أثناء مشاهدتهم الأفلام الإباحية.
أحد أصدقائي قال لي إن والده خبأ كاسيتات "VHS" في الدرج الثالث من مكتبته، مقفلاً عليه بالمفتاح، ولكن الدرجين الأولين لم يملكا مفاتيح، وإذ بصديقي يُخرج الدرج الأول، ثم الثاني، فيظل الدرج الثالث مكشوفاً عارياً، عارضاً كل محتوياته للمراهق.
أتخيّله في يوم عطلة مدرسية، بينما والداه في العمل، فاتحاً هذا الدرج على مصراعيه، فيخرج ضوء منه، ويسمع ترنيمات بصوت الملائكة، ويشاهد، يعيد ويشاهد، ثم يعيد ويشاهد، لا يدرس ولا يأكل (فلا نفس له أصلاً ولا وقت لديه) فقط يعيد ويشاهد، إلى أن يتعب وترهقه الهرمونات الفائرة والصور الكاشفة وتمرضه على مدى يومين.
عندما كبرت ودرست الإخراج، أصبح لدي علاقة أخرى مع المشاهد الحميمة. فجأة، أصبحتْ كل الصور صالحة للدراسة. كل ما هو ممنوع، صار عرضة، لا بل موضوعاً للتحليل والتفكير، واكتشفت أن بعض المدرسين يرون أعضاء تناسلية في تركيبة الصورة، حتى بعيداً عن العري والمشاهد الجنسية.
في صف تاريخ السينما، أرانا الأستاذ مقطعاً من فيلم "آماركورد" للمخرج الإيطالي فيديريكو فيلّيني، الحاصد على جائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية عام 1975. في الفيلم، شخصية بائعة التبغ التي تلعبها ممثلة ذات حجمٍ زائد. لا أذكر كيف يصل بطل الفيلم، وهو مراهق ذو 16 سنة، إلى أن تكشف له بائعة التبغ عن صدرها الكبير وتضغط برأسه عليه صارخة: “الحس!”.
لا نرى بوضوح وجه الشاب، فهو مطمورٌ بين جبلين عارمين، إنما نفهم بعدها أنه لم يعلم ماذا يفعل وهي تصرخ بصوتٍ أعلى قائلة: “لا تنفخ، بل الحس!”.
لست أدري كم من رفاقي في المدرسة أخبروني أنهم فاجأوا آباءهم أثناء مشاهدتهم الأفلام الإباحية. ما هي الصور التي أثرّت بي في صغري، وأرهقت عيوني "العذراء"؟ هل وقع الصور بنفسها يرهقنا، أو فعل تسجيلها في رؤوسنا كي تصير بطلة أحلامنا إلى حين مماتنا؟
يدخل المراهق بعد هذه الحادثة في مرض مرهق، طوال يومين يعاني من حرارة وهلوسات، وأدخل معه في مرضه، أنا المشاهد الذي يكبره بثلاث سنين فقط، غير ذاكرٍ متى حصل معي هذا أو إذا ما حصل أصلاً، إنما متعاطفٌ، فقط لا غير. شعرت بالحرارة ترتفع وبالقلق الذي يعلو، حتى يجعلنا شاردين في الفلا، مسحورين ومرعوبين في الوقت عينه طوال أيام، أكان على مائدة الطعام، أو في الصف، أو أمام الكتاب الدراسي.
شرح لنا الأستاذ آنذاك، أن المخرج كان في صغره يتلصّص على بائعة الهوى الوحيدة في قريته، والتي كانت سمينة، ومنذ ذلك الحين خلق لديه إعجاب لا بل انسحار بالنساء السمينات، بحسب قوله.
يقول بعض علماء السينما إن الأفلام في القرن الماضي كانت تحتوي على كمية أكبر بكثير من المشاهد الحميمة، إلى حين بدأ عصر الإنترنت والبورنوغرافيا المتناولة بيد الجميع، كأن المشاهد الذي كان يروي عطشه من الشاشة الكبيرة، يرتوي الآن من الشاشة الأصغر، وأصبح بإمكان الأفلام السينمائية أن تلتهي بأشياء أخرى.
وبدأت أفكر: ما هي الصور التي أثرّت بي في صغري، وأرهقت عيوني "العذراء"؟ هل وقع الصور بنفسها يرهقنا، أو فعل تسجيلها في رؤوسنا كي تصير بطلة أحلامنا إلى حين مماتنا؟ ربما نحن كالكمبيوتر، عندما نُدخل عليه برنامجاً جديداً، يصدر الحاسوب صوتاً وحرارة وتبطأ حركته ويتعب لمدة، حتى يعتاد على كمية المعلومات الجديدة التي أُدخلت فيه.
لم يكن لدى أبي أفلام إباحية (ليس على حد علمي) ولم يكن لي أصدقاء يدعونني إلى منازلهم لنشاهد "كاسيتات البابا"
لم يكن لدى أبي أفلام إباحية (ليس على حد علمي) ولم يكن لي أصدقاء يدعونني إلى منازلهم لنشاهد "كاسيتات البابا"، فكبرت وأنا أحاول إشباع فضولي برؤية كل ما يحاوطني، وهنا بدأت رحلة التفتيش عن الفانتازم المناسب في المكان المناسب.
طبعاً، كان للمسلسلات اللاتينية حصة كبيرة، فرغم علمنا أننا لن نرى أي شيء خارج عن المألوف، كانت هذه الشخصيات جريئة تحب وتنتقم وتعشق وتخون، وتراها تخلع ثيابها وتمارس الحب في كل أرجاء البيت، في الحقل، على البحر أو حتى في البيوت المهجورة، أما الأفلام الأميركية على الشاشات الأرضية، فهي كانت تخضع لرقابة عالية، ولا أذكر أي مشهد جريء فيها أكثر مما رأيت في المسلسلات اللاتينية، سوى مرة واحدة فقط. كنت طفلًا يعاني من مشاكل صحية واجداً نفسه غالباً في المنزل، غائباً عن المدرسة.
في سن الخامسة، وبينما كانت أمي في المطبخ وإخوتي في الصف، كنت أشاهد كاسيتات عروض شانتال غويا الواحدة تلو الأخرى، وفي ذلك اليوم، انتهى الشريط وأنا على السجادة أمام التلفاز عندما رأيت مشهداً على شاشة محلية، يحصل في صالة كبيرة مع مدعوّين متألقين على طاولات من المأكولات.
تدخل عصابة من الرجال، مخبئين وجوههم، حاملين مسدسات، ويطلبون من جميع الحاضرين أن يخلعوا ثيابهم ثم يربطونهم بحبال حول بعض. من كل هذا الفيلم أذكر مشهد الدخول بالمسدس، ثم مشهد تلك المرأة ولكلكات شعرها، عارية ومربوطة بحبالٍ حول رجلٍ عار أيضاً، يحاولون أن يعتادوا على غرابة الموقف.
عندما كنت في الخامسة عشر، وشى بي أخي، قائلاً لوالدتنا إنني أشاهد صوراً إباحية على الكومبيوتر مع ابن الجيران.
صمت. صمت ولد وسنينه الخمس.
ثم أعود وأقول إنني ربما حلمت هذا الفيلم، فأي شاشة ستعرض قبل الظهر فيلماً كهذا، ولماذا لم يتبق لي سوى مشهدين، ولماذا بقيت أمي في المطبخ كل هذا الوقت؟
في هذا المطبخ نفسه، عندما كنت في الخامسة عشر، وشى بي أخي، قائلاً لوالدتنا إنني أشاهد صوراً إباحية على الكومبيوتر مع ابن الجيران.
كنت قد تجرأت قبل يومين، وطلبت من أحد الطلاب الأكبر سناً في الباص المدرسي، إذا ما كان يملك floppy يحتوي على صور إباحية. قلت له إنني أريد أن أطبع هذه الصور وألصق عليها صور أصدقاء لي كي نتسلّى. أعتقد أنه لم يصدقني ولكنني لم آبه. في اليوم التالي، بعد المدرسة، اتصلت بابن الجيران، ودعوته لمشاهدة المضمون مع بعض. أظن أنني لم أجرؤ أن أراه لوحدي. أذكر جيداً كيف بدأت الصورة الأولى تظهر بشكل متقطّع إبتداءً من فوق.
من كل هذه الحادثة، لم يتبق لي سوى الصورة الأولى وعدد الشخصيات الكثيرة فيها، وجدتها غريبة وبغاية الابتذال، لا بل القرف. دخل علينا أخي الأكبر بغتةً، وبسرعة الرعد أغلقنا تطبيق الصور، أخرجنا الديسك وأمرت ابن الجيران أن يهرب به. لم تقل أمي شيئاً عندما صارحها أخي هازئاً بالمعلومة، ربما لم تعلم ماذا تفعل، أو ببساطة لم تصدقه.
بعد لقائي السريع مع الصور الرقمية، وقعت عيناي على صحيفة محلية رافقتني لسنين. كان دكتور بول يداوم مع أبي في عمله بعد الظهر، وكنت أمضي بعض الوقت معهم. دكتور بول كان رجلاً مثقفاً يحب القراءة، يأتي مع صحيفته كل يوم، فكنت أتصفحها بينما يعمل هو وأبي.
وإذ بهذا العدد من "النهار" يحتوي على "نهار الشباب" وفيه تقرير عن الدش والأفلام الإباحية. في هذا التقرير صفحتان مع صورتين جميلتين مأخوذتين من أفلام سينمائية أوروبية ذات طابع إباحي. شربت كل كلمة والتهمت كل حرف في هذا المقال، تهت في "بِكْسلات" الصور والكلمات، إلى أن صارت عيني كالكاميرا المكبّرة تخرق عمق الصورة حتى الوصول إلى نسيج ورق الجريدة. لاحظ أبي أنني مأخوذ بالقراءة، فبدأ يقترب مني. صار قلبي يدق بسرعة، وأغلقت الجريدة بسرعة تاركاً الكرسي، وإذ به يفتحها قائلاً: "شو اللي آخدلك عقلك هون؟".
لو كان لدي أولاد مراهقون، كانوا طبعاً وجدوا في أدراجي مجلات فوتوغرافيا وأفلام DVD لسينما المؤلف، تحتوي على مشاهد محظورة لغير الراشدين، منتظرة أن تصبح ملجأ ملهِماً لهم ولأصدقائهم
التهمني الخوف، أنا الذي كنت ألتهم الكلمات منذ دقيقة، وذهبت أختبئ في الحمام، أنظر لوجهي المرعوب في المرآة وهو يكاد يذوب من الحرج. عند خروجي، قال لي دكتور بول مع ابتسامة هازئة ولطيفة في الآن نفسه: "لازم نجبلك دش". ابتسمت خجلاً وهرْوَلت إلى البيت متحجّجاً بفروضي المدرسية.
لم يعلق أبي على هذه الحادثة أبدًا.
في اليوم التالي، وجدت الجريدة في مكانها ككل جرائد اليوم السابق والتي مصيرها أن تصبح ممسحة للزجاج. فتحتها، سرقت الورقتين التي طُبع عليهما التقرير، أخذتهما وخبّأتهما في خزانتي، مقتنعاً أن مصيرهما كملجأ لأحلامي المراهقة، أنبل وأشرف لها من تلميع الزجاج.
بعد سنين، شاهدت الأفلام المذكورة في المقال، لا بل درستها، وصارت مشاهد وصور البورنوغرافيا في متناول يدي، لا بل في يدي نفسها، وأنا على يقين أن من يشاهد أفلامي الآن، يعلم ما هي فانتازماتي. ولو كان لدي أولاد مراهقون، كانوا طبعاً وجدوا في أدراجي مجلات فوتوغرافيا وأفلام DVD لسينما المؤلف، تحتوي على مشاهد محظورة لغير الراشدين، منتظرة أن تصبح ملجأ ملهِماً لهم ولأصدقائهم.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


