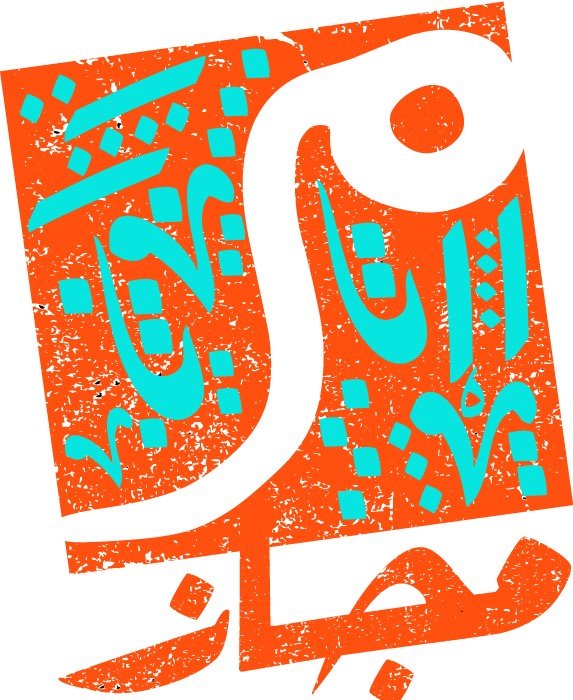 الخائف
الخائف
استلقيتُ بنصف جسدي على نصف "السداري" (الأريكة المغربية)، كأني طفل منفلت، متقمّص لجسد رجل ثلاثيني حائر، لأحدّق في صورتها. تَمَاثَلَتْ أمامي بقفطانها المغربي الهارب من زمن التسعينيات. رقصتْ ثم تمايلتْ، فتمايلتُ ببطء كشطحة الأمهات المترهلات. زعزعت الشابة العشرينية حيرتي ورَمَتها خارج المربّع. حرّرتني للحظات، إلا أنها لم تتحرّر بعد من الكادر.
عدتُ إلى مُربّعي، مستلقياً دون جدوى، أطارد الزمن.
ما الحل؟
"الكسكس يا بني".
نادتني أمي وهي جالسة القرفصاء خلفي بجوار نساء العائلة: "هل ترغب به يا بني؟". أجبتها بصوت لم أسمعه: "أريد القليل منه". استلمت الوجبة من توأمي الأنثى. كانت تكبرني بدقيقة واحدة، وأنا أكبرُ منها حيرة وتردّداً: "هل آكلُ الكسكس أم لا؟".
همست في أذني وكأنها عشيقة لذيذة: "إنه لذيذ، على ضمانتي".
تأملت صوت توأمي أكثر من تحديقي لشكل الكسكس. لقد كان قليلاً، شاحباً بلا طعم. ضقت به، غضبتُ غضبة الأطفال المدلّلين: "ما هذا؟ ما هذا بحق النعمة؟ كسكس قليل يا عباد الله".
"لكنك طلبتَ القليل"، تردّ أمي. ثم أردّ عليها: "أنا لست واعياً ولا ناضجاً. تَفَهَّمي حيرتي رجاءً".
كانت توأمي الأنثى أكثر اتساعاً من ضآلة الراقصة العشرينية، إنها تحتمل هذا الوعاء دون ملل ودون حاجة إلى رقص مُنمّط، كانت تتعامل مع المربّع بمرونة، بل وبشيطانية أحياناً. إنها راقصة داخله، فوقه وخارجه، لذا لم تتوان لهنيهة واحدة عن احتواء غضبي الطفولي.
نادتني أمي وهي جالسة القرفصاء خلفي بجوار نساء العائلة: "هل ترغب به يا بني؟". أجبتها بصوت لم أسمعه: "أريد القليل منه". استلمت الوجبة من توأمي الأنثى. كانت تكبرني بدقيقة واحدة، وأنا أكبرُ منها حيرة وتردّداً: "هل آكلُ الكسكس أم لا؟"... مجاز
أخذَتْ مني الصحن وأعطتْهُ لوالدتي لتملأه كما هو مطلوب، التفتُّ ورائي، وجدت بضع نساء من العائلة يجلسن بجوارها، ثم بسرعة غيَّرتُ اتجاهي نحو الأمام. أكره دوائر العائلة، أمقت التقاليد والنفاق وملل عشية عيد الفطر، وجِدية الرجال في صالة الضيوف بجلابيبهم المهيبة ليلة العزاء.
استلمتُ وجبتي كاملة مكتملة، أكلتُ حتى طردت الزمن شر طردة، ثم كافأتُ نفسي بـ"سداري" هي الأخرى كاملة مكتملة، عريضة وطويلة، تلائم جسدي الثلاثيني. وحتى أطارد الزمن بشكل مضاعف، أكرمت ذاتي بمشاهدة رسوم متحركة آتية من زمن التسعينيات، تعبّر عن هويتي المترنحة بين عالمين: إنه "النمر المقنع"، لكن بأغنية شارة كارتون "بوكيمون". لكن ما هذا؟ ما هذا بحق الراديو أيها التلفاز المتحجّر الغبي؟ ألا تعرف، أم تحب أن أُعَرِّفَكَ مع من تتعامل؟ لن أقبل بهذا القرف؟ لن أقبل بكائنات عجائبية، لا هي ببشر ولا حيوانات ولا روبوتات؟ أنا ابن أواخر الثمانينيات وما قبل سقوط جدار برلين؟ أنا عصي. هل سمعت يا صندوق؟ إذا لم تستجب لطلبي فسأخونك فوراً مع الراقصة العشرينية!
وعلى الفور، استجاب التلفاز لطلبي. بثَّ حلقة ممتعة من كارتوني المفضل. لقد شعرتُ بامتلاء الطفل الحيوي، وانتشيت بفرحة التسعينيات الساحرة.
خرجت من هذا المكان، إنه منزل من لا منزل له، لا أعرف من يملكه ولا هويته، بل الأدهى من هذا أني لا أعرف اسم المدينة التي أعيش فيها. إنها حائرة مثلي، مُترنّحة بين مدينتَيْ أيام الطفولة الأولى ومدينة رفيقي الفيلسوف المثقف.
هذا كله لا يهم. الأهم هو أن أستلقي. هذه المرة على كرسي المقهى، أبصُّ وأقتنصُ اللقطات وأغوص في أعماق الكتل اللحمية التي تسير أمامي، غير آبِهَةٍ لمطاردة الزمن. تمضي بلا مصير وبلا خطوط.
سرق الرجل النملة تركيزي الغارق، ليثرثر كلاماً مفهوماً وغير مفهوم حول الأشياء واللا أشياء. سافرتُ بفوضى حواسي لألمح من بعيد صديقي الفيلسوف. ما هذا بحق "الشفنج" (فطائر مقلية مغربية)؟ لقد صار يطبخ ويبيع "الشفنج" المحروق، ذا الحلقات المدورة على شكل صفر فارغ.
فعلا لا شيء يستحق التفكير. أجل، التفكير الزائد لا جدوى منه. إنها "طاقة مهدورة كان يمكن استغلالها في إعمار الصحراء"، على حد رأي إحدى اليساريات في فيلم "فوزية البرجوازية".
ما يهمني أكثر أنه يقف ويتفاعل ويخاطب بتركيز شديد مع زبائنه الكادحين، وكأنه ينشر لهم فكره الثوري والتنويري بلا ثورة ولا بيانات مسكوكة.
هل لامسَ الحل؟ يبدو ذلك.
تذكرت كلام صديقي المجنون المُؤَجِل لانتحاره لَمّا حثّني على تناول تذاكر الأسيد، وكأنه الخلاص اليتيم وحده لا شريك له. كان يكرّر لازمته مثل الإعلانات الدعائية: "مع الأسيد عِشْ أحلى ما في اللحظة"، أكثر مما أقنعني بشكل عقلاني على وضعه فوق صفحة اللسان. لكن لا يا مجنون، أنا وصديقي بائع "الشفنج" على وشك أن نستوطن لسان الخلاص ونتلذّذ بمذاقات ملونة خارجة عن دوائر هذا المربّع الشاحب الذي يسجننا.
التفكير الزائد لا جدوى منه. إنها "طاقة مهدورة كان يمكن استغلالها في إعمار الصحراء"، على حد رأي إحدى اليساريات في فيلم "فوزية البرجوازية"... مجاز
سأفصح لك لاحقاً عن الجواب/الحل يا مجنون...
من جديد، قاطع الرجل النملة بصَّاتي المتأملة، واقترح عليَّ أن نجُول ونصُول هذه المدينة، بواسطة ماذا؟ بواسطة سيارة رونو (R4) المايكروسكوبية.
هيا بنا يا حائر...
جلستُ في المقعد الخلفي لكنه بدون سقف، لا توجد وسائل السلامة، فقط قضيبان على جانبي المقعد، احتميتُ بهما حتى لا أسقط مغشياً عليَّ، لأن صاحبنا النملة يقود بطريقة فوضوية، ولا يستوعب أشكال المدينة الواسعة والضخمة قياساً لحجمه الضئيل. قاطعت أنا الآخر سائقنا وقلت له: "لا... لا داعي للتجوال هنا، أنا زرتُ هذه الشوارع. كفى، فلنعد إلى المنزل".
"تقصد منزلي وأنا أب لسبعة أبناء"، ردّ علي الرجل النملة.
أخيراً عرفتُ صاحب منزل من لا منزل له، لكن أكثر ما شدّ انتباهي هو كيف لرجل بهذا القد أن يعانق ويضاجع امرأة مترهلة، تَسَعُ كل متاهات هذه المدينة الحائرة، فما بالك أن ينجب منها سبعة أبناء؟ كيف وبحقّ المربّع الذي نعيش فيه أن يقوم بهذه الأشياء وهو بحجم نملة؟
فجأة، زعزع السائق النملة جسدي، وتمايل يميناً ويساراً بعد أن اصطدم بشكل قوي بسيارة ضخمة فارهة، أدى إلى خروجه من الزجاج الأمامي لسيارته، ليكسر علامة الترقيم ويزحف بجسده تحت المركبة الضخمة.
خفتُ على صديقي النملة من تبعات هذا الاصطدام، لكنه جمع أشلاءه وكأنه قط بسبعة أرواح، ثم احتجّ وغضب على سائق السيارة، وقال له ثرثراته المفهومة وغير المفهومة. بيد أن السائق المرفّه لم يأبه له وكأنه لامرئي. لقد مضى مسرعاً تاركاً وراءه سائق سيارة مهترئة، لا حيلة له سوى منزل بلا هوية، وسبعة أبناء وامرأة تسع هذا المربّع الضيق.
انتقلتُ إلى منزل آخر، باحثاً عن شيء ما، لا أدري. لا أعلم. لقد قُلتها في البداية: الحيرة تلازمني.
دخلتُ واتجهتُ نحو الحمام. وقفَتْ أمامي قريبتي الآتية من زمن التسعينيات، ترسم على شفاهها بسمة لذيذة ووجها متقد بالاحمرار الطفولي، تسألني "بلا حشومة" ولا خجل أمام عتبة الحمام: "من زَوَّجَكَ؟". وقفتُ كالمسمار. لا جواب ولا همسات.
"لقد زَوَّجَنِي المربّع أسئلته الفارغة الأشبه بشفنج صديقي الفيلسوف المثقف". هذا جواب لا أفصح عنه إلا لقرارة نفسي.
تركتُ قريبتي متسمّرة في مكانها، لا تهمني أسئلتها "الشفنجية" بقدر ما يهمني أن أخرج لِمَاماً من المربّع، لذا وَلَجْتُ عمق الحمام ثم استرحت، لأني أريد أن أسترخي، ثم أحب...
هل عرفتَ الآن الجواب/الحل يا صديقي المجنون؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





