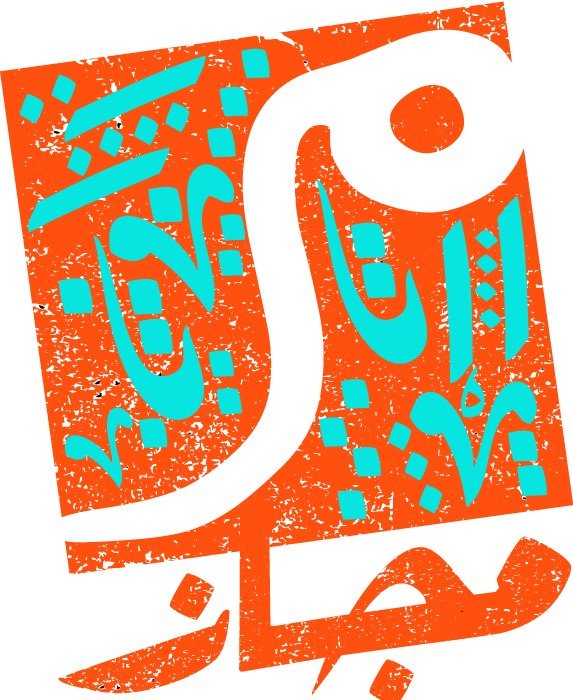 الخائف
الخائف
"مكاني ليس هنا. هذه المدينة ضيقة عليّ وعلى أحلامي". لطالما ردّدت هذه الجملة بهمس بيني وبين نفسي المتطلّبة، بينما أكون جالسة بكامل انتباهي أمام شاشة التلفاز وهي تعرض أفلاماً أجنبية، واحداً تلو الآخر. لم تكن مشاهداتي تلك بدافع التسلية بقدر ما كانت إيقاظاً للأخرى المتمرّدة في داخلي، تلك التي تدعوني للانتفاض على كل ما حولي، وحمل حقيبة قد لا تتسع لشيء سوى لأمنياتي، والهروب من الواقع المتربّص بي. هذه الحرب الداخلية كانت تدور في مرحلة حساسة من حياتي، قد تسمونها "مراهقة"، بينما أراها إرهاقاً.
أما حين واربت الحياة بوابتها قليلاً، أقلعت من فوري كطائر محاصر وجد ثغرة في قفصه.
الحرية هي المفردة السرية والمفتاح الذي بحثت عنه، وقد حدث ذلك بكل يسر، وكأن القدر كان متفرّغاً لإعطائي درساً بأن لكل شيء ثمناً يجب دفعه، قبل أو بعد الحصول على المراد، إلا أنني دفعت ودفعت منذ ابتداء الرحلة وما زلت، دفعت حتى ثمن الإعلانات التي تتخلّل الأفلام وتتخلّل حياتي.
حين واربت الحياة بوابتها قليلاً، أقلعت من فوري كطائر محاصر وجد ثغرة في قفصه... مجاز
كانت البداية "تحت سقف الوطن"، جولات في المحافظات بحثاً عن مدينة تتعرّف عليّ وتعاملني بلطف، الحسكة في الشرق، حلب في الشمال، حمص في الوسط، ودمشق في الجنوب، إلا الغرب، تلك الجهة الحلم، لم أحصل على فرصة السير إليها، حتى تحت سماء تعرفني. كانت تلك المدن محطات سريعة على الرغم من مكوثي فيها لفترات طويلة، محطات دفعت ثمن تذاكر الوصول إليها أجزاءً من روحي، وعلمت حينها أن حقيقة الحياة لا تشبه الأفلام التي شكلت لدي صورة عن خارج المنزل الذي ترعرعت فيه. تأخرت في ذلك، أعلم... ربما خطأ هذا المخرج.
أن تكوني امرأة دخلت الفخّ بملء إرادتها وباتت مجبرة على إكمال الطريق، مقيدة بسلاسل ذلك الفخ، وفي محيط ينتظر الإجهاز على أية ضحية مرمية، هو أمر يجعلك مجرّد قشّة تقصم نفسها. وعلى الرغم من كل هذا، بقيتْ في جعبتي بقايا أمل، بأن هناك جهات ستعرفني وتعاملني بلطف.
أنا التي كنت أنشد الحرية والانفراد عن قطيعي، صرت أبحث عن ظلٍّ يكمل السير معي
فعندما أثقلت الحرب كيان الأرض التي آوتني، قررت المضي نحو وجهة لم تكن خياراً، بل فرضتها عليّ بوصلة الهوية التي حملتها: الإمارات، حلم لاح في أفق كثير من أقراني، إلاي، لكنني خضعت لتلك الجهة، فسلكت الطريق محملة هذه المرة بمظلوميات كثيرة.
أقبلت إلى تلك الأرض، وكما الحال مع سابقتها، اتجهت نحو وجهاتها الأربع، خضعت لشروطها القاسية، تخليت عن كثير من ملامحي لتتقبل التفاعل معي، إلا أنها جافتني منذ اللحظة الأولى.
ثماني سنوات وأنا أتنقل من عمل إلى عمل، ومن بيت لبيت، صعوداً ونزولاً، كأنثى ذئب جريحة في غابة إسمنتية شاهقة. ربما ما حصل لا يعدّ معاناة للبعض، إلا أن الوحدة والمضي منفردة هو ما صبغ هذه الرحلة بلون التعاسة، ربما الخوف من المستقبل الذي بات يشكّل هاجساً بعدما كان مغامرة ممتعة، وربما لكل منا رهابه الذي يصنعه على مقاسه، وربما كل ذلك مجتمعاً.
أنا التي كنت أنشد الحرية والانفراد عن قطيعي، صرت أبحث عن ظلٍّ يكمل السير معي، لكن من دون جدوى... فبينما يلوذ معظم الناس إلى أنصافهم، أجدني أغرق أكثر في مشاهدة الأفلام، صار مطلبي إعادة استحضار المتمرّدة التي سكنتني من قبل ثم لاذت بالفرار وتركتني أواجه مصيري. هذه المرة كانت المشاهدة برغبة ملحّة مني، لأنني أردت الخروج من هذه البلاد.
الحرية هي المفردة السرية والمفتاح الذي بحثت عنه، وقد حدث ذلك بكل يسر، وكأن القدر كان متفرّغاً لإعطائي درساً بأن لكل شيء ثمناً يجب دفعه، قبل أو بعد الحصول عليه... مجاز
استيقظت تلك، وراحت بهمة تساعدني على استخراج تصريح سفر إلى تركيا، وكذلك بدأت تلقي خطاباتها عن مستقبل مزهر في غير هذه البقعة، وعن حياة وردية خالية من السواد. وهكذا خرجتُ من مرحلة ودخلتُ أخرى، إلا أنني وفي أرض المطار فقدتُ بسرعة همّتي، وبدأت أعود إلى ما كنت عليه، وكأن أُخراي أوصلتني هنا واختفت.
في ذلك المكان، اختلفت رؤيتي للجهات، وصارت أكثر إيلاماً، فبعدما عشت جزءاً من فيلم رومانسي مع نصفي الذي تلقفني هناك، وربّت على جراحي، تركني هو الآخر ومضى... ومعه اختفت قناعتي بأنني ما عدت وحيدة، وبأن الانفراد عن قطيعي هو الثمن الذي أدفعه وسأستمر في دفعه.
سنتان، أعدت تكرار كل ما كنت أفعله، تنقلت من جهة إلى أخرى، ومن عمل لآخر، من دون الحصول على فرصة تقيني العودة لمشاهدة الأفلام. وهذا ما لم يحصل، فقد زارتني نفسي المنتفضة بعد جولات من الفراغ المستمر، وأعادت شحني بذلك الحلم، عن الغرب الذي كان عصيّاً، وتحدثت ثم تحدثت إلى أن أوصلتني حيث تريد، أوروبا التي زادت من إيقاع طبول الوحدة، ومن جدوى الحرية التي نشدتها مبكراً، ومن بردي الروحي، بل وأخذت تقرع إيقاعاً آخر تَمثّل باختلاف أنماط الحياة، ربما كان ذلك يوماً ما رغبة من رغباتي، إلا أنه في الحقيقة، فوضوي أكثر من تصوري.
في تلك اللحظات، تغيرت رؤيتي للحلم أيضاً، وبت وحيدة حتى من نفسي الحالمة المنتفضة، صرت أبحث عنها في كثير من الأفلام، وفي فسحة الفراغ الواسعة جداً، بحثت عنها داخلي وخارجي ولم أجدها، تمثلت لي كحلّ يخرجني من الخيبة التي اصطدمت بي واصطدمت بها حد الإدماء، ولكن بلا طائل، فربما تكون قد ماتت بفعل صدمة الخيبة التي واجهتنا.
بعد شد وجذب وبحث عن حلول، ها أنا الآن أجلس أمام شاشة التلفاز، بكامل انتباهي، أشاهد الفيلم الأمريكي "طعام، صلاة، حب" وأنا أتمنى العودة إلى شاشة تلفازنا، في بيتنا الأول، لأتجنّب الأفلام التي أفقدتني الجهات.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


