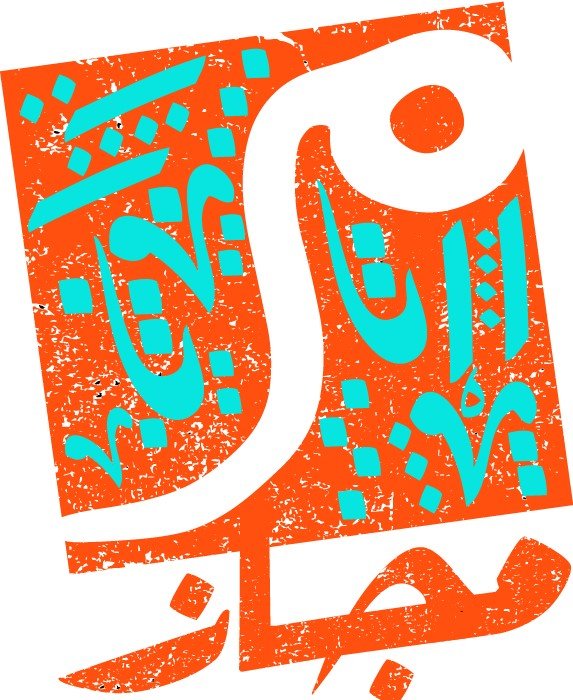
كان يكبرها ببضع سنوات، لكنه كان دوماً يشعر بالعجز نحوها، ربما لفرط فقر موحش عاشه، فهو الذي يسرح مع أبيه أجيراً في أرض الله الواسعة بشتى بقاع المركز عند خلق الله، يخط معه الترع والمصارف، ويخط الفقر ظهره تماماً كما خط ظهر أبيه من قبل، وهي التي تلاحقه في السن من بين أخواته الصغار، رغم أنه يكبرها بخمسة عشر عاماً. الرزق شحيح للغاية، والصغار جوعى، فهم لم يشبعوا يوماً لشحّ الزاد.
من بين أخواته البنات جميعاً كانت هي الأقرب إليه، تجلس سعيدة مبتسمة إلى جواره في دفء جسده الموجوع، على صينية الأكل، تنظر نحوه بشغف وحب، يداعبها ويضحك معها رغم المرار الطافح الذي ذاقه خلال اليوم في بلاد الله، يتصنّع الشبع لتأكل ويأكل معها إخوتها الصغار، تنظر أمه العجوز إليه: "كل يا حبيبي أنت طول النهار شقيان"، يبتسم لها بينما تحمل نظراته طعم المرار: "الحمد لله يا أما شبعت"، تدرك جيداً أنه لم يشبع، فكم من مرّة تصنعت نفس الشبع ليأكل الصغار، تُربت على كتفه: "ربنا يجبر بخاطرك يا ابني زي ما أنت جابر بخاطر إخواتك".
يهيم في بحور الألم، يشعر كأنه عالق في زمنٍ لا يعرف الشفقة، حيث الفقر يسيطر والأمل يتلاشى، يتساءل في حيرة: "هل يمكن أن أكون شعلة نور في تلك الظلمة؟ كيف لقلب مبتل بدموع اليأس أن يغير المصير القاسي للصغار؟ وكيف يمكن أن أطلق العنان لأجنحة أخواتي الصغار البريئة في عالم يحجب عنهم أشعة الأمل والفرص"، قلبه المحزون يناشد العالم بصوت مكتوم، يتمني من يسمع له وجعه، ويلاطف حالته، فروحه الضائعة باتت تتوسّد الأمل الباهت.
يسند ظهره على الحائط المجاور لباب الغرفة، يغمض عينيه، بينما يملأ صدره سيل من التنهيدات المكتومة التي يحاول ألا يلحظها أحد، قبل أن يستعيد الحياة فينظر نحو أخواته البنات ويقول لنفسه: "امتي ياد يا إبراهيم ربنا يعينك وتتستر على الولايا دول وتفرح بيهم"، لم يدرك إبراهيم بعد أنه تجاوز الثلاثين عاماً، وأن حياته أصبحت قرباناً من أجل الأمل في مجرد أبسط حقوق العيش والحياة لأخواته.
صباح كل يوم، وبعد أذان الفجر الذي يصلهم صوته ضعيفاً من المسجد البعيد في القرية المجاورة، تجري مسرعة نحو الكنبة التي يحط عليها جسده في المساء، تداعب شعره وتدعوه برفق أن يصحو، فيبتسم لها: "ايه الصباح الزين ده!"... مجاز
الحياة في أطراف النجوع البعيدة عن القرى ومراكز الخدمات صعبة للغاية، وحروب العيش للحصول على أبسط الحقوق من أبجديات الحياة، أساطير شعبية كثيرة لا يشعر بها الكثيرون، ولكنه يشعر بكل خطواتها الثقيلة كالجبال، والتي لا تنفك تنتهي أو تتغير، أو تقترب من تحقيق شيء، أي شيء، مجبراً يستكمل دورة حياته، محاولاً ألا يشغل باله بالبؤس الذي يزيّن تفاصيل وجهه، والفقر الذي يقتات بلا رحمة على عنفوان شبابه، بعدما قتل كل طموحاته وأحلامه.
مثقلاً بالهموم، كسير الظهر، يجلس أبوه على حافة السرير، يراقب بخيبة أمل ما يحدث من تفاصيل القهر وقلة الحيلة، ينظر إلى ابنه نظرات عجز يدركها كلاهما، فهو رغم مرضه بالكبد قبل سنوات، لم تسعفه الحياة برهة ليرتاح، ولا زال يشقى عند خلق الله، وبالرغم من أن ما يتحصّل عليه لم يكف يوماً هؤلاء الجوعى، الا أنه لا يملك إلا السعي نحو مزيد من الشقاء والتعب، فما باليد من حيلة.
من فرط أحاسيسه نحوها، وحبه لها، فعل المستحيل حتى تستكمل دراستها، كان يتمنى أن تحقق ما لم يستطع تحقيقه، حينما أجبرته الظروف قبل سنوات لمزاملة أبيه في العمل، والتنازل عن تحصيل المعرفة عبر التعليم الذي كان مفتوناً به، من أجل البحث عن فتات من لقمة عيش لا تكفي سد جوع أخواته، الا أنها رفضت، لم تقبل أن تكون سبباً في جوع أخواتها الصغار. أخبرته أنها قادرة على التضحية مثلما فعل هو من قبل، لم يدرك حينها ماذا يفعل، هل يتحمّس لفخرها به واعتزازها بما قدمه من أجلهم جميعاً، أم يوغل في الحزن لأن ما قدمه لم يكفل لهم الحد الأدنى للعيش الكريم.
صباح كل يوم، وبعد أذان الفجر الذي يصلهم صوته ضعيفاً من المسجد البعيد في القرية المجاورة، تجري مسرعة نحو الكنبة التي يحط عليها جسده في المساء، تداعب شعره وتدعوه برفق أن يصحو، فيبتسم لها: "ايه الصباح الزين ده!"، تسبقه أمام باب البيت الذي تكسوه حِزم القش، والذي تجمعه الأم من الحقول المجاورة، وتستخدمه في حريق الفرن البلدي لخبز بعض العيش حينما يتوفر لهم قليل من القمح، تُمسك بأبريق الماء الذي ملأته من الترعة قبيل قليل ليتوضأ ويصلي الفجر، ويستعد لرحلة الشقاء التي لا تنتهي.
جسده موجوع للدرجة التي يحتاج خلالها أن يرتاح، لكن الحياة تفرض عليه كل أعباء الفقر والحاجة، يصطحب أبيه المسنّ ويسافر للنجوع والعزب والقرى المجاورة، ليرى وجوهاً متعبة وأجساداً مستنزفة، الجوع في أعين الأطفال والأمهات، لتلاحقه مشاعر العجز والوجع عبر كل المشاهد المؤلمة، يكسر ريق فمه بقطعة خبر محروقة ويعطي لأبيه باقي الرغيف، يحمل الأثقال ويشعر بالإرهاق، لكنه يستمر في العمل، يحمل في قلبه شعلة أمل، ويتمسّك بحلمه في تحسين مستقبل أخواته.
يحمل عبء العالم على كتفيه، ويدرك أنه لن يستطيع أن يغير واقع حياة عائلته فجأة، ولكنه يعد نفسه بأن يكون الداعم والمعين لهم في كل الظروف، يقدم لهم ما يستطيع، حتى وإن كان قليلاً، لأنه يعلم أن الشقاء والتعب ليست النهاية، بل هي مجرد محطة في رحلة الحياة، التي يتمنى أن يعايش خلالها مرحلة أخرى، في صميم قلبه يحتضن الأمل والحب، ويستمر في القتال والتضحية، يتحدّى الظروف والصعاب، ويستمر في السعي نحو حياة أفضل لعائلته.
في صمته، يصلّي ويستغفر، يعتمد على إيمانه القوي ليمرّر الأيام الصعبة، يصدق أن الله هو الرحيم والمعين، وأنه إذا استمر في الصبر والاجتهاد، فسيجد حتماً طريقاً للخروج من هذا الوضع المأساوي، وفي نهاية كل يوم، عندما يعود إلى المنزل، يجلس بين أخواته الصغيرات، يشعر بالسعادة والامتنان لوجودهن بجانبه، يعلم أن الحب والترابط العائلي هما أعظم قوة يمكن أن يمتلكها، وفي قلبه يتوعد بأن يستمر في الكفاح والسعي، حتى يتحقق لأسرته ما يستحقونه من حياة كريمة.
أدرك حينها والوجع يقتله أنه من تسببَّ بموتها، يناجيها وهو مرمي على صدرها: "هو أنتِ مُتّي يا اختي؟! هو أنتِ مُتّي عشان في يوم شبعتي؟!"... مجاز
شح الزاد يوماً وهي جوعانة، فاصطحبها لأرض فول أخضر على أطراف النجع الصغير لتسد رمقها، مكسورة تنظر نحوه بينما هو يطمئنها بابتسامة رضا: "كلي يا حبيبة أخوكى". تشجّعت، فأكلت حتى شبعت، لكنها في طريق العودة للمنزل شحب لونها، لم تعد تقوى بتاتاً على السير، فجأة سقطت على الأرض، فحملها وصرخ: "إلحقوووني، قلب أخوها هتروح من أخوها". تجمع أبناء النجع الصغير على صراخه، وحملوها إلى الوحدة الصحية في القرية المجاورة، تتنفس بصعوبة بالغة، بينما تلطم أمها على خدها الشاحب: "مالك يا أختى؟".
كان قرار تحويلها على عجل لمستشفى المركز، فهي مصابة بأنيميا الفول، وقد أكلت منه الكثير، وباتت حالتها خطرة وتستدعى تدخلاً عاجلاً وأدوية ليست موجودة في مبني الوحدة بالقرية.
مبني الوحدة الصحية بالقرية قديم ومتهالك، ولا يقدم العديد من الخدمات الصحية رغم تكليف طاقم من الأطباء والتمريض للعمل به، يمكنك القول إنه باستثناء بعض الأمور الروتينية الخاصة بمنح شهادات الزواج الصحية فلا توجد خدمات أصلاً، هنا لا يمكنك الحصول على العلاج مجاناً حتى إذا كنت محظوظاً وكتب لك الطبيب الممارس، بدون كشف دقيق، روشتة علاج، فصيدلية الوحدة دائماً فارغة رغم تواجد الصيدلي، وأجهزة الأشعة والتحاليل الطبية متعطلة منذ أن جاءت، ولا توجد أبسط الأدوات لخلع أو حشو ضرس، ولكن الجميع متواجدون دوماً في المبنى منذ الصباح الباكر حتى أذان المغرب، متواجدون دوماً لفعل وتقديم اللا شيء!
أصر على الركوب معها في سيارة الإسعاف، التي طلبتها الوحدة الصحية بالقرية، ينظر إليها والألم يعتصره: "مالك يا ختي، هو الفول بيموّت؟! "، في الطريق للمستشفى غابت عن الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة. أدرك حينها والوجع يقتله أنه من تسببَّ بموتها، يناجيها وهو مرمي على صدرها: "هو أنتِ مُتّي يا اختي؟! هو أنتِ مُتّي عشان في يوم شبعتي؟!"
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.





