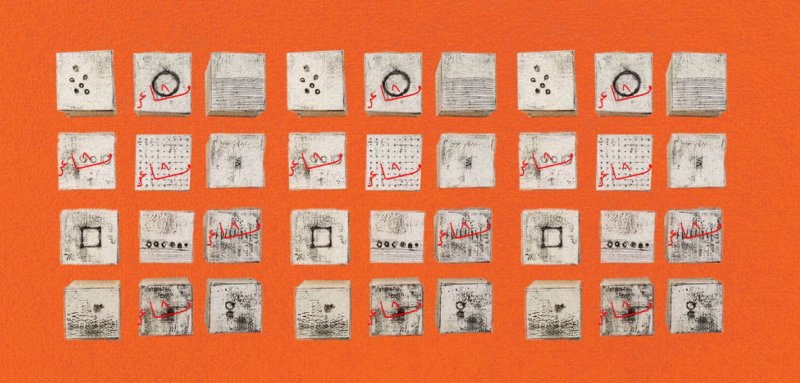العالم لا يتوقف عن الحركة، والأحداث في عصر التكنولوجيا صارت متدفقة بشكل غريب، بالتأكيد ليس غريباً على العالم، بل على الذات بفرادتها، أو على مجموعة من الناس اعتادوا العيش سوياً، يتبادلون نفس الأحاديث كل يوم، كأنهم يعيشون داخل صندوق خشبي، فتحة صغيرة على سطحه، تكفي لإسقاط إنسان آخر داخله، أو إخراج جثة منه، لربما تكون المقبرة لهذا المجتمع هي بمثابة الخروج من الصندوق ومعانقة الهواء الطلق، نيل الحرية، بعيداً عن الطقس المكرّر الذي يعيشون فيه، ويتعاركون، كما يتعارك الدجاج على بيضة فاسدة.
أزمة الإنسان الحديث أزمة مشاعر، فصارت القصة قصة الجميع، ولا يمكن الهرب من سيل الأحداث اليومية في العالم، فلكل حزن في مكان ما في العالم، حزن شبيه، أو مكمّل له، وصار العالم صغيراً جداً، بدليل أن الحزن يحتويه، بضمّ ذراعيه حوله.
فحياتنا صارت مجرد أحداث موحشة، تتطلب تجهيز صف من عُلب المشاعر الخاصة بكل حدث: نفتح العلبة، نشعر، ومن ثم يذهب الحدث، ننساه! ونحتفظ بعُلب كثيرة، جاهزة للاستخدام في أي حدث قادم.
لقد جعلت التكنولوجيا من العالم مأساة أكبر، إذ إن الوجع يحدث في مكان آخر، بعيد عنك، لكنك تسمع صوت نحيب المنكوبين في بيتك، في مكان عملك، على سريرك، والأشد وطأة، أنك تسمع صوت المأساة تكبر داخلك.
تدفّق مثل سيل
حينما سمعت عن زلزال سوريا وتركيا، كنت في السرير أستعد للنوم، ففي الغد يوم طويل من العمل، وبحكم عملي في الصحافة فإنني بحاجة لتركيز أعلى.
حياتنا صارت مجرّد أحداث موحشة، تتطلب تجهيز صف من عُلب المشاعر الخاصة بكل حدث: نفتح العلبة، نشعر، ومن ثم يذهب الحدث، ننساه! ونحتفظ بعُلب كثيرة، جاهزة للاستخدام في أي حدث قادم
كنت أنظر إلى المباني الشاهقة في سوريا وتركيا وهي تهتز، كمن يترقب قنبلة على وشك الانفجار، أنظر إلى الحجارة تتساقط وتتحول إلى ردم، وأتخيل الكتل البشرية بداخلها، تتساقط بين الإسمنت، وأفكر في المشاعر التي يحملها الإنسان لحظة السقوط، في الخوف والهلع والحسرة، في تخشّب الأقدام وخدرها من هول اللحظة.
بعد أن شاهدت الفيديو الأول، قرّرت ألا أقحم نفسي أكثر في الحزن، وأن أتجاهل الأمر، كأنه لم يحدث، ماذا أفعل لأكون كذلك؟ ركنت جوالي إلى جانبي كأنه معطوب، وعطلت الإنترنت، لربما أردت التحول إلى إنسان آلي، يكتفي بعالمه الضيق، لأن العالم ممتلئ بالحزن، حزن لا يمكن تحمله.
لكن لست أدري كيف دار الفضول مرة أخرى، كأنه وسواس لا يتوقف عن ابتزازي، ورحت أتابع من جديد، بل وبحثت عن كلمات الترند، حول زلزال سوريا وتركيا، ورحت أسبح في طريقي نحو المشاعر المسمومة، ورأيت كل المنشورات حول الفاجعة، ولأنني أعرف مسبقاً كيف ينهار المبنى أمام العين، خلال الحروب السابقة على قطاع غزة من قبل إسرائيل، كانت مشاعري تُجسّم الموقف وتعيد تصديره، صرت أعرف أن الحرب لا تغادرنا، وإن توقفت.
رحت أشاهد وأتألم، وأتخيّل وأقرّ، مرة أخرى، بأن العالم مخطط سيئ، لا يتوقف عن إيذاء الإنسان والسخرية منه.
ولأيام طويلة بعد الزلزال، وكنت أشعر خلالها بالهزات الخفيفة في مدينة غزة، باتت مشاعري مثل قماش مهترئ، لا أجد متعة بأي شيء، المتعة التي أعتبرها وسيلة ذكية لمنع الواقع الموحش من التلبس في الإنسان.
قش صغير
إن مأساة الإنسان المعاصر لا تكمن في فقدانه للأمان، ولا في تحوله إلى استهلاكي مكرّر، بل في تدفّق المعلومات الهائل، واتخاذ الأخبار شكل السيل، بحيث تتحول مشاعر الإنسان في لحظة ما، إلى مجموعة من القش الصغير التافه، يمضي مع السيل المتدفق، لا نستطيع أن نقاوم الخبر الكارثي، ولا نعزل أنفسنا عنه، بل نقحم أنفسنا دون إرادة في صلبه، وكأنه حدث في غرفة النوم الخاصة بنا، ونكون على استعداد لفتح علبة جديدة من المشاعر، نستخدمها في تلك الحادثة.
وأظن أن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي حولتنا لكائنات متلقية لأخبار الحزن، فأنا أفكر في سلوكي أحياناً، لماذا أسارع بالدخول لبروفايل شخص غريب أضافني ليتابع ما أكتب، أفتح صفحته دون مقاومة، حينما أراه ينعى شخصاً لا أعرفه، وأدخل لصفحة الشخص الميت حديثاً، أراقب آخر منشور قام بكتابته، وأتألم كأنه كان رفيق درب، أعرفه كما أعرف أعزّ أصدقائي، دقيقة من الحزن، لا أكثر، كأنني أحمل قنينة ممتلئة بالدموع، وأريد فقط أن أرجّها، وسرعان ما يهدأ الارتجاج، وتعود الدموع لممارسة يومياتها بهدوء.
لقد شكلتنا وسائل التواصل الاجتماعي، فصرنا عربات تحمل الأحزان، منا من يوزعه، ومنا من يتلقاه، وتستمر الفاجعة الإنسانية الجديدة في تكرار نفسها بشكل يومي.
هزّة الموج تشبه إلى حد ما هزّة المبنى
منذ أيام، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، سمعت بالخبر وكنت في كافيه، أشرب قهوتي، على ميناء غزة. كنت أنظر لحظتها إلى البحر، أتخيل هزة الموج، وأتذكر هزة المبنى، وقت الزلزال.
يدخل الجيش الإسرائيلي نابلس ليمارس وحشيته في قتل البشر، بينما تهتزّ الطبيعة لتهدّد الجميع، وهذا ما يمكن اعتباره تكراراً لنفس السياق، مشاعر معلبة سرعان ما تنتهي صلاحيتها، ثم يعود الإنسان لتكرار وحشيته على الآخرين، وكان عليّ أن أفتح علبة مشاعر جديدة لأستخدمها هذه المرة.
هدأت الهزات الأرضية قليلاً، وبقيت الهزة، والصخور الممدّدة بشكلها الموحش في الداخل، نحملها ونمضي بها، مثل بذور مخزنة، لأجل موسم آخر للحزن
ويخرج علينا أصحاب الأفكار التشاؤمية وأدعياء النهايات، في مواسم الحزن، ليؤكدوا على اقتراب الميعاد المعلّق في مخيلتهم حول النهاية السوداء للعالم، وأجيبهم بسخرية: هذا يتطلب فتح جميع عُلب المشاعر!
حاوية
في وقت ما يشعر الإنسان بأنه حاوية تحمل مشاعر تالفة، متعفنة، حواس سوداء، كل حدث يحدث خلاها، يمكن تفسيره على طريقة المغادر، الشخص الذي يحزم حقائبه، وينظر للأماكن والجدران بعين زجاجية. لا يستطيع البكاء، لربما ما في داخله أكبر من أن يبكي، أو يقول للعالم بأماكنه وأشخاصه، كلمة واحدة.
لقد هدأت الهزات الأرضية قليلاً، وبقيت الهزة، والصخور الممدّدة بشكلها الموحش في الداخل، نحملها ونمضي بها، مثل بذور مخزنة، لأجل موسم آخر للحزن.
شادر الحزن الأسود
ولأنني في فلسطين، كانت المأساة الجديدة أسرع مما نتوقع، فتوغل الجيش الإسرائيلي داخل مدينة نابلس بعد أيام قليلة من الزلازل المتكررة، وهو ما ملأ خارطة فلسطين كلها بصراخ أمهات الشهداء، وحمل الجميع شادر الحزن الأسود، وتوقفت الحياة، حتى تلاميذ المدارس تم تعطيلهم، لنعلمهم الحزن والبطالة، مثلنا تماماً.
جميعنا عرف أن هناك شهداء، وجميعنا حمل شارة الحزن داخله، وفي الوقت الذي قلت إن هذا الحزن اعتيادي، لا يحتاج إلى مجهود أكبر للتخلص منه بعد يومين، رأيت فيديو الممرّض الفلسطيني إلياس الأشقر، الذي تم استدعاؤه لغرفة الطوارئ لإنقاذ حالة مستعصية لرجل سبعيني، يرقد هناك.
يصور الفيديو الحدث ليس كما هو، ففي الحدث دوماً لحظة أكبر من الصورة، لحظة لا تتوقف عن تفعيل نفسها، فكان صراخ الممرّض أمام الناس المجتمعين في الصالة: "أبوي لك، يا الله أبوي"، لقد عرف الجميع من بعد هذه الصرخات الجهورية أن الرجل قد استشهد، وأن الممرّض هو ابنه. لقد كان الموت هذه المرة دون زلازل، ودون وحشية من الطبيعة، لكن بوحشية الإنسان كما اعتاد، بوحشية إسرائيل ووحشية الدراما، فكان من الممكن أن يكون ممرّضاً آخراً هو من يتم استدعاؤه لعلاج المريض، وكان من الممكن ألا يتم تصوير المشهد من الأساس، لكنها الحياة والتكنولوجيا، لا تتوقفان عن صنع الدراما، لتأزيم مشاعرنا المعلبة كمان المعتاد.
أبواب مخلّعة
لقد أصبحت هذه المشاعر السريعة، المفجعة، التي تمرّر إلينا بشكل يومي، مثل طبق طعام لا نحبه، لكننا مجبرون على أن نستنشق رائحته أثناء الطبخ، مثل مسرح هزلي بلا كواليس، فصارت صياغة الآلام تتمّ أمامنا، بحيث لا يمكننا الهروب، لابد أن نشعر بالحزن، ولابد أن ننسى، ثم يتكرّر الألم، لدرجة أننا أضحينا أبواباً مخلعة، على مدخل غرفة معتمة، لا يسندها أي شيء، جميعنا قد يسقط دفعة واحدة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.