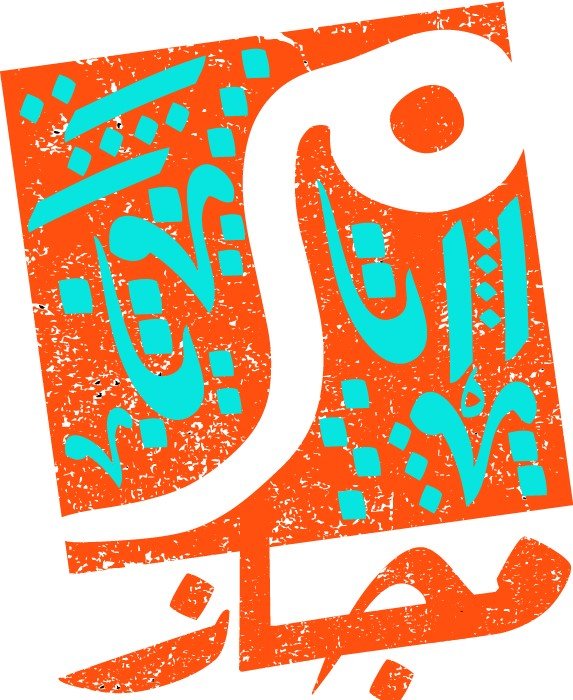 يعيش أهل بلدي
يعيش أهل بلدي
يوقظني هاتفي في السابعة والنصف صباحاً إثر اتصال من أحد الأصدقاء ليخبرني أنه ينتظرني عند بداية الشارع وعليّ ألا أتأخر. أتذكر بعد دقائق سبب تلك المكالمة، فأنهض متأففاً كي أذهب إلى ملعب كلية هندسة المجاور لمنزلي، حتى أتمّ مادة "التربية العسكرية" الإلزامية لأتخرج من الجامعة.
أتأكد من عدم وجود أية شعيرات في وجهي كي أتجنب أية مهاترات، ثم أضع الكاب فوق رأسي المحلوق على درجة "نص". أرتدي القميص الأزرق القميء الذي ابتعته من أجل تلك التمثيلية الإجبارية حتى أتخرّج من كلية كرهتها منذ ثاني عام بها.
أشعر أنني مقيد في طريقي نحو الكلية في الشارع الخالي من البشر الذين ينعمون بالنوم في إجازتهم الصيفية. ألعن كل شيء في طريقي، بداية من استيقاظي المبكر ونهاية بالسؤال اليومي الذي لاحقني منذ انتهائي من امتحاناتي: ما الجدوى وراء كل ذلك؟
أقضي الصباح في طابور طويل، يرأسه عسكري يصغرني ببضع سنوات، وربما لم يكمل تعليمه. يتجمّع في رأسي خلال تلك السويعات إحساس بالإحباط والاستعلاء، مفكراً بأن من معه "الدبلونة" يتحكم في طول مدة تعرّض قفاي للشمس ومظهري العام. يتملقه البعض حتى ننتهي من تلك التمثيلية السخيفة الممثلة بجمل مثل: "محلك سر... ارقد... تحيا جمهورية مصر العربية".
نتجه في النصف الثاني من اليوم إلى قاعة المحاضرات، لسماع كلام من أحد صف الضباط حول الوطنية وكفاح الجيش في حرب 73، وحربه الحالية التي يشنّها على الإرهاب وطوابير الجيل الخامس والسادس وغيره.
يسأل عن وجود صيادلة في القاعة. يوقظني صديقي المتحمّس بزغدة ويرفع يدي معه متطوعاً. يأمرنا بالتقدم نحوه، فأتمنى خلال سيري أن يعفينا ويتركنا نذهب إلى بيوتنا بسلام لنكمل نومنا، لكنه يطلب منا إلقاء محاضرة لتوعية الحضور عن خطورة المخدرات، معطياً إيانا خمس دقائق للتحضير.
أذكر صديقي ووالدته في سرّي بألطف الألفاظ، وأنظر متوتراً لمن يجاوروني. يمسك أحدهم "الحديدة" ويبدأ فـ "الهرتلة"، فأتمنى سيجارة حشيش لتشتتني عما يجري. أفكر أن العالم يتآمر ليقيد حريتي، وأدعو الله أن ينجيني من هذا المأزق، واعداً إياه أنني سوف أحضر كل القداديس التي ستقام حتى نهاية الأسبوع. تتحقق المعجزة حين يعلن الضابط، قبل أن يأتي دور صديقي، بأن وقت المحاضرة انتهى.
*****
"قوم انزل دور على شغل"... "مش ناوي تشتغل؟"... "مش كفاية راحة؟"..."فلانة النهارده قابلتني وسألتني عليك وقالتلي إنها جابتلك شغلانة"..."غيرك بيشتغل من وهو لسه في الكلية"..."صحابك عاملين إيه في الشغل؟".
أقضي الصباح في طابور طويل، يرأسه عسكري يصغرني ببضع سنوات، وربما لم يكمل تعليمه. يتجمّع في رأسي خلال تلك السويعات إحساس بالإحباط والاستعلاء، مفكراً بأن من معه "الدبلونة" يتحكم في طول مدة تعرّض قفاي للشمس ومظهري العام... مجاز
تلك الجمل التي تكرّرت بها كلمة "شغل" لاحقتني منذ يونيو 2019 وحتى التحاقي بوظيفتي في نوفمبر من نفس العام. إن بقيت في المنزل لأشاهد فيلماً أو أقرأ كتاباً، أسمع التعليق من أفراد عائلتي، إن ذهبت إلى الكنيسة، يردّده أحد المتطفلين وكأنني أحصل على مصروفي منه. صرت أسمع كلمة "عمل" في كل مكان، حتى في طريقي إلى طبيبتي النفسية، أكاد أجزم أنني كنت أسمعها من المارة.
لا يفهمون أنني لست مستعداً لفعل أي شيء. أرغب في البقاء وحدي لفهم ما سأفعله في حياتي المقبلة. قد أكون بطيئاً في استيعاب التغييرات، لكنه أفضل من التسرع نحو قرار قد أندم عليه لسنوات مقبلة. لم أحب كليتي ولا أفضّل تجارة الأدوية أو الترويج لها. أحب الكتابة والقراءة والأفلام، لكنها أشياء كما تقول عائلتي: "متوكلش عيش ولا تفتح بيت".
أقضي يومي في منزلي أو في بيت العائلة المهجور بصحبة كتاب ولابتوب. أنتهز فرصة أي قريب يُفتح له المنزل فأذهب إلى هناك بصحبة رواية أسهر معها حتى الفجر، ثم أستيقظ في منتصف النهار بالغرفة التي قضيت بها أسعد أوقات طفولتي.
في منتصف أغسطس، يخبرني أحد الأصدقاء عن رغبته في التقدم لدراسة الماجستير. أتبعه وأبدأ معه رحلة تحضير الأوراق، شاعراً في داخلي أنني لن أكمل، لكنها مجرّد حجّة لشغل وقتي وإقناع من حولي أنني أفعل شيئاً ذا قيمة. أفكر أنني أفتقد ساعات القراءة التي كنت أختلسها وقت المذاكرة، فأقنع نفسي أني سأستعيد ذلك الوقت، و"يحلها ألف حلال وقت البحث عن الرسالة".
تسعد عائلتي بقراري في دراسة الماجستير وتدعمني نفسياً. أستعيد ثقتي بنفسي بعض الشيء وترتفع معنوياتي. ينسون موضوع العمل، وينشغلون معي في رحلة الأوراق التي عليّ استخراجها. يتم قبولي ويتأكد شعوري منذ المحاضرة الأولى أنني لن أكمل هذا الماجستير.
*****
أتقدّم لوظيفة بعيداً عن أجواء مستشفيات الكنائس. أُقبل في مستشفى حكومي يبعد عن منزلي حوالي ساعة. أستغلّ هذا الوقت في القراءة بدلاً من الحديث مع غرباء لا أعرفهم.
يخبروني أن الشرط الوحيد لقبولي في العمل كمتعاقد هو البقاء ثلاثة أشهر دون مقابل. أوافق فوراً.
استوقفني أحد الزملاء بعد نزولي من الباص في أول يوم لي قبل دخولي المستشفى قائلا: "متقلقش كلنا اخوات هنا... وانا أخوك الكبير لو احتجت حاجة متترددش". لم أعرف جدوى تلك الجملة وقتها، وتساءلت إن كان مظهري مذرياً لتلك الدرجة أم أن وجهي جاذب. أدركت فيما بعد أنه كان "عصفورة" المديرة وخازوق كل وافد جديد.
بين العمل خمسة أيام بالأسبوع ومحاضرات الماجستير في اليومين الباقيين، تم شغل وقتي بالكامل. قضيت شهرين لا أنام فيهما جيداً وبالي مشغول بالامتحانات وسؤال أمي الملحّ: "هيمضوك العقد امتى؟".
سيطرت علي مشاعر التقيد في طريقي اليومي للمستشفى. تحولت حياتي ببطء إلى روتين يسجنني داخله. أتحسّر على أيام السهر التي كنت أقرأ خلالها حتى السادسة صباحاً، أو أشاهد مسلسلاً ثم أستيقظ في منتصف اليوم لأعدو على الكورنيش. أستيقظ الآن في السابعة على صوت المنبّه. أرتدي ملابسي بشكل آلي متجهاً بسرعة نحو الكافيه المجاور للباص لأبتاع قهوتي الصباحية. أصل إلى المستشفى، مستمعاً لأحاديث الزملاء حول المرتب الذي لا يساوي تعبهم، ثم ينتبهون لوجودي وسطهم فيصمتون.
أدخل مكان تحضير الأدوية، بعد أن تتأكد المديرة أنني مرتدٍ كل الملابس الإلزامية المعقمة بشكل مهين للغاية، وتوبخني بصوت مرتفع إثر أقل خطأ، كعدم غسل يدي مرتين بالمياه والكحول قبل ارتداء قفازين للتحضير، متجاهلة "عصفورتها" الذي يدخل غرفة التحضير بالحذاء. أتذكّر مرة حين أخبرت أمي بحزن عما يجري، فقالت لي: "كل الأشغال فيها مشاكل، وبعدين صلّي بس أنهم يعينوك، ده انت المسيحي الوحيد في المكان"، لكن صمّت آذان الله عن كل صلواتي التي قلّت تدريجياً مع الوقت.
مر الشهران الأولان، أمرّ خلالهما على كافيتريا المستشفى، أو بشكل أدق الركن الذي يطلقون عليه تلك الصفة، وأقرأ الورقة المعلقة فوق الثلاجة: "ادفع اللي عليك.. طالما المرتب وصل إليك.. إلا أم ايهاب تدعي عليك". كنت أضحك من تلك الورقة في البداية، ثم تبدلت مشاعري تجاهها تدريجياً في نهاية الشهرين إلى غضب. أفكّر أنني لم أقدم القرابين الكافية لمديرتي التي وعدتني بالتعيين مع بداية 2020، حيث كان للعصفورة رأي آخر كما عرفت فيما بعد، فلم أقبض راتبي الأول سوى في مارس.
قالت لي أمي: "كل الأشغال فيها مشاكل، وبعدين صلّي بس أنهم يعينوك، ده انت المسيحي الوحيد في المكان"، لكن صمّت آذان الله عن كل صلواتي التي قلّت تدريجياً مع الوقت... مجاز
*****
"هيحولوا المستشفى لعزل... حظر التجوال هيقلل النباطشيات...هيمشوا التعاقدات عشان مفيش تبرعات".
مع بداية إدراك الحكومة لتفشي كورونا في منتصف مارس، تكاثرت الإشاعات حول مصير المتعاقدين ومرتباتنا التي لن نقبضها. انغمست في العمل والنوبات للحصول على أكبر قدر من المال ليكفيني إن تم فصلي بعد تعييني بشهرين.
تزلزلت حدود الحرية التي وضعتها في حياتي لكي أبقى سليماً نفسياً للعمل وسط المرضى. كنت أكتب بشكل يومي وقتها وأشاهد العديد من الأفلام، ما كان يشتتني عن تعليقات المديرة السخيفة بسبب كلام عصفورتها من وراء ظهري.
فرضت الحكومة قانون العمل بـ"نصف وقت" ، فتمّ تحديد ساعات عملنا إجبارياً، لكن تم تعويضنا مالياً عن أيام اجازاتنا. تنفست الصعداء حينها، حيث لم أكن مجبراً على التخلي عن مساحة حريتي بشكل إجباري. على العكس، تمتعت بفضل كارنيه النقابة بحرية النزول وقت حظر التجوال، وتأمل البحر الذي صارت مياهه شفافة.
بدأت أدخر مبلغاً من المال، وشعرت لوهلة بأن الحياة ستبتسم لي، وليس بسبب يافطات "الجيش الأبيض وغيرها". كانت الفترة التي توقفت بها الحياة عند معظم الناس وتم حبسهم في منازلهم، أكثرها حرية وانطلاقاً بالنسبة لي. كنت أكتب وأقرأ وأخطط للمستقبل بلا قيود. حصلت على جزء من استقلالي المادي ولا أفعل سوى العمل صباحاً والقراءة والكتابة ومشاهدة الأفلام مساء.
لكن مع حلول شهر يونيو، علّقت الحكومة قرار العمل "نصف وقت" وبدأت الحياة تعود لروتينها الطبيعي. تم الخصم من رواتبنا لأتفه الأسباب وتضخمت الأسعار. تعرفت حينها على أحد الأصدقاء الذي أقنعني بضرورة السفر للخارج من أجل مستقبل أفضل، بدلاً من البقاء في بلد يكره أطباءه وصيادلته.
*****
"انت اتجننت؟ سفر ايه اللي تسافره؟ الدنيا خربانة وأوروبا بتفلس... طب ذاكر وانجح ونشوف... سقطت؟ يمكن ربنا مش عايزك تسافر... مصر كويسة بس انت محتاج تشتغل أكتر".
تلك هي الكلمات التي سمعتها حين أعلنت عن رغبتي في السفر. دخلت امتحان اللغة عدة مرات، وصرفت كل ما ادخرته من نقود حتى نجحت في محاولتي الرابعة. استحال الشخص الذي أقنعني بالسفر إلى سرطان يلتهمني حياً مع الوقت. كلما رسبت في محاولة أو تعثرت في التقديم إلى الجامعة يشجّعني حتى لا أتوقف عن المحاولة بحماسة غريبة.
أقنعني أن صداقتنا مهددة بالسفر وأن طريقة حياتي العشوائية ستودي بي إلى الحضيض. راقبت من حولي، وجدتهم يحصلون على رواتب تفوقني أضعافاً، ويعملون ساعات أكثر ويرتبطون. منهم من خطب وآخر في طريقه للزواج وبعضهم أنجب بالفعل.
لم أتأن واندفعت. أذاكر وأعمل. تخليت رويداً رويداً عن كل شيء أحبه لأجل حلم السفر والحرية التي سأقيد نفسي مؤقتاً لنيلها. توقفت عن التفكير في الجدوى من العمل، وإن كنت أحيا لأعمل أو أعمل كي أحيا. لم أعد أقرأ أو أكتب أو أشاهد أي فيلم. ترسب في داخلي إحساس بتأنيب الضمير إن قمت بذلك وورائي العديد من المذاكرة كي أنتهي منها.
أخذت إجازة طويلة محاولاً الغوص في أعماق نفسي، باحثاً عن خيط رفيع يعيدني إلى الطريق الذي رغبت دوماً السير به. أدركت أن هناك طرقاً تبدو منيرة ومفتوحة لكن ليست لي، بينما التي أتشائم من تعرّجها في البداية قد تكون المثالية... مجاز
صرت أدخّن بكثافة لم أعهدها من قبل. أنتهي من علبتي سجائر خلال ساعات العمل والمذاكرة. ابتعدت عن دائرة أصدقائي التي تقلّصت ولم يبق فيها سوى ذاك الصديق الذي يحثني على المذاكرة والانتهاء من أوراقي في أسرع وقت. لم أعد ألاحظ ثقل ذهابي إلى العمل في تلك الفترة. كنت أستيقظ قبل المنبه وأعدو إلى الأتوبيس قبل الجميع.
أعمل لساعات مطولة غير مكترث بعدد الحالات الذي تضاعف بعد موجة كورونا. كنت أسدّ فراغاً خلفه تركي للقراءة والكتابة في داخلي. هزل جسدي وصرت أزعق إثر أقل الأشياء، متحججاً بضغط العمل.
أعلن هذا الشخص في يونيو 2021 أنه سيخطب احدى زميلاتنا. أعجبت بقدرته على الحب وسط كل تلك الفوضى. كان يعمل أضعاف ساعاتي كي يعول عائلته بينما لم أكن مضطراً للعمل. كان دائماً رفاهية من أجل عدم بقائي عاطلاً وحفظ ماء الوجه في الدوائر العائلية.
بعثت حينها بأوراقي وشهاداتي إلى الخارج، وبدأت مرحلة انتظار الردود. قلّت علاقتي به تدريجياً، مع تعمق علاقته بها واقتراب موعد الخطبة. حاولت العودة للقراءة أو الكتابة لكن ذهني ظل مشتتاً. لم أعد الشخص الذي أعرفه. عانيت من الأرق ورأيت المستقبل مظلماً ووجدت نفسي وحيداً به.
فقدت القدرة على دفن همّي في العمل، ولأول مرة منذ تخرجي صار لدي متسع من الوقت لعمل ما أريد، لكنني جلست خلاله في حالة انتظار. قطع هذا الشخص علاقته بي تماماً يوم خطبته، وبعدها بأسبوع عدت للقراءة من تلقاء نفسي. لا أجد تفسيراً منطقياً حول سبب تلك القطيعة، سوى أنني كنت أسد فراغاً أتى غيري ليسده.
*****
أرى من حولي يتزاوجون وينجبون ويتسلقون، بينما أبقى وسط عائلتي، متعلقاً بخيط عمل حكومي يعطيني راتباً بالكاد يغطي نفقاتي، لكنني أقرأ وأكتب. حفرت تلك العادتان بداخلي مقاومة موازية لضغط العمل، من أجل الاستمرار في الحياة متمسكاً بحريتي.
لم أسافر كما خططت لأسباب خارج إرادتي. أخذت إجازة طويلة حينها محاولاً الغوص في أعماق نفسي، باحثاً عن خيط رفيع يعيدني إلى الطريق الذي رغبت دوماً السير به. أدركت أن هناك طرقاً تبدو منيرة ومفتوحة لكن ليست لي، بينما التي أتشائم من تعرجها في البداية قد تكون المثالية لي، وتصالحت مع تلك الفكرة بصعوبة.
*****
"هفضل محبوس بين المستشفى والبيت... مش هتجوز... مش هسافر... مش هحوش فلوس... هعمل ايه في حياتي؟".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


