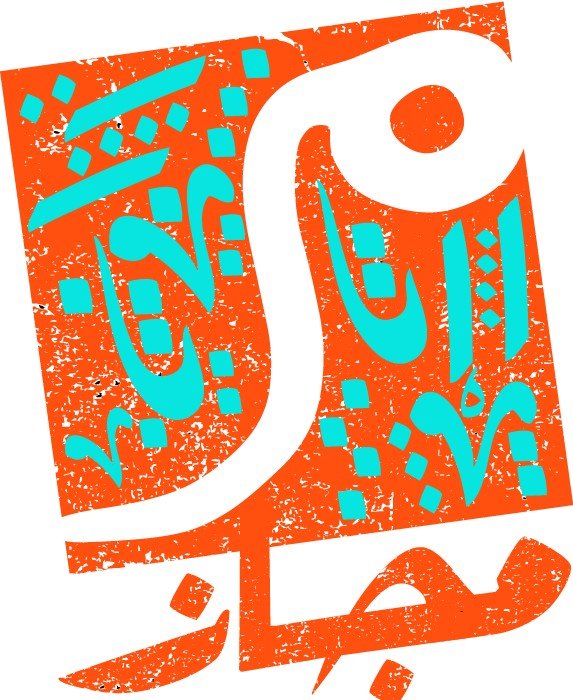 حياكة الكلام
حياكة الكلام
إنها الواحدة بعد منتصف الليل. صوت أم كلثوم يرسل الراحة والسعادة، وعلى غير العادة، لا أشعر بالنعاس إطلاقاً، بل أشعر بأني متحفز جداً لدرجة أنّه يخطر على بالي أن أبعث لكِ رسالةً لتُعدّي القهوة، فأنا في الطريق نحو مدينتك.
أقود سيارتي في الشوارع شبه الخالية، الأمان المريب يخيّم على الأشجار الملاصقة للطريق السريع، وحده المطر يعكّر سكون المشهد بلطفٍ وبطءٍ، نعم أقول "الأمان المريب" لأننا تعودنا في هذه الشرق التعيس على أن تكون الحروب والكوارث والنزاعات الحالة السائدة أو العادية، لدرجة ارتيابنا من لحظات الأمان والهدوء.
كان القمر يلاحق سيارتي من خلف الغيوم ويضيء المشهد وفق مزاجه، أو حسب ما تسمح له الغيوم بذلك، وكأنها زوجته التي ما إن تشرد قليلاً حتى ينظر لأخرى. سيارات قليلة على امتداد الطريق لكنها تومض لي ضوءاً و صوتاً، لا شكّ أني أرتكب خطأ ما في القيادة، و لكنّ المشكلة هو شعوري أنّ كلّ شيءٍ على ما يرام.
أربعينيّة بشعر أشقرٍ قصير، تقود إلى جانبي وتنظر مرةً إلى الطريق و مرةً إلى جسدها، تتساءل في نفسها إن كان فستانها الأحمر فاضحاً كثيراً، أو ليس فاضحاً كفاية ليشتّت انتباه الناظر عن بعض تجاعيد وجهها. لطالما تساءلتُ في نفسي إن كان بالإمكان حل مشكلة التجاعيد من خلال تغيير اسمها، كأن نُسميها "تفاصيل".
تسرع الأربعينية وتختفي على الطريق السريع ليأتي مكانها رجل بربطة عنق حمراء وإلى جانبه امرأة جميلة، بالرغم من وجود طفلين في السيارة، إلّا أنّي أعتقد أنهما غير متزوجين، لأنّه كان يمسك يدها بشغفٍ و هو يقود، يتحسّسهما باهتمام واضح أكثر من اهتمامه بالطريق، وحتى أكثر من اهتمام تلك الأربعينيّة بالجزء البارز من ثدييها، فعادةً ما ينسف الزواج هذه الجزئيات، و يطويها في أحد صفحات كتاب "ذكريات الزمن الجميل ".
فستان أسود يُظهر ربلتيك، وعشرة أصابع مستلقية في سريرين أسودين كزورقين متخمين بأرغفة الخبز الطازج نحو الضفة المحاصرة، يا إلهي إنها الحرب مجدداً تُقحم تفاصيلها في رأسي وتفرض عليّ ما أراه... مجاز
بعد كلّ هذا وصلتُ بيتكِ أخيراً.
فستان أسود يُظهر ربلتيك، وعشرة أصابع مستلقية في سريرين أسودين كزورقين متخمين بأرغفة الخبز الطازج نحو الضفة المحاصرة، يا إلهي إنها الحرب مجدداً تُقحم تفاصيلها في رأسي وتفرض عليّ ما أراه.
طاولة خشبية صغيرة عالية القوائم، فنجانان فيروزيّان وربلة على ركبة، الأخيرة تكسب الدفء والأولى تحصل على شكلٍ جديد، حبذا لو تعلمنا منهما سرّ العلاقات الصحية والمتينة، وهي المصلحة المتبادلة، من يقول إن العلاقات يمكن أن تستمر بدون مصلحة؟ فقد تكون مصلحتي أن أرى ابتسامتك في الصباح، فهذا ما يجعلني أعمل عليها طوال الليل.
صوت كوكب الشرق "لا أنا أد الشوق وليالي الشوق" يخفت على وقع ضربات المطر على الزجاج، كما يخفت صوت القرآن وسط ثرثرة المعزّين، وصورة لكِ مع أختكِ الكبيرة المسافرة و أبويكِ إلى جانب النافذة الزجاجية الكبيرة التي تتزين بمسارات المطر العمودية وهي تنبطح على زجاجها، فتُعطي حضوركِ طابعاً ملحمياً.
بين كل هذه الأصوات تطغى رشفات القهوة من خلف شفاهك، يُنهيها اصطكاك الفنجان بصحنه.
*****
أحسّت بارتباكي وصداعي، فاقتربَت وأخبرتني أنّ أمها ذهبت لتنام عند جدتها المريضة، واضطرّ والدها لأخذ طفلَي أُختها المسافرة إلى المشفى بسبب الحمى، وهذا كان سبب قبولها السريع بمجيئي حيث تخاف أن تبقى وحيدةً في منزلها الكبير ذي الطابقين.
اخترتُ أن أنتظر قليلاً حتى أقرّر، هممتُ نحو النافذة الزجاجية لأتفقّد الطقس، اقتربتُ أكثر نحو صورة العائلة. هنا أصابني الصداع، جمدَت عيناي، الأربعينية والرجل ذو ربطة العنق الحمراء مع ابنتيهما في الصورة!
تذكرتُ فجأةً أني لم أحب القهوة يوماً، ثمّ تذكرتُ أيضاً أني لا أجيد القيادة، لأني لا أملكُ سيارةً أصلاً! لم أعد أستطيع الرجوع، لأني لم أعد قادراً أن أكتب طريق العودة، لا أعرف كيف وصلت ولا أعرف كيف أعود... مجاز
تذكرتُ فجأةً أني لم أحب القهوة يوماً لأنها تقطّع معدتي، ثمّ تذكرتُ أيضاً أني لا أجيد القيادة، لأني لا أملكُ سيارةً أصلاً! وتذكرتُ أن الطبيب حذرني ألّا أكتب أبداً عندما أثمل، لكني هنا عندكِ في البيت لم أعد أستطيع الرجوع، لأني لم أعد قادراً أن أكتب طريق العودة، لا أعرف كيف وصلت ولا أعرف كيف أعود.
لذا عدتُ إلى الداخل، هبطتُ بثقلي على الأريكة، كان أشبه بالسقوط الحر، هنا مرّ شريط الحياة سريعاً أمامي، لكن دون حدود واضحة، لا أعرف أين البداية ولا أعرف أين النهاية.
عصرتُ ذاكرتي جيداً علّني أستذكر اللحظة التي دخلت بها إلى غرفتي أو اللحظة التي جلست فيها على طاولتي وبدأت بالكتابة... حاولت عبثاً أن أرتب مراحل حياتي، ولم أعد أميز بين ما كتبته وما عشته، ثم بدأت أشكّ في نفسي، هل هذه ذاتي الحقيقية؟ أم أنها إحدى الشخصيات التي أكتب عنها؟ هل يوجد داخل رأسي من يكتب هذه اللحظات التي أعيشها، أم أنني داخل رأس من يكتب الآن؟
غرقت في دوامات التفكير، يشتد الصداع فتشتد معه الأسئلة، وكلما حاولت استذكار اللحظة التي مشى فيها قلمي على الورق، تتفجر في رأسي صورة طفلٍ خرج للتوّ من رحم أمه، تُغطيه إفرازات الولادة، تتداخل الصورتان في رأسي لدرجة لا أقدر على فصلهما أبداً.
*****
يُطرق باب بيتكِ، وتبعث طرقاته القوية الرعب في جسدي الذي لم يعد يتحملني، وكأنه يلعن الساعة التي حللتُ بها داخله. مشيت مترنحاً، فلطالما كانت الأسئلة تُسكرني والأجوبة تثير النعاس في عيني، سألتُ: من الطارق؟ لم يُجب أحد. كررت السؤال عدة مرات ولكن لا إجابة سوى طرقات أقوى من سابقتها،
استجمعتُ ما تبقى لديّ من شجاعة وفتحت الباب، ولكن لا أحد، سوى قلم وبجانبه ورقة مُلقاة على الأرض. تناولتها بجزعٍ شديد، وكان هذا النص مكتوباً عليها، خلفها يوجد ورقة بيضاءُ أُخرى... نعم إنه طريق العودة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


