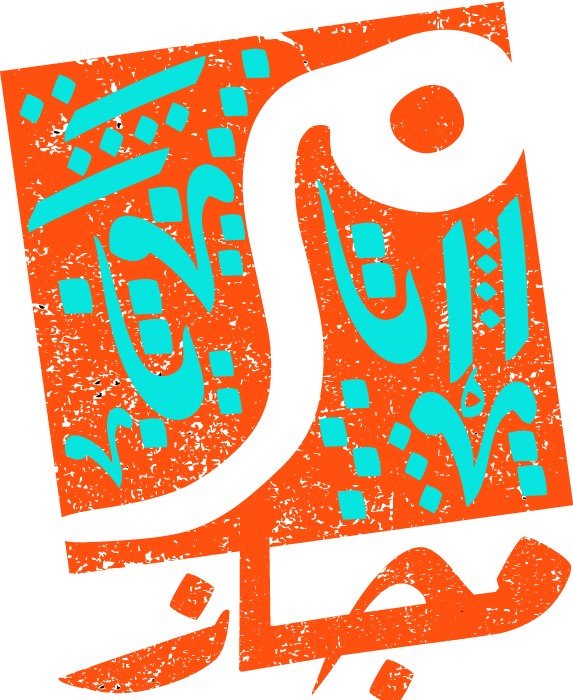 الشتات
الشتات
دققت بنظرتها. لربما قاسمنا المشترك الأوحد، إلا أنها مخضرمة بالقياس لخاصتي التي لم تجرّب الكثير. وضع "المهرّب" في كفي جواز سفر لامرأة تقاربني سنّاً، بشعرٍ أسود كشعري، التفاصيل المتبقية جعلتها رسميّة الصور أقل وضوحاً: نحن أبناء الشتات، نبتكر ويُبتكر لنا أسرجة نمتطيها ونقفز بها فوق القوانين كلّها، علّنا نصل وطناً.
بعد أن عجزت همزة الوصل في كلمات العشق وكتب الوطنية في تلك البلاد أن تخيط شرخاً يتّسع وإشراقة كل شمس، لجأنا إلى المجهول، علّه يمنحنا هُوية ما، فتتنكر لنا ذواتنا ولا نعرفها.
*****
كانت نسمة يونانية أعلنت عن شتاءٍ يخايل تحت ثوب الخريف الشفيف، العاشر من أيلول، تاريخ صعودي أنا الإسبانية الى الطائرة. أترقب وقلبي يمسك بيدي، فبأي لحظة يستحيل المطار غولاً يبتلع كلّي.
المرأة التي يجب أن أكون، أعطيتها كل تفاصيلها حتى التي جهلت، قالت سوسن إن عليّ خلع الحجاب حتى لا يشك بانتحالي للشخصية، فأسبلت لخلف الصورة شعري، ونجح خصري بتحديد طوله لا الصورة. كان لها ملامح الغجر التي شاهدتها في مسلسلات المكسيك وأميركا اللاتينية، بشرة سمراء كقمحٍ قديم، وكحل عربي والكثير من غموض الغجر، وحده لم يستدعِ مني الجهد.
جربت بفنجاني فيضاً من حرفية الغجر، جلست عند الشرفة في أوتيل ساكرتيز، وعلى ضوء الغرفة الخافت وضمن ليل البنّ الحالك، استطعت أن أميّز ثلاثة أحصنة دون لجام.
جاء الصبح، ولأني اليوم غجرية تؤمن بالإشارات، جعلتْ الحقيبة الثالثة من السوق مقصداً ملحّاً. كان سوق موناستيراكي القريب مليئاً بالأشياء المغرية لنا نحن الغجر. ابتعتُ من الثياب تنانيرها الواسعة، حتى هنا ثمة من يعطي لـ"البالة" قيمتها الحقيقية.
انتباهي الذي غدا معدناً جذبته حلي الفضة بمغناطيسها، بحثت عابثة بينها علّي أجد رفيقاً مشابهاً لقرطي، دون جدوى. حسناً سأضعه في أنفي وأبتاع آخراً غجرياً يليق بتاتونيا الجميلة.
كيف للبائع أن يعي طلبي فأنا أريد ثلاثة أقراط متشابهة، شحمة أذني التي ارتقت شهيدة تحتاج لشاهدتين، ها هي اليوم كحزّي يوسفي صغار. وقفت أمام البائع وبالعربية: "سيدي، أخذ رجل الأمن قرطي عنوة حين عاند بأن يُفكّ، لا يفهم رجل الأمن أي عناد ولا يتقبله."
حالما رأى الرجل أذني صرخ: "أووووه". فهم وضحك. ناولني علبة انتقيت منها ثلاثة أقراط، كمان، رِقّ واكسليفون. لابد أن تاتونيا ستكون ممتنة لهكذا انتقاء.
وضعت الأقراط في الإشارة الثالثة، بصحبة طلاء الأظافر الأحمر.
وضع "المهرّب" في كفي جواز سفر لامرأة تقاربني سنّاً، بشعرٍ أسود كشعري، التفاصيل المتبقية أقل وضوحاً: نحن أبناء الشتات، نبتكر ويُبتكر لنا أسرجة نمتطيها ونقفز بها فوق القوانين كلّها، علّنا نصل وطناً... مجاز
******
رجل حمل علبة، وحالما تيقنت بأنها كؤوس زجاجية ضحكتُ بادئ الأمر، وبعد أن أعادت ماكينة الذكرى تطريز مشهد أليم، بكيتُ لحالِ حبٍّ يُحتضر، خطر في بالي العودة لأسأله: "هل ابتعتهم لتقايض بهم الحب؟".
مسكينة من تساوم حبيباً بكؤوسٍ تافهة، أردّدها جهراً وأتحسّس خدي الأيسر، لا زالت الصفعة مؤلمة هنا. لا تهربي مع عاشقٍ يلوذ بجدته، كل الجدّات سيئات يا تاتونيا.
مشيتُ في السوق المرصوف وكأني أدوس على حطام زجاج. تألّمتُ كأن المشهد يتكرّر واقعاً ليس فقط في الخيال. تلك العجوز الخبيثة، انتقمتُ منها، كسرتُ لها زجاجها كاملاً، وعجزتُ عن الإفلات من عقابٍ ترصّد بي عند الباب، ضربني ولحق بي في أرجاء المنزل، أركض فوق الحطام لحين سفحت بلاطات البيت دمي.
******
لابد أن الشال البرتقالي يتناسب والثوب البني… ربطتُه على خصرها النحيل، ثم حرّرتها من السوتيان، تحسّستْ بدورها مكان الثدي الأيسر، وربتت على كتفي: "لا بأس، جميلة بثدي واحدٍ أيتها العربية! فما الحاجة لاثنين".
ندبات ثديي المبتور خدشتْ باطن كفها، ولم تسألني عنه، تصالحتْ تاتونيا مع نقصي الذي أخفيته بلبادةٍ لعشرِ سنوات، نعم هذا الفرق بيننا وبينهم.
أخرجتُ الإبرة ودوّرت ولاعتي: "تباً أين أنت أيتها القحبة، تختفين حين أحتاجك دوماً. آه تاتونيا اعذريني، لا أدخن".
لكن لا بأس بالكحول، سكبتُ من الهوبنتك (ماركة عطور) فوق القرط الدائري حتى اقتنع أنه تعقم، أدخلته عنوة في أرنبة أنفي. نزف الدم، لكنها صمدتْ، فالغجريات لا يتألمن. تركتها وأوراق التاروت، وخلدتُ للنوم مع ألمي الذي يئنّ.
*****
في الصباح، وقبل بزوغ الشمس الشقراء، هممتُ لطلاء الأظافر كأني أتحضّر للقاء. أحب هذا الاهتمام حين أشرع بقراءة نشرة دوائية أو أبتاع منتجاً ما أجرّبه لأول مرة. بدايةً قلّمت أظفاري، فتلك الغجرية عليها أن تغسل ملابسها وتكنس خيمة جدتها، تلبس الحلي ليلاً وتذهب للسيرك، ترمي الودع وتقرأ الأكفّ. لابأس ببعض الطلاء الأحمر. رسمتُ ظفرين به على السبابة والوسطى، ثم طليتهما بعناية، فاختفى الخط الفاصل كمطبٍّ بين الظفر الجديد الآخذ بنموٍ بطيء وبين لحم الإصبع. ضحكتُ بتشفٍّ حين تردّد صوت رجل الأمن في رأسي: "هلق كل ما بدك ترفعي علامة النصر، رح تتذكري صرخات الوجع".
وأنا التي أغفو وأفرد من الأصابع وسطاها وسبابتها، أردّد الكلمة السحرية لحين أغفو كل ليل.
كتبتُ على باطن الساق بدءاً من الكاحل: "أنا الغجرية التي لم ترتحل يوماً"
*****
عند باب الفندق، أخذتني سيارة الأجرة للمطار. قالت سوسن: "عادة لا يسألون إلا عن الأمتعة وعدد الحقائب، وباللغة الإنكليزية". طوال نصف ساعة وحتى الوصول، أحبك العبارات مع بعضها، لتكون جواباً مقنعاً.
سألني الوسيم سؤالاً افترضته عن متعة الإجازة. ورّد خداي وهجاً متصاعداً. ابتسم الشاب، ولا بدّ أدرك أن الغجريات لا يتقن اللغات!. مهر الجواز وناولني إياه، قلت له بلغتي العربية: "هل تعلم بأن لديكم من الأضواء في هذي القاعة ما يلغي التقنين عن بلدي البائس؟!". لحظة أذنت لابتسامة دافئة رسمها ثغر الوسيم، لم يعِ شيئاً لكنهم بارعون في المجاملة. رفعتُ حصاني الثالث بلون الكركم وتابعت بالعربية "هذه الحقيبة الجلدية، هي أفضل ما حصل لي في بلادكم". لم يستغرب لغتي، فالغجر يهذرون بأي لغة يتناولونها من جيوبهم.
*****
ها هي برلين فتحت ذراعيها للغجريات اللاتي يعبرن القارات بسلاسة وإن كان بجوازٍ مزيف.
من تراه ينتظر تاتونيا هنا، حبها الأول الذي خسرت، أم جدتها المضطهدة المريضة في إحدى خيم برلين؟ آه يا جدتي المسكينة كم افتقدتك.
برلين، مدينة المجهول والعبث، تراكِ تنصفيني؟
ربطت الشال على خصرها النحيل، ثم حرّرتها من السوتيان، تحسّستْ بدورها مكان الثدي الأيسر، وربتت على كتفي: "لا بأس، جميلة بثدي واحدٍ أيتها العربية! فما الحاجة لاثنين"... مجاز
في حين أنتظر روتين المطار، تذكرت بأني نسيت الوشم، لابد أن هناك واحداً على الأقل على خارطة تاتونيا. تناولتُ أنبوبة الحناء من حصاني، جلستُ على مقعد جلدي، رفعت قدمي… أسندتها برفيقتها، وبدأت الكتابة بدءاً من الكاحل صعوداً لباطن الساق، لا عبارات تليق بالمقام، فلتؤجل الوشوم إذن.
مررتُ بجانب سوسن التي رفعت لافتة كُتب عليها اسمي، لم أسلّم عليها حتى، وبدورها لم تتعرف علي. رمقتني بنظرة أتبعتها ابتسامة بلهاء ركّزتْ على أقراطي الموسيقية.
حال وصولي لجسر يطل على نهر، وقفتُ معلنة كل تمرّد، قصصتُ خصل شعري الغجري ورميتها قرباناً للتزوير، لعلّ آلهة المدن المضاءة تشفع. ألحقتها بجواز سفري الإسباني وهُويتي السورية. أغمضتُ عيني وصرختُ بأعالي الصوت: "لا رجال أمن ينتزعون الأقراط… ولا جدّات يحصين الأطباق… لا تقنين، لا خوف لا طوابير، لا…". أحاول التذكر وأنا أرفع الوسطى والسبابة، وأضحك مع دموع الخيبة المنتصرة.
وها أنا ذا، من شرفتي المطلّة على أشجار برلين العجائز الصفر، فتاة دونما انتماء، أقف وأغني: "خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلية"، وأندب حظ حبات الخوخ التي سقطت سهواً تحت شجيرات المشمش.
أتسكّع بتنورتي المبالغة بالاتساع في الأسواق، أقرأ الأكفّ، وأرحّب بقبلات يطبعها المعجبون بعد الاستئذان، يتصور معي الجميع إلا نساء يغرن ممن تفوقهن جمالاً.
وفي يومٍ حرّكت الذكرى مستنقعات الحزن الراكدة فيه. فتحتُ كل الملفات البائسة. حرقت الكثير من هفوات العمر في منفضة السجائر، ولجأت لطلاء الأظافر علّ التركيز يشتت الحزن قليلاً. قُرع الباب بشدة. بابي الخشبي أعطى صدى الحديد، فانسكب طلاء الأظافر على ثوبي الأصفر. هرعتُ للباب، صوتٌ عربي في برلين؟!
"صار بتمانية". لم أتردّد بالاندهاش كرّرت: "تمانمية؟!". "إي والله يا مدام كل شي عم يغلى يعني مبارح قلنا سبعمية بس والله ما وفّت".
فتحت حصاني، نعم نقود سورية، أخرجتُ منها طلب الشاب. مسحت بها ما علق بكفي من طلاء أظافر. ناولته إياها ليضع بدوره بيدون الماء الأبيض داخل عتبة الباب الحديدي. عدتُ لأنبوب الحناء. أدركتُ العبارة الأنسب، وكتبتُ على باطن الساق بدءاً من الكاحل: "أنا الغجرية التي لم ترتحل يوماً".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


