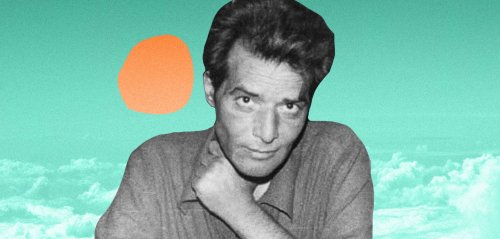استيقظت في الصباح الباكر بلا هدف محدّد. الساعة تدق الثامنة ثم التاسعة. كوب النسكافيه الممتلئ للمرة الثانية لا يفارق يدي، واليد الأخرى تقلّب في الهاتف، أتفحّصه بلا جديد يذكر. تأتي رسالة غير متوقعة: "أنا نازلة الحسين، تيجي أشوفك؟". صديقتي التي لم أرها منذ قرابة الخمس سنوات. أجبت على الفور بالموافقة، رغم كل مخاوفي من المفاجآت غير المتوقعة.
تقابلنا، لم تتجول رحاب كثيراً في القاهرة القديمة. يلفت انتباهها كل شيء، الجدران، الشبابيك، أشكال البيوت القديمة. أسير بجانبها وأنا لا أتطلع سوى إلى وجهها الذي تملأه الدهشة، ويملؤني الاستغراب.
الأسبوع التالي قادتني الصدفة لمقابلة صديقة أخرى، كانت قد أبدت إعجابها بملابسي وتصميماتها، فأخبرتها عن "الترزي" الذي أتعامل معه في الجمالية. طلبت مني أن تزوره، وتكررت على وجهها علامات الاندهاش والإعجاب بالمكان، وارتسمت على وجهي ابتسامة بليدة وأنا أسمع حماسها: "يا بختك يا شيماء إن بيتك هنا".
ثمانية عشر عاماً عشتها في شارع "أم الغلام" بالجمالية. يلاصق منزلي مقام السيدة فاطمة "أم الغلام" ، صاحبة البركات التي تأتيها النساء من الريف والصعيد رغبة في الزواج، أو بحثاً عن مولود. خلف المنزل يقع مسجد الحسين، الجامع الأشهر على الإطلاق لدى محبي آل البيت. إذا اتخذت مساراً شمالياً بعد منزلي، ستسير نحو "قصر الشوق"، ثم "بين القصرين"، ثم يتعرّج بك الطريق، فتسير نحو "خان الخليلي" و"السكرية". يبدو الأمر مدهشاً حقاً، فأنا أعيش وسط رواية أو ربما فيلم سينمائي، إذن لماذا لا تفارق مخيلتي أبداً فكرة الهرب؟
"كم مرة شعرت بهذا الشعور... عندما جلست بوسط مجموعة من البشر تتحدث معهم وفي داخلك تردد هذه المقولة: أنا لا أنتمي إلى هنا"، نجيب سرور.
إذا اتخذت مساراً شمالياً بعد منزلي، ستسير نحو "قصر الشوق"، ثم "بين القصرين"، ثم يتعرّج بك الطريق، فتسير نحو "خان الخليلي" و"السكرية". يبدو الأمر مدهشاً حقاً، فأنا أعيش وسط رواية، إذن لماذا لا تفارق مخيلتي أبداً فكرة الهرب؟
ثمانية عشر عاماً من الحياة بمكان لا أنتمي إليه، جئت بصفة "مؤقتة"، ولم تمنحني السنوات صفة بديلة، لست من ذلك النوع من النساء اللائي لا يعرف معنى الحياة في حي شعبي، فقد ولدت في بولاق أبو العلا، الحي الذي بناه الفرنسيون ترسانة لبناء السفن، عشت بها أغلب شبابي، لكن ثمة فارق بين بولاق والجمالية، فارق بين أن يحاوطك النيل وإن كان بعيداً، وأن يحاوطك سور يعزلك عن العالم أو يعزل العالم عنك.
لم يكن السور الذي بناه جوهر الصقلي حول القاهرة القديمة، هو السور الوحيد الذي عزلني هناك، لكن الحي كله كان أكبر من سور، جدار ضخم عازل بينه وبين الغرباء الذين لا يشبهونه، على مدار ثمانية عشر عاماً لم أستطع أن أشبه الجمالية، فلم تحبني، فتحت لي من الأبواب بقدر ما فتحت لكني ظللت أشعر أنها لا تقدم لي ذلك عن محبة. شيء ما كان دوماً يجعلني "مش من هنا".
أربعون عاماً ويزيد، هي عمري الذي قضيته متنقلة بين ثلاثة أحياء، بولاق أبو العلا الذي غادرته في العام الأخير من الجامعة، إلى حدائق المعادي، حيث الخيار الوسط بين عشوائية دار السلام و التمحّك برقيّ حي المعادي، ثم أخيراً الجمالية، حيث سكنت غريبة واستمريت على غربتي طيلة عمري فيها.
في أحد الفيديوهات التي سجلها جمال الغيطاني مع نجيب محفوظ عن حياته في الجمالية، يقول الأديب العالمي: "غادرت الجمالية في الثانية عشر من عمري، وحينما عدت إليها شاباً، نظرت لها بعين السائح".
يزيد عمري في الجمالية عن عمر محفوظ حين غادرها، وعيني التي رأيتها بها كشابة وزوجة وأم، اختلفت عن عين الشاب المتجول بلا هدف سوى التماس حكايا البشر. كنت أنا وسط الحكاية التي يشاهدها السائح محفوظ، كنت صاحبة القصة، التي بدأت في 2006 بـ "هنعيش هنا سنة ولا اتنين لحد ما الأمور تتظبط وننقل". لم تنضبط الأمور أبداً، ليست حياتي وحدها التي لم تنتقل إلى ضفة أخرى، لكن لم تعرف البلد بأكملها انضباطاً منذ ذلك الحين.
مع اندلاع ثورة يناير في 2011، كنت "الغريبة" التي تسير في الشوارع الصامتة تهتف بسقوط النظام، يلاحقني زوجي محاولاً الإمساك بي والإفلات من جحافل المؤيدين لمبارك. كنت بينهم "البت بتاعة كفاية"، رغم عدم انتمائي يوماً للحركة المعارضة. نجحت ثورة يناير نجاحاً "مؤقتاً" ومعها تغيرت حياتي، عدت لعملي بالصحافة الذي تركته بعد الزواج والإنجاب. لم أعد غريبة في الجمالية، صرت "الأستاذة".
الألقاب في الجمالية لا تطلق عادة على النساء، يحملها الرجال فقط، بينما النساء هن أم فلان أو مدام فلان، على أقصى تقدير، لكن أبداً لم يهبني أهالي الجمالية تلك الألقاب الحميمية. كنت "الأستاذة الصحفية" دلالة واقعية على اغترابي عن المكان وأهله. لم يقبلوني منهم أبداً، رغم ابتسامي في وجه الجميع، ومعاونتي لهم بحكم المهنة، وحديثي الصباحي مع بائع الخضار حول أحوال الناس، ومسامرتي لعم بديع، صاحب عربة الفول الذي يرسل لي سلامه كل صباح مع كيس السلطة المفضل لدي: "السلام أمانة للأستاذة... ده كفاية ضحكتها وهي داخلة المحل". لماذا لم تجعلني تلك الضحكة أكثر حميمية من ذلك يا عم بديع. رحل بديع الطيب وأنا لا أعلم متى ستفتح لي الجمالية قلبها و ليس أبوابها فقط.
في الأحياء الشعبية، الأب ليس هو البطل في قصص الأطفال، الأم هي التي تفرض سطوة أبنائها، وفي الجمالية لن تحمي نقابة الصحفيين أبنائي، وارثي انعزالي وملامحي، من التنمّر بهم كغرباء عن الحي الذي ولدوا به ورغم ذلك لا يعرفهم أحد، لذا لم يكن هناك مفر من إعداد سلاح خاص وانتظار المناسبة، اخترت "العباية السمرا" كسلاح، وجاءت المناسبة حين تهجّم بعض الأطفال على طفلي وهو في السادسة من عمره. لم يتخيل أحد أن الأستاذة ستصرخ في الشارع وهي تمسك بملابس طفل يقارب طولها: "فين أمك يالا، عشان لو ما بتعرفش تربي نعلمها تربيك إنك ملكش دعوة بحد... لا أنت ولا أي حد في المنطقة دي له دعوة بعيالي". سكت الجميع واحتضنني طفلي، ولم أحتج بعد ذلك للعباية السمرا، فاستقرت بالدولاب.
خضت الحرب ضد الاستغفال عشرات المرات، في كل مرة أقول ذات الكلمات: "انتوا فاكرني من الزمالك". في النهاية أصل لما أريده، لكني أصل منهكة
"جوز أخته الشرير"، العبارة الكاشفة للكاتب أسامة أنور عكاشة، في إشارة لدور المنتصر بالله على تتر مسلسل "أرابيسك"، الصفة الواضحة لرمضان الخضري، التي لا ينخدع فيها سوى الغرباء عن الجمالية، كذلك أغلب من عرفتهم في الحي القديم، يحملون ذات الابتسامة المرحبة والوجه البشوش، لكن الأمان هو آخر ما تجده هناك، ففي الغالب سيخدعك من ابتسم بوجهك.
خضت الحرب ضد الاستغفال عشرات المرات، في كل مرة أقول ذات الكلمات: "انتوا فاكرني من الزمالك". في النهاية أصل لما أريده، لكني أصل منهكة. الشعور الدائم أن أحداً تبتاع منه وتشتري سيغشك عاجلاً أم آجلاً شعور ثقيل، لم أتجاوزه حتى بعد تحذيراتي المتكررة، لكن يبدو أن الأمر كان لابد أن يتجاوز التحذير، واستوجب إنهاء الصراع أن تتخذ المشاجرات منحى آخر من الألفاظ التي تأكد بها أهل الجمالية أنني بالفعل لست من الزمالك.
لسنوات عديدة عانيت من الاكتئاب، فقدت الكثير من الكيلوجرامات الزائدة، تخلى عني الحجاب، وتخليت أنا عن الحياة. اختبأت بمنزلي لشهور لا أرى أحد، فقط كانت حبوب الاكتئاب تعينيني على القيام بمهامي اليومية ثم العودة لفراشي للاحتماء به. شراء الدواء من إحدى صيدليات الجمالية، كان مناسبة ليسأل الصيدلي زوجي: "لمن هذا الدواء؟"، فيرد للمدام. "الأستاذة اللي شوفتها مع حضرتك؟". هز زوجي رأسه علامة الموافقة،
فنصحه الصيدلي: "بلاش الأدوية دي، خليها تمشي من هنا".
النصيحة لم تنفذ حتى اليوم. ذهب الاكتئاب تاركاً أثره بطيف من الرهاب الاجتماعي، وأسئلة من أهالي الجمالية لا تنقطع عن الأستاذة التي لا تشبههم.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.